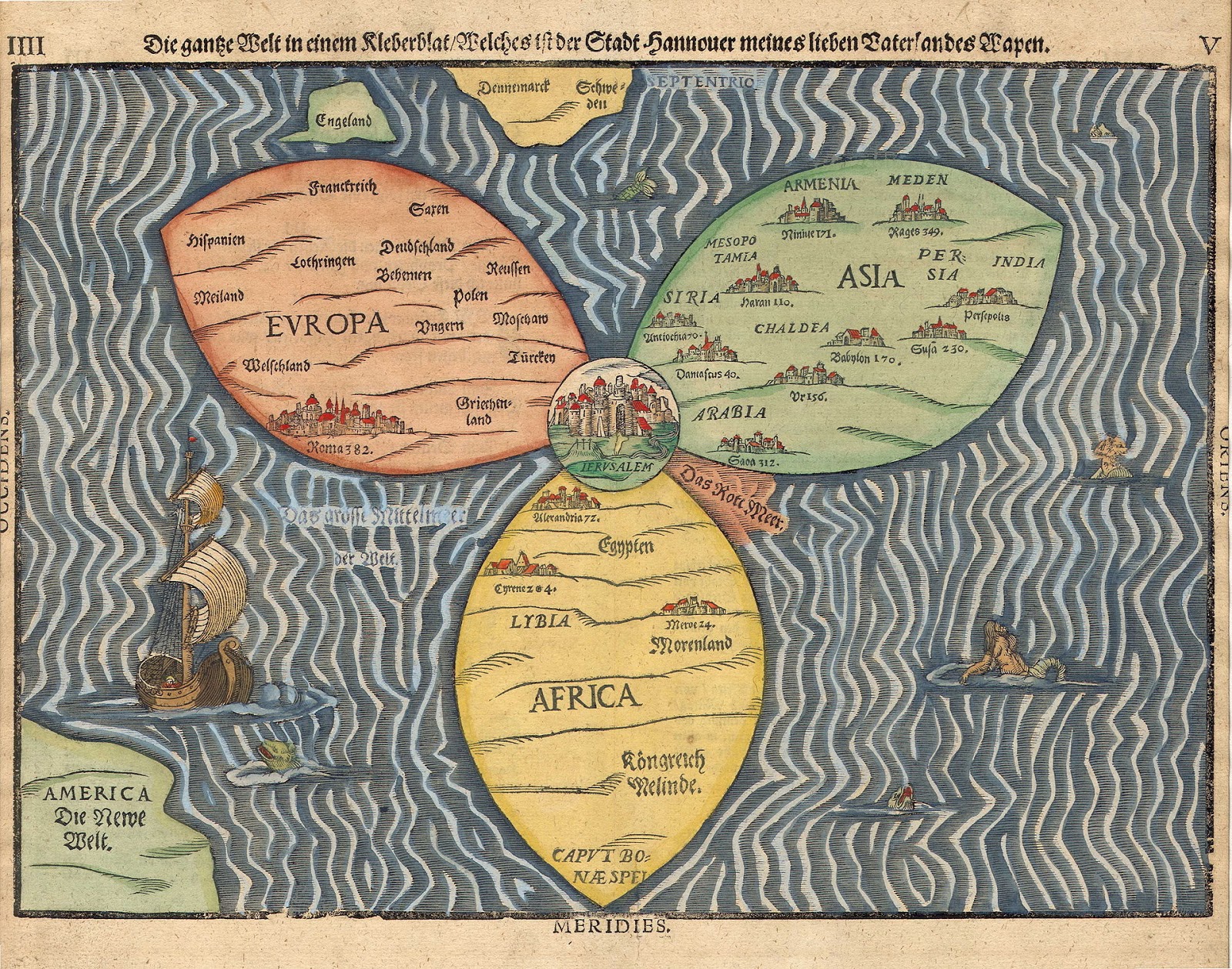ولد فوزي القطب لعائلة مقدسية في دمشق في العام 1917. وصفه المؤرخ الأمريكي J. Bowyer Bell بأنه لم يكن يشبه العرب أبداً، فارع الطول أشقر وعيونه خضراء، “يبدو أن الصّليبيين قد نسيوه خلفهم بعد الحروب الصّليبة”، فلا تكاد تميّزه عن أي أوروبيّ، وقد أجاد الإنجليزية منذ مراهقته لعمله في المطبعة الحكوميّة البريطانيّة، كما أجاد اللغة التركيّة عن أمّه، كما كان مولعاً بتفكيك الأشياء وإعادة تركيبها.
“حرّروا الأسرى السياسيين أو الموت المؤكد لكم جميعاً”، وُجِدت هذه العبارة مكتوبةً على مطويةٍ ممهورةٍ بتوقيع “المقاتلين الأناركيين الأمريكيين”، على بُعدِ عدةِ شوارعٍ من مكان الانفجار. كان الأناركي “ماريو بودا” في العام 1920 قد ساق عربة الحصان التي أثقلها بحمولةٍ كبيرةٍ من الديناميت ليركنها مقابل شركة “جي بي مورغان” في “وول ستريت” في نيويورك.
“عربة بودا” كان الاسم الذي منحه “مايك ديفيس”، مؤلف كتاب “تاريخ السّيارة المفخخة”، لتلك الحادثة، معتبراً أن “عربة بودا” هي النموذج الأول للسيارة المفخخة، التي تحوّلت لاحقاً، وبشكلٍ فعّالٍ، إلى سلاحٍ شبه استراتيجيٍّ. بدا كأن الأمر يسير وفق المعادلة: “امتلكْ سلاح طيران بسيارةٍ مسروقةٍ و400 دولار”.
ففي ظلّ ظروفٍ معينةٍ تستطيع السّيارةُ المفخخةُ أن توازي في فعلِها ووظيفتها فعلَ ووظيفة سلاح الطّيران لقدرتها على استهداف المواقع الحضريّة الحيويّة والحساسة، واستهداف المقرات الرئيسية للتّحكم والسّيطرة، بالإضافة لقدرتها على إرهاب الجمهور، كما أنّها تتماشى مع نظرية القصف الاستراتيجيّ.
يتتبّع “مايك ديفيس”، في كتابه، تاريخ المفخخات التي غابت بعد “عربة بودا” لحوالي عقدين، لتظهر مرةً أخرى في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، وذلك حين قامت منظمة “شتيرن” الصهيونية بتفجير مقر الشرطة البريطانية في حيفا في العام 1947، مروراً بمفخخات “سايغون” التي استهدفت الاستعمار الفرنسي في فيتنام في العام 1952، ومفخخات “الفلاقة” الجزائريين عام 1962، التي من الواضح أنها استُلهمت من التّجربة الفيتنامية عبر المقاتلين الجزائريين في الجيش الفرنسيّ العائدين من فيتنام، بالإضافة إلى مفخخات الجيش الجمهوري الإيرلندي، ومروراً بالحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب الله. ولم يتوقف هذا التاريخ عند مفخخات الفصائل الفلسطينية في التسعينايت وانتفاضة الأقصى، بل وصل إلى مفخخات المنطقة الخضراء في بغداد، عند مقر الحكم العسكريّ الأمريكيّ بعد احتلال العراق عام 2003.
والناظر إلى تاريخ السيارات المفخخة عبر الكتب والأوراق العديدة التي بُحثت فيه سيجد اسماً سيظلّ يتداول في كل تلك الأدبيات، هو اسم خبير المتفجرات الفلسطيني فوزي نامق القطب.
عن فوزي القطب
وُلد فوزي القطب لعائلةٍ مقدسية في دمشق في العام 1917. وصفه المؤرخ الأمريكي J. Bowyer Bell بأنه لم يكن يشبه العرب أبداً، إذ كان فارعَ الطول أشقر، وعيونُه خضراء، “يبدو أن الصليبيين قد نسوه خلفهم بعد الحروب الصليبية”، فلا تكاد تميّزه عن أيّ أوروبيٍّ، وقد أجاد الإنجليزية منذ مراهقته لعمله في المطبعة الحكومية البريطانية، كما أجاد اللغة التركية عن أمّه، كما كان مولعاً بتفكيك الأشياء وإعادة تركيبها.
سرعان ما بدأ الفتى يخطّ مسيرته النضالية في مواجهة الحركة الصهيونية والانتداب البريطاني، فقد أُجبِرَ مع عددٍ من زملائه على ترك مدرسته الرشيدية في القدس إثر مظاهرات عام 1933 وانتقل حينها للعمل في مطبعةٍ. وما إنْ انطلقت ثورة 1936 المباركة حتى كان من المسارعين لخوض غمارها، وشارك خلالها في معاركَ كبيرةٍ.
وكان القطب قد شكّل برفقة بعض شباب القدس الطليعيّ خليةً سرّيةً تعمل داخل القدس، وكانت مكوّنةً من شخصه ومن زملائه صبحي أبوغربية (استشهد في 1967 وهو شقيق المناضل بهجت أبوغربية)، وصبحي بركات (استشهد في 1948)، وقاموا في إحدى المرات بالاشتراك في تكلفة شراء مسدسٍ وسبع طلقاتٍ. وفيما بعد، انضم لهم شبابٌ آخرون، وقد تبعوا الخلية الأكبر سناً منهم، التي شكّلها سامي الأنصاري وبهجت أبوغربية والشّيخ الشّهيد عبد الحفيظ بركات، وآخرون.

كان فوزي قد عرف الطريق إلى ألغامٍ تركيّةٍ من مُخلّفات الحرب العالميّة الأولى، ليعيدَ تشكيلَها إلى قنابلَ بدائيةٍ يتمّ إشعالها بفتيلٍ. وافتخر الفتى بأن إلقاء القنابل على بيوت الصّهاينة قد أصبح عادةً روتينيةً عنده، فقد صرّح بأنه ألقى بيده في الثّورة الكبرى 56 قنبلةً على حافلات وبيوت العدوّ، ليصبح “سيد القنابل اليدوية”، كما أطلق عليه المؤرخون الصّهاينة والأوروبيّون.
سرعان ما أصبح الصّهاينة أكثر حذراً، فتطلّب الأمر من القطب أن يقوم بالابتكار في تكتيك الهجوم بالقنابل واللجوء إلى الحيلة، فمثلاً لجأ إلى ربط فتيل قنبلةٍ يدويّة الصّنع ببالونٍ، ومن ثم ألقاها أمام بيوت الصّهاينة، فينفجر البالون قبل القنبلة، ليهبّ العدوّ للخروج لمعرفة مصدر الصّوت، فتنفجر في وجوههم القنابل. وبعد عدة هجماتٍ على هذه الشّاكلة، تنبّه العدوّ لهذا التّكتيك، فاستتروا من قنابله.
وذُكر في أحد المصادر عن القطب أنّه في اليوم الذي حصل فيه على أول قنبلةٍ يدويّةٍ من نوع mills، قرر الاحتفال بوجبةِ غداءٍ دسمةٍ، إلا أن فرحته العارمة بالقنبلة لم تمهله حتى يتناول غداءه، فقد حملته ساقاه سريعاً ليرميها على مقهىً يهوديٍّ.
فتىً وقذائفُ قوسيّةٌ
كان سؤال “ويلفرد ستوكس”، الجندي البريطاني في الحرب العالميّة الأولى، هو كيفية إصابة الأهداف المستترة، وسرعان ما اهتدى إلى فكرة القذائف القوسيّة، أو ما يُعرف بالمورتر أو الهاون. وإن كان هناك تاريخٌ سابقٌ طويلٌ في استخدام القذائف القوسيّة، بدءاً من استخدام المنجنيق وقذف الحجارة، مروراً بحصار العثمانيين لبلغراد، واستخدام قذائفَ قوسيّةٍ متفجرةٍ، ومروراً أيضاً بالحرب الأهليّة الأميركية، إلا أنّ نموذج “ستوكس” و”براندت” (جندي فرنسيّ) هو ما يشكّل اليوم أشهرَ وأكثفَ استخدامٍ للقذائف القوسيّة في هذا العصر. وقد كان حلّ “ستوكس” و”براندت” لضرب الأهداف المستترة عبر نيرانٍ قوسيّة تقع على شكلِ قوسٍ في الجهة الموجبة من المستوى الديكارتيّ، إلا أن فوزي القطب قام بقلب القوس لتكون إحداثياته في الجهة السّالبة من المستوى الديكارتيّ.
كان الأمرُ ببساطةٍ يحتاج من القطب أن يُحدد بيوت الصّهاينة في البلدة القديمة في القدس من خلال أسطحها، ويقيس إحداثيات المسافة بين الشّباك المستهدف وبين سطح البيت، ومن ثمّ يُحضِّر حبلاً طولُه مناسبٌ للحسابات الهندسيّة، وبعدها يقف على سطح البيت ويربط الحبل في عصا طويلةٍ من جهةٍ، وفي الجهة الأخرى يربط القنبلة ويشعلها ويرميها، فتصنع حركة القنبلة قوساً يشبه حركة بندول السّاعة، لتكسر القنبلةُ المزوّدةُ بفتيلٍ وبفعل العزم الذاتيّ لها شباكَ البيت المستهدف، وتنتهي القنبلة وقد انفجرت في الهدف المستتر.
القطب فعّال في الثّورة الكبرى
في 12-6 -1936 جرتْ محاولةٌ لاغتيال ضابط الشّرطة البريطانيّ “آلان سيرجست” Alan Sigrist، إذ حاول كلٌّ من سامي الأنصاري وبهجت أبوغربية قتلَه في القدس (لغاية عام 2010 ساد اعتقادٌ بأن “آلان سيرجست” قد هلك في العملية، إلا أن الباحث Matthew Hughes اكتشف أنّ الضابط لم يمت، بل أُصيبَ إصابةً تعافى منها لاحقاً فهرب إلى بريطانيا، وتكتّم على حياته، ومن ثمّ مات في بريطانيا في العام 1983). وفي تلك العملية، أصيب سامي الأنصاري واستشهد بعد 3 ساعاتٍ، وذلك أثناء التحقيق معه.
على إثر استشهاد الأنصاري، خرج الشّيخ عبد الحفيظ بركات إلى الجبال برفقة بعض أعضاء الخلية، فقد تم دمج الخليتين معاً، ونفّذت عدّة عملياتٍ من قتل جنودٍ وشرطةٍ وعملاء، واستهداف الصّهاينة ومصالحهم. وفي بداية شهر أيلول من عام 1938، تكثفّت عمليات المجموعة تطبيقاً لخطة القائد عارف عبد الرازق الذي خطّط لتحرير القدس من الإنجليز، حتى إنّه لم تكن هناك دوريةٌ بريطانيةُ في البلدة القديمة إلا وتعرّضت لإطلاق النّار. وقد كان فوزي القطب جزءاً من تلك المجموعة. وفي 13 أيلول 1938، دخلت قوات الثّورة إلى القدس لتحرّرها حتى 20 أيلول 1938.
فتى على الجسر
بعد معركة القدس في العام 1938، اضطر فوزي القطب إلى اللجوء إلى سوريا، ومن هناك انضمّ إلى عبد القادر الحسيني ورفيقه في النّضال صبحي أبوغربية في بغداد، وما أن انفجرت ثورةُ رشيد عالي الكيلاني في العراق ضدّ الإنجليز (عام 1941) حتى انضمّ لها الفلسطينيون وقاتلوا جنباً إلى جنب مع الثّوار.
وقد قاتل حسن سلامة على جبهة الحبانية برفقة 165 مقاتلاً فلسطينياً، وقاتل عبد القادر الحسيني برفقة 16 مقاتلاً فلسطينياً؛ من بينهم فوزي القطب في منطقة صدر أبو غريب على جسر الفالوجة، فحرّروا ضفة الجسر لينسحب الإنجليز إلى الجهة الأخرى وليحتل مقاتلو عبد القادر استحكامات الإنجليز. وقد بدأ القصف المدفعيّ والجويّ على الفرسان الستة عشر كما أسمتهم الصّحافة العراقية، وتقدمّت دبابةٌ انجليزيةٌ ليهبّ فوزي القطب بقنابله ليقتل كامل طاقم الدبابة، ولتصبح الدبابة عائقاً أمام تقدّم الدبابات الإنجليزيّة الأخرى. وقد حافظ المقاتلون لمدة 10 أيامٍ طوالٍ على ثغرهم في مقابل كتيبة مشاةٍ إنجليزيةٍ مُدّعمةٍ بمدفعيةٍ وسرية دباباتٍ، تحت غطاءٍ جويٍّ، لتكونَ مجموعة عبد القادر الحسيني آخرَ من ينسحب من تلك الجبهة.
على إثر قمع الثّورة العراقية وملاحقة الثوار الفلسطينيين، اضطر بعضهم إلى الهروب إلى إيران، بينما توّجه آخرون إلى سوريا وتركيا. وقد توّجه القطب مع الحسيني و5 آخرين إلى بلدة “زاخو” شمال العراق، ليتسلل لاحقاً إلى سوريا. وفي سوريا، قٌبض عليه في دير الزور وأُودع في سجن حلب، ومن ثمّ فرّ من السّجن إلى لبنان، ثم أعاد الكرّة إلى سوريا، ومنها إلى تركيا التي اعتقلته وأعادته إلى سوريا، فعاد الكرّة عبر تركيا ومن ثمّ اليونان، إلى أن التحق بالمفتي الحاجّ أمين الحسيني في إيطاليا.
ليست حربي
وما لبث أن التحق بدورة كوماندوز للوحدة الوقائية النّازية (Schutzstaffel أو المعروفة بالاختصار SS)، وأتمّها ليكمل دورةً في المتفجرات في هولندا، حيث أجاد هناك الألمانية وتعلّم بعض الإيطالية (وبذلك أصبح يتحدث خمسَ لغاتٍ)، واستمر بالتّعلم لعدّة سنواتٍ، ليحصل على أفضل تدريبٍ في صناعة وتركيب المتفجرات على مستوى العالم في حينه. وفي العام 1944 طُلِبَ منه لتفوقه التوجّهُ إلى الجبهة الشّرقية ليحارب مع الألمان. وفي روايةٍ أخرى، كان الطلب أن يصحبَ أربعة أعضاءٍ من الكوماندوز الألمان إلى فلسطين، إلا أنه رفض مجيباً: “هذه ليست حربي”. وبسبب هذا الرفض، تقول الرواية، إنه اعتقل وحُكم بالإعدام، ونُقل بعد الحكم إلى معسكر Wrocław الاعتقالي في بولندا، الذي كان مخصصاً لليهود. وقد حمل على ساعده الوشم التّعريفي للمعتقلين اليهود في المعسكرات النّازية.
قضى الشّاب المقدسي ثلاثة شهورٍ طويلةٍ في هذا المعسكر جائعاً وعاملاً بالسّخرة بين ركامٍ من الأجساد المتهاوية لليهود المحتجزين. إلا أن رسالةً حملها حارسٌ ألماني مرتشٍ من فوزي القطب إلى المفتي أمين الحسيني يخبره عما حدث له، قد أنقذته. فبعد هذه الرسالة، طلب المفتي من أحد رجال أدولف هتلر، وهو “هاينرش هيملر”، العفوَ عن القطب، وهذا ما حصل. وما إنْ أُطلق سراح فوزي حتى بدأ العمل في الإذاعة الألمانية النّاطقة بالعربيّة في برلين، لكن سرعان ما كانت جيوش الحلفاء تطبق على برلين، وما إن وصل الروس إلى برلين حتى انتزع فوزي القطب عن ضابطٍ ألمانيٍّ قتيلٍ زيّه العسكريّ، وتوجّه جنوباً في رحلةٍ طويلةٍ إلى النمسا، حيث قبض عليه الجيش الأمريكي، وأُودع في الاعتقال مدة 4 أشهرٍ، ومن ثمّ أطلق سراحه، ليبدأ بعدها رحلةً جديدةً، لكن هذه المرة إلى فلسطين.
تشير المصادر العربية إلى أنّه عاد إلى سوريا، ومن ثمّ دخل إلى فلسطين مع حسن سلامة بعد إعلان قرار التّقسيم، الا أن كلّ المصادر الأجنبية والصّهيونيّة تتفق على أنه عاد إلى فلسطين عبر سفينةٍ من مارسيليا تحمل على متنها 1500 من اليهود ضحايا النّازية، وأنه استطاع التّسلل إلى تلك السّفينة عبر الوشم الذي يحمله من المعسكرات النّازية، الذي أوحى بأنه أحد النّاجين من المحرقة، وقد ساعدته هيئته واللغات التي يتقنها على التّخفي.
وما إن وصل عبد القادر الحسيني إلى فلسطين قادماً من مصر عبر التيه وصولاً إلى الخليل بعد شهرٍ من صدور قرار التّقسيم حتى اجتمع من جديد كلُّ رجاله حوله، وتمّ تكليف فوزي القطب برئاسة فرقة التّدمير العربيّة.
الصّحيفة احتجبت ذلك الصّباح

وكان الهدف الانتقامي الأول من العدوّ نسفَ بناية جريدة “الباليستاين بوست”، النّاطقة باسم الوكالة اليهودية الواقعة في شارع “هاسوليل”، والتي تحوي كذلك مكاتبَ عدّة صحفٍ ووكالات أنباء ومكاتب مرابين ورجال أعمالٍ صهاينةٍ، ولم يكن الهدف من العملية إيقاعَ أكبر عددٍ من الضّحايا، بل نشر الرعب والخوف في صفوف العدوّ، لذلك نُفذت العملية ليلاً.
نصفُ طنٍ من TNT موصولٌ بفتيلٍ، وجنديان بريطانيان (ايدي براون وبيتر ماديسون)، وسيارةٌ عسكريّةٌ بريطانيٌّة مسروقةٌ برفقة مقاتلٍ عربيٍّ ثالثٍ، في وسط الأحياء اليهودية في القدس والمحاطة بحواجزَ بريطانيّةٍ وصهيونيّةٍ، وسيجارةٌ تمّ تثبيتها في طرف الفتيل. في السّاعة الحادية عشر ليلاً من الأول من شهر شباط لعام 1948، تمّت العملية. كانت الرسالة واضحةً: “نستطيع الوصول إلى أي مكان”، وكانت تلك أولى سيارات فوزي القطب المفخخّة، وأكبر مفخخّة حتى تلك اللحظة. في تلك الليلة، دُمرت أكثرُ من بنايةٍ، واحتجبت الصّحيفة الصّهيونيّة عن الصّدور صباحاً، ببساطةٍ لأنه لم تعد هناك صحيفةٌ.
عملية معقدة في “بن يهودا”
كانت الخطة العسكريّة التي وضعها عبد القادر الحسيني في الفرقة التي كان يقودها تؤتي أكلها، وتحديداً في القدس، حيث أكبرُ تواجدٍ صهيونيٍّ. وانطلاقاً من موقعٍ دفاعيٍّ، وصل العرب إلى مرحلة توازنٍ مع العدوّ، وكان لا بدّ أن يتم الانتقالُ إلى مرحلة هجومٍ استراتيجيٍّ. ولإتمام الحصار العربيّ على الأحياء اليهودية في القدس والمستعمرات المجاورة، كان لا بدّ من ضرب سلسلة الهرم القيادية في عصابتي “إرغون” و”شتيرن”، وبالتّالي رفع معنويات المقاتلين وتحطيم معنويات العدوّ. ونظراً للتفوق الصّهيونيّ في نوعية السّلاح وعدد المقاتلين، تصبح النّاحية المعنوّية مهمةً جداً في خطّةٍ من مثل خطط “اختراق الخطوط المحصّنة”، ولا تُحسب نسبة القوّة في مثل هذه الحالة بالعدد والعدّة فقط، بل أيضاً بالتّدريب والخبرة والمعنويات.
بناءً على ما سبق، تم اختيار شارع “بن يهودا” (عشرات العمليات الفدائيّة تمّ تنفيذها في ذلك الشّارع منذ 1948 إلى اليوم)، وهو أحد أكبر الشّوارع وأجملها في الأحياء اليهودية في القدس، ويشكِّل قلب المدينة التّجاريّ، وفيه تسكن الطبقة الغنيّة من يهود القدس، ويقع في منطقةٍ منيعةٍ يعتبرها العدوّ إحدى قلاعهم الحصينة، كما يقع فيه (فندق الاطلنطي) الذي ينزل فيه كبار الضّيوف والشّخصيات الصّهيونيّة البارزة، كما تقع بناية رئاسة قيادة “الإرغون” فيه، لذلك كان يعتبر استهدافه إنجازاً ملحاً.
اشترى الحسيني قافلةً من 3 شاحناتٍ عسكريّةٍ تتقدّمها مصفّحةٌ بريطانيةٌ من ضابطٍ بريطانيٍّ مرتشٍ دفع ثمنها أهالي قريتي عين سينيا وبيرزيت. وكانت القافلة تحمل 5 جنودٍ بريطانيين؛ من ضمنهم “إيدي براون” و”بيتر ماديسون”، بالإضافة إلى مجموعةٍ من المقاتلين الفلسطينيين الذين تزوّدوا بأزياء الجيش البريطانيّ وبهوياتٍ مزوّرةٍ، وكانت الشّاحنات الثّلاث تحمل شيئاً آخرَ غير الرجال، ففي كلّ شاحنةٍ طنٌّ من متفجرات TNT.

اعتكف فوزي القطب برفقة عبد القادر الحسيني، الذي كان أيضاً يجيد التّعامل مع المتفجرات، في مرآب قيادة الجهاد المقدس في بيرزيت للعمل على تفخيخ الشّاحنات بواسطة 3 أطنانٍ من الـTNT أحضرها قاسم الريماوي من دمشق خصيصاً لهذه العملية. وقد أضاف لها القطب 100 كيلوغرامٍ من مركبٍ لزجٍ يُسمى بـ FLASH POWDER، يساعد على خلق وهجٍ يساوي وهج ألفي قنبلةٍ مضيئةٍ، كما أنّها تضاعف قوة الانفجار بنسبة 50٪، وتُرسل شذراتٍ لمسافةٍ طويلةٍ جداً، بشكلٍ يشبه الموليتوف المحترق. وقد وضع القطب هذه المادة في 12 وعاءً معدنيّاً، ووصل العبوات بساعتي توقيتٍ؛ ساعة اليد الخاصّة به وساعة اليد الخاصّة بأخته، ونذكر هنا أنه كان مغرماً بالساعات.
انطلقت القافلة من بيرزيت باتجاه اللطرون، وفي طريق يافا-القدس عند باب الواد حرفت طريقها إلى القدس بهدف التّمويه بقدوم القافلة من تل أبيب. وفي 22 شباط 1948، انفجرت الشاحنات الثلاث بفارقٍ زمنيٍّ من دقيقتين بين كلّ انفجارٍ، وبمسافة 50 متراً بين كلّ شاحنةٍ وأخرى. وقد أسفر التّفجير عن هدم 9 بناياتٍ ضخمةٍ في شارع “بن يهودا”؛ من بينها “فندق الأطلنطي” ومقر قيادة “الإرغون”، وقُتل فيها العشرات. وكانت هذه العملية إشعاراً بتحول التّوازن إلى هجومٍ استراتيجيٍّ لخرق حصون مستعمرات القدس.
رأس الافعى تستحق ساعةً ذهبيةً
اشترى فوزي القطب من برلين سّاعة ذهبيةً سويسرية الصّنع ليهديها لفتاةٍ أحبها من يافا. لكن السّاعة لم تعرف طريقها إلى يد تلك الفتاة، فقد نزع القطب عقرب السّاعات منها ليثبّتها على عبوةٍ متفجّرةٍ مكوّنةٍ من 250 كيلوجراماً من TNT. وضع القطب عبوته المتفجرة في سيارةٍ خضراء باهتة اللون من نوع “فورد” تحملُ علم الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف القطب إلى متفجراته مركباً من خليط الزئبق وحمض النايتريك والكحول، أو ما يسمّى بفلومينات الزئبق ليستخدمها كمفجّرٍ ابتدائيٍّ لعبوته الضخمة.
شقّت السّيارة طريقها من باب الخليل باتجاه الغرب، وكان يقودها الفلسطيني الكولومبي أنطوان “داوود”. ركن داوود السّيارة بكلّ أريحيةٍ داخل ساحة أكثر مبنىّ محصّنٍ عند العدوّ؛ مبنى الوكالة اليهودية. بعد 5 دقائق، انهار جزءٌ كبيرٌ من المبنى، وقُتل وأصيب العشرات من الصّهاينة، كان من بينهم Arie Leib Jaffe أحد مؤسسي الحركة الصّهيونية، إذ كان رأسه يستحق التّضحية بساعةٍ ذهبيّةٍ.
قِلاعٌ على الطريق
اتّسم نمط الحرب على فلسطين على طوال تاريخها في الصّدامات المتتالية مع الاستعمار الأوروبيّ بنمط قتالٍ أوروبيّ يلجأ إلى التّحصين وبناء القلاع. في المقابل، اتّسم نمطُ العرب في الدّفاع عن فلسطين بنمطِ الإغارة والاعتماد على السّرعة وخفة الحركة والمواجهة. فكان لا بدّ لصلاح الدّين والظاهر بيبرس أن يقوما بهدم القلاع الأوروبيّة التي بُنيت على السّاحل الشّامي لمنع إعادة احتلال تلك المدن، والركون إلى حصونها المنيعة من قبل الأوروبيّين.
وبنفس العقلية الأوروبيّة، أراد الصهاينة بناء قلاعٍ لهم في فلسطين عبر المستعمرات، وكذلك حافظ أهل البلاد على نفس نمط قتالهم، ونرى هذا بوضوح في حرب 1948. وقد استطاعت خطط الفلسطينيين العسكريّة في حرب 1948 إفشالَ مهمة المستعمرات المتقدمة كنموذجٍ لقلاعٍ عسكريّةٍ، وهذا ما وصل له “بن غوريون” في استنتاجه بأنّه ما من أهميّةٍ عسكريّةٍ لتلك المستعمرات، بل تمتلك الأخيرة أهميةً سياسيةً، معتبراً أنّ سكان تلك المستعمرات تحوّلوا إلى عبءٍ على الجيش ورهائن في أيدي الفلسطينيين أثناء الحرب.
ومع بداية الحرب بعد قرار التّقسيم، اندفع العرب إلى فصل مستعمرات القدس عن الثقل الديموغرافي للعدوّ والموجود في السّاحل الفلسطيني. لذلك شهد باب الواد، منذ اليوم الأول وحتى الهدنة وترسيم الحدود، أعنفَ المعارك وأشدَّها، ومن ثم فُرض الحصار على كلّ مستعمرةٍ، وجرى فصلها عن باقي المستعمرات في القدس ومنع التّواصل فيما بينها. وقد جدّ العدوّ كلّ الجدّ في محاولة خلق هذا التّواصل الجغرافيّ، إلا أنهم فشلوا بفضل الاستراتيجية العسكريّة التي وضعها الحسيني، واستكملها القائد عبد الله التّل بعد استشهاد الحسيني.
وضمن هذه الاستراتجية العسكريّة كان يعمل فوزي القطب وفرقة التّدمير العربية التي كان يقودها، فبعد تفجير الوكالة اليهودية بيومين، شارك القطب وفرقته في الهجوم على مستعمرة “ميكور حوليم” وتفجير تحصيناتها وبعضٍ من مبانيها الاستراتيجية. وفي 23 آذار 1948، فجّروا حي المنتفيوري غربي باب النبي داوود؛ تلك القلعة المحصنة الواقعة على الطريق بين بيت لحم والقدس، بشاحنةٍ تحمل 3 أطنانٍ من المتفجرات.
وبعد أيامٍ، شارك القطب في معركة “كفار عتصيون”؛ تلك القلعة الصّهيونيّة التي تقطع الطريق بين القدس والخليل، ولاحقاً شارك في معركة “بيت هداسا” وتفجير طريق القسطل، وذلك في معركة مستعمرة “النفيه يعقوب” التي حرّرها العرب، وشارك في الدفاع عن باب الخليل وباب النبي داوود، وأُصيب في تلك المعارك بأكثر من 20 إصابةً ظلّت ترافقه شظاياها حتى وفاته.
وكانت معركة تحرير حارة الشّرف في البلدة القديمة في القدس قمّةَ عمل القطب النّضالي، فقد قاد 200 مقاتلٍ فلسطينيٍّ وأردنيٍّ استطاعوا دخول البلدة القديمة بعد منع قوات الانتداب البريطاني القائد عبد الله التّل من دخولها. وفي معمله الذي افتتحه في أحد حمامّات القدس التّركية، حوّل القطب 1500 علبةٍ من علب الأغذية المعدنيّة إلى قنابلَ يدويةٍ ساهمت النّساءُ والأطفال في صناعتها وإلقائها، حتى اعتقد العدوّان الصّهيونيّ والبريطانيّ أن آلاف المقاتلين يتواجدون في البلدة القديمة من شدة الكثافة النّارية التي صنعتها تلك القنابل.
وبواسطة 40 كيلوجراماً من المتفجرات وسيجارةٍ مشتعلةٍ (لطالما أشعل القطب قنابله بسيجارته) في برميل ثُبِّتَ على مقدمة سلّمٍ، فتح القطب ثغرةً كبيرةً في جدار الكنيس في حارة الشّرف؛ آخر معقلٍ تحصّن فيه مقاتلو “الهاجاناه”، ليدخل بعدها رجال فوزي القطب وعبد الله التّل إلى الكنيس. وقد كانت تلك المرة الأولى التي يكون فيها عدد البنادق عند العرب أكثرَ من عدد الرجال بفضل الغنائم التي غنموها.
خاتمة
فوزي القطب نموذجٌ من آلاف نماذج البطولة في تاريخ المقاومة في فلسطين، وتتبعُ سيرتِه والتّنقيب فيها في المصادر العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة والإسبانيّة والعبريّة والألمانية يحيلنا إلى الكثير من الروايات المتناقضة، إلا أنّها تتفقُ جميعها على فرادة تجربة هذا المناضل وعبقريته وعزمه. ولا نستغرب أبداً من حجم الإطراء والمديح له وإطلاق الألقاب المتعددة عليه من قبل العدوّ، فقد أطلقوا عليه لقب المهندس، إذ فعلت قنابله فعلها في وعيهم.
وتنتهي كلُّ المصادر الصّهيونيّة في الحديث عن سيرة القطب بجملة “شوهد لآخر مرةٍ في دمشق”، لتمنح دلالةً مهمةً على استمرار ملاحقته حتى وفاته. ظلّ القطب في القدس حتى النكبة، ومن ثمّ انتقل إلى دمشق وافتتح مركزاً للترجمة بلغاته الخمس التي يتقنها، وتوفي في عام 1988 في دمشق.