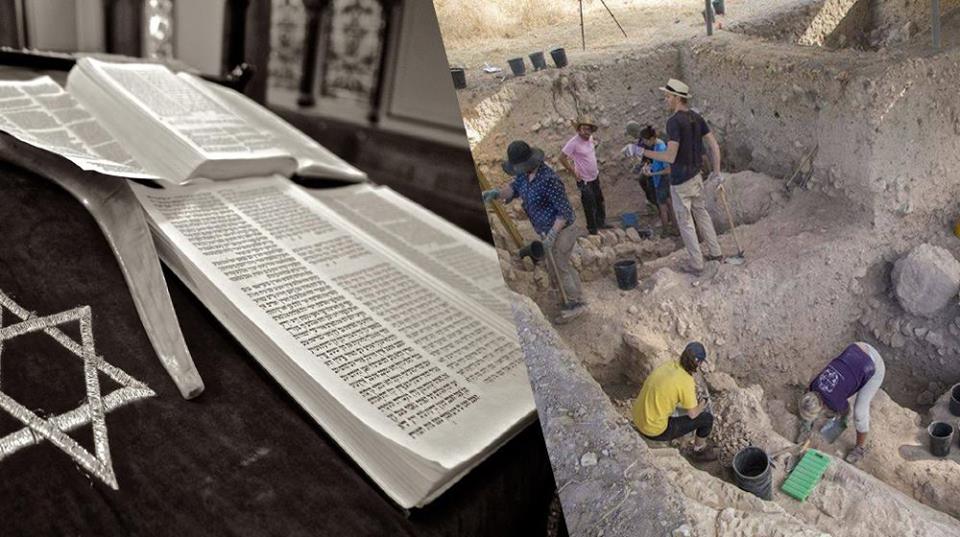نضع بين أيديكم دراسةً أعدَّها، مؤخّراً، الأسيرُ المحكوم بالمؤبّد وائل الجاغوب من خلف قضبان سجنه في معتقل نفحة “ريمون”. يناقش الجاغوب، في دراسته هذه، الأيديولوجيا والممارسة الصهيونيتين اللتين تحكمان المشروع الصهيوني، بوصفه مشروعاً استعماريّاً استيطانياً قائماً على ثنائية الطرد/ الإحلال، مُستعرِضاً من خلالها أدبياتٍ عدّةً تُكثّف الوعيَ بالأدوات التوظيفيّة في سياق سعي المشروع الصهيوني لتحقيق مآربه بتملّك الأرض وتاريخها وذاكرتها والحيز الزمكاني الخاص بها. ينطلق الجاغوب من ضرورة فهم العقلية الصهيونية ليس بهدف الامتثال العاجز لها وإسكات الفعل الفلسطيني، بل بهدف التحرّر منها والانعتاق بالكامل من القبضة الاستعمارية التي تحاصر الفلسطيني على الدوام، مُقترِحاً بذلك مجموعةً من المرتكزات التي يرى أنّ بإمكانها إحياءَ فكرة المواجهة الدائمة مع المشروع الصهيوني حتى يصل الأخيرُ إلى نهايته المُستحقة.
توطئة
نضع بين أيديكم دراسةً أعدَّها، مؤخّراً، الأسيرُ المحكوم بالمؤبّد وائل الجاغوب من خلف قضبان سجنه في معتقل نفحة “ريمون”. يناقش الجاغوب، في دراسته هذه، الأيديولوجيا والممارسة الصهيونيتين اللتين تحكمان المشروع الصهيوني، بوصفه مشروعاً استعماريّاً استيطانياً قائماً على ثنائية الطرد/ الإحلال، مُستعرِضاً من خلالها أدبياتٍ عدّةً تُكثّف الوعيَ بالأدوات التوظيفيّة في سياق سعي المشروع الصهيوني لتحقيق مآربه بتملّك الأرض وتاريخها وذاكرتها والحيز الزمكاني الخاص بها.
ينطلق الجاغوب من ضرورة فهم العقلية الصهيونية ليس بهدف الامتثال العاجز لها وإسكات الفعل الفلسطيني، بل بهدف التحرّر منها والانعتاق بالكامل من القبضة الاستعمارية التي تحاصر الفلسطيني على الدوام، مُقترِحاً بذلك مجموعةً من المرتكزات التي يرى أنّ بإمكانها إحياءَ فكرة المواجهة الدائمة مع المشروع الصهيوني حتى يصل الأخيرُ إلى نهايته المُستحقّة.
****
مدخل
يستدعي تناولُ الكيان الصهيوني أيديولوجياً وسياسياً وممارساتياً إدراكَ المفاهيم الحاكمة للممارسة والمُشكّلة للأيديولوجيا، والمُوجِّهة للسياسة بمداها القصير والبعيد، إذ إنّ مواجهة هذا العدو تتطلّب الوعيَ بمكوّناته، والذي يُعتبر احتياجاً رئيسياً لصياغة رؤيةٍ ومشروعٍ لمقاومتِه.
إنّ مُجمل السياسات التي ينتهجُها الاحتلال الصهيوني إزاء الفلسطيني، سواءً على صعيد الاستيطان وتهويد القدس وحصار أهلنا في فلسطين التاريخية، وما يمارسه من جرائم في غزة، وما يحاول فرضه من أمرٍ واقعٍ، تستند بمُجملها إلى هدفٍ لن يغيب دوماً عن الأيديولوجيا والعقل المسيطر والمهيمِن داخل الكيان؛ إذ إنّ الهدف لا ينحصر فقط في السيطرة على الأرض، بل يتجاوز ذلك نحو إبادة المكان والإنسان بشكلٍ تدريجيٍّ، وبما تسمح به الظروف.
يبني ما تقدَّم سؤالاً رئيسياً لهذه الورقة؛ مفادُه: هل المفاهيمُ المطروحةُ لقراءة واقع الكيان وممارساته وأيديولوجيته، رغم اختلافها، مترابطةٌ ومتصلةٌ ببعضها البعض؟ وارتباطاً بذلك، هل ممارساتُ الاحتلال المتواصلة غيرُ مترابطةٍ، أم تنطلق من قاعدةٍ أيديولوجيةٍ تمثّل حالةَ إجماعٍ لديه؟ وهل ما يُمارَس ضدّ شعبنا يخرج عن إطار عملية تطهيرٍ عرقيٍّ منظّمةٍ ومُحكمةٍ ومُخطَّطٍ لها؟
إطارٌ نظريٌّ
أنتج المنظّرون العديدَ من المفاهيم، التي يمكن من خلالها قراءةُ الصراع القائم وطبيعة الكيان الصهيوني، إذ طرح بعضُهم مفهومَ إبادة المكان، ليتواءم مع المشروع الصهيوني، بوصفه “ليس مشروعَ إبادة جنسٍ ما، بل مشروعُ إبادةِ مكانٍ”. [1]
ووفقاً لهذا المفهوم، فإن أيّة قراءةٍ للصراع الفلسطيني الصهيوني تستخدم إبادة الجنس كقياسٍ لمدى العنف الكولونيالي، لا تشكّلُ قاعدةً لفهم آليات هذا الصراع. [2]
كما يبرز، في هذا السياق، مفهومُ إبادة الجنس الرمزية، والذي يتمحور حول فكرة “أنّ لكل شعبٍ رموزَه، وقادته الوطنيين، والمؤسسات السياسية، ووطنه، وأجياله السابقة والمُقبلة، وآماله. وتمثّل هذه جميعاً الشعبَ تمثيلاً رمزياً، ولذلك فإنّ أيّ اعتداءٍ على أيٍ منها، يمثلُ إبادةَ جنسٍ رمزيةً”. [3]
كما يقترح بعضُ المنظّرين والمفكّرين مفهومَ الأبارتهايد الزاحف لفهم الحالة الصهيونية. ويُعبّر هذا المفهوم عن “المأسسة التدريجية لأنماطٍ متعدّدةٍ من الفصل وعدم المساواة في الأراضي الواقعة بين الأردن والبحر، ليتمَّ حصرُ الفلسطينيين في غيتوهاتٍ مجزّأةٍ سوداءَ محرومةٍ من الحقوق ومهمّشةٍ، فيما يكون البقاء اليهودي في الأرض بالكامل”؛ [4] إذ إنّ الأبارتهايد الزاحفَ يعمل على إلغاء الفصل بين “إسرائيل” والمناطق الفلسطينية المهدّدة. [5]
كما يشير هذا المفهوم إلى الخليط القائم في ماهية الكيان الصهيوني، باعتباره استعماراً استيطانياً وحكومةً تكنوقراطيةً قائمةً على الممارسات الديمقراطية الإثنية، والليبرالية الاقتصادية والاستقطاب في ذات الوقت. كلّ ذلك من شأنه أن يجعل من “إسرائيل” نظام أبارتهايد زاحفٍ. [6]
في السياق عينه، يبرز مفهومُ “الاستعمار الاستيطاني” الذي يُعرَّف بكونه “عمليةً اجتماعيةً اقتصاديةً تهجُرُ فيها جماعةٌ بشريةٌ أرضَها إلى أرضٍ أخرى لإقامة مجتمعاتٍ بشريةٍ مُستحدثةٍ، وعادةً ما يشكّل محوُ الأصلانيين واستبدالُهم عاملاً ناظماً لهذا النوع من الاستعمار”. [7]
ومن هذا المنطلق، فإنّ الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية يمثّل حركةً استعماريةً صهيونيةً إحلاليةً؛ هدفُها إحلالُ مجموعةٍ إثنيةٍ يهوديةٍ مكانَ السكان الأصلانيين، موظِّفةً أدواتٍ مختلفةً في سبيل الاستيلاء على الأراضي التي تشكّل العنصر الأساسي لهذه العملية. [8]
بذلك، يصبح فعلُ إزالة السكان الأصليين من أراضيهم الطريقةَ المُثلى للسيطرة على الأرض التي يتعاطى معها الاستعمار الاستيطاني بقيمتها القومية، وليس بقيمتها الاقتصادية النفعية؛ إذ لا يقوم هذا النوع من الاستعمار بهدف استخلاص القيمة الفائضة واستغلال السكان الأصليين كأيدٍ عاملةٍ، [9] بل عادةً ما يُشدَّدُ على أنّ المستعمرات الصهيونية أُقيمت على أساس مبدأ القضاء على المجتمعات المحلية وماضيها وحاضرها، إذ إنّ المستوطنين يحلُّون بهدف البقاء والغزو، [10] ليكون هذا النوع من الاستعمار اختباراً لتجسيد قدرته على ممارسة الإبادة الجماعية. [11]
من ناحيةٍ أخرى، فإن كان الاحتلال كمفهومٍ يعني “سيطرةً مؤقتةً لدولةٍ على أخرى، وعلى جزءٍ من أرضها رغماً عنها، ويتمُّ ذلك بشكلٍ عامٍّ من خلال الإقدام على وسائل السيطرة العسكرية والحربية، وإذ يُعتبر الاحتلال من أقدم وسائل الاستعمار في التاريخ البشري، [12] فيمكننا اعتبار الحالة القائمة اليوم، في الضفة الغربية، قد اجتازت حالة الاحتلال العسكري التقليدي، لسببين: الأول/ استمرارُه لأكثر من 50 عاماً، والثاني/ بناءُ المستوطنات النقية أو المخصّصة لليهود حصراً. وهذا يعني أن الاحتلال الذي يحكمُ أراضي 1967 يتميّز عن غيره، بكونه توليفةً من ممارساتٍ لسياساتٍ استعماريةٍ استيطانيةٍ داخل مناطق تمَّ احتلالُها بقوة السلاح قبل أكثر من خمسين عاماً. [13]
كما يستدعي نقاشُ المشروع الصهيوني، أيضاً، تعريفَ بعض المفاهيم التي تنطبق عليه؛ ومنها الدولة الإثنية التي يحكم تعريفَها استثناءُ الجماعات الإثنية والقومية، التي لا تنتمي إلى الجماعات الإثنية المتسلِّطة، من مجمل الأهداف القومية للدولة التي تخصُّ الجماعة المُتسلّطة بمعاملةٍ مميزةٍ تقرّها منظومة الدولة وقوانينها. [14]
وبهدف تحقيق ذلك، تمارس هذه “الدولة” الإبادة والتطهير العرقي والترانسفير، وحسب تعريف منظّمة الأمم المتّحدة، فإنّ مفهوم الإبادة والتطهير العرقي يُعنى بما يلي:
• قتلُ أعضاء جماعةٍ معينةٍ.
• إبادةٌ جسمانيةٌ أو جسديةُ لأعضاء المجموعة.
• التدمير والتسبّب بضررٍ كبيرٍ لظروف حياة المجموعة، عبر إبادتها كلياً أو جزئياً.
• استعمالُ أساليبَ تهدف إلى منع الولادة في صفوف المجموعة.
• نقلُ أبناء مجموعةٍ معينةٍ وانتمائهم إلى مجموعةٍ أخرى. [15]
من جهته، يُقصد بالترانسفير أيضاً “تهجير أو نقل مجموعةٍ أو جزءٍ منها من سكنها التاريخي إلى منطقة سكنٍ أخرى رغماً عنها. [16] كما يقترح بعض المنظّرين مفهوم “الدولة الثيوقراطية” لنقاش الحالة الصهيونية، ويُقصَد بهذه الدولة “دولة الوطن القومي لمجموعةٍ إثنيةٍ واحدةٍ بين المجموعات الموجودة فيها، بمساواةٍ جزئيةٍ لأعضاء المجموعات الأخرى”. [17]
يُستخدم هذا التعريف لقراءة واقع دولة الكيان الصهيوني التي تمارس محدودية الديمقراطية، والمرتبطة بكونها دولةً ثيوقراطيةً تسيطر بها الغالبية على الأنظمة، غيرَ مانحةٍ مساواةً فرديةً أو جماعيةً. وبطبيعة الحال، لا يتعارض هذا التعريف مع وصم المشروع الصهيوني بالتطرّف والعنصرية؛ إذ يتمّ اعتبارهما وجهين لعملةٍ واحدةٍ، انطلاقاً من كون العنصرية تقومُ على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، مُستهدفةً تعطيل أو عرقلة منحِ أحد الأطراف حقوقَ الإنسان والحريات الأساسية، أو التمتّع بها، أو ممارستها على قدم المساواة في الميادين كافةً”. [18]
إنّ تناول الصهيونية كأيديولوجيا وممارسةٍ عنصريتين يتيح لنا فهمَ منطقها القائم على احتلال الآخر واضطهاده وقمعه، مُرتكزةً بذلك على نظامٍ من التمييز العنصري وأيديولوجيا الإقصاء، ومُتغذّيةً أيضاً على فكر وممارسة التطهير العرقي والترانسفير السكاني، وكل ذلك من أجل تحقيق هدف بقاء اليهودي في أرض فلسطين. [19]
وفقاً للأدبيات السابقة، يمكننا القول إن المشروع الصهيوني، الذي يُعدُّ آخر تجارب الاستعمار وأكثرها تعقيداً، مشروعٌ استعماريٌّ استيطانيٌّ، وفقاً للمحدّدات هذه: أولاً/ تأتي ممارستُه في ظلّ ما يُعرف بالاستيطان الانفصالي الذي مارسه المستوطنون في جنوب أفريقيا وروديسيا وكينيا، مُنبثِقةً عنه كياناتٌ استيطانيةٌ. ثانياً/ جمعُه ما بين القومية والدين، والنظام الاستيطاني الإجلائي والاستعمار التقليدي القائم على التوسّع ونهب الخيرات. ثالثاً/ إنتاجُه تشكيلةً اجتماعيةً اقتصاديةً فريدةً في تكوينها، أوجدت مؤسساتِ السلطة قبل أن يتشكّل مجتمعٌ بعينه. رابعاً/ استفادت “إسرائيل” من تجارب الأبارتهايد والفصل العنصري في العصر الحديث. [20].
إنّ تحليل سياق وواقع المفاهيم الحاكمة للأيديولوجيا والممارسة الصهيونيتين، بالاعتماد على مفاهيمَ ترتبط بمفهوم الاستعمار الاستيطاني بنوعه النقي، يعتبرُ مفتاحاً رئيسياً للوعي بممارسات دولة الاحتلال التي تطوّر من نفسها حتى يومنا هذا.
المشروعُ الصهيونيُّ مشروعُ استعمارٍ استيطانيٍّ
يُعدّ المشروع الصهيوني، وفقَ معايير مفهوم الاستعمار الاستيطاني، أحدَ أشكاله المميزة، مُنتِجاً تجربةً تنبعُ خصوصيتها من واقع استمرارها منذ سبعين عاماً، وسعيها الدائم لتحقيق أهدافها على قاعدة إقصاء وتهجير “الآخر”. غير أنّ هذه العملية، التي عادةً ما تتمُّ على مراحل، تُواجه تحدّياً مركزياً مُتمثّلاً بمقاومة الشعب الفلسطيني لهذا المشروع.
ميّزت دراساتٌ وأبحاثٌ عدّةٌ اشتُغلت في حقل الاستعمار الاستيطاني بين نماذجَ مختلفةٍ للأخير، مُحدّدةً ماهيتها وخصائصها. وقد قدّم الباحثان “فيلدهاوس وفريدريكسون” أربعة نماذج للمستعمرات الكولولنيالية، وهي:
1. المستعمَرة العسكرية – (occupation colony).
2. المستعمَرة المختلطة – (mixed colony)، وهي خليطٌ بين مجموعاتٍ إثنيةٍ مختلفةٍ.
3. مستعمرة المزارع – (plantation colony).
4. مستعمرة الاستيطان النقي – (pure settlement colony)؛ بمعنى أن جميع السكان، أو معظمهم، هم من الأصل النقي للمهاجرين؛ أي المستوطنين الأوروبيين. [21]
ينبني النموذج الأخير- أي الاستيطان النقي- على تركيبٍ إثنيٍّ واحدٍ، ومن شروطِه طردُ السكان المحليين وإبادتُهم، ويُعتبر هذا النموذج الأبرزَ لنمط الاستعمار الكولونيالي الاستيطاني، قائماً بذلك على عدّة ركائز؛ وهي:
“هجرةٌ بشريةٌ إلى المنطقة المستهدفة للاستيلاء على الأرض بأيٍّ من الوسائل المُتاحة، وطردُ السكان المحليين من ديارهم والحلول مكانهم، أو محاصرتُهم في معازلَ منفصلةٍ عن المستوطنين، وإنشاءُ سلطةٍ سياسيةٍ تحوزُ السيادة على المنطقة المُستهدفة”. [22]
وعادةً ما يمتلكُ هذا المشروع عدّةَ امتيازاتٍ يمكن تحديدُها على النحو الآتي:
• العلاقة الاقتصادية مع السكان الأصلانيين.
• علاقته المؤقتة مع المركز الإمبريالي.
• علاقته الدائمة مع الأرض المستعمَرة.
• كثافة الخطاب الأيديولوجي الإقصائي الذي يوظّفه.
• بناءُ تشكيلاتٍ رأسماليةٍ غيرِ تابعةٍ.
• هندسته الاجتماعية الدقيقة. [23]
بناءً على ما تقدّم، يمكننا القول إنّ المشروع الصهيوني مشروعٌ استعماريٌّ كولونياليٌّ اعتمد نموذجَ الاستيطان النقي منذ بدايته، والقائم على تركيبٍ إثنيٍّ محدَّدٍ، والمُعتمد على السيطرة على الأرض وإقصاء السكان الأصلانيين عنها، بجانب سعيه الدؤوب إلى شرعنة خطواته الراهنة وإجراءاته، بوصفه امتداداً للمشروع الاستعماري الغربي وممارسته، مُتمثّلاً بفكره الاستشراقي.
إن مجمل ذلك يجعل المشروع الصهيونيَّ ومركّباته مشروعاً استيطانياً كولونيالياً توسّعياً، ويركز هذا المشروع على بُعدين: الفكر الاستشراقي وما تمثله الكولونيالية الاستيطانية الأوروبية، والبعد الأيديولوجي الديني؛ إذ اكتسب المشروع الصهيونيُّ خصائصَه في الاستئصال والإقصاء من مصدرين؛ أحدهما الاستيطانية الكولونيالية الأوروبية التي نجحت في بسط سيطرتها على المناطق التي ابتُليت بالاستيطان. أما المصدر الثاني، فهو استعادةُ المشروع الصهيوني من مفردات الكتاب العبري ليشكّل منها مضمونها الأيديولوجي بما فيها من تأسيسٍ للفكر الإباديّ. [24]
في الواقع، يتطلّب تعريف المشروع الصهيوني، بشكلٍ عامٍّ، أخذَ خصوصيّته بعين الاعتبار، بوصفه نموذجاً استيطانياً وكونه آخرَ التجارب الاستعمارية التي مارست الاستيطان الانفصالي، فضلاً عن جمعه ما بين القومية والدين، وما بين الاستيطانَيْن الإحلالي والتقليدي، مُقتبِساً خصائصَ عدّةً من تجاربَ استعماريةٍ مختلفةٍ، وواضعاً إيّاها في وحدةٍ واحدةٍ وخليطٍ متعددٍ من التجارب، سعياً منه إلى إفراغ الأرض من سكانها والسيطرة عليها.
اعتبر المشروع الصهيوني ولا يزال “ترحيلَ العرب من فلسطين لاستيعاب اليهود المُهاجرين إليها من شتّى أصقاع الأرض، وإقامة دولةٍ يهوديةٍ نقيةٍ وخاليةٍ من السكان العرب، حجرَ الزاوية في الأيديولوجيا الصهيونية، وهي قضيةٌ مُسلّمٌ بها بالنسبة للأحزاب الصهيونية باختلاف مكوناتها”. [25]
الديمغرافيا هاجسُ الاستعمار
تُعتبر الأرضُ بجانب العمل والسكان مركّباتٍ هامةً في الاستيطان الصهيوني؛ الأرض لناحية السيطرة عليها وتهويدها، أمّا العملُ فكان من الشعارات الأولى للحركة الصهيونية بعد الهجرة الصهيونية الثانية، والذي سرعان ما تطوّر بعد سيطرة المشروع الصهيوني على فلسطين باتجاه تقسيمه ما بين العمل الأسود البسيط، وعمل النخب الصهيونية المُسيطرة على الموارد الاقتصادية.
فيما يمثّل العامل الديمغرافي أساساً للمشروع الصهيوني من ناحية تشكّله بفعل مهاجرين يهود من مختلف دول العالم، مقابل تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم. وهذا ما تطلّب السيطرة على الأرض بالاستيطان و”عبرنة” العمل، ورصد الخطط اللازمة لتهجير السكان الفلسطينيين بهدف خلق يهوديةٍ غالبيةٍ مسيطرةٍ.
أدّى العامل الديمغرافي إلى تأسيس الكيان الصهيوني مجلساً ديمغرافياً أُقيم عام 1967 بقرارٍ من حكومة “ليفي أشكول”، مؤكّداً ضرورةَ العمل بشكلٍ مهنيٍّ لتسويق سياسةٍ ديمغرافيةٍ تهدف إلى خلق بيئةٍ تشجّع التكاثر؛ نظراً لضرورتها لدى الشعب اليهودي. [26]
ظلّ هذا المجلسُ فاعلاً حتى عام 1998، ليُعاد تفعيلُه مجدّداً بقرارٍ من حكومة الكيان عام 2002، [27] لتكون بذلك أهدافُ تشجيع الهجرة وخلقُ بيئةٍ للتكاثر مرتبطةً بالسيطرة على الأرض والعمل على إفراغها من سكانها، نظراً لحالة القلق التي يمثّلها وجودُهم.
إنَّ عملية الفرز لم تعنِ يوماً بالنسبة للمشروع الصهيوني الحفاظَ على تفوّقٍ عدديٍّ ديمغرافياً فحسب، بل تعني أيضاً إبقاءَ إثنيّةٍ واحدةٍ مسيطرةٍ قائمةٍ على عملية تطهيرٍ عرقيٍّ شاملةٍ للسكان الأصليّين، إذ إنّ قبولها بوجود أقليةٍ عربيّةٍ في فلسطين المحتلة 1948، أو فيما تبقى من أنحاء فلسطين، كان أمراً واقعاً مؤقتاً برؤية نُخب المشروع الصهيوني.
في هذا السياق، يقول المؤرخ الصهيوني “بيني موريس” فيما يتعلق بسياسة “بن غوريون” إزاء العرب: “كان يمكن لإسرائيل أن تتمتّع اليوم بالسلام، لو أن “بن غوريون” طرد كلّ الفلسطينيين عام 1948″. [28]
تمثّل هذه النظرة إلى الوراء أساساً استشرافياً لما ينبغي عليه أن يكون المستقبل، مسكوناً بصياغة وتأطير مفاهيم التطهير العرقي وممارستها، ولو بشكلٍ تدريجيٍّ، فالمشروع الصهيوني يسعى إلى تحقيق أهدافه وتحديد معايير الدولة التي يريد، واستكشاف قدرتها على الاستمرار وفقَ معاييرَ حدَّدها؛ إذ سيكون بمقدور الكيان الصهيوني البقاءُ أو الاستمرارُ في الوجود، فقط في حال توفّرت فيه أغلبيةٌ يهوديةٌ قوميةٌ واضحةٌ تعيش في منطقةٍ جغرافيةٍ تسعى لتحقيق سيادة الدولة والدفاع عنها، بجانب تمتّعها بمستوىً معيشيٍّ يُلائم مجتمعاً غربياً. [29]
بناءً على ما تقدّم، يمكننا القول إن البعد الديمغرافي يُعتبر بعداً مركزياً لسياساتٍ عدّةٍ تهدف إلى الدفع قُدُماً بعملية تهجيرٍ هادئةٍ للسكان الفلسطينيين، عبر التضييق اليومي ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، والتشجيع على الهجرة، واستهداف الوعي الوطني، إذ إنّ هدف المشروع الصهيوني هو “تحويل كلّ البلاد لليهود فقط، وطرد كلّ سكانها غير اليهود على مراحل بقدر الإمكان”. [30]
سياسة الترانفسير
ترتبط سياسة الترانسفير بالجانب الديمغرافي، وهي متجذّرةٌ في الأيديولوجيا الصهيونية. تمثّل هذه السياسة حالةَ سيطرةٍ في إطار الثقافة السائدة، فالفكر الترانسفيري دوماً ما يكون مُحلّقاً في أجواء المجتمع الصهيوني، وما نتج ولا يزال ينتُجُ عنه من فوبيا التفوق الديمغرافي للفلسطينيين على الصهاينة. [31]
على وقع ذلك، يُعتبر فكر الترانسفير مُشكّلاً رئيسياً للأيديولوجيا الصهيونية، وجزءاً أصيلاً من سياساتها؛ إذ لا يمكن السيطرةُ على الأرض الفلسطينية دون وجود سياسة تهجيرٍ للسكان، إذ إنّ عملية “طرد العرب من أراضيهم وتجريدهم من حقوقهم بدأت منذ الهجرة اليهودية الأولى، حيث كان تهويد الأرض يشكّل توجّهاً مركزياً”. [32]
لقد تمّ إنضاجُ الفكر الترانسفيري منذ المراحل المبكرة لبدء المشروع الصهيوني في فلسطين، وعبر أشكالٍ عدّةٍ، مستغلاً الظروف الموضوعية دوماً. ومن حينها، تُمارَس سياسة الترانسفير الهادئ بأشكالٍ مختلفةٍ؛ منها ممارسةُ سياسة الاستيطان والقمع والحصار الاقتصادي، وتهويد ومُصادرة الأراضي ومنع الوصول للثروات الطبيعية، فضلاً عن استخدام بعض المناطق كمكبٍّ لنفاياتٍ مشعّةٍ، وتشجيع الهجرة، واستهداف ذاكرة المكان، ونحت الرواية التوراتية على الأرض.
إنَّ مثل تلك الإجراءات المُتّخذة بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ تُشرَّع عبر قوانينَ قضائيةٍ وتشريعيةٍ، كما يتمّ في الداخل المحتل عام 1948 من استهدافٍ للجليل والنقب، إذ أشارت وثيقةٌ نُشرت عام 1976، وكان قد أعدَّها المسؤول عن المنطقة الشمالية في وزارة الداخلية الصهيونية- ويُدعي “إسرائيل كينت”- إلى أنّ عملية التطهير العرقي التي نُفّذت عام 1948 في الجليل، قد حقّقت نجاحاً محدوداً نسبياً.
سعى “كنت”، في تقريره، إلى تنبيه حكومة الكيان الصهيوني إلى واقع مخاطر عروبة الجليل، مُقترِحاً وسائلَ لتغيير الوضع القائم جذرياً، متمثّلةً في ممارسة سياساتٍ متنوعةٍ؛ أهمُّها المصادرة المتسارعة للأراضي، وتسريع عملية استيطان اليهود فيها، وصولاً إلى تشجيع الفلسطينيين على الدراسة في الخارج ومنعهم من العودة، [33] والبدء فيما باتت تُعرف بسياسة تهويد الجليل، وهذا ما يشمل النقب أيضاً.
كما يبرزُ الترانسفير المتجذّرُ في الأيديولوجيا الصهيونية في العديد من الإنتاجات التي قدَّمها زعماءُ الحركة الصهيونية، كمقترح “أفيغدور يعقوب يان” الذي طُرح عام 1932، والقاضي بتنفيذ خطةٍ سياسيةٍ تقضي بعدم إمكانية تحقيق التقسيم بمعزلٍ عن سياسة الترانسفير. وعليه، اقتُرح ترحيلُ عشرين ألفَ عربيٍّ مقابل تعويضاتٍ من أراضٍ مخصصةٍ للاستيطان الصهيوني. [34]
يتقاطعُ ما سبق مع المبدأ الذي أرساه “ليتنسون”، بقوله: “لا يوجد للسكان العرب، كمجموعةٍ قوميةٍ، حصرُ ملكيةٍ في الأرض، لذلك يجب نقلهم من مكانٍ إلى آخر، بجانب إخلاء وتخليص المناطق الفلسطينية بالاستيطان”. [35]
لا تزالُ سياسة الترانسفير مستمرةً حتى يومنا هذا، إذ إنّ قراءة الموقف الصهيوني من قِبل الفلسطينيين المتبقين في المناطق المحتلة عام 1948 وعام 1967 تشير إلى أن سياسة الاحتلال الصهيوني تجاههم قائمةٌ على تفكيك أو تدمير التماسك الجغرافي والطبقي والقومي والاجتماعي، بهدف ترحيلهم أو تحويل ما تبقى منهم إلى مجرّد تراكمٍ هُلاميٍّ؛ لا رابطَ أو قضيةً سياسيةً قوميةً تجمعهم. [36]
النصُّ الديني المؤدلج
إن مفاهيم إبادة المكان وإبادة الجنس الرمزية، والتطهير العرقي والأبارتهايد الزاحف، وثيقةُ الارتباط بمفهوم الاستعمار الاستيطاني، ويمكن استخدامُها لقراءة سياق ممارسات الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لأرض فلسطين، والذي يمتلكُ خصوصيةً من ناحية عدم قدرته على تنفيذ عملية التغيير العرقي بشكلٍ تامٍّ؛ إذ إنّ ثمّة ميلاً في سياساته من أجل إنجازها تدريجياً، بما تشمل ممارساته لسياسة تطهير المكان والذاكرة، والتي تحكمُ ممارساتٍ ومفاهيمَ مؤسسةً للأيديولوجيا الصهيونية؛ أبرزُها السيطرة والقوة والاستئثار، مُحاوِلاً إضفاءَ الطابع المقدس عليها عبْرَ توظيف النصوص التوراتية.
من بين هذه النصوص، يبرز سفر “يشوع بن نون”، باعتباره بلغة عصرنا الراهن، نصّاً لممارسة سياسة التطهير العرقي، ويستند له راهناً العديدُ من سياسيي ومفكري الحركة الصهيونية الدينية بالأخص، معتمِدين بذلك على نصٍّ ورد في سفر “يشوع” يحكي دخوله أريحا، مشيراً إلى ما يجب أن يقوم به جنوده بأنْ “َحَرَّمُوا كُلَّ مَا فِي المَدِينَةِ مِنْ رَجُل وَامْرَأَةٍ، مِنْ طِفْل وَشَيْخٍ، حَتَّى الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالْحَمِيرَ بِحَدِّ السَّيْفِ”. [37]
يمكننا توصيف هذا الفعل بأنه فعلُ تطهيرٍ عرقيٍّ وإبادةٍ جماعيةٍ، إذ شُدِّدَ عليه بالقول: “يَشُوعُ لَمْ يَرُدَّ يَدَهُ الَّتِي مَدَّهَا بِالْحَرْبَةِ حَتَّى حَرَّمَ جَمِيعَ سُكَّانِ عَايٍ”. [38] ويُشار، أيضاً، إلى روايةٍ في سفر “يشوع” تحكي قصةً تصطدم بالحساسيات المعاصرة؛ فقد يكون “يشوع” مؤسساً لهويةٍ قوميةٍ، لكنّه يفعل ذلك بربط هذا المشروع بمحاولة إبادة السكان الأصليين واحتلال أراضيهم. [39]
كما يُشير بعضُ المفكرين إلى “يهوه” باعتباره إلهاً مسكوناً بكراهية الأجانب وُمشبّعاً بالروح العربية، وعنصرياً وإقصائياً وهمجياً، على حدّ توصيف “غاريت جبتسون”. [40]
إنَّ توظيف الحركة الصهيونية الأيديولوجيَّ للبعد الديني هامٌّ، ويحتلّ مركّباً رئيسياً في رؤيتها، وهذا بحجم حاجتها للاستناد إلى مشروعية الاستيلاء على الأراضي، بجانب توفير عنصرٍ تبريريٍّ للجريمة المُرتكبة بحق شعبٍ آخر. ونستعيد، هنا، مقولة “ديفيد بن غوريون” حول العلاقة بين “يشوع” وجيش الاحتلال الصهيوني: “ثمّة تواصلٌ تاريخيٌّ بين يشوع بن نون وجيش الدفاع الإسرائيلي”، [41] مؤكداً أنّ الجيش يؤدّي الدور الذي مثله “يشوع” تاريخياً. وفي هذه المقولة شرعنةٌ للدور الذي يضطلع به الجيش الصهيوني في عملية التطهير العرقي ضدّ الشعب الفلسطيني.
إنَّ الحركة الصهيونية احتاجت إلى نقطة ارتكازٍ تاريخيةٍ؛ إذ إنها “احتاجت إلى تاريخٍ لكي تثبت أن اليهود في كل مكانٍ يشكلون كياناً واحداً، على اعتبار أن ثمّة تتابعاً وتعاقُباً منذ إسرائيل ويهودا في العقود القديمة وحتى اليهودية المعاصرة”، [42] فالمشروع الصهيوني بتعريفه ودوره “لم يكن مشروعاً قومياً، وإنما هو مشروعٌ استيطانيٌّ قوميٌّ. ولذلك، فإن تكريس الوطن القومي من خلال الكتاب المقدس والأركيولوجيا الكتابية كان لا بُدَّ له أن يكون مزدوجَ البُعد أو ملكاً لأمّةٍ يهوديةٍ، وهو ضمنياً محظورٌ على العدو المتمثّل في الساكن الأصلي”. [43]
كما تتجلّى ضرورةُ توظيف النصوص التوراتية كأداةٍ في سبيل تحقيق المشروع الاستيطاني القومي الصهيوني في قول “يتسحاق شيبرا”- مؤلف كتاب “توراة الملك” عام 2009- “تدور الفكرة حول أن التعليمات الواردة في الكتاب عن الامتناع عن قتل الناس تنطبقُ حصراً على اليهودي الذي يقتل يهودياً، بيْدَ أنه يُسمح قتل الناس الصالحين من الأمم الأخرى، وإن لم يكونوا مسؤولين عن خلق أية حالةٍ من التهديد لإسرائيل، إذ إنّ لا خطأ في قتل أيٍّ من الأغيار”. [44]
إنَّ استخدام الدين ونصوصه، كما يتمُّ في العهد القديم، وتوظيفها بما يلائم سياسات وممارسات الحركة الصهيونية، وما يعنيه من أفكارٍ حول التفوق العرقي والوعد الإلهي والتمييز العنصري والاستخفاف بالقتل والإبادة، بل والتشجيع عليها والادّعاء بامتلاك الحقيقة، كلُّها جوانبُ تبرِزُ طبيعة المشروع الاستيطاني الصهيوني وخصوصياته.
كما تُسقِط الحركة الصهيونية النصَّ الدينيَّ على الواقع الراهن، تحديداً فيما يتعلق بالأرض، إذ يُطلق على كل عملية شراءٍ أو مصادرةٍ للأراضي “تخليصٌ للأرض”، بُغية نفي أبعاد الصبغة الاقتصادية النفعية عن تلك الصفقات، مقابل التشديد على أن هذه الأرض ليست سلعةً مشتراةً، بل مِلكٌ مسترجعٌ. [45]
إن استخدام النص المقدس والاعتداء على الأرض الفلسطينية لن يمرّا دون صعوباتٍ، إذ واجه المشروع الصهيوني، ولا يزال، مقاومةً فلسطينيةً هائلة، فالإنسان هو العقبة الأصعب التي تعيق صياغة ذاكرةٍ جماعيةٍ داعمةٍ للمشروع الصهيوني وتطلعاته. [46]
إنّ ما يطرحه النصُّ المقدسُ والحاخامات الصهاينة ليس وحيداً، إذ أشار الحاخام الصهيوني “هيس” إلى موضوع التطهير العرقي، وحدّد مراحلَه بثلاثٍ:
• إخضاع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية لأحكام الشريعة اليهودية، على أن يحتلّوا وضعية الأجنبي المقيم.
• الدفع باتجاه تهجير العرب وترحيلهم.
• تنفيذ الأمر المتعلق بالعماليق، كما عنونه الحاخام “هيس” في مقاله “الأمر بإبادة الجنس بالتوراة”.[47]
ويُضاف إلى الحاخامات أيضاً مفكّرون مثل “زئيف جابونتسكي”، صاحب نظرية “الجدار الحديدي” التي يلخّصها بقوله: “إنَّ اتفاقاً طوعياً بيننا وبين عرب أرض إسرائيل لا يمكن التفكير فيه أبداً في الوقت الحاضر ولا في المستقبل المنظور.. ومن غير الممكن الحصول على موافقةٍ طوعيةٍ لعرب أرض إسرائيل لتحويل فلسطين إلى بلادٍ تسكنها غالبيةٌ يهوديةٌ، ولذلك النتيجة دولةٌ يهوديةٌ بالقوة، ومن وراء جدارٍ حديديٍّ لا يقوى السكان المحليون على تخطّيه”، [48] علماً أنّ الجدار، هنا، لا يمتلك مكاناً محدّداً، لكنَّ أساسَه قائمٌ على فكرة السيطرة على الأرض وتحقيق عملية الطرد.
ويؤكّد “جابونتسكي”، أيضاً، أهمية التمسّك بالرأي، قائلاً: “كلُ إنسانٍ آخرَ على خطأ، وأنت وحدك على صوابٍ، لا تحاول أن تجد أعذاراً من أجل ذلك، فهي غير ضروريةٍ وغير صحيحةٍ. وليس بوسعك أن تعتقد بأيّ شيءٍ في العالم إذا اعترفت، ولو لمرةٍ واحدةٍ، أن خصومك قد يكونون على صوابٍ… لا توجد في العالم إلا حقيقةٌ واحدةٌ، وهي بكاملها ملكُكَ أنت. إنْ لم تكن واثقاً بذلك، عليك البقاء في بيتك، لكن إنْ كنت واثقاً، فعليك ألا تتطلع إلى الوراء، وستأتي الحقيقة في اتجاهك”. [49]
إن التدقيق في قول “جابونتسكي” يمكّننا من إيجاد تجلياته في سياسات وممارسات حكومة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين. وسياسياً، ذكر العديدُ من السياسيين الصهاينة موضوعَ الإبادة والتطهير العرقي والترانسفير. وهذا ما أكّده، مؤخراً، نائبُ رئيس الكنيست، بتشديده على خيار تهجير السكان وخطته لتحقيق ذلك. وبهذا، يكون “المسؤول الأرفع الذي قال بوضوحٍ إن خيارَ الجينوسايد قائمٌ، إذا لم يوافق الفلسطينيون على شروطنا”، مُستنِداً بذلك إلى سفر “يشوع”. [50]
ويشير الصحافي الصهيوني “يوسي كلاين هاليفي” إلى أن النخب الصهيونية الدينية المسيطرة تعمل وفقاً لهذه القاعدة: “يتحدثون بصوتٍ مرتفعٍ عن الضم، وهم يفكرون في الترانسفير. وغداً سيتحدثون بصوتٍ عالٍ عن الترانسفير، ويفكرون بما فكّر به أعضاءُ التنظيم السري اليهودي”. [51]
كما يتساءل الكاتب “نيرون بنكس” بقوله: “هل حاولنا النضال من أجل البقاء من خلال عملية التطهير العرقي، حيث أرسلنا شعباً إلى المنفى لأننا نريد سلبَ أرضهم؟”. [52]
إن توظيفَ الدين سلوكٌ جوهريٌّ للحركة الصهيونية، لكن هذا المشروع القائم يبقى استيطانياً بامتيازٍ. تُعتبر الحركة الصهيونية معولمةً منذ بدايتها بعكس الدين اليهودي، هذا من جهةٍ. ومن جهةٍ ثانيةٍ، فإن الحركة الصهيونية قد صهينت الديانة اليهودية. ومن هذا المنطلق، يمكن التعامل معهما مندمجتين؛ أي بقدر صهينة الدين وتوظيفه وإلحاقه، وليس بقدر تهويد الصهيونية. [53]
الذاكرة – الحيز المكاني والزماني
تُعتبر الذاكرة الجمعية عنصراً هاماً في كلِّ مجتمعٍ، فهي الوعاء الذي تحتفظ به الجماعة بذكرياتها، إذ تحمل حكايتها وتاريخها وعاداتها وأفكارها. لذلك، دوماً ما يكون استهدافُ الذاكرة سياسةً تلجأ إليها القوى الاستعمارية؛ فقتلُ الذاكرة يعني “الفعل العمد الذي يتقصّد مستخدموه محوَ جميع أو بعض ما يذكِّر جماعةً إنسانيةً، شعباً أو أمةً، بماضيها السياسي أو الاجتماعي أو الفكر العقائدي”. [54]
إنّ تغيير وعي الجماعة لذاتها لا يتمُّ على صعيد المفاهيم بمعزلٍ عن واقعها، بما يتطلبه ذلك من إحداث تغييرٍ في الحيز المكاني بما يساهم في ترجمته على صعيد الوعي، إذ إنّ واقع المكان لا يشير إلى الجغرافيا فحسب، بل إلى السكان أيضاً. بالتالي، فإنّ إحداثَ تغييراتٍ ديمغرافيةٍ يساهم في إعادة رسم المعالم والحكاية، في مُحاولةٍ لنفي حكاية “الآخر” المختلفة.
بناءً على ما تقدّم، عمدت حكومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين إلى ممارسة سياساتٍ ترتبط بإحداث تغييراتٍ على صعيد الحيز المكاني لاستهداف الرواية الأخرى الأصلية.
الأسماء استبدالٌ مكانيٌّ في الوعي
أقرَّ وزير المواصلات في حكومة الاستعمار الصهيوني عام 2009 “شطبَ أسماء البلدات والمدن العربية عن الإشارات واللافتات المنصوبة على الشوارع والطرقات الرئيسية، مقابل الاحتفاظ بأسمائها العبرية”. [55]
ويُعتبر تغيير الأسماء أحدَ أهم المعالم الرئيسية التي حُدّدت من قِبل حكومات الكيان المتعاقبة، بحيث شكّل رئيس وزراء الاحتلال الأول “بن غوريون” لجنةَ الأسماء العبرية بهدف عبرنة مواقعَ في النقب. [56] وتوسَّع دورُ وأداءُ هذه اللجنة لاحقاً، بجانب العمل على إعادة صياغة ذاكرة المكان وِفقَ الرواية التوراتية، لتتمَّ عمليةُ تدميرٍ ممنهجةٌ لذاكرة المكان كما يتمُّ في القدس ومواقعَ عديدةٍ أخرى.
ونُلفِتُ النظر هنا إلى “أنَّ التهويدَ المستمرَ للحيز المكاني من خلال عمل لجان التسميات الحكومية والمؤسسات الفاعلة على الأرض، وبجهد مصمّمي الرأي من كتّابٍ وصحافيين ومؤرخين، تسيرُ في عملية التهويد قُدُماً من دون أن تواجه هذه العمليةُ ردودَ فعلٍ مدروسةً ومهنيّةً من الجانب الفلسطيني، إن كان على مستوى المناضلين في الداخل، أو على مستوى المناضلين بشكلٍ عامٍّ”. [57]
الحكاية والأرض
مَنْ يروِ الحكاية يَرِثْ أرضَ الحكاية، على حدّ تعبير الشاعر الراحل محمود درويش، إذ إنّ الرواية تمتلك خاصّية الهيمنة، وهي كذلك أيضاً على صعيد مجتمع الاستعمار الاستيطاني، لتُقدَّم الرواية باتجاهين؛ الأول: التمجيد من ثمّ النفي لرواية السكان الأصلانيين، والثاني: بناءُ روايةٍ مفترضةٍ أخرى.
في هذا السياق، تُدرَّس في مدارس المجتمع الصهيوني مساقاتٌ عدّةٌ مبنيّةٌ على قيمتي المحو والبناء، منها مثلاً مساق “اعرف بلدك”، إذ يتمُّ عبْرَه تحميلُ العرب مسؤوليةَ الخراب البيئي للبلاد كلها، حيث لم يقم الصهاينة بسرقة الأرض من سكان البلد وحسب، بل يتّهمونهم بالتخريب. [58] هذا بجانب روايةِ طوعيةِ تركِ السكان لبيوتهم، بناءً على دعوات الزعماء العرب، وذلك على الرغم من أنّ هذا الادعاء لم يُعثر على أيِّ دليلٍ لإثباته.
ولِكون الصهاينة ينسجون روايتهم على قاعدة نفيِ روايةٍ أخرى، فإنّ المؤسسة التعليمية التابعة لهم تخدم في سبيل تحقيق ذلك، إذ أقاموا الجامعة العبرية لتعليم جماعة المستوطنين الموجودين والمستقبليين، والعمل ضمنياً على إقصاء السكان المحليين الأصليين عنها. [59]
وللإبقاء على الرواية الرسمية المهيمنة، حاول الكيانُ الصهيونيُّ “منعَ خطاب الروايات المختلفة، فهي لا تسمح بروايةٍ أخرى خلافاً للرواية الرسمية، ويمكن اعتبار ذلك محاولةً لمنع التصدعات في الرواية المُتجانسة”. [60]
إن عملية بناءِ أو هدمِ أو نفيِ رواية الآخر تُعتبر جزءاً من عملية التغيير التي أسّستها عمليةُ التطهير العرقي، والتي ستستمرُ باستهداف المجتمع الفلسطيني، وخاصةً ذاكرته وتاريخه، حيث “تمَّ منعُ الفلسطينيين من العودة إلى حضارتهم، وتم نفيهم من ماضيهم، واعتُبرت ذاكرتهم سلاحاً خطيراً، لذلك كان من الضروري محاربتُها”. [61]
هكذا، يصبحُ استهداف الحيز المكاني وإحداث تغييرٍ فيه، على صعيد الذاكرة والتاريخ، جزءاً من عمليةٍ متكاملةٍ يتمُّ تنفيذُها بشكلٍ اعتياديٍّ؛ وهي التطهير العرقي الهادئ.
خلاصاتٌ عامّةٌ
إنَّ الخلاصة الرئيسية التي يمكن تسجيلُها تتعلق، أولاً، بطبيعة المشروع الصهيوني الذي نواجهه؛ إذ نعتبره مشروعاً استعمارياً استيطانياً توسّعياً تنطبق عليه معاييرُ الاستيطان الاستعماري. ثانياً، يمكننا القول إن هذا المشروع استطاع تطويرَ ممارساته لتحقيق غاية الطرد وإبادة السكان الفلسطينيين. وبهذا، حملت تلك الممارسات أبعاداً مختلفةً، سواءً البعد الرمزي على صعيد الوعي وحيّزي المكان والذاكرة، أو البعد المادي المباشر عبر التضييق والتهجير والاستهداف المستمر والمتواصل، واستخدام سياسة الترانسفير وتطبيقها بالإكراه المباشر وغير المباشر.
ثالثاً، يمكننا الاستنتاج بأن المشروع الصهيوني لا يزال يسعى لتطبيق مفهوم التطهير العرقي الهادئ، والسيطرة على الأرض دون السكان بوجود أقليةٍ مؤقتةٍ بوعيٍ متأقلمٍ. أمّا رابعاً، فإنّ الغطاء الأيديولوجي للمشروع الصهيوني يتمُّ عبر أدلجة الدين وتوظيفه كإرثٍ في الاستعمار الاستشراقي.
وبهذا، فإن المشروع الصهيوني، وبجميع الدلائل المترجمة يومياً من استيطانٍ وتهويدٍ للقدس وتدميرٍ للبيوت، وإعادة صياغة ذاكرة المكان عبر سياسات التضييق والحصار، والتشريعات الصادرة من قانون النخبة إلى قانون القومية، يأتي في سياق عملية تطهيرٍ واضحةٍ للأرض.
كما يحتل الوعي مكاناً مهمَّاً في محاولة تكريس المشروع الصهيوني نفسَه، إذ يقول الباحث “ديفلسكي”: “الشيءُ الأساسُ هو فنُّ القصص، وكلُ الأعمال في الواقع تنبع من الهيمنة على الوعي؛ لأنه الميدانُ الحاسمُ الذي يصوغ الواقع. وهذا هو الميدان الذي عرف النازيون والفاشيون السيطرةَ عليه، فلا يمكنُ القيامُ بأيِّ عملٍ في الواقع، وتنفيذُ أيِّ مصادرةٍ لأرضٍ أو استيطانٍ، وتكريسُ أيِّ فرقٍ في ظل رأسماليةٍ متوحشةٍ إلا بفضل تغيير الوعي فقط”. [62]
ما العمل؟
إنَّ الحاجة إلى المواجهة حاجةٌ ضروريةٌ وملحّةُ، وتحديد طبيعة العدو الذي نواجهه يُعتبرُ أساسياً لصياغة مشروع المواجهة الغائب حالياً عن الفلسطينيين. يتطلّبُ برنامجُ المواجهة توحيدَ الصف الوطني، دون أن يعني ذلك الانتظار، على اعتبار أنّ عنصرَ المبادرة هامٌّ وفاعلٌ ومؤثرٌ. على وقع هذه المعطيات، يجبُ صوغ برنامجٍ ينطلق من عدة مرتكزاتٍ، ويمكن اعتباره جزءاً من برنامجٍ وطنيٍّ عامٍّ، والذي يرتكز على التالي:
المرتكز الأول:
ضرورةُ تحديد طبيعة العدو الذي نواجهه بوصفه مشروعاً كولونيالياً توسّعياً استيطانياً إجلائياً. وبالتالي، فإنّ التصالح مع هذا المشروع غيرُ واقعيٍّ، وغيرُ قائمٍ دون هزيمته؛ لا خيارَ آخرَ أمامنا.
المرتكز الثاني:
رفضُ التعايش والتعاطي مع واقع تكبيل وتقسيم الشعب الفلسطيني جغرافياً إلى أجزاء، وما أنتجه هذا الواقع المفروض على صعيد الوعي ما بين الداخل المحتل عام 1948 والضفة وغزة والقدس والشتات، وضرورة إعادة التوحيد على قاعدة شعبٍ واحدٍ يواجه مشروعاً استعماريّاً استيطانياً، ويقاومه بشتى الوسائل وبجميع الساحات، مع توفير الترجمة السياسية لذلك.
المرتكز الثالث:
إعادةُ التأكيد على أن القضية الفلسطينية مُركّبٌ ما بين الأرض والإنسان، وجوهرها حقُّ العودة، لذلك لا يمكن مساومتها عليه، فهذا الهدف الوطني يكثّف العلاقة ما بين الإنسان والأرض، والإنسان والذاكرة، الإنسان والهوية، ممثِّلاً خطابَ الحق الحقيقي.
إن هذه المرتكزات تجعلنا قادرين على صياغة الأدوات؛ إذ إنّ توحيدَ البرنامج والأهداف في مختلف الساحات يتطلّبُ صياغاتٍ سياسيةً محددةً، تتمثّلُ في قيادةٍ وطنيةٍ مُوحَّدةٍ معبّرةٍ وممثِّلةٍ بشكلٍ حقيقيٍّ عن الشعب الفلسطيني؛ لا تستثني أحداً سياسياً وجغرافياً.
وبهدف تحقيق ذلك في الواقع الفلسطيني الراهن، فإن المطلوبَ المبادرةُ بتشكيل جبهة الإنقاذ الوطني من أجل صياغة البرنامج الوطني المقاوم، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسسٍ ديمقراطيةٍ ومشاركةٍ شاملةٍ لعموم القوى السياسية، على قاعدة خوض المواجهة مع المشروع الصهيوني.
قد تبدو هذه الأفكار، للوهلة الأولى، غيرَ واقعيةٍ وتمثّل حالةَ اجترارٍ، لكنَّ المختلف هنا هو الدعوةُ لتوحيد الجهد من قِبل جميع التيارات صاحبة المصلحة لتشكيل إطارٍ يتمثّل في جبهة الإنقاذ الوطني كهدفٍ عامٍّ. بَيْدَ أنّ ثمّة مهماتٍ أخرى تحتاج إلى مبادرةٍ من أجل المواجهة، ومنها الأفكار التالية:
أولاً: العمل على صعيد تقديم الرواية الفلسطينية وتقديم حقيقة ما تمَّ ويتمُّ ضد الشعب الفلسطيني من عملية تطهيٍر عرقيٍّ، وذلك عبر التأسيس لإطلاق حملةٍ دوليةٍ تحت شعار “المشروع الصهيونيُّ عمليةُ تطهيرٍ عرقيٍّ لا تزال جاريةً”. إنّ ممكنات مثل هذه الحملة قائمةٌ عن طريق القوى السياسية الحيّة فلسطينياً وعربياً ودولياً، والمؤسسات والشخصيات التي يمكن توحيدُ جهودها، عبر حملةٍ مُخطّطٍ لها ومُعدٍّ لها جيداً، على أن يتمَّ تأطيرُ خطاب هذه الحملات بفكرة أن المشروع الصهيوني مشروعُ استعمارٍ استيطانيٍّ وفصلٍ عنصريٍّ يمارس عمليةَ تطهيرٍ عرقيٍّ راهنةً على الأرض.
ثانياً: إطلاق مبادراتٍ تحت عنوان “الحكاية الفلسطينية نرويها”، بحيث تُنظَّم فعالياتٌ تحت عنوان هذه المبادرة، لتشمل فلسطين التاريخية والخارج، وتتضمّن التعريف بما تعرَّض له الشعب الفلسطيني من جرائم، فضلاً عن التعريف بفلسطين التاريخية جغرافياً، وإحياء المناسبات الوطنية، بجانب العمل على صعيد التعريف بالمشروع الصهيوني.
ثالثاً: إطلاق مبادراتٍ شبابيةٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تكونَ تحت عنوان “الحقُّ أقوى من القوة”، متسلّحةً بالوعي والإرادة، حيث تشملُ تقديماً للمفاهيم الوطنية وتجارب الحوار، والتعريف بالمشروع الصهيوني وأهدافه، إضافةً إلى محاربة المفاهيم وبعض الأفكار والقيم الدخيلة التي أُسّست على قاعدة الانقسام الجغرافي.
رابعاً: ممارسة حقّ العودة لتغدو المهمة نموذجاً مُستقىً من مسيرات العودة التي انطلقت من غزة، بحيث نستفيد من هذه التجربة من ناحية تعميمها عبر مسيرات العودة في كافة الساحات، وتطوير أفكارٍ تتعلق بممارسة حق العودة.
خامساً: إعادة الحوار وطنياً فيما يتعلق بخطاب الحق التاريخي في كلّ فلسطين، وليس جزءاً منها، وهو ما يضمن حقّ العودة فعلياً.
سادساً: إعادة تفعيل لجان العودة على أسسٍ جيدةٍ وبمهامٍ مبتكرةٍ.
إن هذه الأفكار وغيرها يمكن أن تفتح المجال أمام المبادرة في ظلّ هذا الواقع البائس سياسياً، والتي تحتاج إلى فعلٍ جماعيٍّ من أجل المواجهة.
يمكنكم قراءة وتحميل الدراسة بصيغة (pdf) من هنا
****
نبذةٌ مختصرةٌ عن الكاتب الأسير
وُلِدَ الأسير وائل نعيم الجاغوب في مدينة نابلس بتاريخ ٢٣ أيار ١٩٧٦م. اعتقل لأولِ مرةٍ عام ١٩٩٢م، حيث أمضى ستِ سنواتٍ في الأسْر، ليٌفرج عنه عام ١٩٩٨. التحق حينها بالدراسة الجامعية في جامعة القدس المفتوحة، لكن قوات الاحتلال الصهيوني أعادت اعتقاله عام ٢٠٠١، ليُحكم عليه بالسجن المؤبد هذه المرة. له عدةُ مؤلفاتٍ وكتاباتٍ أنجزها في الأسر، مثل “حكاياتٌ أسيرةٌ” و”التجربة الاعتقالية والتنظيمية” بالتعاون مع الأسير كميل أبو حنيش. كما ينشر العديد من المقالات والأبحاث السياسية. يشغلُ الأسير وائل الجاغوب عضوية اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما أنه نائب مسؤول فرع الجبهة الشعبية في السجون.
****
الهوامش
[1] عدّة مؤلفين. 2002. “ذاكرة، دولة وهوية: دراسات انتقادية حول الصهيونية وإسرائيل”. ترجمة أنطوان شلحت. رام الله، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار). ص 149.
[2] نفس المرجع السابق. ص 92.
[3] نفس المرجع السابق. ص 99.
[4] يفتاحئيل، أورن. 2009. “بين الكولونيالية والثيوقراطية: الأبارتهايد الزاحف في إسرائيل”. مجلة “قضايا إسرائيلية”. رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار). العدد 35. ص18.
[5] نفس المرجع السابق. ص 18.
[6] نفس المرجع السابق. ص 18.
[7] نفس المرجع السابق. ص 19.
[8] منصور، جوني. 2014. “إسرائيل والاستيطان: الثابت والمتحول في مواقف الحكومات والأحزاب والرأي العام من 1967 حتى 2017”. رام الله: مدار.ص 19.
[9] حبّاس، وليد. صيف 2017. “مفهوم الاستعمار الاستيطاني: نحو إطارٍ نظريٍّ جديدٍ”. مجلة “قضايا إسرائيلية”. رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار). العدد 66.
[10] بيتربيرغ، غابرييل. “المفاهيم الصهيونية للعودة، أساطيرُ وسياساتٌ ودراساتٌ إسرائيليةُ”. ترجمة سلافة حجاوي. رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار). ص 86.
[11] نفس المرجع السابق. ص 87.
[12] منصور، جوني. 2014.”إسرائيل والاستيطان: الثابت والمتحول في مواقف الحكومات والأحزاب والرأي العام من 1967 حتى 2017″. رام الله: مدار.
[13] غانم، هنيدة. 2009. “ما بين الاحتلال العسكري الاستعماري والأبارتهايد”. مجلة “قضايا إسرائيلية”. رام الله: مدار. العدد 35.
[14] غانم، أسعد. مصطفى، مهند. 2009. “الفلسطينيون في إسرائيل: سياسات الأقلية في الدولة الإثنية”. رام الله: مدار. ص 28
[15] نفس المرجع السابق. ص 46.
[16] نفس المرجع السابق. ص47.
[17] نفس المرجع السابق. ص50.
[18] ورقة مقدمة في المؤتمر السنوي السادس حول أداء القطاع الأمني الفلسطيني. أريحا: جامعة الاستقلال. 15-16 كانون ثاني 2011.
[19] شلحت، أنطون. سوم، ديفيد. 2008. “الدولة اليهودية فوق أي حقوق: قراءةٌ في ردات الفعل الإسرائيلية، مستقبل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل”. رام الله: مدار. ص 133.
[20] الأبارتهايد الصهيوني. مصدر سبق ذكره. ص31.
[21] ذاكرة، دولة وهوية. مصدر سابق. ص 149.
[22] سخنيني، عصام. 2012. “الجريمة المقدّسة: الإبادة الجماعية من أيديولوجيا الكتاب العبري إلى المشروع الصهيوني”. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ص 28
[23] حباس، وليد. “مفهوم الاستعمار الاستيطاني: نحو غطارٍ نظريٍّ جديدٍ”. مصدر سابق. ص110.
[24] سخنيني، عصام. مصدر سابق. ص 12
[25] الأبارتهايد الصهيوني. مصدر سابق. ص31.
[26] سلطان، نمر. “الأقلية العبرية في إسرائيل”. مصدر باللغة العبرية. ص 19.
[27] ازرحون، ازرحائيم. منصور، نمر. “مواطنون بدون مواطنة”. ص 19.
[28] سلطان، نمر. مصدر سابق. ص 19.
[29]مؤلفون عدّة. 2011. “إسرائيل ديمغرافياً 2010 -2030: في الطريق نحو دولةٍ دينيةٍ”. ترجمة سليم سلامة. سلسلة “أوراق إسرائيلية”. رام الله: مدار. ص20.
[30] صحيفة هآرتس. مقالة لهيرتزمان. 2018.
[31] “منقذ الأرض وداعية الترانسفير”.كراسة خاصة في يوميات ومذكرات يوسف فايتس.
[32] “120 عاماً على الصراع الصهيوني الفلسطيني”. مجلة “قضايا إسرائيلية”، رام الله: مدار.
[33] بيتربيرغ، غابرييل. مصدر سبق ذكره. ص16.
[34] من مجلة “قضايا اسرائيلية”. مصدر سبق ذكره. ص11-12.
[35] نفس المصدر السابق. ص 12.
[36] سمارة، عادل. 2015. “الاقتصاد السياسي للصهيونية: المعجزة والوظيفة”. دار اليازوري العلمية. ص 21.
[37] العهد القديم، سفر يشوع، 6-7 ، آية 21-22.
[38] العهد القديم، سفر يشوع، 8-9، آية 26-27.
[39] سخنيني، عصام. مصدر سابق. ص 44.
[40] نفس المصدر السابق. ص37.
[41] نفس المصدر السابق. ص 55.
[42] ذاكرة ،دولة وهوية. مصدر سابق. ص197.
[43] بيتربرغ، غابرييل. مصدر سابق. ص 294.
[44] سخنيني، عصام. مصدر سابق. ص 63.
[45] كبها، مصطفى. 2009. “الصراع الفلسطيني الصهيوني والحرب على الذاكرة في الحيز المكاني”. مجلة “قضايا إسرائيلية”. رام الله: مدار. العدد 36، ص 40.
[46] سخنيني، عصام. مصدر سابق. ص40.
[47] نفس المصدر السابق. ص60-61.
[48] الأبارتهايد الصهيوني، مصدر سبق ذكره، ص 17.
[49] الأبارتهايد الصهيوني، مصدر سبق ذكره، ص162.
[50] صحيفة “هآرتس” حول خطة ستريتش، إعداد الصحافي “داينان بيتمان”.
[51] مقال بعنوان “طغمتنا المتدينة”. ديكلاين، 13-4-2017.
[52] بنفيستي، ميرون. 2001. “طمس تاريخ الأرض المقدسة منذ 1948”. ترجمة سامي مسلم. رام الله: مدار.
[53] سمارة، عادل. مصدر سبق ذكره. ص250.
[54] سخنيني عصام. مصدر سابق. ص41.
[55] سخنيني، عصام. مصدر سابق ص41.
[56] المشهد المقدس. مصدر سابق ص 42.
[57] فيلدمان، جاكي. 2010. “في أعقاب الاستغلال الإسرائيلي للمحرقة: الوفود الشبابية الإسرائيلية إلى بولندا والهوية القومية”. مجلة “قضايا إسرائيلية”، رام الله: مدار. العدد 36. ص 42.
[58] المشهد المقدس. مصدر سابق. ص 91.
[59] بيتربيرغ، غابرييل. مصدر سابق. ص 78.
[60] أورون، يائير. 2015. “المحرقة، “الانبعاث”، النكبة”. ترجمة أسعد زعبي. رام الله: مدار. ص3.
[61] عميت، غيش.2009. “معطياتٌ جديدةٌ حول مصير المكتبات العربية التي نهبتها دولة إسرائيل عند قيامها”. مجلة “قضايا إسرائيلية”. رام الله: مدار. عدد 36. ص 29.
[62] شلحت، أنطوان. 2014. “بنيامين نتنياهو: عقيدة اللاحل”. رام الله: مدار. ص 10.