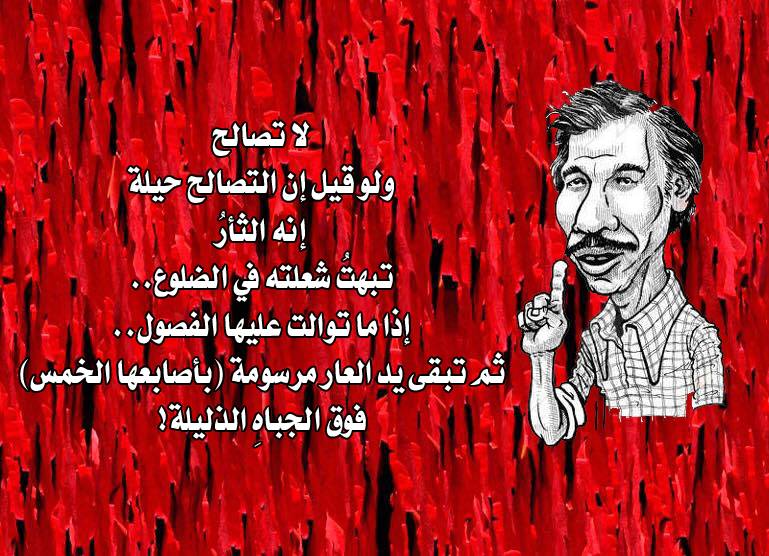تبحث هذه المقالة في سياسات الجسد الفلسطيني باعتبار الأخير امتداداً للصراع على الأرض، ممتلئاً بالحقل السياسي ومشاريعه المختلفة. تخوض الباحثة سجى الطرمان في هذا الجزء الأول غمارَ سياستَيْ الموت المولّد، والجثامين الحيّة المنتظرة.
توطئة
تسعى هذه المقالة، في جزئها الأول، إلى تفكيك أشكال مقاومة الجسد الفلسطينيّ المتمثّلة في الموت المولّد، والجثامين الحيّة المنتظرة، فيما ستناقش في جزئها الثاني سياسات السجن وفلسفة القضبان، ومسيرات العودة في قطاع غزّة. تنظر المقالة إلى هذه السياسات كآلياتٍ طوّرها الفلسطينيّ لتحدّي منظومة السيطرة الصهيونيّة على شؤون حياته وموته.
تبقى المقاومة، والشهادة، والموت، والاعتقال آلياتٍ منتجةً للمعاني السياسيّة عند الفلسطينيين، بهدف إعادة تشكيل الجماعة الفلسطينية الفاعلة بوعيٍ سليمٍ قائمٍ على الإيمان بحتميّة التحرر. يتمّ ذلك برغم عمليات التفكيك الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ الساعية إلى صهر الوعي ومحوه وتجريده من صبغته التحرريّة. بالمجمل، ترى المقالة أنّ دراسة الأنماط السائدة للموت والحياة، والأجساد وحركتها في فضاءات المجتمع الفلسطيني، تعدّ مؤشّراً على فهم المجتمع نفسه، والسلطة الواقعة على أفراده، وبالتالي مقاومتهم لها. [1]
مقدّمة
يحظى الإنسان بقدرةٍ على رفض الواقع المزري الذي يعيشه، والعمل على تغييره بواقعٍ أفضل، بعيداً عن الاستسلام له أو مجرّد إدانته لفظيّاً. لا يتوقّف الرفض عند رفض الواقع الاستعماري فحسب، إنّما يتعدّاه إلى القدرة على مواجهته؛ إذ تمارس المقاومة التحرريّة فعلها عبْر الاتصال العميق بالواقع الاستعماري، وانفصالها الكليّ عنه في الآن نفسه.
يقوم النضال الفلسطينيّ على سمةٍ ثابتةٍ ترفض الركون إلى الدعة، ومقارعة الاستعمار بأطواره المختلفة منذ ما ينيف على مئة عامٍ. ولأنّ الظروف والمتغيرات المحيطة بهذه السياسة النضاليّة لم تكن مواتيةً دوماً، فقد انطبعتْ بسمةٍ أخرى تمثّلت في القدرة على إعادة التكوين، وتوظيف كلّ الوسائل المتاحة والممكنة للتعبير عن إرادة التحرّر.
بناءً على هذا، سلكت المقاومة دروباً سبق لحركات تحررٍ أخرى أنْ سلكتها، وتمكّنت بطول المراس من إبداع وسائلها الكفاحيّة الخاصة بها. كانت المقاومة المسلّحة ولفترةٍ طويلةٍ، تحديدًا منذ مطلع 1965، الوجه الأكثر بروزاً للنضال الفلسطينيّ، حيث تبنّت الحركة الفلسطينيّة العنف المسلح، واعتبرته الأسلوب الوحيد لتحقيق الأهداف التحرّرية في مواجهة الاستعمار الاستيطانيّ في فلسطين.
بالمقابل، أخذت المقاومة طابعاً شعبيّاً بين 1987 و1993. كان الانتقال من شكلٍ مقاومٍ إلى آخر نتيجةً لعوامل داخليةٍ ذاتيّةٍ، وأيضاً خارجّيةٍ- إقليميّةٍ، [2] جمعتها محاولاتٌ مستمرةٌ للتحرّر من المنظومة الاستعماريّة المفروضة على الفلسطيني، والتي تسعى لتحويله إلى ذاتٍ مطيعةٍ منسلخةٍ عن ماضيها، ومغيّبةٍ في حاضرها.
تقرأ المقالة هذه السياسات كمحاولات إعادة تشكيل الجماعة الفلسطينيّة الفاعلة، بعد توالي عمليّات التفكيك الجسديّ البيولوجيّ الجمعيّ للفرد الفلسطيني، والتي جرى تكثيفها لحظة النكبة وما تلاها. على إثر ذلك، نفكّر في الجسد الجمعيّ الفلسطينيّ كموقعٍ مركزيٍّ في الحدث السياسيّ والذاكرة؛ ذلك أنّه يمثّل وِحدة التحليل السياسيّ في إشكاليّة حضوره وغيابه. سنتتبّع هنا تحوّل إدراك الذات الفلسطينيّة لجسدها من كونه منتهكاً معذّباً ومقيّداً في الحالة الاستعماريّة، إلى كونه فاعلاً محرّكاً للواقع يصدح برفض الحالة الاستعماريّة ومقاومتها، ويساهم في إعادة تشكيل الذات الفلسطينيّة.
تعدّ دراسة الأنماط السائدة للموت والحياة، والأجساد وحركتها في فضاءات مجتمعٍ ما، مؤشّراً على فهم المجتمع نفسه، والسلطة الواقعة على أفراده، وبالتالي مقاومتهم لها. وقد انشغل المؤرّخون بمعالجة تاريخ الجسد منذ زمنٍ طويل، كركيزةٍ بيولوجيّةٍ خالصةٍ للوجود، بيْدَ أنّ الجسد ممتلئٌ بالحقل السياسيّ؛ إذ تؤدّي علاقات السلطة عملاً مباشراً فيه، بتوظيفه، وتطبيعه، وتقويمه وتعذيبه، وتنميطه، وضبطه، كحيزٍ للاستثمار السياسيّ وفقاً لعلاقات القوة والسيطرة. [3] سننتقل الآن إلى البحث في أوّل أطوار محاولات تحرّر الجسد الفلسطيني من آليات السلطة الاستعمارية، وهو الموت المولّد.
الموت الفلسطينيّ
يرى الفلسطيني في موته سبيلاً للمحافظة على كيان الجماعة، متجرّداً من مصالحه الشخصيّة، ومدّرباً على التخلي عنها، وإنكار ذاته دون قيدٍ أو شرطٍ، كما يسميّه “إيميل دوركهايم” “الانتحار الطوعي” كسجيّةٍ أخلاقيّةٍ لصيقةٍ بالبدائيّ. ففي هذه الحالات، يتطلّع الجسد إلى التجرّد من كينونته ليتلاشى في ذلك الشيء الآخر الذي يراه جوهره الحقيقيّ، حيثما يجد ذاته مجرّدةً من كلّ وجودٍ خاصٍ. لكنّ فعلها المصنوع من الأمل يمتدّ إلى آفاقٍ أبهى تُخلق عبر موته، حينما يجري توظيفه على نحوٍ مفيدٍ للجماعة. يبدو هذا الفعل مرتبطاً أشدّ الارتباط بتلك الأخلاقيّّة التي ترفع عالياً الشخصيّة الإنسانيّة التي لم يعد بوسعها الخضوع لأيّ شيءٍ. [4]
يبدو المشهد في السياق الفلسطيني أكثر وضوحاً، انطلاقاً من خصوصيّةٍ لا نوردها هنا على سبيل الابتذال أو الإخفاق في فهم النظام الدلاليّ للواقع، إنّما هي خصوصيّةٌ نابعةٌ من موته، تفرض فهماً متمايزاً عن المفاهيم ذاتها الشائعة في دراسة المجتمعات الأخرى. في هذا الصدد، وفي دراسةٍ أُجريت حول تاريخ الموت الاجتماعيّ، يسعى “آلان كيليهر”، على مدار كتابه، إلى تبيان كيفيّة تأثير الترتيبات الاجتماعيّة المختلفة على تجربة الموت، والطريقة التي يحرّك بها الموت الناس. [5]
واقتباساً لهذا الطرح، يشير إسماعيل ناشف إلى أنّ الإنسان لا يموت بحسب هواه، إنّما طريقة موته مرهونةٌ بشكل النظام الاجتماعيّ الذي يعيش فيه الجسد. طريقة الموت، مثل المرض والقتل والموت الطبيعي، هي بمثابة نسقٍ سلوكيٍّ مثل أيّ ممارسةٍ اجتماعيّةٍ أخرى تُشتق من النظام الاجتماعي العام، وتتحقّق في سياق حياة الفرد الذي سيموت. [6]
كانت النكبة حدثاً شموليّاً مؤسّساً لما هو فلسطينيّ، فالحياة لم تعدّ الحياة ذاتها، بل أصبحت حياةً كليّةً أخرى. [7] وجدت هذه الكليّة طريقها في الموت الفلسطينيّ كمشروعٍ لم يكتمل ويحمل في طياته الرغبة في الحياة، يكشف الممكن ويضيء طرق تحرّره المحتملة. ظلّ الموت الفلسطينيّ قادراً على التعبير عن حدث النكبة ضمن بنيته التفكيكيّة، منبثقاً عن المبنى الداخليّ للحدث، ليبنيه من جديدٍ وفقاً لتشكيلاتٍ بمعايير غير نابعةٍ منه. قتلت النكبة الفلسطينيّ على المستوى الجسديّ الإنتاجيّ، وعلى المستوى الاجتماعيّ بتفكيك لحمته مكانيّاً واجتماعيّاً، وكذلك على المستوى البنيويّ بوجود نظامٍ استعماريٍ يحّتم موت الجماعة الفلسطينيّة. [8]
تدرك الشعوب المستعمَرة أنّ ظهور المجتمع الجديد يسبقه اندلاع العنف. [9] فليست المقاومة التحرريّة سفكاً غزيراً للدماء أو مجرّد حربٍ، بل إنّها -بالدرجة الأولى- تغييرٌ جذريَُ وشاملٌ لا يؤدي فيه العنف العسكري سوى دور الوسيلة، ولا يجري ذلك بهدف التخفيف من وطأة الواقع المأسويّ المجّسد من خلال المستعمِر، إنّما لتجاوزه.
يعلن “جان بول سارتر” على لسان “فرانز فانون” أنّ “العنف لا يمكن قهره… إنّما هو جوهر الإنسان، إذ يعيد خلق نفسه بنفسه”، وأنّّ “معذَّبي الأرض” لا يمكنهم أن يصبحوا بشراً إلا عبْر “الجنون القاتل”. [10] انطلاقاً من هذا المنظور، فإنّ المسعى المشتهى في الحالة الفلسطينيّة يتمثّل في العودة، فالأخيرة جوهرٌ تلتفّ حوله آلياتٌ شتّى من إنتاج المعاني تشكّل مجتمعةً ما هو فلسطينيّ. وبفهمٍ إجرائيٍّ، تمثّل العودة خُطى الصراع على تحرير إدارة شؤون الموت الفلسطينيّة من قبضة الاحتكار الصهيونيّ لها.
وعليه، فإنّ المقاومة كشكلٍ من العودة المتعدّدة، تسعى لخوض هذا الصراع في مسعىً للتحرّر من آليات السيطرة على شؤون الموت الفلسطينيّ. كانت المقاومة المسلّحة تعبيراً عن إعادة إنتاج الفلسطينيّ، أو كما يسمّيها يزيد صايغ البحث عن “الكيان”، وتأكيد الوجود الفلسطينيّ، وإنْ كنّا أكثر ميلاً لتوصيف ناشف باعتبار المقاومة آليّةً عينيّةً لإعادة إنتاج الفلسطينيّ ذاتَه الجماعيّة؛ [11] إذ إنّّ المقاومة بجوهرها صعودٌ للفدائي من صورة الضحيّة. [12]
قدّمت المقاومة بشكلها المسلّح بنىً تنظيميةً للفلسطينيين للتعبير عن ذواتهم، تمّ تكثيفها لاحقاً في منظمة التحرير، [13] في مسعىً لاسترداد زمام أمورهم، وانتزاع السيطرة على الموت الفلسطينيّ، واستثمار الأخير في اقتصادٍ سياسيِّ للتحرّر الوطني.
تؤديّ كثافة الموت كماً وكيفاً –على نحوٍ نسببي- إلى كثافة التحرّر أرضاً ومجتمعاً. يستوجب هذا على الفلسطينيّ استثمارَ جميع ما في موته ليتمكّن من تحقيق مشروع التحرير الناجز. [14] يزيل هذا التراكم الكميُّ للموت من نفس المقاوم ظلمات الاستعمار شيئاً بعد شيء، وصولاً للانعتاق من النظام الاستعماري، ونفي آليّته في تفكيك البنية التحتية للمجتمع الفلسطينيّ.
كانت المقاومة المسلّحة بصورة الموت/ الشهادة بمثابة إعادة البناء الاجتماعي، حيث منحت الصورة واللغة الكفاحَ المسلّح جوهراً جديداً، فأخذ الفلسطينيون ينظرون إلى أنفسهم كشعبٍ بوجودٍ [15] ماديٍّ مرئيٍّ فاعلٍ يخوض بجسده كفاحاً فعليّاً لتقرير مصيره. فأنْ تموت شهيداً يعني أنك تنتزع من النظام سيطرته على إدارة شؤون الموت الجماعيّ الفلسطينيّ، حتى وإنْ كان هذا الانتزاع رمزيّاً و/أو جزئيّاً. [16]
ومقابل التمرّد الفلسطينيّ على آليات السيطرة والاستحواذ الاستعماريّة، نرى المستعمِر واجه ذلك بآلياتٍ أكثر شراسةً. أفضى غزو “إسرائيل” للبنان في عام 1982 إلى تصفيةٍ شبه تامةٍ للبنية المؤسساتيّة والعسكريّة لمنظمة التحرير. وشيئاً فشيئاً، تخلّت منظمة التحرير عن الكفاح المسلّح، متحوّلةً نحو خيار السلام والمفاوضات، لينتقل الفعل الجمعيّ إلى غزة والضفة الغربية. خضعت الأخيرة لآليات تفكيكٍ متتاليةٍ أفرزت بالمحصلة تفكّك البنى التنظيميّة والقوّة العسكريّة لمعظم الفصائل الفلسطينيّة بعد انتفاضة الأقصى، فضلاً عن التفكيك الاجتماعيّ.
ساهم ما سبق في تغيير المزاج الشعبيّ لبعض الشرائح في الضفة الغربيّة، إذ تحوّلت بناها الخطابيّة من كونها “شعباً تحت الاحتلال”، إلى مجرّد مواطنين يسعون لتحقيق متطلّبات “الرفاه”. تحقّق هذا بفعل سياسات “السلام الاقتصاديّ” والدور الذي لعبته العقيدة الأمنيّة الجديدة للسلطة الفلسطينيّة، والتي لا تزال تمثّل عائقاً بوجه أيّ مشروعٍ مقاومٍ في الضفة. يأتي هذا بالتوازي مع السيطرة الأمنيّة الكبيرة لجيش الاحتلال على معظم مناطق الضفة الغربيّة، والجدار العازل، والطرق الالتفافيّة، وغيرها من عناصر السيطرة الصهيونيّة التي تقلّل من هامش الحركة لفعاليات المقاومة بأنواعها كافةً.
كما تمّ تكبيل الفلسطينيّ اقتصاديّاً، نظراً لارتباط السلطة الفلسطينيّة “عضويّاً” بالاحتلال من الناحية الاقتصاديةّ، ما أضعف إمكانية القيام بأيّ نوعٍٍ من المقاومة بالمعنى الشامل والمستمرّ. جعلت قيود أوسلو التي ربطت السلطة بالاحتلال، عبْر سياسات التنسيق الأمني والسيطرة على الحدود والاقتصاد والضرائب، أيّ قرارٍ للسلطة تجاه التمرد على هذه القيود مُكلفاً بالمعنى “الوجودي” للسلطة. [17]
بالمقابل، لم تحُلْ هذه القيود دون انطلاق هبّةٍ شعبيّةٍ تصاعدتْ منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2015، متّخذةً شكلَ عمليّات المقاومة الفرديّة لتجاوز مسألة التنظيم السياسيّ التقليديّ. سار المقاوم وفي نصب عينيه الانتصارات النهائية أو اللاشيء، حيث يبدأ الشهيد/ الاستشهادي/ المقاتل حياته من نهايتها، يعدّ نفسه ميّتاً بالقوة، فهو موقنٌ أنّه مقتولٌ لا محالة. [18] يمثّل هذا أسمى درجات التمرّد على امتلاك المستعمِر زمامَ موته وحياته، “فالشعور بالقتل إنّما هو اللاشعور الجمعيّ للمستعمَرين في زمن عجزهم، حين يقتل المستعمَر المستعمِر، يضرب عصفورين في حجر: يُزيل مضطهِداً، ومضطهَداً في آنٍ واحدٍ، فيبقى بعد القتل رجلٌ ميتٌ ورجلٌ حرٌ”. [19]
إنّ ذاك الرفض مصدرُ شجاعةٍ لا تُصدّق، حيث يجد المرء إنسانيّته بموته، فهو ابن العنف ويستمدّ منه إنسانيّته في كلّ لحظةٍ. [20] أمّا على صعيد الاستشهاديّ، فتبقى صورة موته آليّة تنبيهٍ مستمرٍ لمتلازمة القلق الوجودي في المشروع الصهيوني. قرّر الاستشهاديّ كفردٍ تحويل مقولة الانتصار الحتمي إلى آليّات فعلٍ ومواجهةٍ بجسده، وكأداةٍ منتجةٍ لإعادة تشكيل الفلسطينيّ، فهو لم يحمل عتاداً وسلاحاً، بل اختار جسده البيولوجي أداة قتالٍ. [21]
يلتفّ الكفن الأبيض حول أطراف الاستشهادي/ الشهيد، ويُترك له كلّ الوقت كي يودَّع بقدسيّةٍ نحو مثواه الأخير – مبجّلاً ومحروساً في طقسٍ مهيبٍ يدقّ الوعي والذاكرة والحاضر بشراسة الاستعمار، واستمرار القدرة على ضرب منطق السيطرة وشكل العلاقة الاستعماريّة. ففي لحظة تشييعه، يتحوّل الشهيد لأحد مكوّنات تخيّل ولادةٍ سليمةٍ للوعي الجمعيّ الفلسطينيّ.
الجثامين الحيّة المنتظرة
ينتهي الموت بوصول جسد الميّت إلى مثواه الأخير، وقد يُعلّق ويُجمّد إلى أجلٍ غير مسمى في معتقلات “جثامين الشهداء” الصهيونيّة، كوسيلةٍ يستخدمها العدو بغية تأكيد سيادته على الأرض وعلى الجسد الفلسطينيّ، حيّاً كان أو ميّتاً. [22]
يشير الباحث خالد عودة الله إلى معهد أبو كبير كبوابةٍ رئيسةٍ للحديث عن آليات الضبط والسيطرة الاستعماريّة في التمثيل بالجثث الفلسطينيّة، بما يجسّده من وظيفةٍ استعماريّةٍ للفصل بين الجثّة الصهيونيّة “المختارة” والجثّة الفلسطينيّة “المدنّسة”. تحضر جثة الجنديّ المحارب ضمن صناعة حالةٍ تقديسيّةٍ لبطولة المقاتل الصهيوني، وبناء أسطورة “الشهيد” الصهيونيّ. يكمن الجزء المتمّم لهذه العملية في تدنيس الجسد الفلسطيني والعبث به، بغرض إفقاده قدسيّته، عبْر قتل الجثة وسحق قيمتها، وإهانة الميّت وتأخير دفنه، وحرمان الجسد من الراحة بالمجمل.
يُضاف إلى ذلك تجريدُ الفعل المقاوم من البعد السياسيّ، باعتباره مصدر قيمةٍ للجسد، ووسْم الفعل الذي أدّاهُ جسد الشهيد بالإرهاب، كفعلٍ لاعقلانيّ غير خاضعٍ للمنطق، ومنزوعٍ من أيّ بعدٍ سياسيٍّ، تمّ نتيجةً لليأس فحسب. يحوّل هذا المنطق الفعلَ إلى حالةٍ نفسيّةٍ مرضيّةٍ تدفع المُقدِم على الشهادة لـ”الإجرام”.
بالمقابل، يعدّ فعل الشهيد عند الفلسطينيين نافذةَ أملٍ لهم، يعطي قيمةً للحياة بوصفه مستقبلاً. يتجلّى هذا المعنى بكليّته في لحظة تشييع الشهيد، لذلك يسعى المستعمِر لقتل هذه اللحظة بإتمام التشييع ليلاً أو عبْر حصر مراسمه في أهل الشهيد من الدرجة الأولى، سالباً بذلك الجماعة الوطنيّة من بناء العلاقة المباشرة مع جسد الشهيد بلحمه ودمه. تتعدّى هذه العلاقة الفردَ الشهيد إلى إعادة بناء الوعي الوطنيّ والتذكير المستمر بالحالة الاستعماريّة، بغية الخروج على المنطق الطبيعيّ للواقع المعاش. يمثّل هذا هاجساً رئيساً للنظام الصهيونيّ، فبالنسبة له “الموت مسموحٌ، أمّا الشهادة كفعلٍ مقلقٍ يعيد ولادة الوطنيّ بقداستها مرفوضةٌ”. [23]
أمّا عن أكثر الممارسات قمعاً لـ”الأجساد الميتة” فتتمثّل في حجز الجثامين ودفنها في مقابر الأرقام. يعكس التأمّل في اعتقال جثمان الفلسطيني، وتعليق/ تجميد موته أنماطَ الاستخدام “الإسرائيليّ” لجسد الميت، في مسعىً لإعادة صوغ علاقات السيادة بين العدو والفلسطينيين الأحياء. كما يكشف مواقع ومساحات مقاومة الفلسطينيّ لهذه السيادة من خلال جسد الميت ذاته.
فإنْ كان الجثمان الفلسطينيّ عُرِّف جسديّاً وبيولوجيّاً بوصفه ميّتاً، إلا أنّه يبقى كائناً موجوداً يحمل حياةً سياسيّةً تصير اجتماعيّةً. فحينما يُعاد جسده إلى عائلته من معتقلات “جثامين الشهداء” الصهيونيّة، أو ما تسمّى مقابر الأرقام السريّة، وثلاجات التجميد، فإنّه يموت مرةً أخرى. [24] لا يمكن فهم منطق الانتقام من المقاوم بالتمثيل بجثته واحتجازها لفترةٍ تقتل الجثة حتى بعد موتها، إلا بإيعازه لسببٍ نفسيٍّ جوهره الشعور الصهيونيّ بالعجز، بعد أن أصبحت الأجهزة العقابيّة الممثّلة بالمخابرات والجيش ومصلحة السجون معطلّةً بالكامل أمامها. هكذا، يُعاقب صاحب الجثّة وعائلته، كما تُستخدم هذه الآلية كوسيلةٍ للردع، للحيلولة دون تكرار فعل الشهادة بصورته الثوريّة المقلقة صهيونيّاً. [25]
لسنا بحاجةٍ إلى القول إنّ اعتقال جثامين الفلسطينيين ممارسةٌ غير قانونيةٍ ومخالفةٌ للاتفاقيّات الدوليّة بشأن التعامل مع الجثامين، بهدف التدليل على شناعة الصنيع الاستعماري بجثث الشهداء. ففي السياق الاستعماريّ، تُجمّد القوانين والأعراف الدوليّة، وتصبح لاغيةً لفرض السيادة على جسد الفلسطينيين حتى الأموات منهم، بل يمتدّ ذلك إلى المشاعر وطقوس التعبير عن الحزن.
بدأ العدو باحتجاز الجثامين منذ نهاية ستينيّات القرن الماضي، مستنداً في ذلك إلى قانون الطوارئ البريطانيّ 1945 الذي يمنح الحاكم العسكريّ الصهيوني حقَّ التصرف بالجثمان. هناك أكثر من 260 فلسطينيّاً وعربيّاً منفيّون ومعتقلون في أربع مقابر أرقامٍ (تذكر بعض المصادر أنّها خمس مقابر). وثّق مركز القدس للمساعدة القانونية أسماء وقصص هذه الجثث المعتقلة، بعد إطلاقها حملة استرجاع الجثامين والمفقودين عام 2008. [26]
يعتقد العدو أنّ الاحتفاظ بجثامين الشهداء من شأنه أن يغيّب الشهيد عن الذاكرة الجمعيّة، إلا أنّ معطيات الواقع تشير إلى أنّ الشهداء لا يمكن محوهم من الذاكرة، بل إنّ الممارسة الاستعماريّة من شأنها أن تبقيهم أحياءً منتظرين. تبقى قصصهم حيةً ماثلةً كالحقيقة، فيما تشكّل استعادة الجثمان الفلسطينيّ استعادةً لسيادته على جسده بعد أن قرر الشهيد الخروج على منطق الاستعمار في إدارة شؤون حياته، واستخدام جسده كأداةٍ تفيض حريةً لذاته ومجتمعه المستعمَر.
خاتمة
هدِفَ المشروع الصهيونيّ منذ نشأته إلى إعادة هندسة الفلسطينيين اجتماعيّاً وسياسيّاً، مستخدماً وسائل عدّة لتحقيق هذه الغاية من تفكيك البنى التحتيّة لمقولة الشعب، والإجهاز على القيم الجامعة له، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى سجنٍ كبيرٍ كآليةٍ للتطويع والإخضاع، حيث يُحتجز الفلسطيني في معازل جغرافيةٍ متعددةٍ، رِفقة سياساتٍ عسكريّةٍ واقتصاديّةٍ وسياسيّةٍ لتطويق المجالات الممكنة لفعله المقاوم.
بالمقابل، استمرّ الفلسطينيّ في إبداع أساليب المقاومة عبْر جسده، معبّراً عن ممارسة سلطته الخاصة في ميدان الحياة والموت، بل ومشكّلاً فضاءً سياسيّاً تحررّياً يتموضع فيه فعله، بجانب إلهامه نماذجَ مستقبليّةً تراكم في الفضاء ذاته وتطوّره. يعود هذا إلى أنّ جسده ممتلئ بالحقل السياسي والأمل في بناء آفاقٍ أبهى تلوح بعد موته وتوظّفه الذات الجمعيّة الفلسطينيّة.
خلصنا من هذه المقالة إلى أنّ طريقة الموت مرهونةٌ بشكل النظام الاجتماعيّ الذي يعيش فيه الجسد، فالموت ظلّ قادراً على التعبير عن النكبة كبنيةٍ شموليّةٍ مؤسّسةٍ لكلّ ما بعدها من فقدانٍ مولّدٍ. بالتالي، جاءت كثافة الموت تعبيراً عن كثافة التحرّر أرضاً ومجتمعاً، لتحقيق مشروع التحرّر الناجز، بيْدَ أنّ التمرّد الفلسطينيّ لانتزاع شؤون موته وحياته، قابله المستعمِر بآلياتٍ أكثر شراسةً أدّت في المحصلة إلى تفكيكٍ شبه تامٍ للبنية العسكريّة والمؤّسساتيّة للفعل المقاوم، بل وتغيير المزاج الشعبيّ عند بعض الشرائح الفلسطينية، بسعيها إلى تحقيق متطلّبات الرفاه، ما قلّل من قدرة المقاومة على التعبير عن ذاتها.
ورغم هذا الواقع المكبّل للمقاومة، والذي انعكس بدوره على آليات إدارة الفلسطينيين أجسادَهم، ظلّت المقاومة حاضرةً في بضع ممارساتٍ فرديّةٍ مثّل الجسد فيها الأداة الرئيسة للقتال ومناهضة الاستعمار. كما أوحت بعدم انعدام الأداة لدى الفلسطيني مهما تحقّقت سياسات تطويق إمكانياته للمقاومة.
أخيراً، يمكن القول إنّ أكثر الممارسات قمعاً للأجساد الميتة في حجز الجثامين وتعليق موتها، يُبرز شعور الصهيونيّ بالعجز وتعطيل منظومة الأجهزة العقابيّة أمام صنوف المقاومة الفلسطينيّة. فإنْ كان الجثمان عُرِف بكونه ميتاً، إلا أنّه يبقى حيّاً يحمل حياةً سياسيّةً تصبح اجتماعيّةً حينما تحتضنه العائلة من جديد، فالشهداء لا يمكن محوهم من الذاكرة، بل إنّ الممارسة الاستعمارية تبقيهم أحياءً منتظرين.
يُتبع…
******
الهوامش:
[1] تمّتْ بلورة الفكرة الرئيسة للمادة مع الصديقة أفنان عوايصة، من باب الأمانة الأكاديميّة جدر التنويه.
[2] عبير قبطي، “المقاومة الشعبية نجاحات وإخفاقات: باب الشمس نموذجاً”، مجلة الدراسات الفلسطينية 95 (صيف 2014): 44.
[3] ميشيل فوكو، السلطة والمعاقبة “ولادة السجن” (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1990)، 64.
[4] إيميل دوركهايم، الانتحار (دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، 2011)،277.
[5] .Raf Vanderstraeten, “Book Review: Allan Kellehear A Social History of Dying”, Sociology Volume 44, no. 1 (2010): 17
[6] إسماعيل ناشف، صور موت الفلسطيني (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015)، 7.
[7] إسماعيل ناشف، “التعبير عن النكبة: مقاربة نظرية”، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 116( خريف 2018): 186.
[8] ناشف، صور موت الفلسطيني، 15.
[9] حنة أرندت، في العنف (بيروت: دار الساقي، 1992): 14.
[10] فرانز فانون، معذبو الأرض (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، 2015)، 31.
[11] ناشف، صور موت الفلسطيني، 11.
[12] المرجع السابق، 32.
[13] يزيد صايغ، الكفاح المسلح والبحث عن دولة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2002)، 33.
[14] ناشف، صور موت الفلسطيني، 26.
[15] صايغ، الكفاح المسلح والبحث عن دولة، 8.
[16] ناشف، صور موت الفلسطيني، 66.
[17] مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، تقدير استراتيجي (96)، المقاومة في الضفة الغربية: التحديات واحتمالات المستقبل.
[18] المرجع السابق، 32.
[19] فانون، معذّبو الأرض، 31.
[20] المرجع السابق، 33.
[21] ناشف، صور موت الفلسطيني، 47.
[22] سهاد ظاهر ناشف، “الاعتقال الاداري للجثامين الفلسطينية”، مجلة الدرسات الفلسطينية، عدد 107 (صيف 2016) :2.
[23] خالد عودة الله، “جثامين الشهداء كأداة للعقاب والضبط الاستعماري في فلسطين”، محاضرة ألقيت ضمن فعاليات دائرة سليمان الحلبي للدراسات الاستعماريّة والتحرّر المعرفي. يمكن الاستماع إليها من هنا.
[24] ناشف، “الاعتقال الإداري للجثامين الفلسطينية”، 21.
[25] خالد عودة الله، “حول التمثيل بجثامين الشهداء باحتجازها”، باب الواد، نشر بتاريخ (7/15/ 2018). يمكن استعادته من هنا
[26] سهاد ظاهر ناشف، “إمّا مقاوماً وإّما مقتولاً: الانتفاضة الفلسطينية الأولى كنقطة تحول في إعادة صياغة وكالة جسد وروح الفلسطيني/ة”، مجلة إضافات، العدد 46 (ربيع 2019): 89.