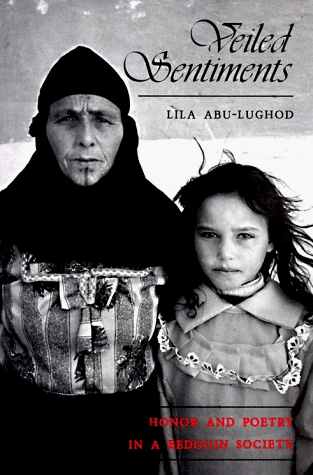«أنتم لستم مليوني فلسطيني يواجهون «إسرائيل»، بل مئة مليون ألف عربي. يجب أن تتصرّفوا وتفكّروا على هذا الأساس. وعندما تناقشون [محاربة] «إسرائيل» يجب أن تضعوا خريطة العالم العربي أمام أعينكم. أتانا وفدٌ جزائري على رأسه كريم بلقاسم، وأخبرونا بأنّ بلدهم قد خسرت مليونَيّ شخصٍ في سبيل الاستقلال. أخبرتهم بأنّ الشعوب لا يجب أن تخاف من تقلّص عددها في حروب التحرير، لأنهم سوف يحظون بعدها بأوقات سِلمٍ تمكّنهم من الإنجاب والتكاثر».
رئيس جمهورية الصين الشعبية، «ماو تسي تونغ»، لوفدٍ من منظمة التحرير الفلسطينية على رأسه أحمد الشقيري، عام 1965. [1]
«إنّ الصين تعتبر فلسطين و«إسرائيل» شريكين مهمين في مبادرة الحزام والطريق. وهي مستعدة للعمل ضمن مفهوم التنمية من أجل السلام بهدف دفع فلسطين و«إسرائيل» للانخراط في تعاون ينفع كِلا الطرفين».
السفير الصيني لدى الأمم المتحدة «ليو جيه يى» عام 2017. [2]
يلمع اسم الصين عند الحديث عن تسليح الحركة الوطنية الفلسطينية المنبثقة بعد عام 1965 وتدريب كوادرها ودعمها سياسياً. كما يظهر اسمها أيضاً عند الحديث عن أكثر الدول التي تربطها علاقات اقتصادية مع الكيان الصهيوني، سواءً علاقات تنموية أو تجارية. يحمل هذا التناقض في طيّاته تطوّراً للرؤية الصينية لفلسطين ولحركة التحرّر العربي، وللإمبريالية العالمية بشكلٍ عام. بنظر الصين، ما زالت الرياح الشرقية تقهر الرياح الغربية، ولكنّ سُبُل القهر قد تغيّرت من المجابهة العلنية والصريحة للإمبريالية العالمية المتمثلة بالولايات المتحدة وقواعدها الإمبريالية في العالم، «إسرائيل» مثالاً، إلى بناء تكتّلٍ اقتصادي يتمحور حول الانعتاق من سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. ويمكن القول إنّه في ضوء هذه المتغيّرات ومع انحسار الشرخ السوفياتي-الصيني، وتغيّر المناخ في منظمة التحرير الفلسطينية والأنظمة العربية الرسمية من مناخٍ رافضٍ لمشاريع التسوية إلى مناخٍ منجذب نحو تلك المشاريع، بدأت الصين بالتعامل مع الرجعيّات العربية، على رأسهم المملكة العربية السعودية، و«إسرائيل» على قاعدة أنّهم قد أصبحوا أمراً واقعاً في عالمٍ مُعَولم.
بناء على ما تقدّم، يسعى هذا المقال لدراسة تطوّر علاقات الصين مع المقاومة الفلسطينية من جهة، ومع «إسرائيل» ومشاريع التسوية من جهةٍ أخرى، مسلّطاً الضوء على تطوّر النظرة الصينية للإمبريالية وكيفية مجابهتها.
«إسرائيل» وجمهورية الصين الشعبية 1949-1955: بذورٌ لم تثمر
إبّان انتصار الثورة الصينية في عام 1949، وهروب متعاوني وجيش حكومة الكومينتانغ بقيادة «تشانغ كاي شيك» إلى جزيرة تايوان، اعترف المعسكر الاشتراكي بأكمله، وعلى رأسه الاتحاد السوفياتي، بجمهورية الصين الشعبية كالحكومة الصينية الشرعية. وكانت الدولة الوحيدة غير الاشتراكية التي اعترفت بالصين في عام 1949 هي الهند. كما حاولت «إسرائيل» في ذلك العام الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية على أساس الاعتراف المتبادل، غير أنّ جمهورية الصين الشعبية رفضت الاعتراف بـ «إسرائيل» لأنّه، وعلى لسان «ماو تسي تونغ»: «قد علمنا بأنّ العالم العربيّ بأكمله قد كان ضد إسرائيل، ونحن بدورنا لا يمكننا الاعتراف بإسرائيل لأنها قاعدة للإمبرياليات الأميركية والبريطانية والفرنسية والغرب ألمانية». [3]
بدورها، اعترفت حكومات العراق ولبنان وسوريا ومصر والأردن بتايوان بدلاً من بكّين. وفي هذا السياق، رأت «إسرائيل» موازين القوى وأخذت بعين الاعتبار تمتّرس جمهورية الصين الشعبية وراء المعسكر الاشتراكي التي حاولت كسب ودّه في هذه الفترة لاعتباراتٍ سياسية. وعليه، قرّر الكيان الصهيوني الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية كالحكومة الصينية الشرعية، على الرغم من عدم اعتراف الجانب الصيني به.
نظرت جمهورية الصين الشعبية (لغرض التسهيل، سوف يشار إليها باسم «الصين» من الآن فصاعداً) إلى هذا التطوّر، حيث اعتبرت حكومة الكيان أول حكومة في غرب آسيا اعترفت في الصين بدلاً من تايوان، بعينٍ من الريبة، ولم تُرِد المضي بالاعتراف بالكيان الصهيوني نظراً لاعتبارات أيديولوجية من جهة، ونظرتها لـ«إسرائيل» بأنها موطئ قدمٍ أميركي في غرب آسيا من جهة أخرى، وخوفًا من أن تؤثّر قضية الاعتراف بالكيان بعلاقاتها مع الدول العربية وتدفعهم للاعتراف بحكومة تايوان بشكلٍ دائم. وعلاوةً على هذه الدوافع الأيدولوجية، اقتدت مصالح الصين بأن يزداد الاعتراف العالمي لها، وإقامتها لأي علاقاتٍ مع الكيان قد يستعمَل كذريعةٍ لدى الأنظمة العربية لترسيخ علاقاتهم مع تايوان. وعليه، مَضَت الصين في سياسةٍ تمنع التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني.
ولكن، لم تمنع قضية التطبيع العلني الصين من إنشاء علاقات غير رسمية مع أطرافٍ «إسرائيلية»، إذ وقّعت اتفاقية تجارية مع «إسرائيل» في عام 1955، قبيل أسبوعين من مؤتمر باندونغ المناهض للاستعمار. وتوافقاً مع الخط السوفياتي، وحتى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، اعتبرت الصين بأنّه يمكن التواصل مع الجهات «الإسرائيلية» الشيوعية، أشهرهم «شموئيل ميكونيس»، وبناء علاقات معهم على أساس معاداة خطّ حكومة «بن غوريون» وحزب «ماباي» الحاكم في النظام الصهيوني السياسي.
تقودنا هذه الإضاءات للاستنتاج بأنّ الصين نظرت في هذه المرحلة إلى «إسرائيل» على اعتبارها عاملاً سلبياً في الوطن العربي: فاعتبرتها موطئ قدمٍ أميركي في المنطقة وفاعلاً سلبياً في محاولاتها لاستقطاب أكثر عددٍ من الدول المعترِفة بها، وبناءً على ذلك قاطعت الكيان ورفضت الاعتراف الدبلوماسي به، على الرغم من التصريحات الصينية عام 1954 التي وعدت بالاعتراف الدبلوماسي بالكيان الصهيوني. [4] وتباعاً للسياسة السوفياتية، قررت الصين دعم الحزب الشيوعي «الإسرائيلي» لكونه الجسد «الإسرائيلي» الوحيد الذي عارض الولايات المتحدة الأميركية، ولو شكلياً، في خطاباته. وعليه، غُيِّب الشعب الفلسطيني ونكبته من الصورة، وذلك حتى مؤتمر باندونغ.
مؤتمر «باندونغ»
في عام 1955، انعقد مؤتمر باندونغ المناهض للاستعمار في مدينة باندونغ الإندونيسية، بمشاركة حوالي 29 دولة، منهم ماليزيا والصين وغالبية الدول العربية والهند، وغيرها من الدول الآسيوية والأفريقية. رأت الصين بمؤتمر باندونغ فرصةً ذهبية لكسر عزلتها في أفريقيا وآسيا على الأقل. وأتى وفدٌ صيني على رأسه رئيس الوزراء الصيني «تشاو إن لاي» حازماً بأن تحظى الصين بنهاية المؤتمر باعتراف نسبةٍ لا بأس بها من الدول المشاركة في المؤتمر. فألقى خطاباً مشحوناً تناول فيه ضرورة مجابهة الاستعمار والاستقلال الكلّي منه، وتحدّث عن مصر وقضية قناة السويس، وإيران وسرقة الإنجليز للنفط الإيراني، فضلاً عن ضرورة استقلال المغرب والجزائر وإنهاء الفصل العنصري في اتحاد جنوب أفريقيا. ولكن عند تناول قضية فلسطين، قال رئيس الوزراء الصيني إنّ «قضية اللاجئين العرب من فلسطين ما زالت بحاجةٍ إلى حل». [5] عبّر هذا الخطاب عن رؤية الصين لقضية فلسطين حتى عام 1955، حيث اعتبرتها قضيّةً إنسانيةً بحتة، يمكن حلّها بالتواصل مع الأطراف الدولية والشيوعيين «الإسرائيليين» والضغط على حكومة «بن غوريون» لاستقبال ما سمّتهم بـ«اللاجئين العرب من فلسطين».
تصادفت الأقدار وانضمّ أحمد الشقيري، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية لاحقاً، إلى الوفد السوري في باندونغ بهدف وضع قضية فلسطين على طاولة المؤتمر. استغلّ الشقيري هذه الفرصة للتواصل مع الوفد الصيني وشرح تاريخ فلسطين حتى النكبة. وبعد هذا الحوار، وعده رئيس الوزراء الصيني بأن يدعم «القرارات العربية المتعلقة في فلسطين». وتمخّض عن هذا اللقاء، على الرغم من كونه ضمن إطار سوري-صيني، أوّل تقارب فلسطيني-صيني.
كان كلام «تشاو إن لاي» عن «القرارات العربية» تلميحاً بأنّ الصين سوف تتّخذ موقف الأنظمة العربية الرسمية من قضية فلسطين، التي أخذت إطار الالتزام بقرارات الأمم المتحدة حول عودة اللاجئين. [6] وقد يُعزى ذلك الموقف إلى عدم وجود إطار فلسطيني جامع يمكن التحدث إليه والاستماع إلى مطالبه؛ إذ اتّخذت الأنظمة العربية الرسمية حينها، مثل الأردن وسوريا ومصر، موقع الحديث باسم القضية الفلسطينية. وبالمجمل، حققت الصين نجاحاً كبيراً في مؤتمر باندونغ، واعترفت بها كل من مصر وسوريا واليمن كالحكومة الشرعية في الصين، لتبدأ بتطبيع علاقاتها مع هذه الدول والتقرّب من مصر بقيادة جمال عبد الناصر.
حركة «فتح»، منظمة التحرير الفلسطينية، والثورة الصينية
في عام 1963، تمّ افتتاح مكتب فلسطين في الجزائر، بموافقة جزائرية رسمية، من قبل ثلّة من الشّبّان الفلسطينيين على رأسهم شخص يُدعى خليل إبراهيم الوزير المكنّى بأبي جهاد. كان هدف هذا المكتب، بوصف أبي جهاد، بأن «يبني من العدم، ويستقطب وجوداً وتحالفات وصداقات، ويعيد فلسطين إلى الحياة وإلى الخريطة السياسية، والأهم من ذلك إعادتها إلى المعادلة الدولية التي كانت قد شُطِبَت منها في العام 1948». [7]
وعليه، يمكن الاستنتاج بأنّ مكتب فلسطين شكّل النواة الأولى للعمل الدبلوماسي لحركة «فتح»، حيث كان المكتب على تواصلٍ تام مع باقي أعضاء الحركة في الكويت. ومن أهم إنجازات هذا المكتب هو حضور مهرجان التضامن مع شعب فلسطين العربي في بكّين بدعوة رسمية من الصين بعد أن تواصل مكتب فلسطين في الجزائر مع الحكومة الصينية. ويمثّل هذا تطوراً مهمّاً في نظرة الصين إلى فلسطين: حيث لم تعُد ترى تمثيل فلسطين محصوراً بالنظام العربي الرسمي وبوفود الحكومات العربية. وهذا يعزى إلى عدّة عوامل، منها الشرخ السوفياتي-الصيني، حيث أصبحت العلاقات بين الصين والاتحاد السوفياتي في تدهورٍ ملحوظ نتيجة خلافات إيديولوجية حول ضرورة مجابهة الإمبريالية العالمية ومحاولات «خروتشوف» تخفيف حدّة الحرب الباردة مع الولايات المتحدة. أدّى ذلك الشرخ إلى سياسة خارجية صينية أكثر ثورية، حيث لم تعُد تأبه لشعار «وحدة الصفّ الشيوعي» في سياق تشكيل سياستها الخارجية والداخلية، لأنّها اعتبرت الاتحاد السوفياتي بقيادة «خروتشوف» قوّةً «إمبريالية-اجتماعية».
ثمّة عاملٌ آخر جعل الصين أكثر جرأةً وهو ازدياد الاعتراف الدولي بها، ما أدّى إلى فرض نفسها في النزاعات ودعم الحركات الثورية عالمياً. يضاف هذا إلى عامل آخر وهو وجود تكتّل فلسطيني، ولو كان هامشياً وصغيراً كحركة «فتح» آنذاك، يمكن الحديث معه. إذ لم يكن هناك قبلها تنظيم فلسطيني معنيّ بإقامة علاقاتٍ مستقلة مع الصين.
وبناءً على هذه العوامل، زار خليل الوزير (اسمه الحركي آنذاك قد كان محمد خليل) ومحمد عبد الرؤوف عرفات القدوة (كان اسمه الحركي آنذاك محمد رفعت) جمهورية الصين الشعبية وشاركا في المهرجان الأول للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وألقى محمد القدوة (الذي أصبح اسمه الحركي لاحقاً ياسر عرفات) خطاباً في ذلك المهرجان يؤكّد على تلاحم الشعب الفلسطيني والشعب الصيني والمصير المشترك بين فلسطين والصين، وعن ضرورة مجابهة الإمبريالية العالمية. وبحسب قول أبي جهاد إنَّه بعد انتهاء مهرجان التضامن مع فلسطين، استدعى رئيس الوزراء الصّينيّ سفراء الدول العربية في الصين وأبلغهم بموقف الصين الرسمي من الكيان الصهيوني، وهو:
« 1- المقاطعة الشاملة لإسرائيل
2- عدم السماح لأي سفينة إسرائيلية بالرسوّ في أي ميناء صيني
3- عدم السماح لأي سفينة مرّت على ميناء إسرائيلي بالرسوّ في ميناء صيني
4- عدم السماح لأي سفينة صينية بالمرور على ميناء إسرائيلي». [8]
بهذا، تغيّر الموقف الصيني حسب الوقائع السياسية على الأرض ووجد طرفاً فلسطينياً يمكن بناء استراتيجية ورؤية مشتركة معه. كما أدّى الشرخ الصيني-السوفياتي إلى تعميق السياسة الصينية المعادية للإمبريالية الأميركية و«الإمبريالية الاجتماعية» السوفياتية، حسب الرؤية الصّينية. فكان الوقوف ضد «إسرائيل» ككيانٍ استعماري موقفاً مناهضاً لهاتين القوّتين العالميّتَين.
تقارب فلسطيني صيني
في تلك الفترة، طرح جمال عبد الناصر فكرة «الكيان الفلسطيني»، حيث رأى أنّ وجود طرف يمثل الشعب الفلسطيني هو أمرٌ ضروري لمجابهة احتكار الملك حسين تمثيل الفلسطينيين. وعلى هذا الأساس، تمّ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة أحمد الشقيري في عام 1964. وفي عام 1965، كانت الصين أول حكومة غير عربية تقدّم اعترافاً دبلوماسياً بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد زيارة وفدٍ من المنظمة على رأسهم أحمد الشقيري للصين، حيث طلبوا الدعم المادي لجيش التحرير الفلسطيني والدعم السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ككُلّ. [9]
بالمقابل، كانت رؤية أحمد الشقيري لجيش التحرير الفلسطيني بأنه أشبه بالجيش النظامي، فلم يؤيّد مبدأ الصين في حرب العصابات. ولكنّه، وعلى الرغم من اختلاف رؤيته لماهية الصراع عسكرياً، تلقّى الدعم الصيني العسكري عبر ميناء الإسكندرية في عام 1966 بدون عِلم جمال عبد الناصر، الأمر الذي أثار غضبه. [10] وفي نفس الزيارة، عَرَض مدير المكتب العام لوزارة الدفاع الوطني، «شاو شيانغ غونغ»، على أحمد الشقيري وقائد جيش التحرير الفلسطيني آنذاك وجيه المَدَني خريطةً مفصّلة لفلسطين يشرح فيها وجهة النظر الصينية العسكرية للصراع العربي-الصهيوني، حيث قال التالي:
«إنّ وجود ج.ت.ف (جيش التحرير الفلسطيني) في الضفة الغربية هو عاملٌ مهم لمعركة التحرير. إنّ الضفة الغربية، لو استغلت بطريقة فعّالة، لديها مواقع استراتيجية مدمِّرة يمكن أن تساعدكم في الهجوم على إسرائيل… ولهذا نفهم لماذا الإمبريالية الأميركية قد تمنع حشد قوّاتكم في الضفة الغربية. إنَّ معلوماتنا تشير بأنّ الجيش الأردني جيشٌ مدربٌ جيداً ولدى وحداته قدرات قتالية عالية، ولكنّ المشكلة تكمن بأنّ مصير هذا الجيش ليس بيد الشعب، وبناءً على ذلك لا يمكن التعويل على هذا الجيش في الحرب الشعبية […] التحرير لا يحتاج إلى جيشٍ عَرمرم. يجب أن ينظّم جيشكم في وحداتٍ صغيرة مدرّبة خصّيصاً على القيام بعملياتٍ جريئة وسريعة تكبّدُ العدوّ أكبر الخسائر الممكنة. يجب أن تتجنبوا محاربة العدوّ في المساحات المفتوحة. إنّ السّلاح الحقيقي في المعركة هو الجندي الذي يعلم كيفية استغلال قدراته العملياتية». [11]
إنّ تغيّر الخطاب الصيني، من خطابٍ حقوقي يطالب بعودة «اللاجئين العرب» إلى فلسطين حسب قرارات الأمم المتحدة إلى خطابٍ متجذّر في عقيدة تحرير كامل فلسطين، يدلّ على تطور الرؤية الصينية تجاه فلسطين واستعمارها. ويمكن القول إنّ مسار الحرب الباردة (العدوان الأميركي على شبه الجزيرة الكورية، والعدوان الثلاثي على مصر، والعدوان الأميركي على فيتنام، والشرخ السوفياتي-الصيني) وتحرّر الجزائر من الاستعمار الفرنسي قد أثّرا بنظرة الصين للصراع العربي-الصهيوني، ليصبح موقف الصين من التحرير حازماً ورافضاً لأنصاف الحلول، نكايةً بالمواقف السوفياتية التي أيّدت أيّ عمليةٍ سلمية كانت، خاصةً بعد حرب النكسة. وسيستمرّ هذا الرفض الصيني التام حتى ثمانينيّات القرن الماضي.
اقرأ/ي أيضاً على باب الواد
ثورات الجنوب (1): الثورة الصينية وإنهاء قرن الذل
1967: نقطة التحوّل
بعد حرب 1967 واحتلال «إسرائيل» لما تبقّى من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزّة)، وهضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء، وافق مجلس الأمن في الأمم المتحدة على قرار 242 الذي ينصّ على ما يلي:
«يؤكد [مجلس الأمن] أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين:
أ – سحب القوات المسلّحة من أراضٍ احتلتها في النزاع.
ب- إنهاء جميع ادّعاءات أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي، وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة».
شكّل هذا القرار الرغبة الأميركية-السوفياتية في إبرام صفقات تطبيع ما بين الكيان الصهيوني وبين سوريا ومصر. شكّل قرار 242، القائم بترسيخ مبدأ «الأرض مقابل السلام» الذي استندت عليه لاحقاً اتفاقيتا كامب ديفيد وأوسلو، أرضية المحادثات التطبيعية بين الأنظمة العربية والكيان الصهيوني. من طرفها، كانت الصين رافضةً لهذا القرار بشكلٍ كامل، وصرّحت بأنه نتاج «صفقة أميركية-سوفياتية». [13] وتوازياً مع رفض قرار 242، عملت الصين على دعم حركة «فتح» قبل وبعد ترسيخ هيمنتها على منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، وفي ذلك صرّح الشهيد خليل الوزير:
«تطوّر الدعم تدريجياً حيث قدّموا لنا عام 1968 دعمًا يكفي لـ 2000 مقاتل، وفي العام 1969 دعماً يكفي لـ 7000 مقاتل، وفي العام 1970 قدموا لنا دعماً يكفي لـ 14 ألف مقاتل، ثم دعماً لـ 15 ألف مقاتل وصل إلى العراق […] وبعد ذلك قدموا لنا دعمًا لما يكفي لـ 30 ألف مقاتل».
بالمقابل، كان الدعم الصيني إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى، مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شبه معدوم، وهو ما قد يعزى لحجم حركة «فتح» وتأثيرها السياسي الضخم على الساحة الفلسطينية بحكم أنها الفصيل المُهيمِن على المنظمة، على الرغم من القدرات القتالية العالية لباقي الفصائل. وكسببٍ مباشر لتوزيع الكتاب الأحمر الصيني على المقاومين في حركة «فتح» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، [15] طغى المبدأ الصيني لحرب العصابات في مجابهة «إسرائيل» على رؤية المقاومة الفلسطينية لطبيعة الصراع بينها وبين المحتلّ. وقد لعبت حرب النكسة دورها، حيث أثبتت للصين وللمقاومة الفلسطينية بأنّ استراتيجيا الحرب التقليدية لن تنفع في مقاومة الكيان الصهيوني، وعليه تمّ استلهام التجربتين الفيتنامية والصينية على الرغم من الفروقات الشاسعة في الحالة الفلسطينية. وفي هذه الحالة المناهضة للتسوية، يمكن رؤية خطٍ صينيّ مغاير للخط السوفياتي الذي كان أقرب للخطّ الأميركي من حيث ضرورة التوجّه نحو حلٍ سلميّ للصراع مع الكيان. وقد ضُخّ الدعم الصيني في جميع أنحاء المعمورة على هذا الأساس. فمن جهة، زادت الصين دعمها لحركات التحرّر في جميع أنحاء العالم، ومن جهةٍ أخرى دعمت المقاومة الفلسطينية لتشكيلِ نظرةٍ عربيةٍ مغايرة للمواقف الأميركية-السوفياتية حيال طبيعة الصراع.
وفي الحديث عن الفروقات بين النموذج الصيني والفلسطيني، قد يكون أكبر فرقٍ بين الحالتَين الثوريّتَين هو وجود أراضٍ بعيدة عن مرمى الاحتلال والرجعيين مكّنت المقاومة الصينية، سواءً قبل أو بعد الاحتلال الياباني، الاحتماء بها وتجميع قواهم. وهذا ما حدث تماماً مع الثوّار الشيوعيين ومكوثهم في مدينة يانان، حيث تقع في إقليم بعيدٍ ومهمّش يسمى بإقليم شمال شَنشي، وأيضًا مكثوا في إقليم يونّان في جنوبَي الصين. وعند النظر إلى المقاومة الفلسطينية، نرى بأنه لم يكُن لديها ترف الاحتماء بأراضٍ شاسعة مثل تلك الموجودة في الصين. وبحسب التجربة التاريخية، كان مكوثها في الأردن ولبنان مهزوزاً نتيجة السياسات الداخلية لتلك الدول والتدخل الخارجي (الصهيوني-الأميركي في لبنان، مثالًا). ولذلك، كان هناك تباين بين الحالة الفلسطينية والحالة الصينية. وقد كان «ماو تسي تونغ» مدركاً لتلك الفروقات، حيث قال لوفدٍ من منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1965: «لا تخبروني بأنكم قرأتم هذا أو ذاك في كُتُبي، إنّما لديكم حربكم ولدينا حربنا. يجب عليكم أن تبنوا الأُسُس والأيديولوجيا التي تستند عليها حربكم». [16]
يمكننا القول إنَّه، وعلى المستوى التكتيكي على الأقل، اتّبعت المقاومة الفلسطينية خطاً مميّزاً، حيث خطف الطيارات وعمليات إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مستعمرات العدوّ لم تنطوِ تحت أيّ مبدأ من مبادئ «ماو تسي تونغ» للحرب الشعبية. لكن، استراتيجياً، يُمكن تفسير نظرة المقاومة الفلسطينية للخارج الفلسطينيّ باعتباره العامل الأساسي لوجودها المسلّح بأنه مبنيٌ على فهمٍ خاطئ للتجربتين الصينية والفيتنامية وحتى الجزائرية، حيث شكّلت جبال أوراس ملاذاً للثوار الجزائريين، ولم تخضع لسلطة حاكمة. وعلى نقيض ذلك تماماً، كانت قوات التحرير الشعبية في قطاع غزّة والضفة الغربية تتّبع نمط حرب العصابات من ناحية التكتيك والاستراتيجيا، حيث نصبت الكمائن للعدوّ بالأسلحة الخفيفة والقنابل، وقامت ببناء بنية تحتية مقاوِمة من بقايا أسلحة الجيش المصري وجيش التحرير الفلسطيني، الذي كان أغلبه مزوّداً من الصين قبيل النكسة. وقد كانت البيئة الحاضنة للمقاومة تلعب دوراً أساسياً في استدامة المقاومة في فترة ما بعد حرب النكسة، خاصةً في قطاع غزّة.
السبعينيات: بدايات التسوية
رأت الصين في نضال المقاومة الفلسطينية -ونضال ثورة الظُفار أيضاً- فرصةً لمحو النفوذ الأميركي في المنطقة، بما يشمل ذلك محو «إسرائيل». وعندما خرجت المقاومة الفلسطينية من الأردن، وبدأت الحرب الأهلية اللبنانية، وسُحِقَت ثورة الظفار بدعمٍ بريطاني خليجي، قلّ الدعم الصيني العسكري للمقاومة الفلسطينية تدريجياً. ومن أبرز العوامل التي قادت إلى ذلك هو التقارب السوفياتي الفلسطيني في فترة السبعينيات، والتقارب الصيني الأميركي الذي بدأ بزيارة الرئيس الأميركي «ريتشارد نيكسون» للصين عام 1972، وأيضاً محاولة الصين كسر عزلتها العالمية التي نتجت عن سياساتها المعادية للاستعمار. كما يظهر التغيّر الصيني في النظرة للقضية الفلسطينية جليّاً بعد وفاة الرئيس الصيني «ماو تسي تونغ»، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان والتي دعمتها الصين سياسياً. [17] وبهذا، يُمكن القول إنّ الصين أصبحت شيئًا فشيئًا متقبلةً للتسوية العربية مع الكيان الصهيوني وغير معنية بمجابهة الإمبريالية الأميركية في المنطقة نتيجة محاولتها لكسر العزلة العالمية المفروضة عليها، والانضمام للأمم المتحدة في عام 1971 ما كان إلّا محاولة صينية للتقارب مع باقي دول العالم.
وعلى الرغم من إعطاء الغطاء الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، صرّح رئيس الوزراء الصيني «زاو زيانغ» في عام 1982 بأنّ «جميع دول الشرق الأوسط، وهذا يشمل دولة إسرائيل، لديها الحق بالتمتّع في الاستقلال والوجود… على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967، وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني». [18] ومع عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الصين والكيان الصهيوني، أبرم الأخير عدّة صفقات أسلحة سرية مع الصين في الثمانينيات. [19]
بدأت هذه العلاقات الصينية الصهيونية بالترسّخ مع وصول «دينغ شياو بينغ» إلى سدّة الحكم، واتّباعه لسياسةٍ سلمية مهادنة في التعاطي مع القضايا الأممية والنضالية، حيث ركّز على إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني لاستيعاب مدّ العولمة، المدعوم أميركياً، الذي اجتاح العالم في الثمانينيات. ومع اندلاع الانتفاضة الأولى وظهور بوادر التزام منظمة التحرير الفلسطينية بقرار 242 الذي رفضته الصّين سابقاً، والذي ينصّ على ضرورة إيجاد حلٍ سلمي للصراع بناءً على سيادة جميع الدول في المنطقة، بما في ذلك الكيان الصّهيوني، بدأت الصين حملة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
في عام 1989، أقام الكيان الصهيوني مكتباً أكاديمياً في بكّين بموافقة الحكومة الصينية. وفي أواخر عام 1991، زار وزير الحرب «الإسرائيلي» «موشي آرنز» الصين سرّاً، كما زار نائب رئيس الخارجية الصيني الأراضي المحتلّة في نفس العام. [20] وفي عام 1992، أقامت الصين علاقاتٍ دبلوماسية رسمية مع الكيان الصهيوني واعترفت به. وجاء هذا الاعتراف بعد انعقاد مؤتمر مدريد عام 1991؛ أيّ أنّ مسار التسوية العربي «الإسرائيلي» قد مدّ الصين بغطاءٍ للتطبيع العلني، فهي الآن تريد كسب الودّ الأميركي والسوفياتي، وترميم العلاقات معهما، وأن تستغل الكيان الصهيوني للاستفادة من خبراته العسكرية والتكنولوجية، وهذا ما يفسّر كثرة تبادل الخبرات العسكرية الصينية «الإسرائيلية» بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بما يشمل تبادل التكنولوجيا العسكرية وصفقات السلاح. وقد أزعج هذا الأمر الولايات المتحدة الأميركية، لأنّها ترى بأنَّ الاستقطاب الصيني قد يجعل «إسرائيل» ضمن التكتّل الاقتصادي-السياسي المناهض للهيمنة الأميركية التي تحاول الصين ترسيخه منذ أوائل القرن الحالي.
من عام 2000 إلى اليوم: حلّ الدولتين ومشروع الحزام والطريق
بحلول القرن الواحد والعشرين، أصبحت العلاقات الصينية «الإسرائيلية» حميمية أكثر فأكثر، وازدادت العلاقات التجارية حتى غدت الصين في عام 2020 أكبر مصدر للواردات في الكيان الصهيوني. [21] كما وصلت قيمة الاستثمارات الصينية في الكيان الصهيوني إلى 19 مليار دولار أميركي، موزّعةً على قطاع الهاي-تِك (High Tech) ومشاريع البنية التحتية. [22] كما استثمرت الصين في ميناء حيفا، [23] وفي سكك القطار الخفيف، وخصوصاً في «الخط الأحمر» الذي سيشقّ طريقه إلى مستوطنات السهل الساحلي الفلسطيني المحتل. [24]
وكمثال بسيط على مدى عمق الاستثمار الصيني في الكيان الصهيوني: اشترت شركة «برايت فوود» الصينية في عام 2014 56٪ من أسهم شركة «تنوفا» الإسرائيلية، وبذلك استحوذت رسمياً على الشركة بمبلغٍ يقدّر بمليارَيّ ونصف دولار أميركي. [25]
وبخصوص الاستثمار في «مشروع أوسلو» المتمثّل في السلطة الفلسطينية، اتْبعت الصين السياسة الأميركية التي تهدف إلى ترسيخ حكم السلطة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية من خلال ضَخّها بالرّيع والرساميل الأجنبية، فتدفقت المنتجات الصينية إلى الضفة، وأدّى ذلك لإضعاف بعض الصِنَع المحلية مثل خياطة الملابس. وعند التكلّم عن الريع الأجنبي، نحن نتكلم عن الدعم الدولي المقدّم لميزانية السلطة الفلسطينية؛ فالصين، كغيرها من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، تقدّم دعمها للسلطة الفلسطينية.
وبالعودة للنقطة الرئيسية، أتت كل هذه المشاريع الاستثمارية الصينية في الكيان كنتاجٍ لمحاولات الصين بناء تكتّل اقتصادي مناهض للولايات المتحدة الأميركية، ذاك التكتّل المبني على تعزيز مقدّرات دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، حيث تمّ الاستثمار بسِكك الحديد والموانئ ونشر المنتجات الصينية في تلك الدول، خاصةً المنتجات التكنولوجية. وعليه، يمكن فهم القلق الأميركي من هذا المشروع لكونه يهدف بشكل خاص إلى خلق نظامٍ موازٍ للنظام النيوليبرالي العالمي المتمثّل بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ضمن هذا السياق، ترى الصين بالكيان الصهيوني جسرها البرّي لأفريقيا ومركزاً كبيراً للنفوذ الأميركي يمكن استقطابه لصالح الصين. وفي السنين الأخيرة، لوحظ تحركٌ صيني تجاه تعزيز دورها في المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني على حساب دور الولايات المتحدة؛ فقد أصدر رئيس الصين الحالي، «شي جين بينغ»، برنامج «النقاط الأربع» في عام 2013، ومن ينظر لهذا البرنامج لا يراه مختلفاً عن تصريحات باقي الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، ولكن يجب ربطه بالسياسة الصينية السابقة التي فضّلت الانحياز الصامت لنظام أوسلو دون إبداء برامج سياسية، حتى عام إصدار برنامج «النقاط الأربع». وفي السنتين الأخيرتين، رأينا الصين تندّد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزّة أثناء معارك سيف القدس، ووحدة الساحات، وثأر الأحرار، وتدعو «إسرائيل» إلى «ضبط النَفس».
الدوافع والمستقبل
نرى جليّاً بأن العلاقات الصينية الفلسطينية لديها تاريخٌ ثري ومرّت بعدة محطاتٍ مهمة. فقد كانت الصين يوماً ما شريكة للمقاومة الفلسطينية، وشريكة الدمّ ضد الإمبريالية الأميركية. وقد صرّح بذلك «ماو تسي تونغ» حينما قال: «إنّ الإمبريالية تخافُ من الصين والعرب. إنّ إسرائيل وفورموسا [تايوان] قواعد الإمبريالية في آسيا. أنتم [العرب] البوابة الأمامية لهذه القارة الكبيرة، ونحن بوابتها الخلفية». [26] اعتبرت الصين القضية الفلسطينية مفتاحاً لتحرّر العرب من التبعيّة الأميركية، ودعمت حركة «فتح» على هذا الأساس. وفي السياق الأكبر، يُمكن قراءة دعم الصين للمقاومة الفلسطينية كدعم مشروط بالتأثير على النفوذ السوفياتي أيضاً، وخلق جبهةٍ مناوئة لهم عالمياً. ومن خلال هذه العدسة، وعدسة تغيّر الموقف الفلسطيني -والعربي عموماً- من مشاريع التسوية من الرفض إلى الدعم، يمكن الاستدلال على أسباب تغيّر الموقف الصيني بشكل بطيء حتى دعم الصين لاتفاقية كامب ديفيد والاعتراف الصيني الكامل بـ«إسرائيل» في عام 1992.
وكما أسلفنا، شكّل تغيّر الموقف العربي ذريعةً سمحت للصين بتمييع موقفها وتطبيعه تحت غطاء حل الدولتين. فقد استفادت من جهة من التكنولوجيا «الإسرائيلية»، وضمنت من جهةٍ أخرى تمدّدها إلى الأسواق العربية وعدم عزلتها سياسياً من قبل النظام العربي الرسمي بسبب التسوية مع الكيان الصهيوني. وبهذا تكون قد ضربت عصفورين بحجرٍ واحد: كسبت ودّ الدول العربية وودّ الكيان الصهيوني.
وفي هذا السياق، ومنذ عام 1992، لم تَلبَث الصين إلّا أن تحاول استقطاب الكيان الصهيوني والاستفادة من التكنولوجيا العسكرية التي يقدّمها لها. وقد رسخ انطلاق مشروع الحِزام والطريق الرؤية الصينية تجاه فلسطين، فهي ترى بالكيان الصهيوني فرصةً استثماريةً بحتة، نتيجةً للموقع الجغرافي والسياسي لفلسطين، وتحاول قدر الإمكان بأن تلعب على التناقض بين المركز الاستعماري (الولايات المتحدة الأميركية) والثكنة الاستعمارية (“إسرائيل”) من خلال زيادة الاستثمار الصيني في الأراضي المحتلة، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة تفكر مليّاً بعلاقتها مع ثكنتها الاستعمارية في غرب آسيا.
في الختام، وعلى الرغم من اختلاف الأوضاع الميدانية الراهنة في الأرض المحتلّة عن بداية الألفية الحالية، سواء مع وجود فصائل المقاومة المنظّمة في غزة أو صعود مجموعات مقاومة وفضاءاتٍ محصّنة في الأراضي المحتلّة، غير أنّ الوضع السياسي على حاله، بل يمكننا القول إنّه أسير الجمود مع غياب مشروع تحرري جامع يمثّل هذه الطاقات ويقويّها. في ظل ذلك، يمكن لنا أن نستشرف بأن الموقف الصيني من «إسرائيل» لن يتغيّر في المستقبل القريب، ولربما التناقض بين أميركا و«إسرائيل» حيال علاقة الأخيرة مع الصين قد يدفع بتغييرٍ سياسي إيجابي، ولكن لا يزال أي تغييرٍ جذريٍّ في هذا الصدد بعيد المنال.
[1] Cooley, John. “China and the Palestinians.” Journal of Palestine Studies, vol. 1, no. 2, 1971, p. 6.
[2] زيد الشعيبي. “خطة الصين الجديدة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.” الشبكة، 12 أيلول 2017:
https://al-shabaka.org/memos/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/.
[3] Behbehani, Hashim S. China’s Foreign Policy in the Arab World: 1955-75. 3 Case Studies, Kegan Paul International, London U.a., 1985, p. 46.
[4] Han, Xiaoxing. “Sino-Israel Relations.” Journal of Palestine Studies, 1993, p. 65.
[5] للنظر إلى النص الكامل للخطاب: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121623.pdf?v=e1cd06384e2e67bdff11f809ead78849.
[6] Behbehani, 21
[7] الوزير، خ. (2015). حركة “فتح”: البدايات. مجلة الدراسات الفلسطينية، (104)، ص. 71.
[8] الوزير، ص. 74.
[9] Behbehani, p. 40.
[10] عيّاش، عبدالله محمود. جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية ودورهما في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي 1964-1973. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2014. ص. 123.
[11] Behbehani, p. 44.
[12] للنظر إلى نص قرار ٢٤٢: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/240/94/PDF/NR024094.pdf?OpenElement
[13] Behbehani, p. 62.
[14] الوزير، ص.97.
[15] تم رصد الكتاب الأحمر الياباني في أيادي مقاومي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الفيلم “الجيش الأحمر الياباني/الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إعلان الحرب العالمية” في الدقيقة 32:50. لمشاهدة الفيلم: https://youtu.be/CIx81VAPMiY
[16] Cooley, p.7
[17].Han, p. 67
[18] Han, p. 67-68.
[19] Clarke, Duncan. “Israel’s Unauthorized Arms Transfers.” Foreign Policy, no. 99, LLC,
1995, p. 103 – p. 107.
[20] Han, p. 68.
[21] “China Becomes Israel’s Largest Source of Imports in 2020.” Xinhua, http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/20/c_139684705.htm.
[22] مع انعدام وجود مصادر صينية عن مدى استثمار الصّين بالكيان الصّهيوني، قرّر الكاتب على مَضض بأن يستخدم مصدرًا إسرائيليًا لغرض البحث:
https://www.inss.org.il/publication/chinese-investments/#_ftn3
[23] “Israel Opens Chinese-Operated Port in Haifa to Boost Regional Trade Links.” Reuters, Thomson Reuters, 2 Sept. 2021, https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-opens-chinese-operated-port-haifa-boost-regional-trade-links-2021-09-02/.
[24]“China-Made Electric Train in Tel Aviv Israel Completes Test Run.” CGTN, https://newsaf.cgtn.com/news/2021-10-22/China-made-electric-train-in-Tel-Aviv-Israel-completes-test-run–14yi9ENNoGI/index.htmls.
[25]Jourdan, Adam, and Tova Cohen. “China’s Bright Food to Buy Control of Israel’s Tnuva to Boost Dairy Sales.” Reuters, Thomson Reuters, 22 May 2014, https://www.reuters.com/article/us-bright-food-grp-tnuva-apax-idUSBREA4L01Q20140522.
[26] Cooley, p. 4