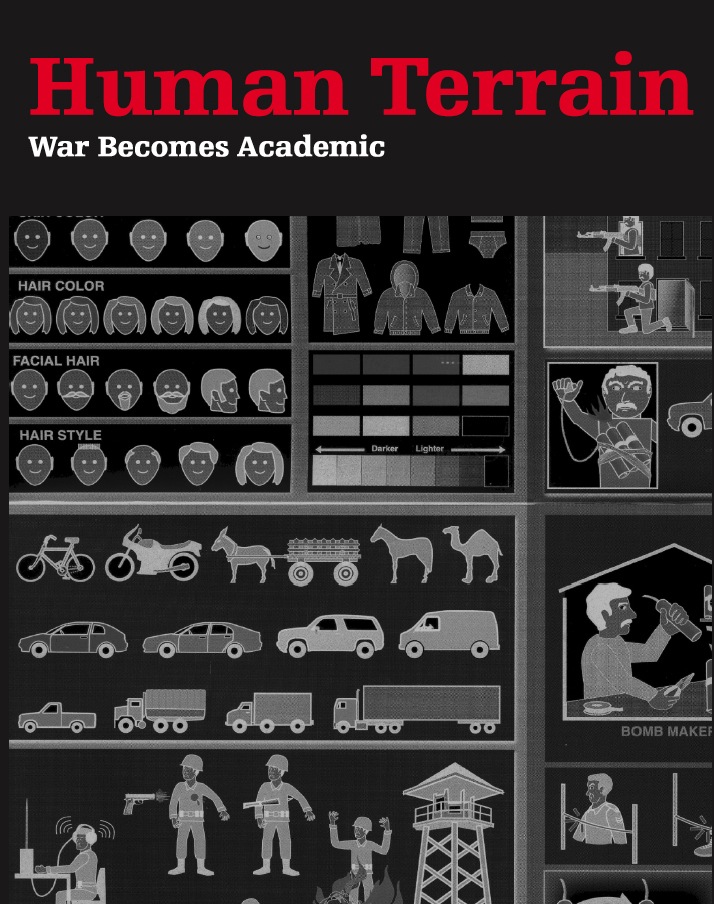يقدّم ياسر المعادات في هذه المقالة مراجعةً موسّعةً لكتاب “آثار استعماريّة: تشكّل الهويّة الوطنيّة في الأردن” لجوزيف مسعد. يتقفّى الكتاب الآثار الاستعمارية التي حفرت عميقاً في بنية الدولة الوطنيّة الأردنية، تحديداً على صعيد المؤسّستين العسكريّة والقانونيّة.
الاستشراق: أسلوب تفكيرٍ يقوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين ما يسمّى “الشرق”، وبين ما يسمّى (في معظم الأحيان) “الغرب”. [1]
إدوارد سعيد
ترتكز أطروحة جوزيف مسعد “آثار استعماريّة: تشكّل الهويّة الوطنيّة في الأردن”، على دور الاستشراق في تكوين هذه الهويّة عبر التدخّل الكولونيالي المباشر، وما تلاه من دورٍ للآثار الاستعماريّة التي فرضت نفسها على صعيد تطوّر الهويّة الوطنيّة في الأردن.
كان مسعد قدّم هذه الأطروحة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة كولومبيا التي يُدرّس فيها اليوم، لكنّها لم تحظَ وقتها بالاهتمام الكافي، بحكم نشرها باللغة الإنجليزيّة لأوّل مرةٍ عام 2001. تُرجمت في مطلع العام الماضي إلى العربيّة، مع إضافاتٍ أدخلها الكاتب عليها، لتثير بعضَ النقاش في الأوساط الأردنيّة.
يركّز مسعد في تحليله لتكوّن الدولة، ومن ثمّ تشكّل الهويّة الوطنيّة في الأردن، على دراسة التحّولات في المؤسّستَيْن القانونيّة والعسكريّة، مُنافيًا من يسمّيهم بـ”الوطنيين الإقصائيين”، وعلى رأسهم الراحل ناهض حتر الذي كان يروّج لجذورٍ أردنيّةٍ تاريخيّةٍ انعكستْ على نشوء الدولة وتشكّل هويّتها حتى قبل إعلانها دولةً.
يُفرد مسعد مساحاتٍ واسعةً من كتابه لنقاش تلك الجدالات والرّد على المنطق “الإقصائي” الذي يتّبعه هؤلاء بحسبه. غير أنّ ذاك التحليل ونقده مِن بعده غيّبا الشعب كفاعلٍ في تشكيل الهويّة الوطنيّة، يستحق المعالجة بنفس القدر الذي عالج به مسعد الدور المؤسساتي، الأمر الذي عرّض العمل لقصورٍ في التغطية أربكَ منتجه النهائي.
قوننة الوطن
في الفصل الأول من كتابه الذي يتناول دور المؤسسة القانونيّة في صناعة الوطن، يستند مسعد إلى تنظير ماركسيين مُعتبرين على غرار “ألتوسير” و”غرامشي”، لإثبات أهمية المؤسسة القانونيّة في تشكيل الدولة الوطنيّة ورسم ملامحها، ومن ضمنها الهوية الوطنيّة بالطبع.
يعرّف مسعد الهويّة الوطنيّة على هذه الشاكلة: “وأعني بالهويّة الوطنيّة مجموعة الصفات والعلامات (الأصول الإقليميّة، والأصول العائليّة من الأب أو الأم، والدين، والجنس، والنوع، والطبقة، واللغة) التي يضعها الفكر الوطني شروطاً مسبقةً للتمتّع بهويّةٍ وطنيّةٍ معيّنةٍ كما يعرّفها ذلك الفكر الوطني نفسه”. [2]
ورغم أنّ مسعد لا يوضّح ماهيّة الفكر الوطني الذي عرّف الهوية الوطنيّة في الأردن، إلّا أنّه يحيلنا إلى الدور الكولونيالي المتمثّل في السلطة الانتدابيّة البريطانيّة في تشكيل هذه الهويّة بمساعدة النظام الأميري الهاشمي الناشئ في عشرينيّات القرن الماضي. يعتبر الكاتب قانون الجنسية الصادر رفقة القانون الأساسي عام 1928 المحاولةَ الأولى لتأسيس هويّةٍ وطنيّةٍ أردنيّةٍ، فيما يعدّ ما سبقهما إرهاصاتٍ فحسب في طريق تأسيس هذه الهويّة.
يقول مسعد واصفًا قانونَ الجنسية وسواه من القوانين الأردنيّة: “يكاد كلّ شيءٍ قد أسهم في تشكيل الذاتيّة القانونيّة الوطنيّة الأردنيّة أن يكون استنساخاً حرفيّاً من القوانين البريطانيّة”. [3] بل إنّه يتعدّى ذلك نحو محاولة إثبات الدور الكولونيالي الصِرف في تأسيس الدولة، ومن ثمّ الهوية الوطنيّة في الأردن، قائلاً: “والحقيقة أنّه لم يكن هنالك بلدٌ أو منطقةٌ أو شعبٌ أو حركةٌ وطنيّةٌ تسمّى شرق الأردن أو شرق أردنيين قبل إنشاء هذه الدولة الوطنيّة”. [4]
بالمقابل، يشير الكاتب إلى نمو نزعةٍ وطنيّةٍ “بذور حركةٍ وطنيّةٍ” أردنيّةٍ في عشرينيات القرن الماضي مع شعار (الأردن للأردنيين) الذي كان أطلقه الشاعر مصطفى وهبي التل “عرار”، ناهيك عن ثورة سلطان العدوان التي قمعتها القوات البريطانيّة. فيما سيتحاشى مسعد التوسّع في هذا السياق، بحكم التزامه بمنهجيّته المُعلِية لدور المؤسسات في تكوين الدولة وهويتها الوطنيّة على حساب دور النضال السياسي والشعبي؛ إذ لا يذكر التمّرد الذي قاده كليب الشريدة في الكورة في مطلع العشرينيّات. ولن يذكر لاحقاً ثورة الأمير راشد الخزاعي التي استهدفت المصالح الإمبرياليّة البريطانيّة في الأردن. بينما سيعرّج مسعد على مقرّرات المؤتمرات الوطنيّة الأردنيّة التي انطلقت عام 1928، وقابلتها السلطات الحاكمة بالقمع وسنّ القوانين العرفيّة، غير أنّ هذا الأمر لم يحُلْ دون قيام الأحزاب السياسيّة وتنامي الوعي السياسي في الإمارة.
يتتبّع مسعد تالياً التطوّر التاريخي لقانون الجنسية في الأردن، ويربطه بالتحوّلات السياسيّة التي مرّت بها البلاد خصوصاً، والمحيط العربي عموماً، سواءً عبر الهزيمة في حرب 1948 التي تبعها ضمُّ الضفة الغربيّة بعد مؤتمر أريحا 1949، وما ترتّب عليه من تجنيسٍ لسكّانها، أو تنامي النزعة القوميّة لاحقاً بفضل نجاحات الضبّاط الأحرار في مصر، وظهور مصطلح (العرب) في قانون الجنسيّة، وصولاً إلى تعديل القانون عام 1987، والذي يندرج ضمن استحقاقات فكّ الارتباط مع الضفة الغربيّة، مع تناول التمييز الممأسس ضمن أحكام القانون ضد النساء وتطور هذا التمييز واستمراره حتى اليوم.
فضاءاتٌ مختلفةٌ كأنّها أزمنةٌ مختلفةٌ
يقول مسعد في معرض تمهيده للفصل الثاني: “فالزمن الوطني (أي زمن الثقافة التراثيّة والتقاليد)، بحسب التصوّر الوطني، تسكنه النساء (اللاتي تضعهنّ الوطنيّة البرجوازيّة في فضاءٍ منزليٍّ) ويسكنه البدو (أهل الصحراء غير الحضريّة). ويختلف هؤلاء عن الرجال وأهل الحضر (الذين يعيشون زمن الوطن الحديث)”. [5]
يبدأ مسعد في هذا الفصل استدخالَ أدوات التحليل المبنيّة على فضح دور الاستشراق في تقييد البداوة، تمهيداً لتوظيفها في رفد الجيش- الذي يهيمن عليه البريطانيون- بالزاد البشري. يشدّد الكاتب على الدور الكولونيالي في قمع البدو وإلغاء هويّتهم البدويّة، بغية خلق هويّةٍ جديدةٍ أكثر انسجاماً مع شكل الدولة الوطنيّة الناشئة. كما يستعرض مسار تطوّر أحوالهم في القانون الذي ظلّ يحرمهم من حقوقٍ عدّةٍ يكتسبها الحضر، مشيراً إلى دور هذه القوانين في تدمير الاقتصاد البدوي، [6] وتحويل البدو للاتّكال بشكلٍ شبه تامٍّ على الدولة، قبل إلغاء قوانين العشائر في منتصف سبعينيّات القرن الماضي.
بالمقابل، يناقش مسعد حرص الدولة على التذكير بالأصول العشائريّة لنشأتها، في سياقٍ يحاول فرض شرعيّة العائلة (العشيرة) الحاكمة وإسقاطها كشكلٍ مثاليٍّ لبنيةٍ فوقيّةٍ اجتماعيّةٍ على الوطن، ناهيك عن توظيف البدو كصورةٍ ترويجيّةٍ للدولة عبر ما أسماها “بدونة الثقافة الأردنيّة”، والتي شملت بحسبه الغناء والمسلسلات والملابس والطعام، وحتى استخدام البدو كواجهةٍ سياحيّةٍ.
يسوق مسعد على هذه المحاججة العديدَ من الأمثلة، كاللجوء إلى المغنية اللبنانيّة سميرة توفيق في معرض اختراع أغنيةٍ بدويّةٍ رُوِّج لها برعايةٍ رسميّةٍ، أو استخدام البتراء كواجهةٍ تعبّر عن حضارة الأردن الممتدّة عبر التاريخ كما يروّج لها النظام الحاكم. لكنّ مسعد يعود ويؤكّد على الدور الكولونيالي في هذا السياق، قائلاً: “فقد كانت سلطات الانتداب البريطاني هي التي حوّلت البتراء إلى هذه الصورة والمشهديّة الوطنيّة التي صارت عليها الآن، وما قامت به الأردن بعد الاستعمار لم يكن إلا استمراراً لثقافةٍ استعماريّةٍ وليس لتقليدٍ وطنيٍّ”. [7]
يتابع الكاتب ما كان بدأه في نهاية الفصل الماضي بما يخصّ عرض التمييز ضد المرأة وفقدان حقّها الدستوري في المساواة، سواءً كان هذا التمييز يشمل الحقوق السياسيّة أو الاقتصاديّة أو حتى الاجتماعيّة، مُناقشاً دور النساء المنحصر في الفضاء الاجتماعي الخاص مقارنةً مع الرجال المتاح لهم “حصراً” الفضاء الاجتماعي العام.
يتناول مسعد قوانين الأحوال الشخصيّة المتتابعة ومدى الظلم الاجتماعي الذي توقعه على النساء، بالإضافة إلى العديد من القوانين الأخرى (قانون الجنسية، قانون العمل، قانون التقاعد، قانون الضمان الاجتماعي، قانون العقوبات) التي ترسّخ الظلم الاجتماعي تجاه النساء. في ضوء هذا، يبيّن مسعد تناقض هذه القوانين مع الدستور القاضي بمساواة الأردنيين أمام القانون، الأمر الذي يعزّز شكل هذا الظلم ويجعل منه عرفاً اجتماعيّاً مع الوقت.
تشكّل هذه القضية لدى مسعد مبعثاً لتناول الدور التاريخي للحركة النسويّة في محاولة خلق دورٍ للنساء في الفضاء العام، عبر نضالهنّ الوطني من خلال الجمعيات والنوادي المنادية بالمساواة والعدالة الاجتماعيّة، والمنادية كذلك بإنهاء السياسات الاستعماريّة البريطانيّة في البلاد. يعبّر هذا، بحسب الكاتب، عن وعيٍ وطنيٍّ بشكل الهيمنة الكولونياليّة المستمرّة في الأردن “والحديث عن بداية الخمسيينات”، قبل أن تتحصّل النساء حقّها في التصويت، ومن ثمّ الانتخاب الذي تحقّق لاحقاً في السبعينيات على إثر تجارب نقابيّةٍ محدودةٍ للنساء.
تجانسٌ ثقافيٌّ أم استنساخ كولونيالي
يمثّل هذا الفصل لبّ أطروحة مسعد، كونه يناقش نصوص سيرة “جون باغوت غلوب” (غلوب باشا) أو (أبو حنيك) كما كان يسمّيه البدو، وهو قائد الجيش في الأردن في الفترة (1939-1956)، حيث يدرس مسعد سيرته كعملٍ استشراقيٍّ، ويربطه بتطوّر مؤسّسة الجيش ودورها الإنتاجي هناك.
يعود تأثير (غلوب باشا) إلى ما قبل فترة قيادته للجيش، حيث عمل نائباً لقائد الجيش السابق “فردريك بيك باشا” منذ عام 1930، قبل أن يصبح قائداً للجيش عام 1939. عاصرَ (غلوب باشا) الحقبة المركزيّة في تأسيس إمارة شرق الأردن، التي دخلها أول مرّةٍ عام 1924. وعليه، فإنّ أدواره العسكريّة والسياسيّة وحتى الاجتماعيّة الكولونياليّة، كانت محطّ اهتمام الكثير من الدارسين، فيما يتفرّد مسعد في مُنجزه هذا بدراستها من جوانب استشراقيّةٍ، وِفقَ أدوات نقدٍ أدبيٍّ وسياسيٍّ معتبرةٍ في هذا السياق.
يتناول الكاتب مراحل التطوّر التاريخي للجيش والدور الكولونيالي الذي لعبته بريطانيا في تأسيسه، ومن ثمّ التحكّم بشكله، قبل أن يصل (غلوب باشا) ويُحدث تغييراتٍ جذريّةً في المؤسسة العسكريّة، ستسهم لاحقاً في خلق ثقافةٍ بدويّةٍ “قام بهندستها والتأثير فيها بنفسه”، كان بدأها باستحداث قوات البادية ومنحها أدواراً حاسمةً في خدمة المساعي الإمبرياليّة.
يدلّل مسعد على هذه الأدوار بتدخّل هذه القوات لصالح الإمبرياليّة ضدّ ثورة 1936 في فلسطين، وتدخّلها لسحق الوطنيين العراقيين المناهضين للاستعمار البريطاني هناك. يقول مسعد في ظلال هذه المسألة: “أدمج غلوب البدو في جهاز الدولة القمعي مباشرةً، وضَمن بذلك وقف إغارتهم داخل الحدود على بعضهم وعبر الحدود، وكذلك نقل ولائهم الجماعي إلى الدولة الوطنيّة”. [8]
يسلّط الكاتب الضوء على منهجّية عمل (غلوب باشا) الكولونياليّة، مثلما يضيء على دوره في إحداث التغيير الاجتماعي “الإجباري” في حياة البدو في الأردن، عبر إدماجهم القسري في الدولة الوطنيّة الناشئة، وهو ما شمل حتى أنماط حياتهم الاقتصاديّة، التي بدت تميل نحو الاستقرار، ما أفضى إلى نفي الشكل البدوي واستبعاده كطورٍ حضاريٍّ نحو أطوار أعلى.
كما يعرّج مسعد على صفات (غلوب باشا) الشخصيّة التي ترتكز على مخزونٍ ثقافيٍّ استشراقيٍّ، حدّد طبيعة تعاطيه مع المجتمع الأردني خلال أكثر من ربع قرنٍ مكثه في الأردن. يستشهد الكاتب بمقتطفاتٍ من سيرة غلوب باشا التي يقول فيها: “وكان لباس الرأس يتكوّن من كوفيةٍ رُسمت عليها مربعاتٌ حمراء وبيضاء (ونحن من صمّمها)، والتي أصبحت منذ تلك اللحظة نوعاً من الرمز الوطني العربي، فقبل ذلك لم يكن يرتدي الرجال في شرق الأردن أو فلسطين سوى أغطية الرأس البيضاء”. [9]
يستفيض مسعد في تبيان دور (غلوب باشا) في خطّ أولى خطوات مشروع بدونة الثقافة الأردنيّة، والتي رسمتْ خطّ النظام الرسمي لاحقاً في سبعينيات القرن الماضي، سواءً في ما يتعلق بالموسيقى والآلات المستدخلة عليها “القربة”، أو اعتماد المنسف- بشكله المحدّث؛ أي بالأرز والجميد مع اللحم بدلاً عن شكله التقليدي بالثريد- كأكلةٍ تراثيّةٍ ورسميّةٍ للدولة ككلٍّ، وليس للبدو وحدهم، وغيرها الكثير من المجالات الثقافيّة. لكنّ مسعد يبيّن زيف هذا الاستدخال الثقافي، قائلاً: “ليس البدوي الذي أنتجه غلوب سوى نسخةٍ باهتةٍ من أصلٍ ليس له وجودٌ، وليس بدوي غلوب سوى تعسّفٍ مجازيٍّ يشير إلى مدلولٍ مغايرٍ أو غير موجودٍ أصلاً”. [10]
وطننة الجيش
ترتكز رواية مسعد الخاصّة بتكوّن الهويّة الوطنيّة الأردنيّة على افتراض دورٍ مركزيٍّ للآثار الاستعماريّة في المؤسستين القانونيّة والعسكريّة، مُنطلِقاً من تنظيرٍ ثقافيٍّ وفلسفيٍّ يدعّم بها حجّته التي يعبّر عنها شكلُ المؤسستين وسياستهما في إطار الدولة الوطنّية الحديثة في الأردن، والتي لا تزال مرتبطةً بالإرث الاستعماري الذي رافق نشأة الدولة.
يعتمد مسعد في تناوله للتحوّلات التي شهدها الجيش في هذا الفصل “محاولة وطننته” على مذكرات شاهر أبو شحوت أحد مؤسّسي حركة الضبّاط الأحرار في الأردن. وللضبّاط الأحرار هؤلاء قصّةٌ مرتبطةٌ بالمدّ القومي الذي نشأ في بداية خمسينيات القرن الماضي، والذي رافقه نجاح الضباط الأحرار في مصر في الوصول إلى السلطة، خصوصاً في ظلّ نزعةٍ وطنيّةٍ قوميّةٍ عُرف بها الأمير- ومن ثم الملك المعزول لاحقاً- طلال ابن الملك “المؤسس” عبدالله الأول. لطالما رُويت عن الأخير حكاياتٌ عن عدائه لـ(غلوب باشا)، لكنّ هذه الآمال مُنيت بالخيبة بعد عزل الملك طلال إثر عارضٍ نفسيٍّ، وتتويج ابنه البكر الحسين بن طلال بعد ذلك.
لم يسكن الضبّاط الأحرار ولم يرضخوا للأمر الواقع الذي حاول الاستعمار فرضه عليهم. فرغم إعلان الاستقلال رسميّاً عام 1946، إلّا أنّهم عقدوا العزم على محاولة محاكاة حركة الضبّاط الأحرار في مصر، بغية الإطاحة بـ(غلوب باشا) من قيادة الجيش والإتيان بنظامٍ قوميٍّ مناهضٍ للاستعمار، علماً أنّ بذور المشاعر المناهضة للاستعمار كانت قد انبثقت حتى قبل الأمثولة المصريّة، سواءً عبر تمرّد قائد معركة القدس عبد الله التل، أو عبر التنظيمات والخلايا السريّة التي كان قد أسّسها كلٌّ من أبوشحوت ومحمد المعايطة وضافي الجمعاني كنواةٍ لحركةٍ اشتدّ عودها لاحقاً.
تمثّلت نقطة التحوّل التي صّبت في صالح الضبّاط الأحرار في نمو علاقاتٍ وديّةٍ للغاية تجمعهم بالملك الشاب الجديد “الملك الحسين”، عن طريق الضابط الشاب علي أبو نوار الذي لعب دوراً مركزيّاً في إقناع الملك باعتناق أفكار الضبّاط الأحرار لتطهير الجيش من التواجد البريطاني، ومنح هؤلاء الضبّاط الفرصةَ للشروع في وطننته (تعريبه).
لم تكن استجابة الملك الشاب فوريةً؛ إذ احتاج الأمر إلى احتجاجاتٍ شعبيّةٍ مناهضةٍ لانضمام الأردن إلى حلف بغداد الإمبريالي، شارك فيها الضّباط الأحرار في مواجهة الضّباط البريطانيين، ما وفّر لهم الغطاء والدعم الشعبيَيْن في مشروعهم. حاول (غلوب باشا) الانتقام عبر تسريح عددٍ من الضبّاط الأردنيين، وِفقَ لائحةٍ قدمها للملك، غير أنّ المفاجأة بالنسبة له لم تكن رفض الملك للائحة فحسب، بل تمثّلت في قرار طرده من البلاد الذي اتّخذه الملك بالتعاون مع الضباط الأحرار في مظاهر عدائيّةٍ للغاية تجاه القائد البريطاني السابق للجيش، قبل أن يغادر لاحقاً بقية الضباط البريطانيين.
بالمقابل، أعاد علي أبو نوار تنظيمَ الجيش، بحسب خطة تحديثٍ وطنيٍّة هدفتْ إلى خلق مؤسسةٍ عسكريّةٍ وطنيّةٍ بعيداً عن التدخّل الكولونيالي. لكنّ شهر العسل هذا لم يدُم طويلاً، حيث خشي الملك من فقدان سلطته بعد هيمنة القوميين على الجيش، ومن ثمّ على الحكومة، عبر قيادة سليمان النابلسي زعيم الحزب الوطني الاشتراكي للحكومة، خصوصاً وأنّ الرجل يبدي عداءً واضحاً لكلّ ارتباطٍ للأردن مع المراكز الإمبريالية، مُتوّجاً ذلك بإلغاء المعاهدة الأردنيّة البريطانيّة. لكنّ الملك لاحقاً أطاح به وبحكومته والضباط الأحرار أنفسهم إثر مزاعم وقوع انقلابٍ ضد الملك!
يُورد مسعد جزءاً من خطابٍ كان ألقاه النابلسي في الذكرى الأولى لتعريب الجيش، حيث يقول فيه: “هذا الجيش الذي أراده [غلوب] خالصاً له ولبلده، منفذاً لمشيئته، مطيعاً لأمره، ضارباً بسيفه، هذا الجيش، جيش الشعب، جيش فلسطين، جيش القوميّة العربيّة المتحرّرة، جيش الأمة العربيّة الواحدة، يحتفل الآن بيوم تعريبه، يوم خلاصه، يوم انتصاره، يوم طرد الطاغية… وزال كلوب [كما في الأصل]، فأصبح هذا الجيش العربي عربيّاً، عربيّاً لحماً ودماً، عربيّاً فكرةً وروحاً، عربيّاً أملاً وطموحاً”. [11]
لم تعجب هذه الخطابات ومن بعدها السياسات التي اتبعتها الحكومة الوطنيّة الديمقراطيّة، التي يقودها النابلسي، الملكَ الحسين، خصوصاً مع صعود الإمبرياليّة الأمريكيّة كراعٍ جديدٍ للنظام الحاكم في الأردن عِوضاً عن البريطانيين. جاء ردّ الملك بفرض حكمٍ ذي قبضةٍ فولاذيّةٍ قوّضت التجربة الوطنيّة والديمقراطيّة الأردنيّة ووأدتْها في مهدها.
بطبيعة الحال، لم يركّز مسعد هنا على هذه التطورات السياسيّة، فما كان يهمّه هو دراسة التغيّرات التي طرأت على الجيش وفاءً لتخصيص المؤسّستين القانونيّة والعسكريّة كمجاليْن للبحث. لكنّ الأمر لم يشهد اختلافاً كبيراً في سياق الجيش الذي أُقصي الضباط الأحرار عنه، بل قد تمّ تسريحهم ومحاكمتهم، وبالتالي إنهاء أيّ نزعةٍ وطنيّةٍ لا تدين بالولاء للهيمنة الكولونياليّة على الجيش.
وبحسب مسعد، لم يشكّل انضمام الفلسطينيين “أهل الضفة الغربيّة الملحقة بالأردن بعد مؤتمر أريحا” فارقاً هاماً في تركيبة الجيش وشكله. ظلّ هؤلاء على هامش القيادات الوطنيّة من شرق الأردن في الجيش، خصوصاً وأنّ انخراطهم فيه جاء في ظلّ سطوة غلوب باشا “الكاره للفلسطينيين”، والذي أعاق أيّ دورٍ هامٍ يمكن أن يقوم به هؤلاء، قبل أن يُقوَّض أيّ دوٍر لهم بعد “الحرب الأهليّة” في أيلول 1970، خصوصاً في ظلّ انشقاق جزءٍ كبيرٍ من الجنود الفلسطينيين عن الجيش وانضمامهم إلى الفدائيين.
الوطن ككيانٍ مرنٍ
لعب الفلسطينيون الذين أخذ النظام الأردني وحلفاؤه يعرّفونهم على أنّهم “الآخر”، دوراً رئيساً في المساهمة في تشكّل ذاتٍ أردنيّةٍ هي نقيض ذلك “الآخر”، حيث لم تعد المواطنة والوطنيّة شيئاً واحداً بحسب الوطنيين من “الإقصائيين” الجدد، بحسب مسعد. [12]
يناقش مسعد في هذا الفصل أثرَ “ضمّ” الضفّة الغربية إلى الدولة- المستقلّة حديثاً في الأردن- على تطوّر الهويّة الوطنيّة في الأردن، ومن ثمّ تشظّيها إلى هويّاتٍ فرعيّةٍ أدت إلى ظهور التيار الإقصائي الذي يوجّه هجومه نحوه.
يتتبّع الكاتب مراحل الإدماج القانوني لمواطني الضفّة في الدولة الأردنيّة، وما رافقها من فرض النظام السياسي سلطته المطلقة على مصير أبناء الضفة الغربية، لكنّ حدثاً هاماً أعاق خطط إدماج السكان، باعتبارهم مكوّناً جديداً يُضاف إلى تشكيل الهويّة الوطنيّة الأردنيّة. تمثّل هذا الحدث في اغتيال الملك عبد الله على يد شابٍ فلسطينيٍّ، ما ولّد مشاعرَ سلبيّةً لدى المنظومة الحاكمة تجاه إمكانية مواصلة خطط إدماج الفلسطينيين في إطار الهويّة الجديدة.
رغم ما سبق، أحدثَ انضمام ما يقرب من ضعف عدد سكان الأردن لهذا التشكيل بعد نكبة عام 1948 تغييراً جذريّاً في التشكيل الديموغرافي للدولة في الأردن. حتّم هذا ظهورَ تشكّلاتٍ وأنماطٍ – وحتى مشاكل- اجتماعيّةٍ أكثر تنوعاً داخل الدولة، ما أسهم في التفاوت في التحديث والتنمية بين الضفتَيْن لصالح الضفّة الشرقيّة على حساب الغربّية بحسب الكاتب.
شكّل قرار إنشاء منظّمة التحرير الفلسطينيّة عام 1964 ضربةً موجعةً لطموحات الملك الحسين في توطيد هيمنته على الضفة الغربيّة، خصوصاً في ظلّ انزياح ولاء فلسطينيي “الضفتين” نحو هذه المنظّمة. وعلى الرغم من عدم منازعة قيادات المنظمة لسلطة النظام الحاكم في الضفتيْن، إلّا أنّ الواقع العملي أثبت وجود تناقضٍ بين المشروعين حتّمَ الصدام بينهما، خصوصاً مع ظهور العمل الفدائي الذي كانت الأراضي الأردنيّة مُنطلقاً له، بقيادة حركة فتح التي تزعّمها ياسر عرفات، واصطدمت في أحيانٍ كثيرةٍ بسلطة الجيش.
فاقمت نكسة حزيران 1967 من عمق أزمة الهويّة الوطنيّة في الأردن، تزامناً مع نزوح أفواجٍ جديدةٍ من اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن بعد احتلال الضفة الغربية. وعلى الرغم من النقطة المضيئة التي تمثّلت في انتصار الجيش والفدائيين على الصهاينة في معركة الكرامة بقيادة مشهور حديثة، إلا أنّ لحظة الانفجار في أيلول من عام 1970 قضتْ على أيّ إمكانيةٍ لوجود تعايشٍ بين قوى اجتماعيّةٍ متنافرةٍ يحاول كلٌّ منها فرض الشكل الذي يتصوّره للدولة.
يتناول مسعد الظروف التي أدّت إلى الصدام في أيلول، مُضيئاً على تصرّف النظام الحاكم تجاه تطوّر الأحداث، ومحاولته حشد الجماهير الشعبيّة، وبالتحديد العشائريّة منها، ضدّ الفصائل الفلسطينيّة المتواجدة على الأرض الأردنيّة، فيما لا يتناول الكاتب جانب الفدائيين في فترة ما قبل اندلاع الحرب.
أسفرتْ الحرب عن هزيمة الفدائيين كمقدمةٍ لطرد الفصائل من الأردن نهائياً بعد ذلك بأقلّ من عامٍ، مُخلّفةً آلافَ الضحايا من الطرفيْن، اللذيْن لم يتموضعا تماماً كأردنيين وفلسطينيين في هذه الحرب، خصوصاً في ظلّ تواجد نسبةٍ كبيرةٍ من الفلسطينيين في الجيش، ووجود عددٍ لا بأس به من الفدائيين الشرق أردنيين. لم تحظَ حينها مساعي النظام في تأجيج مشاعر الجماهير ضدّ الفدائيين بنجاحٍ مطلقٍ، في ظلّ رفض الوطنيين الأردنيين ضربَ قواعد المقاومة، وكان على رأس هؤلاء قائدُ معركة الكرامة مشهور حديثة، الذي فرض عليه الملك الإقامة الجبريّة بعد موقفه الرافض لشنّ الحرب على المقاومة.
مُنيت مساعي النظام في إعادة تشكيل الهويّة الوطنيّة في الأردن بضربةٍ موجعةٍ بعد قيام منظمة أيلول الأسود باغتيال رئيس الوزراء وصفي التل. كان الأخير قد هندس مشروع الاتحاد الوطني بُعيد انتهاء إرهاصات حرب أيلول، قبل أن تؤدي عزلة الأردن العربيّة إلى رضوخه لقرارات مؤتمر الرباط والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينيّة كممثلٍ شرعيٍّ وحيدٍ للفلسطينيين.
يضيء مسعد على الأنماط الثقافيّة السائدة بعد أيلول، حيث استُعيد الإرث الكولونيالي عبر استدعاء مشروع بدونة الثقافة الوطنيّة الذي كان ابتدأه (غلوب باشا) في ثلاثينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى إحداث تغييراتٍ جذريّةٍ في أنماط الغناء والرقص واللباس وكرة القدم وحتى اللهجات المحليّة، بغية خلق شكلٍ ثقافيٍّ يمكن تصديره على أنّه يمثّل الأردنيين “من شتّى الأصول والمنابت”.
يتناول الكاتب تالياً المراحل التي أدّت إلى قرار فكّ الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، والذي صدر عام 1988، أي بعد عامٍ واحدٍ من انطلاق الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى، مُناقشاً آثاره القانونيّة المتعلّقة بنزع الجنسيات عن فلسطينيي الضفة رغم عدم صدور قانونٍ بهذا الخصوص، أو دسترٍة لفكّ الارتباط كما كان يطالب الراحل ناهض حتر مثلاً.
مَن هو الأردني؟
هذا العنوان الذي صيغ على شكل سؤالٍ كان قد طرحه ناهض حتر عام 1995 ليس عنواناً لفصلٍ سادسٍ في الكتاب، إنّما يمثّل عنواناً جزئيّاً ضمن الفصل الخامس والأخير، لكني أودّ وضعه كخاتمةٍ لهذه المراجعة الموسّعة للكتاب.
أجاب الملك الحسين على تساؤل ناهض حتر قائلاً: “هناك مَن يسأل مَن هو الأردني. وأنا أسأل: ما هو الأردن؟ إنّ الأردن لا شيء في الأصل، إنّما صنعه الهاشميون”. [13]
حمل هذا الردّ تبعاتٍ لاحقاً بحقّ حتر، أدّت إلى محاكمته بتهمة إطالة اللسان. أورد الراحل حتر السياقَ الذي طرح فيه هذا التساؤل بُعيد توقيع اتفاقيّة وادي عربة، بعد سجالٍ احتضنته جريدة “الأخبار” اللبنانيّة، ودار بينه وبين مسعد الذي يضع الأوّل على رأس قائمة من يُطلق عليهم” الإقصائيين الوطنيين” في الأردن.
يقول مسعد: “فإذا كشفتْ نتائج هذه الاختبارات حدودَ الهويّة الوطنيّة الأردنيّة ومكوّناتها، فينبغي، حرصاً على الاتّساق، أن نجري هذه الاختبارات على شتّى المجتمعات التي يضمّها الأردن. وحقيقة أنّ الأردنيين الفلسطينيين هم المجموعة الرئيسة التي تخضع لهذا التحقيق يثبت كم أصبح إنتاجهم حديث العهد كـ”آخر” المبدأَ المنظّمَ لتشكيل “الذات” الأردنيّة الجديدة”. [14]
يفترض مسعد في الشقّ الثاني من العبارة “حقيقةً” يبرر من خلالها استثناءه لبقيّة مكوّنات الهويّة الأردنيّة التي يذكرها على الهامش دون تناولٍ حقيقيٍّ لها أو دراسةٍ اجتماعيّةٍ تخصّها، خلا “الشرق أردنيّة والفلسطينيّة”، قبل أن يحاول تفنيد الطرح “الإقصائي” لناهض حتر وبقيّة “الإقصائيين الوطنيين”، الذين يسمّي من بينهم: فهد الفانك، وأحمد عويدي العبادي، وعبد الهادي المجالي. لكنّ مسعد يركّز على طرح حتر “الإقصائي”، و”شوفينيّته” تجاه الفلسطينيين، مع غياب الطرح الموضوعي لديه تجاههم.
يذكّر الكاتب حتر بالهنات العديدة التي يسوق بها خطابه “الإقصائي”، سواءً من جهة وضعه تواريخَ زمنيّةً غير ذات دلالةٍ لتحديد من هو الأردني، أو تجاوزه لبعض الأحداث التاريخيّة الهامة التي وسّعت الكيان الأردني “ضمّ معان والعقبة إلى الإمارة”، وغيّرت بالتالي من تشكيله الديموغرافي. ينتقد مسعد في الجهة الأخرى الخطاب التعميمي- لم يسمِّه إقصائيّاً- لدى الفلسطينيين تجاه الشرق أردنيين، سمّى من بين مروّجيه عدنان أبو عودة وعريب الرنتاوي. إذ ينطلق خطابهم من تصوّرٍ هوياتيٍّ حصريٍّ في تفسير الهوّة الحقيقيّة في تقسيم العمل داخل المجتمع الأردني، فيما يقضي مسعد بتجاهل مثل هذه الخطابات الصراعاتِ الطبقيّةَ التي تحكم المجتمع بكافة مكوّناته الهوياتيّة، حيث يورد على ذلك الوضع الصعب الذي يعاني منه الجنوبيون الشرق أردنيّون
ينتقل مسعد في هجومه على “الإقصائيين الوطنيين” عبر تناوله المسيحيين الأردنيين. والمثير للدهشة هنا أنه يشمل في هجومه هذا حتى القائد الوطني الشيوعي يعقوب زيادين، بعد تصريحات الأخير ضدّ منظمة التحرير بخصوص حرب أيلول. يتجاوز مسعد بذلك النقد الذاتي الذي أدلتْ به الكثير من قيادات المنظمة تجاه أزمة أيلول، مع افتراضه مسؤوليّةً أحاديةً (نظاميّةً مُدعّمةً بتأييدٍ شرق أردنيٍّ مع استثناءاتٍ معدودةٍ) عن اندلاع الحرب في أيلول.
يقول مسعد في ختام الكتب ناصحاً أو”مُحذّراً”: “وربما تستطيع الحكومة الأردنيّة والوطنيون الأردنيون من خلال سياساتٍ منفتحةٍ (قانونيّةٍ وعسكريّةٍ بشكلٍ خاصٍّ) توحيدَ البلاد في ظلّ هويّاتٍ لا تستبعد إحداها الأخرى، وبالتالي استبعاد حربٍ أهليّةٍ ثانيةٍ سيخسر فيها كلّ الأردنيين، بصرف النظر عن أصولهم الجغرافيّة” [15]
بنظري، تعبّر هذه النصيحة أو “التحذير” عن سوء قراءةٍ للواقع السياسي والاجتماعي في الأردن، ناهيك عن الاقتصادي الذي مرّ عليه مسعد مرور الكرام في هذا الكتاب، خصوصاً أنّه لا يضع الظروف الموضوعيّة بعين الاعتبار. ذلك أنّ واقع الصراع اليوم يتّخذ شكلاً اجتماعيّاً اقتصاديّاً يعتمد إلى حدٍّ بعيدٍ على معطيات الصراع الطبقي. فبينما يفترض مسعد (والكلام قبل عقديْن) إمكانيّة تصاعد حدّة الصراع الهويّاتي، نرى اليوم هامشيّته بالمقارنة مع الصراع المبنيّ على القضية الاقتصاديّة الاجتماعيّة، خصوصاً وأنّ مسعد نفسه يذكر في الكتاب شواهدَ عديدةً حول اندماجٍ أكبر لجلّ المكوّنات المشكّلة للهويّة الأردنيّة في الدولة الوطنيّة، وإذ به فجأة يحذّر من حربٍ أهليّةٍ ثانيةٍ!
أخيراً، يمكننا القول إنّ جوزيف مسعد قدّم في هذه الأطروحة الأكاديميّة لوناً جديداً لم يتمّ تناوله سابقاً بخصوص تأريخ تأسيس الدولة الوطنيّة في الأردن وتشكّل هويّتها، مستنداً في ذلك إلى جملةٍ من أدوات نقد الاستشراق ودراسات ما بعد الكولونياليّة، ليكشف عن العلاقة بين الدورَيْن الكولونياليّ والوطني في تطوّر مسار الدولة وهويّتها.
ورغم إضافته النوعيّة على هذا الصعيد، إلّا أنّه تنازل طوعاً عن تفكيك عناصر عدّةٍ كان بإمكانها إثراءُ هذا العمل ورفعُ قيمته كمرجعٍ تاريخيٍّ. إذ إنّ اقتصار مجال الدراسة على المؤسستيْن القانونية والعسكرية، قلّص بدوره من شموليّة العمل، تحديداً بتجاوزه دورَ السكان وسيرورة علاقتهم مع السلطة الحاكمة؛ فهو وإنْ كان عالجَ هذه العلاقة في بعض الفصول، إلّا أنّه لم يأخذها مرتكزاً لدراسته، كما فعل مع الجيش والمؤسّسة القانونيّة، الأمر الذي كان سيفتح أمامه حتماً مجالاً أكثر اتساعاً وتناسقاً لدراسةٍ أكثر عمقًا وقيمةً تاريخيةً.
بإمكاننا أن نتقّفى أثر هذا القصور في المعالجة في ما خلُص إليه مسعد في نهاية الكتاب، حيثما الغيابُ لرؤيةٍ واقعيّةٍ لمآلات صراع الهويّة في الأردن، وحصره لهذا الصراع بين مكونيْن متضاديْن (شرق أردني وفلسطيني). أنتجت هذه المسألة منطقاً شبيهاً بالمنطق الذي أعابَهُ على مَن سمّاهم بـ”الإقصائيين الوطنيين”، والذين عبّروا بحسبه عن رفضٍ لإدماج الآخر “الفلسطيني” في هذه الهويّة الوطنيّة. فمسعد إنْ اتّخذ موقف الدفاع عن الهوية المضادّة لهؤلاء (أي الفلسطينيّة) بغرض التصدي لهذا الخطاب الإقصائي، إلّا أنّه تجاهل في الآن ذاته تناول باقي مكوّنات هذه الهوّية وتأثيرها في تشكّلها ومن ثمّ تطوّرها، مقتصراً على ذكرها دون التعمّق في دراستها اجتماعيّاً.
*****
الهوامش:
[1] إدوارد سعيد، الاستشراق، رؤية للنشر والتوزيع، ص 45.
[2] جوزيف مسعد، آثار استعمارية: تشكّل الهوية الوطنية في الأردن (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، 2019)، 49.
[3] المرجع السابق، 53.
[4] المرجع السابق، 60.
[5] المرجع السابق، 97.
[6] يقول مسعد بخصوص هذه النقطة: “كان المقصود بهذه السلسلة من القوانين تحقيق عدة أشياء. ففيما يخص البدو، كان قانون العشائر يخضع لتفسيراتٍ غير بدويةٍ، ويمكن تنظيمه والتحكم به واستخدامه عند الضرورة أو سحبه عند الضرورة، بينما ظلّت المنظومة ككلٍّ خاضعةً لولاية الدولة الوطنيّة غير البدويّة ومبادئها القضائية المهيمنة التي لا علاقة لها بالتقاليد البدوية، والتي تدعي في الوقت نفسه بأنها تمثّلها” (ص 112).
[7] مسعد، آثار استعمارية، 139.
[8] المرجع السابق، 201.
[9] المرجع السابق، 218.
[10] المرجع السابق، 286.
[11] المرجع السابق، 338.
[12] المرجع السابق، 395.
[13] ناهض حتر، الأردن أفقٌ لبناء «الشام الحقيقيـة»، جريدة”الأخبار” اللبنانيّة، الثلاثاء 18 أيلول 2012
[14] مسعد، آثار استعمارية، 469.
[15] المرجع السابق، 489.