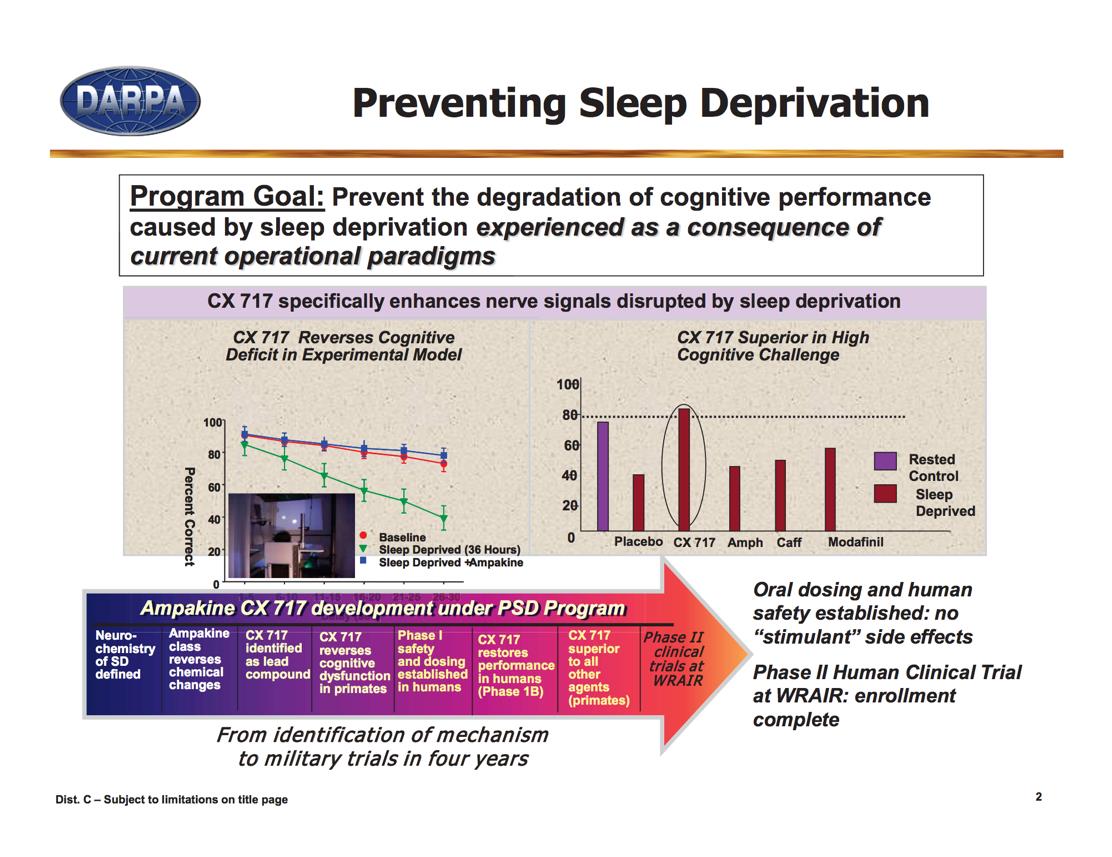(هذا المقال هو الثالث ضمن سلسلة مقالات “الجنود وانفتاح الكينونة”، للاطلاع على الجزء الثاني من هنا).
*****
نعود في هذا الجزء مجدداً إلى قضية التوجّس واللاشيء أو العدم. رأينا في الخاصيّة الأولى للكينونة- في العالم- أنّ الوجدان ينتمي لبنية الكينونة ذاتها، وأنه “الكيفيّة الأوليّة والمستمرّة التي ينكشف لنا بها كونُنا في العالم، لدى الأشياء ومع الآخرين. وعليه، فإن كل تصرّفٍ للكينونة، سواءً أكان نظرياً أو عملياً، وسواء كان إزاء ذاتها أو الأشياء أو الآخرين، يكون قائماً على أساس حالٍ وجدانيٍّ معيّنٍ: فرح حزن، دهشة، فضول، حنين، شوق، أمل، يأس، استياء، لامبالاة وما إلى ذلك”[1].
بهذه الطريقة، أنقذ هايدغر ما نطلق عليه، عادةً، المشاعر والأهواء والانفعالات من التحفّظ الشائع القائل بأنها “ظواهرُ عابرةٌ تطفو أحياناً على سطح الكينونة ثم تختفي، وأنها تتوفر على طابعٍ ذاتيٍّ محض، ولا علاقة لها بتاتاً بالحقيقة”، تبعاً لتصوّر الحقيقة كتوافقٍ بين الفكرة والموضوع. في حين ينطلق هايدغر من تصوّر الحقيقة كانكشافٍ، تبدو الأحوال الوجدانيّة أجدرَ بالحديث عن الحقيقة، على اعتبار أنها الكيفية الأولية والمستمرّة التي ينكشف لنا فيها كونُنا في العالم[2].
في مثال القرويّ، لم يكن الغضب حالةً نفسيةًّ عاشها (س) فترةً زمنيّةً محددةً، بل تجلّى في علاقة هذا الغاضب مع كلّ ما صادفه في العالم من أحداثٍ وأشياءٍ أو أناسٍ آخرين، في وجوده أصلاً في المقبرة، وفي ما يفكّر فيه ويجهّز له، في انطلاقه لضرب الشارع وفي علاقته مع كل ما قابله في طريق الذهاب، في عودته وفي علاقته مع كل ما قابله في طريق الإياب (بالعاميّة نقول “راح بالعروة”).
لا يمكن اعتبار هذه العلاقة بالأشياء والآخرين نتيجةً لحالة الغضب الداخلية، بل إنها تنتمي أصلاً إلى هذا الحال الوجداني، يعني أنّ الحقيقة في هذا المثال ليست بتوافق الأثر بين السبب والمسبب، “ضَرَبَ الشارع لأنه كان غاضباً، وكان غاضباً لأنه خسر إحدى أغنامه، بعد أن دهسها مستوطنٌ ما، وهرب أثناء عبور الشارع”، وإنما الحقيقة بانكشاف العالم أمامه كقوّةٍ جبريّةٍ فُرضت عليه (اكتشاف الدازاين أنه ملقىً به إلى هذا العالم، أي ماضيه)، عبْر التصرف إزاءه بأدواتٍ معينةٍ (إدراك الدازاين يعني إمكان التصرف إزاء كينونته- في العالم- ضمن احتمالاتٍ لانهائيةٍ؛ أي مستقبله).
بالنسبة لهايدغر، “تتمثل خصوصيّة الوجدان بالمقارنة مع كيفيّاتٍ أخرى للانفتاح في أنها تكشف الكينونة بصفتها ملقىً بها. إن ما ينفتح في الوجدان هو الكينونة باعتبارها حِمْلاً، وليس المقصود بذلك هذا الحِمْل أو ذاك، بل ما ينفتح في الوجدان هو أن هذه الكينونة كائنةٌ في وضعيّاتٍ معطاةٍ مسبقاً، وأن عليها أن تكون وأن تضطلع بكونها. إن كشف طابع الكينونة كحِمْلٍ ليس خاصّاً بالأحوال الوجدانية المرتبطة بالانقباض مثل الحزن والكآبة، بل حتى الأحوال المرتبطة بالانشراح تكشف هذا الطابع، ولكن في كيفية الانصراف عنه والتخلص منه. غير أننا في الحياة اليومية، وبالضبط في كيفية الكينونة الزائفة، نهرب من طابع الحِمْل هذا بإغراق أنفسنا في مهامٍ وانشغالاتٍ متلاحقةٍ، ما يجعل وجودنا ينغلق علينا كحملٍ، وبالتالي ككينونةٍ ملقىً بها، فتنغلق بذلك علينا نهائيّةُ كينونتِنا. لكن هناك بعض الأحوال الوجدانيّة التي تنتابنا دون إرادتنا، وتجعلنا أمام كينونتنا ككينونةٍ واحدةٍ ونهائيّةٍ (ككل)، وتفتح أمامنا بذلك إمكانية الكينونة الأصيلة، ويدخل التوجّس ضمن هذه الأحوال”[3].
ليست كلّ الأحوال الوجدانيّة، إذن، كبعضها، ولو كانت كذلك، فالتوجّس هو الاستثناء، أو ما يطلق عليه هايدغر “الأحوال الوجدانية الأساسية” كالتوجّس والملل والغضب بشكلٍ رئيسيٍّ، والتي يفضّلها على غيرها، نظراً لقدرتها الأكبر على الكشف وندرتها. لكن، ما الذي يكشف عنه التوجّس بالتحديد؟ للإجابة على هذا السؤال، يقارن هايدغر بين التوجّس وبين حالٍ وجدانيٍّ آخرَ كثيراً ما يُخلط بينهما؛ وهو الخوف، وهي مقارنةٌ من ثلاث زوايا: زاوية ما نخاف أو نتوجّس منه، وزاوية الخوف والتوجّس ذاتهما، ثم زاوية ما نخاف أو نتوجّس عليه.
أولاً: كلُّ خوفٍ هو خوفٌ من شيءٍ أو من كائنٍ محددٍ وواضحٍ داخل العالم، وضرره علينا محددٌ وواضحٌ كذلك، كالمرض، المعركة، الحريق، الفيضان، إلخ. في حين لا نتوجّس من شيءٍ محددٍ بالضبط، ولا من كائنٍ يمكن أن ندركه ونتعامل معه، وإنما ما نتوجّس منه هو كلُّ شيءٍ- كلُّ أحدٍ، أو أيُّ شيءٍ- أيُّ أحدٍ، وبالتالي لا شيءَ- لا أحدَ واضحٌ ومحددٌ، وكذلك ضرر ما نتوجّس منه[4].
ثانياً: “في الخوف، تكتشف الكينونة الكائنَ باعتباره مخيفاً، وذلك قبل أن تدركه وتتعامل معه. إننا لا ندرك أولاً ما هو مخيف إلا في الخوف ذاته. ليس هناك ما يخيف إلا بالنسبة للخائف والمتخوّف، أما الإدراك الصريح للمخيف والتعامل معه فهما يأتيان بعد ذلك. أما التوجّس، فلا ينشأ عن تمثّل اللاشيء وإدراكه وفهمه، بل إنّ اللاشيء لا يكون حاضراً إلا في التوجّس. إن التوجّس هو الذي يكشف اللاشيء الذي نتوجّس منه، يكشف وحشة الكينونة- في العالم- حيث لا يبقى الكائن بالنسبة لنا معتاداً ومألوفاً وقائماً رهن إشارتنا. في تجربة التوجّس، في الإحالة إلى الكائن في كليته وهو ينفلت، ينكشف للكينونة كونها ملقىً بها ومتروكةً لذاتها”[5].
ثالثاً: كلُّ خوفٍ هو خوفٌ على شيءٍ واضحٍ ومحددٍ، إننا نخاف على بيتنا ومالنا وعائلتنا في المرض أو الحريق أو الفيضان، على أن يتمّ خطفنا أو نصاب بتشوّهٍ خلقيٍّ في أرض المعركة، وهكذا. في حين لا نتوجّس على شيءٍ أو كائنٍ محددٍ، وإنما على انفلات الكائن في كليّته وفقدانه لكل دلالة، فيصبح العالم المألوف والعمومي بدون أهميّةٍ، وتنحلّ كل الروابط مع الآخرين، وهكذا تحسّ الكينونة بأنها متروكةٌ لذاتها. لكن التفرّد الجذري في التوجّس لا يجرّ الكينونة إلى عزلةٍ عن الآخر، بل إنه يحررها من سيطرة الممارسات والتأويلات الشائعة، يجعلها مستعدةً لكينونةٍ أصيلةٍ مع الآخر. والتوجّس إذ يخلّص الكينونة مما هو شائع ومتداول، يضعها أمام إمكانية انبثاق مشاريعها وقراراتها منها هي ذاتها؛ أي إمكانيّة الكينونة الأصيلة، إمكانيّة الحريّة التي تتأسس على اللاشيء الذي يتجلى في التوجّس[6].
إنّ ما يكشفه التوجّس هو اللاشيء، لأن التوجّس غيرُ مرتبطٍ بشيءٍ أو كائنٍ محددٍ، وإنما بالكينونة- في العالم- بما هي كذلك، وبالكينونة- في العالم- ككلّ. هذا الغموض في التوجّس يجعلنا نشعر بأننا غرباء عن هذا العالم، منفيّون عنه. وهي بحسب هايدغر الحالة الأصيلة للدازاين والمخفيّة عن أعيننا طوال الوقت، بفعل الانغماس في مشاغل الحياة اليوميّة[7].
بناءً على كلّ ما سبق، يمكن الآن تأكيد هذه النقاط النهائية في ما يتعلّق بقضية العلم والعدم والعالم: “١- ليس العدم كائناً لأنّ التوجّس لا يرتبط بشيءٍ محددٍ. ٢- لا يكون العدم حاضراً بصفته منفصلاً عن الكائن وقائماً بجانبه، بل إنه يتجلّى في التوجّس في وقتٍ واحدٍ مع الكائن في كليته وهو ينفلت. ٣- ليس العدم إفناءً للكائن، ذلك أنّ التوجّس هو حالة العجز التامّ. ٤- ليس العدم نتاجاً لنفي كليّة الكائن، ذلك أنّ التوجّس غريبٌ عن النفي الصريح كعمليةٍ للفهم، وفوق ذلك فإنّ نفي كلية الكائن يفترض العدم. ٥- العدم يصدّ، إنه يصدّ عن ذاته كلَّ تحديدٍ له باعتباره كائناً. إنّ العدم، بصفته ما نقلق منه وعليه، لا يسمح بأيِّ تحديدٍ. ٦- العدم يحيل، إنّه يحيل إلى الكائن في كليته، وهو ينفلت. في التوجّس ينحلّ كل شيء، بحيث لا يُقدّم أيّ كائنٍ سنداً. ٧- العدم يعدم. إنّه يجعلنا نرى الكائن في انفلاته. ٨- العدم يكشف. إنّه يفتح أمامنا الكائنَ بصفته الآخر َبالنسبة للعدم. القلق يُعلّم الكينونة أن تندهش من أنّ الكائنَ كائنٌ وليس لاشيئاً”[8].
“الجنديّ لا يخاف، الجنديّ يتوجّس” قد لا يعلم الجنديّ بأنه يقوم بمهمة الفيلسوف في بعض كلامه، لكنّه يؤمن به، وهذا ما يهمّ. في هذه المقولة، أو بالأحرى، الإجابة، إجابة الجنود على سؤال شديد الخصوصيّة متعلّقٍ بالخوف (هل كنت خائفاً؟)، لعب الجنود دور هايدغر في التفريق بين الخوف والتوجّس، والتفريق هنا بمعنى النفي والتأكيد، كما في الحوار التالي مع أحد الضبّاط المظلّيين:
– مظلّيٌّ ليومٍ مظلّيٌّ للأبد، يعني لو قيل لي ستقفز غداً بالباراشوت سأقفز بالتأكيد، سأتوجّس قليلاً كما الجميع، هذا طبيعي، لكن سأقفز بالرغم من ذلك!
– هل هذا مخيف؟
– لا، ليس مخيفاً، المظلّيُّ لا يخاف، المظلّيُّ يتوجّس، ليس نفس الشيء، دائماً ما نتوجّس من ألا يفتح معنا الباراشوت، أو من تتشابك خيوط الباراشوت مع الآخرين، إلخ. لكن ليس الخوف، لأننا لا نعرف الخوف، ولو كنتَ “خوّيفاَ” لا ينبغي عليك أن تدخل الجيش أصلاَ، وبالتحديد فرقة المظلّيين، لأنه لو كنت “خوّيفاً” فعلاّ، ماذا ستفعل في المعركة؟ لن تطلق النار، ستموت، رفاقك سيموتون لأنك خفت أن تضغط على الزناد. لذلك لا، لا يجب عليك أن تخاف. نفس الشيء أيضاً عند القفز بالباراشوت، لو خفت أن تلقي بنفسك من الطائرة، وفي الأسفل، رفاقك ينتظرون ما تحمله لهم من ذخيرة وطعام، ماذا تفعل إذن؟ تترك رفاقك يموتون لأنك كنت خائفاً، لا!
– لكن أليس الخوف شيئاً طبيعياً يأتي دون إرادةٍ منّا؟
– صحيح، لكن الجنديّ لا يخاف، الجنديّ يتوجّس، التوجّس من أن يُطلق عليه النار وغيره، لكنه لا يخاف، ولو خاف فعلاً، عليه أن يترك الجيش مباشرةً، لأنّ مهنة الجنديّ مهنةٌ خطيرةٌ جداً، كلنا يعرف ذلك مسبقاً، إنّها أخطر من مهنة محاسب في كارفور. هنالك احتماليّة الهجمات الإرهابية في حال كنت محاسباً في كارفور، لكن كم فرصة حدوثها مقارنةً بالجنديّ الذي يذهب إلى أفغانستان ومالي، حيث فرصة الموت أو الإصابة بالتشوهات الجسدية والنفسية أكبر بكثير. لذلك، لا للخوف، كنت أقول لجنودي دائما أثناء الحصص: انسوا الخوف، اتركوه في الخزانة. أما التوجّس فنعم، هذا طبيعيّ. سيكون عليكم أن تقفزوا غداً بالباراشوت، هذا صعب، معنوياً يجب أن تكون مجنوناً قليلاً كي تقفز من طائرة على ارتفاع ٤٠٠ متر، لكن ليس الخوف، التوجّس فقط”.
لنتذكّر الآن زوايا المقارنة الثلاثة بين الخوف والتوجّس عند هايدغر، وهي: الخوف/التوجّس من، الخوف/التوجّس ذاتهما، والخوف/التوجّس على. وبتطبيقها على هذا الحوار، ستبدو النتيجة صادمةً، فالجنديّ بحسب الضابط يخاف من شيءٍ محددٍ وواضحٍ، من القفز بالباراشوت، أو من الضغط على الزناد، وما يخاف عليه هو أيضاً محددٌ وواضحٌ: النفس (يأخذ الخوف في هذه الحالة صفة الأنانيّة، ولهذا السبب بالتحديد تنبذه ثقافة الجيش القائمة على روح الجماعة).
لا يتوجّس الجنديّ من شيءٍ محددٍ وواضحٍ كما في الخوف، عند القفز بالباراشوت على سبيل المثال، لا يكون التوجّس فقط من “ألا يفتح معه الباراشوت”، وإنّما من كل ما يمكن أن يحصل، وهو ما يطلق عليه هايدغر “الكائن في كليّته” أو “انفتاح- انفلات الكينونة”. كذلك في التوجّس من “أن يُطلق عليه النار”، لم يحدّد الضابط مصدر النار. بالتالي، الأدقّ أن يُفهم التوجّس هنا كتوجّسٍ من رصاصةٍ طائشةٍ، من حيث ما تعنيه للجنديّ من حسٍّ أمنيٍّ.
ولا يتوجّس الجنديّ على شيءٍ محدّدٍ، لا على نفسه فقط، ولا على رفاقه فقط، ولا على فشل المهمة فقط، وإنما “على انفلات الكائن في كليّته وفقدانه لكل دلالة، فيصبح العالم المألوف والعمومي بدون أهميّةٍ، وتنحلّ كل الروابط مع الآخرين، وهكذا تحسّ الكينونة بأنها متروكةٌ لذاتها”. ولذلك، يقول الضابط “عليك أن تكون مجنوناً قليلاً كي تقفز من طائرة على ارتفاع ٤٠٠ متر”، ثم تُترك لذاتك التي يقذف بها في الهواء”.
أما في مسألة الخوف والتوجّس ذاتهما، فالجنديّ لا يدرك ما هو مخيف إلا في التراجع إزاء القفز بالباراشوت، أو في التراجع إزاء إطلاق النار، إلخ. وعلينا أن نفهم التراجع هنا بمعنى المعركة أو تجربة القتال الحقيقي. ولهذا، فإن كل ما تقوم به الجيوش في ما تُسمّى “صناعة الجنديّ” هو عملياً تقليصُ، ما أمكن، الفجوةِ بين ما هو متخيّلٌ في التدريبات العسكريّة وما هو حقيقيٌّ على أرض المعركة.
أما التوجّس، فلا ينشأ عن عدم انفتاح الباراشوت مع الجنديّ، ولا عن تلقّي رصاصةٍ طائشةٍ، بل إنّ التوجّس هو الذي يكشف هذه الأمور التي يتوجّس منها الجنديُّ، إلا أن هنالك ما هو متجاوزٌ لهايدغر في هذا الحوار، وهنا يتجلّى في نظري أفضلُ تفريقٍ على الإطلاق بين “النظرية والممارسة”، فالفيلسوف يعرّف التوجّس على أنه “تراجعٌ إزاء…،” وأن هذا التراجع “ليس هروباً، بل إنه سكونٌ مشدوهٌ” مصدرُهُ الإحالةٌ إلى الكائن في كليته وهو يتوارى، أو السكون المندهش من أنّ هنالك شيئاً بدلاً من لاشيء[9].
قد أوافق هايدغر في مسالة تعريفه للتوجّس على أنه تراجعٌ إزاء كافة احتمالات الكينونة، لكن هذا التراجع ليس سكوناً أبداً، ولا ينبغي أن يكون كذلك، فالجنديّ لا يملك هذا الترف، بل على العكس، يكمُن في توجّس الجنديّ نوعٌ من التراجع المقدام الذي يجعله يلقي بنفسه من باب الطائرة على الرغم من توجّسه إزاء…، ويجعله يمضي قدماً في مهمته على الأرض بالرغم من توجسّه إزاءها.
كذلك في مثال القرويّ، لم يكن جلوسه في المقبرة بدلاً من مركز القرية، حيث يثرثر الشبّان أمثاله على سور الملعب، أمراً عبثيّاً. ففي تذكّر الموت يكمن، بحسب هايدغر، الضيق ذرعاً “بالكينونة معاً الواحد مع الآخر”؛ أي بالانحطاط في مشاغل الحياة اليوميّة ونسيان التساؤل عن معنى الكينونة. لكنّ القروّي لم يكتفِ بذلك، وإنمّا انقضّ على الشارع الرئيسي الذي يمرّ منه المستوطنون، وأتمّ ضربته ثمّ عاد. وهنا يتجلى التراجع المقدام في التوجّس مرّة أخرى. لماذا يتوجّس الجنديّ؟ بحسب هايدغر، لا يحدث التوجّس الأصليّ إلا في لحظاتٍ نادرةٍ[10]. لهذا السبب، ولقدرته الكبيرة كأحد الأحوال الوجدانية الأساسية على الكشف؛ كشف الكائن في كليّته، يأخذ التوجّس مكانةً متميزةً عند هايدغر. لكن متى يحدث التوجّس بالضبط؟
لا يملك هايدغر الإجابة على هذا السؤال. في الحقيقة، لو عدنا إلى تشبيه الكينونة- في العالم- بما هي وجدانٌ بالراديو: في البدء كان القذف. بولادتنا، نحن نقذف في هذا العالم، متصّلين به وجدانيّاً، ولذلك نفهمه. ثم نكونه بالتنقل بين إذاعة (وجدان) وأخرى. فعلُ التنقّل هذا أو التشويش بين الإذاعات لا يهتم به هايدغر. وبالتالي، فالتوجّس، وبالرغم من تميّزه على غيره من الأحوال الوجدانيّة التي نكون- في العالم- من خلالها، يأتي فحسب. لكن، بقراءة أطروحة هايدغر ككل، نفهم على الأقل بأن التوجّس هو الخروج عن المألوف الذي تعيشه الكينونة (معاً الواحد مع الآخر) في الحياة اليوميّة. وعلى سبيل المثال، الجلوس في المقابر ومواجهة حقيقة الموت الذي يمكن أن يعدمنا في أية لحظة ليس أمراً يمكن التقدم به لطلب يد فتاةٍ ما للزواج من وليّ أمرها، في حين أنّ أموراً مثل الدين أو المال أو “العلم” ستقوم بهذا الأمر بسهولة. غير المألوف هذا يوضّحه “الكولونيل إكس” في هذا المقتطف القصير من الحوار معه:
“ليس خوفاً، وإنّما شيءٌ… هو التوجسّ في الحقيقة، لأنك لست في الوضع الطبيعي لك، ليس وضعاً طبيعياً أن تقفز بالباراشوت! ليس وضعاً طبيعياً أن تفكك لغماً! ليس وضعاً طبيعياً أن تلقي القنابل اليدوية أو أن تُلقى عليك! ليست حركاتٍ يوميّةً نقوم بها في الأيام العاديّة، ربّما في فلسطين (يضحك)! لكن حتى في فلسطين، لا أعتقد أنكم تقومون بهذه الأمور بشكلٍ يوميٍّ. بالتالي، عليك بالضرورة أن تتوجّس من كلّ شيءٍ، من الضوضاء، من هبوب الريح، ممّا سيحصل”.
هل يمكن بناء كائن متوجّس؟ (أو كيف نقرأ مقولة “مظلّي ليومٍ واحدٍ، مظلّي للأبد) هل جربّت في ليلة ليس فيها ضوءُ قمرٍ أن تسير مغطّى العينين في طريقٍ ما، طالما قصّ لك جدّك عنه قصص الضباع والجانّ والقطط المتحولّة؟ أو أن تنام في العراء في ليلةٍ حالكة الظلام؟ هذه إحدى التدريبات التي يقوم بها الجنود من أجل تحضير أنفسهم للقتال الحقيقيّ. لا أنوي في ختام هذا النصّ الخوض في آليات بناء التوجّس عند الجنود، وهي غالباً عمليةٌ ضمنيّةٌ تقوم بالأساس على خمس آلياتٍ رئيسيةٍ يمكن مراجعتها في الفصل الأخير من دراسة عسكرة المشاعر.
ما أريد الدفاع عنه، هنا، هو أنّ التوجّس شيءٌ يمكن بناؤه، ويمكن له أن يدوم، بعكس اعتقاد هايدغر بأن التوجّس حالةٌ نادرةٌ يصعب الحصول عليها وإبقاؤها. بكلماتٍ أخرى، إذا اعتبرنا أنّ الانضمام إلى الجيش هو الآلية العامّة التي تندرج تحتها الآليات الأخرى في بناء التوجّس، فإنّ التوجّس لا يختفي بمجرد انتهاء الخدمة العسكرية والعودة إلى الحياة المدنيّة، بل يزداد تألقاً أحياناً.
والسبب وراء ذلك، بحسب الضابط في الحوار التالي، هو إعادة فقدان الجنديّ لذاته التي عثر عليها في انضمامه إلى الجيش:
“في الجيش، لسنا وحيدين أو معزولين، إننا دائماً في جماعةٍ، شخصين، ثلاثة… لدينا دائماً شخصٌ ما بجانبنا، هذه هي نقطة قوّة الجيش، إنها عائلة كبيرة، فلو قابلت شخصاً ما لا تعرفه في اختبارٍ ما لمرةٍ واحدةٍ فقط، ثم رأيته بعد سنين، ستتذكر هذا الشخص. في حين لو كنت موظفاً في مؤسسةٍ ما، لن تجد روح الأخوّة هذه، ليس نفس الشيء! الآن أنا مدنيٌّ، أشعر بكل هذا، العالم المدني لا يمتّ بصلة لكل هذه القيم، العالم المدني قاسٍ ووحشيٌّ جداً. إنه صعبٌ جداً مقارنةً بالجيش. في الجيش هناك اتحاد الأفراد، هناك الوفاق، أما في العالم المدنيّ، فلا يوجد تماسكٌ بين الأفراد، ولو وُجِد فهو مزيّفٌ، وليس كما في الجيش. وفي الجيش، تستطيع أن تقول لأحدهم أن يأتيك بعد ساعة، سيأتيك بعد ساعة بالضبط. أما هنا، لو قلت لأحدهم نفس الشيء، سيبدأ بالتذمر، “أنا مريض، لا أقدر!”. أصدقائي الحقيقيون والوحيدون فقط عساكر، أنا حزينٌ لقول ذلك، لكن هذه حقيقةٌ، مضى الآن ثلاثة أعوام على تركي الجيش، لم أستطع فيها أن أكوّن صداقةً حقيقيةً مع أحدٍ، مع أحدٍ يمكن أن أقول له: هيّا، سنذهب في جولةٍ طويلةٍ على الأقدام، سنخيّم في ذاك المكان ليومين، إلخ. هل ترى؟ ليس نفس الشيء! هذا ما أشتاق له في الجيش… أتواصل حتى الآن مع كثيرٍ من رفاقي في الجيش، ولو حصلت معي مشكلةٌ ما، أنا على يقين بأنّ أوّل من يصل لمساعدتي لن يكون جاري، بل رفيقي الذي يسكن على بعد ١٦٠ كيلومتراً من هنا. لا يوجد هديّةٌ أجملُ من هكذا صداقةٍ في العالم، وبالتحديد، في هذا العالم الذي نعيش فيه. لا أعلم، ربّما لا يفكّر الجميع بهذه الطريقة، لكن، أنا جنديٌّ في الروح، لا يمرّ أسبوع إلا وأفكر في الجيش، في اللباس العسكريّ. في بيتي علقت العلم الفرنسيّ بالتأكيد، صور رفاقي، أحرص دوماً على أن يكون بحوزتي شيءٌ ما يذكّرني بالجيش”.
إنّ هذا الفشل بالانغماس في العالم المدنيّ، لكونه قاسياً وصعباً ومزيفاً مقارنةً بالجيش، هو ما يعنيه التوجّس كرفضٍ للانحطاط في الكينونة (معاً الواحد مع الآخر). ولم يكن الضابط دوماً على هذا الحال، بل وُلد ونشأ في نفس العالم الذي يرفضه الآن. لذلك، يمكن القول بسهولة بأن الجيش هو منشأ هذا التوجّس، وأنّ استمراره هو ما تعنيه مقولة المظلّيين الشعبيّة “مظلّيٌّ ليومٍ واحدٍ، مظلّيٌّ للأبد”، ومن ضمن ما تعنيه أيضاً، كما جاء على لسان أحد الجنود: “أنّه لا قدّر الله لو قيل لي، غداً ستخوض فرنسا حرباً كبيرةً، وأنها بحاجة إلى جنودٍ قدامى متطوعين للذهاب إلى ساحة القتال، سأكون أول من يذهب”، وهنا يتجلّى التوجّس المقدام مرةً أخرى.
*****
المراجع:
[1] مارتن هايدغر، كتابات أساسية، مصدر سابق، ص: ١١.
[2] المصدر نفسه، ص: ١١.
[3] المصدر نفسه، ص: ١٢.
[4] المصدر نفسه، ص: ١٣.
[5] المصدر نفسه.
[6] المصدر نفسه، ص: ١٣-١٤.
[7] Graham Harman, op.cit., p. 70.
[8]مارتن هايدغر، كتابات أساسية، مصدر سابق، ص: ١٤-١٥.
[9] مارتن هايدغر، كتابات أساسية، مصدر سابق، ص: ٢٦، ٣٦.
[10] المصدر نفسه، ص: ٢٧.