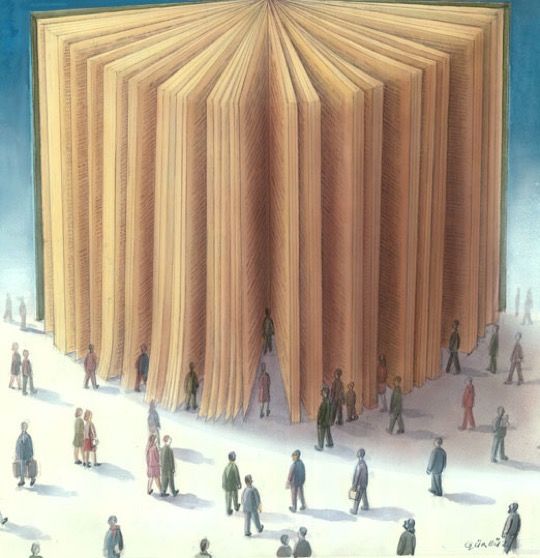يقدّم لكم فريق “باب الواد”، في هذه المقالة، مجموعةً من مختارات قراءاته لشهر نيسان الماضي، والتي انتقيناها لكم من منابرَ مختلفة، نبدأها بالأرشيف المتنازع عليه في مناهضة وتقويض الاستعمار، مروراً بحوارٍ مع المؤرّخ اللبناني وجيه كوثراني حول تاريخٍ طغت عليه الطوائف والملل، انتقالاً إلى الاقتصاد المشتبك، أو اقتصاد مستدامٍ للمقاومة، في فلسطين، وأخيراً مسألة الأرض في الجزائر بين العدالة والنجاعة.
“تاريخٌ بلا وثائق”: الأرشيف المُتنازَع عليه لتقويض الكولونيالية في الشرق الأوسط
أصدر “مركز نماء للدروس والبحوثات” ورقةً مترجمةً للباحثة أمينة الشاكري، ترجمتها صفاء الزرقان، تتناول الأرشيف المتنازع عليه لمناهضة (تقويض) الكولونيالية، أو ما أسماه مؤرّخٌ مصريٌّ يوماً “تاريخٌ بلا وثائق” في وصفٍ تهكّميٍّ لكتابة تاريخ الفترة الناصريّة. ووفقاً للدراسة، يُحيل هذا التاريخ إلى معنيين: الأول، ما أُطلق عليه “الآكل الزمني” للدولة، وهي الآليّة التي تبدّد بها الماضي، إمّا عبر التدمير المادّي للأرشيف، أو عبر “غربلة” كتابة التاريخ، والثاني يشير إلى التاريخ الذي نسعى لإعادة بنائه بسبب انعدام إمكانية الوصول إلى الوثائق.
وفي ضوء هذه الإشكاليّة، تنطلق الورقة من التعامل مع الأرشيفات بصفتها “تأسيساً تخيليّاً” يسعى إلى جمع أو طمس الموروث غير المكتمل، وبوصفها أيضاً “مراكز تأويلٍ” تتطلّب مصداقيةً معرفيّةً وأخلاقيّةً. كما تنطلق الباحثة من ضرورة التشكيك في المنطق الإنشائي للمتخيّلات الأرشيفيّة؛ بمعنى وجوب السؤال عمّا يجعل شيئاً/شخصاً ما قابلاً للأرشفة، وكيف يتذكّر/ينسى المؤرّخون التقاليد والتيارات والنقاشات الفكريّة المتنوّعة، بالإضافة إلى ضرورة مساءلة المنطق الإنشائي الذي يحكم أرشفة/عدم أرشفة المفكّرين ضمن تاريخ وإرث مناهضة الاستعمار.
تحاجج الورقة بأنّه وإنْ شكّل الأرشيف نقطةً مكثّفةً للسلطة ما بعد الاستعماريّة، فقد حجبت لامنفذيّته طبيعة الجدالات السياسيّة والاجتماعيّة في أعقاب مرحلة التحرر من الاستعمار، ما جعل تلك المرحلة أقلّ إدراكاً. كما تُفضي الورقة إلى ضرورة إعادة تصوّر أرشيف “تقويض الكولونياليّة”، والنظر إلى مناهضة الاستعمار كصيرورةٍ مستمرّةٍ وسلسلةٍ من الصراعات التي لها امتداداتها الإقليمية، فضلاً عن كونها صراعاً فكرياً وثقافياً ودينياً بقدر ما هو صراعٌ سياسيٌّ.
كما تنظر الورقة إلى التيارات الفكريّة المنتمية إلى أرشيفات تقويض الكولونياليّة في منطقتنا، من خلال نموذجي سيد قطب وإلياس مرقص، متناولةً أرشفة الجدالات التاريخيّة وموضعة الفكر الإسلامي ضدّ القيم العلمانيّة والثوريّة في الأرشيفات، فضلاً عن تناقض الأدلة التاريخيّة في كثيرٍ من الأحيان لـ”التفرّد المتبادل” للجماعات الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم دراسة الفكر العلماني والديني ضمن حقلٍ تحليليٍّ واحدٍ بعد، وكيفيّة تعزيز ذلك للتاريخانيّة السوداويّة.
فعادةً ما يُنظر إلى سيد قطب من المنظور الإسلاموي الصرف، في الوقت الذي انهمك فيه المؤرخون في تأصيل فكره وأثره على المجموعات الجهاديّة، لتطغى هذه الجهود على محاولات قراءته كمنظّرٍ أو لاهوتيٍّ تحرّريٍّ تبنّى البرنامج الإسلامي لمحاربة الإمبرياليّة. إذ جسّدت الرأسماليّة عند سيد قطب السلبيّة العالميّة للحداثة الغربيّة، الأمر الذي يتشارك مفاهيميّاً مع مفكّرين علمانيين ومنظّرين ماركسيين مناهضين للاستعمار كـ”فانون”. كما تقارب الباحثة بين إرث سيد قطب الفكري وبين علي شريعتي من خلال رؤيتهما الإسلامَ محرّكاً أيدولوجيّاً وقلباً دياليكتيّاً للفكر الماركسي، وسعى كلاهما لتجديد الإسلام كمنافسٍ أيدولوجيٍّ لنظام الحكم بعد الاستعمار.

كما تتّخذ الدراسة من أعمال الباحث الماركسي السوري، إلياس مرقص، نموذجاً للأرشيف الضائع للماركسيّة العربيّة، والذي ركّزت كتاباته الأصيلة على التاريخ المقارن بين الماركسية اللينينيّة وتاريخ الأحزاب الشيوعيّة في العالم العربي. نظّر مرقص للتعامل مع المشروع الاستعماري كمشروعٍ مستمرٍّ ضمن صيرورةٍ تاريخيّةٍ عالميّةٍ، ودعا إلى ضرورة إدراك النضال الثوري وإعادة النظر بدور النضال الوطني. وبينما ركّز الباحثون الغربيّون القلّة على فهرسة مرقص الموسوعيّة للأحزاب والحركات الشيوعيّة العربيّة، هُمّشت أطروحاته الفكريّة ومساهماته في الكتابة الماركسيّة والتحرّرية، فيما تعامل “اليسار العربي الجديد” مع أطروحاته على أنّها “عرضيّةٌ”. وهكذا، طُويت أعمال مرقص، وفقاً للباحثة، في سرديةٍ تحدّريةٍ لفشل الحداثة العربية في تقويض الكولونيالية، بدلاً من النظر له كفاعلٍ ومنظّرٍ هام.
تعاطى كلٌّ من إلياس مرقص وسيد قطب مع مناهضة الاستعمار بوصفها مسألة ثورةٍ سياسيّةٍ واجتماعيّةٍ وإقليميّةٍ، لا وطنيّة فحسب، فضلاً عن كونها جزءاً من المشاريع المعادية للرأسماليّة. كما اعتبرا المسألة الفلسطينيّة تذكيراً حاضراً للطبيعة غير المكتملة لمناهضة الاستعمار في المنطقة ومسألةً هامةً للصراعات الاستعماريّة. وبحسب الورقة، يمكن القول إنّ التيارين العلماني والديني قد تشاركا في مساحة المشكلة، ودعا كلاهما إلى أهمية إعادة التفكير في التقدّم وتقييم النهضة، ما يعني أنّ وضعهما ضمن حقلٍ خطابيٍّ واحدٍ يعدو مجرّد تمرينٍ فكريٍّ، إنّما هو شرطٌ أساسيٌّ لسياسة اليوم. وبينما لا يمكننا فصل تقويض الاستعمار عن مسألة الرأسماليّة، بالكاد تطرّق مؤرّخونا لتاريخ الفكر الاقتصادي والاقتصاد السياسي الذي صاحب تشكّل الدول الحديثة في منطقتنا بعد الاستعمار.
كما تحاجج الورقة بأنّ أرشفة التيارين بشكلٍ منفصلٍ تعزّز النظر لمسألة مناهضة الاستعمار من منظور المواقف الأيديولوجيّة التي تختلف بشكلٍ كبيرٍ ظاهرياً. وأخيراً، تدعونا الباحثة إلى تجريد التصنيفات المهيمنة ودراسة الظروف الماديّة الحقيقيّة لحالة مناهضة الاستعمار، وأرشفة الخيال كما الحقيقة وتحديد الفكريّ والمادّي في الأرشيفات.
للقراءة من هنا
وجيه كوثراني: تاريخنا تاريخ مِللٍ وطوائف
افتُتح الحوار الذي أجراه أحمد محسن مع المؤرّخ اللبناني وجيه كوثراني، ونُشر على منصّة “الأخبار” اللبنانيّة، بالحديث عن التاريخ العثماني وما تضمّنه من نظامٍ زراعيٍّ شكّل العلاقة بين السلطة والسكان والأرض. يبيّن كوثراني أنّ نمط الزراعة العثمانيّ لم يأتِ من فراغٍ، بل من النظام الزراعيّ التقليديّ القائم على الملكيّة وأرض الخراج، مفسّراً أنّ انتقال الأراضي ليد المتنفّذين جاء إثر خوف الفلاحين من تسجيل الأراضي بأسمائهم هرباً من الضرائب، ما أسّس لقيام نظام الإقطاع في أواخر القرن التاسع عشر، والذي يعدّ سبباً في فشل الإصلاح العثمانيّ الذي كان ينخره الفساد.

وعن نشأة الدولة الطائفيّة وتفسير الاستبداد كأثرٍ استعماريٍّ، يقول المؤرّخ اللبناني إنه لا يمكن تفسير الاستبداد بالاستعمار، بل بثلاثة عوامل؛ منها الطائفية التي عزّزتها الدولة العثمانيّة بتعاملها مع الطوائف والإثنيات بصيغة المجتمع الأهليّ الذي لم يخلُ من تدخّل الهيئة الحاكمة. ويشير كوثراني إلى أنّ مؤرّخي القومية اللبنانيّة يقومون بمراجعاتٍ حول هذه النظرية التي لم يتّفقوا معها؛ فرغم أنّ أيديولوجياتهم لا تتغير بسهولةٍ، إلّا أنّه يرى بوصول البحث العلمي لخلاصاتٍ لا يمكن التنصُّل منها.
ويعزو كوثراني عدم تزحزُح السرديات الرئيسيّة في بنية التاريخ اللبنانيّ المتداول بين الناس، أولاً، إلى التخلّف في الوعي التاريخيّ؛ فرغم ظهور مدارس تعمل على تحديث علم التاريخ ليصبح تاريخاً اجتماعيّاً، غير قائمٍ على الأحداث والأخبار، وإنّما على تاريخ البشر والأفكار، إلّا أنّ المؤرّخين لم يواكبوا هذه القفزة. أما ثانياً، فيُرجع المسألة إلى الأيديولوجيا التي تُستخدم كسلاحٍ سياسيٍّ وتعبويٍّ في المجتمع اللبنانيّ المتعدّد، وهو ما مكّن الطبقة السياسيّة من القيام بدورٍ رجعيٍّ في تطوير علم التاريخ والعلوم الأخرى.
أمّا على صعيد صناعة الأبطال وأسطرة الشخصيّات، فيعتبر كوثراني البطل “ابن السياق التاريخيّ بظروفه الاجتماعيّة والسياسيّة”، موضّحاً أنّه حتى بداية القرن العشرين لم تكن صناعة الشخص البطل سهلةً، وذلك لما تحتاجه من بناء أسطورةٍ متماسكةٍ بعد فقدان المنطقة لمشروعٍ وطنيٍّ كبيرٍ. نتج عن ذلك اختراعُ الشخصيات، إلى حدٍّ ما، على قياس اختراع الطوائف لأبطالها، بسبب غياب سرديةٍ وطنيةٍ حقيقيةٍ، في ظلّ حضورٍ طاغٍ للطوائف والمِلل.
للقراءة، من هنا
الاقتصاد المشتبك في فلسطين
في بحثٍ تحت عنوان “الاقتصاد المشتبك” نُشر باللغة الإنجليزيّة عام 2015، وُترجم حديثاً إلى اللغة العربيّة، يناقش الباحث الفلسطيني علاء الترتير تبعات النموذج التنموي النيوليبرالي الفلسطيني ومشكلاته كأحد الأسباب الجذريّة المسبّبة للاشتباك. كما يقدّم نقداً لقطاع المساعدات الدوليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بصفته مصدراً للاشتباك. على وقع ذلك، يقترح الترتير فكرةَ الاقتصاد المقاوم كنموذجٍ قائمٍ على مفاهيم السياسة المشتبكة والفعل الجماعي المشتبك.
ويدرس الترتير الحالة الفلسطينيّة باعتبارها مجتمعَ حراكٍ اجتماعيٍّ تشكّل عبر السنين من عدّة حلقاتٍ اشتباكيّةٍ متراكمةٍ في عملية مقاومة الاستعمار، التي تمخّض عنها ولادة الثورة الفلسطينيّة. غير أنّ الأخيرة ستتبدّل بشكلٍ جذريٍّ بعد اتفاقية أوسلو، وستتحوّل مؤسساتها إلى السلطة الفلسطينية التي تفتقد الشرعيّة وتمارس الاستبداد. ويوضح الكاتب أنّ هذا التحوّل الجذري ستنتُج عنه حلقاتٌ اشتباكيّةٌ جديدةٌ بين الشعب وقيادته، ستؤدّي بدورها إلى خروج المظاهرات السياسيّة والاقتصاديّة، مُستدرِكاً أنّ الأخيرة فشلت، حتى اليوم، في التحوّل إلى حركةٍ اجتماعيّةٍ مُستدامةٍ.
يحاول البحث في فصله الأول تأطير وتنظير السياسة المشتبكة والاقتصاد المشتبك في فلسطين، عبر استعراضٍ لتعريفات السياسية المشتبكة ونظرياتها، مؤكّداً أنّ الفعل الجمعي الاشتباكي أساسٌ للحركات الاجتماعيّة والثورات، من خلال بناء هويّاتٍ وهيكليّاتٍ جمعيّةٍ تحافظ على العمل الجماعي.

ورغم عدم إجماع المفكّرين على تعريف ومنهجيّة السياسية المشتبكة، إلّا أنّ الكاتب يرى صعوبة دراسة الحالة الفلسطينيّة بمعزلٍ عن سياق الشرق الأوسط وتفاعله مع نظريّات السياسية المشتبكة، وذلك باعتبارها محوراً أساسيّاً من الصراع الأوسع ضد التنمية غير المتوازنة والسيطرة على الثروة.
ويعزو البحث نشأة جذور الاقتصاد المشتبك إلى ظهور النيوليبراليّة الاقتصاديّة كنتيجةٍ لتوقيع اتفاقيّة أوسلو التي تبنّتها السلطة الفلسطينيّة سياسيّاً واقتصاديّاً؛ إذ يقوم الاقتصاد الفلسطيني حسب القانون الأساسي على مبادئ الاقتصاد الحر، ما يضمن الدور الريادي للنخب الرأسماليّة والقطاع الخاص. فيما برّرت اتفاقيّة أوسلو نفسها اقتصاديّاً بمسعاها لتحسين المستوى المعيشي للفلسطينيين، وتشجيعهم على المشاركة في السلام واستدامته.
وبتبنّي السلطة الفلسطينيّة هذه الفلسفة، فإنّها فشلت بالقيام بدورٍ تنمويٍّ رئيسيٍّ ضمن شبكةٍ معقّدةٍ من الفساد والمحسوبيّة وشخصنة المكاسب بعيداً عن مصلحة المجتمع. وقد ترسخّت هذه الأجندات النيوليبراليّة الاقتصاديّة في الحقبة “الفياضيّة”، واكتسبت زخماً أكبر لتزامنها مع الانقسام الفلسطيني وتبعاته السياسيّة.
وفي فصله الثالث، ينتقد البحث قطاع المساعدات الدوليّة كأحد مصادر الاشتباك والمواجهة، خاصّةً أنّ كلّ المساعدات الماليّة المقدّمة إلى الفلسطينيين لم تحقّق أيّاً من التنمية أو الأمن للشعب الفلسطيني. ويعتبر الباحث أنّ معضلة التنمية من خلال المساعدات تشكّل مثالاً واضحاً لعملية التنمية العكسيّة أو اللاتنمية، نظراً لترسيخها وجودَ السلطة الفلسطينيّة من جهةٍ، وسعيها للحفاظ على الوضع الراهن ودعم الاحتلال، من جهةٍ أخرى.
وعلى ضوء ما استعرضه الترتير في الفصول السابقة، يطرح في فصله الأخير تحت عنوان “تحدي السلطات: نحو نموذج اقتصاد مقاومةٍ مستدامٍ”، نموذجاً بديلاً يبتعد عن النيوليبراليّة، وذلك ضمن إطار الاقتصاد المشتبك والسياسة المشتبكة، من خلال استعادة الحقوق الاقتصاديّة نظرّياً وعمليّاً.
ويعرّف هذا الفصل الاقتصاد المقاوم بكونه نموذجاً يفهم عملية التنمية كعمليّةٍ تراكميّةٍ وتكامليّةٍ اقتصاديّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً، وهو بديلٌ حقيقيٌّ يمكن تنفيذه والحفاظ عليه لتحقيق الاستدامة للاقتصاد الفلسطيني، وتحرير الشعب الفلسطيني من الفقر وانعدام المساواة والخوف والاضطهاد، وتوسيع خياراتهم وإمكانياتهم.
للقراءة، من هنا
مسألة الأرض في الجزائر: بين العدالة والنجاعة
في مقالٍ نُشر في “السفير العربي“، يتناول الكاتب الجزائري الأخضر بن شيبة مسألة الأرض والقطاع الفلّاحي في الجزائر، بدءاً بالتدمير والسلب الاستعماريّ الممنهج للأرض لأكثر من 132 عاماً، وحال الريف الجزائري في ظل الدولة الناشئة ما بعد الاستقلال، وصولاً إلى سياسات الدولة الزراعيّة التي تباينت بين النزعة الاشتراكيّة والليبراليّة المتردّدة.
ينطلق الكاتب في الحديث عن مسألة الأرض في الجزائر من ضرورة دراسة البعد الاستعماري وأثره كي يتسنّى فهم تطوّر السياسات الزراعيّة التي انتهجتها الدولة منذ الاستقلال حتى اليوم. فقد ارتبطت الأرض الجزائريّة بعنف استعمارٍ استيطانيٍّ أدى إلى تحوّلٍ جذريٍّ في شكل الريف الجزائريّ، من استيلاءٍ على الأرض بالقوّة، واستغلال أهلها اقتصادياً، وتسخير مختلف القوانين والأدوات لنهبها، فضلاً عن عمليةٍ ممنهجةٍ لتدمير النسيج الفلّاحي وتفكيك المجتمع الجزائري. فقد استهدف الاستعمار الفرنسي نظام الشيوع والملكية العقاريّة الفلاحيّة، والذي طغى عليه الطابع الجماعي وشكّل قاعدةً قويةّ للتماسك العائلي في الريف قبل الاستعمار، وسنّ مختلف القوانين والسياسات بهدف تقويضه.

كما يضيء المقال على تجربة نظام التسيير الذاتي التي انطلقت بعد الاستقلال مباشرةً، ودون توجيهٍ من الدولة الناشئة أو جبهة التحرير، وانتظمت فيها لجان تسييرٍ من الفلّاحين بهدف العناية بالمزارع الكبرى التي تُركت مهجورةً بعد حرب التحرير، وتمكّنت هذه اللجان الزراعيّة آنذاك بحصاد الموسم الفلّاحي لتبدأ أولى بوادر نظام التسيير الذاتي. لم يبدأ تقنين هذا النظام حتى عام 1962، بعد صدور مراسيم تنظّم القطاع الفلّاحي والإصلاح الزراعي وتسيّر المزارع “المتروكة” وتضع الأملاك الشاغرة تحت الوصاية الإداريّة. شهدت تلك المرحلة عقد أوّل مؤتمرٍ للفلاحين في تشرين الأول 1963، والذي شارك فيه الفلاحون الجزائريون من كلّ مكان، ويصفها الكاتب بأنّها اتّسمت بالحماس والرومانسية، ولكنها دامت لمدة عامٍ واحدٍ.
فبالرغم من مواصلة سير العمل، لم يحسم تقنين نظام التسيير الذاتي قضية الملكيّة، ما أدّى إلى تآكله لصالح تسييرٍ مباشرٍ من الدولة ونظامها البيروقراطي، وتراجع استقلالية لجان التسيير أمام الحكومة. بالمقابل، تحوّل الفلاحون العاملون في المزارع المسيّرة إلى شبه موظفين في الدولة، وهُمّش قطاعٌ واسعٌ من الفلّاحين أصحاب الأراضي ذات المردوديّة البسيطة، ما دفع بنزوح بعض العائلات الريفيّة إلى المدن.
استمرّ حال القطاع الفلّاحي بالتدهور بعد الاستقلال وحتى انطلاق الثورة الزراعيّة في 1971، والتي أقرّ فيها نظام هواري بومدين تأميم الأرض وتثمينها لفائدة الجماهير الريفيّة، انطلاقاً من مبدأ: “الأرض لمن يخدمها”. أعادت الثورة الزراعية توزيع نحو 1. 1 مليون هكتارٍ، وبنت 200 قريةٍ فلاحيّةٍ اشتراكيّة،ٍ ووضعت الحكومة أملاك الدولة تحت تصرّف صندوقٍ وطنيٍّ للثورة الزراعيّة، والذي أسّسته لإدارة توزيع الأراضي وإنشاء المستثمرات والتعاونيات الفلاحيّة المختلفة. كما باشرت الحكومة بتأميم أراضي الملّاك الغائبين بهدف الحدّ من حجم الملكياّت العقاريّة الكبيرة وضمّها للصندوق، لتنال هذه الخطوة تأييد اليسار الجزائري، وتُقاَبل بمقاومةٍ شديدةٍ من التيار المحافظ والبرجوازيّة الجزائريّة.
ومع نهاية عام 1978، بدأ التوجّه نحو الانفتاح الليبرالي ومحاولات إعادة تنظيم القطاع الفلاحي، كما بدأت السياسات الزراعيّة بالتوجّه نحو البحث عن المردوديّة، ما أدّى إلى فقدان الاستقرار في القاعدة العقاريّة وانخفاض الاستثمارات الزراعيّة. ومع بداية الألفيّة، بدأ تنفيذ مخطط وطنيّ للتنمية لمعالجة حالة الركود هذه ، وخُصصت ميزانياتٌ لدعم الفلاحين وتحديث المستثمرات. كما صدر قانون التوجيه الفلاحي في عام 2008 بهدف تكريس مبدأ الامتياز ومنح ضمانةٍ قانونيةٍ لأصحاب المستثمرات الزراعيّة، ولكن ما لبثت الدولة حتى استرجعت الكثير من هذه الأراضي بسبب عدم استثمارها.
ظلّت حصيلة جهود النهوض بالقطاع الفلاحي متواضعةً، في ظلّ محاولات الخصخصة وغياب التخطيط والمتابعة، كما يشهد القطاع تزايداً في رفع التصنيف الزراعي عن المساحات الزراعية استجابةً للطلب العقاري، وهو ما يثير القلق بحسب الكاتب، لا سيّما في ضوء ضآلة المساحات التي يمكن استغلالها في الجزائر.
للقراءة، من هنا