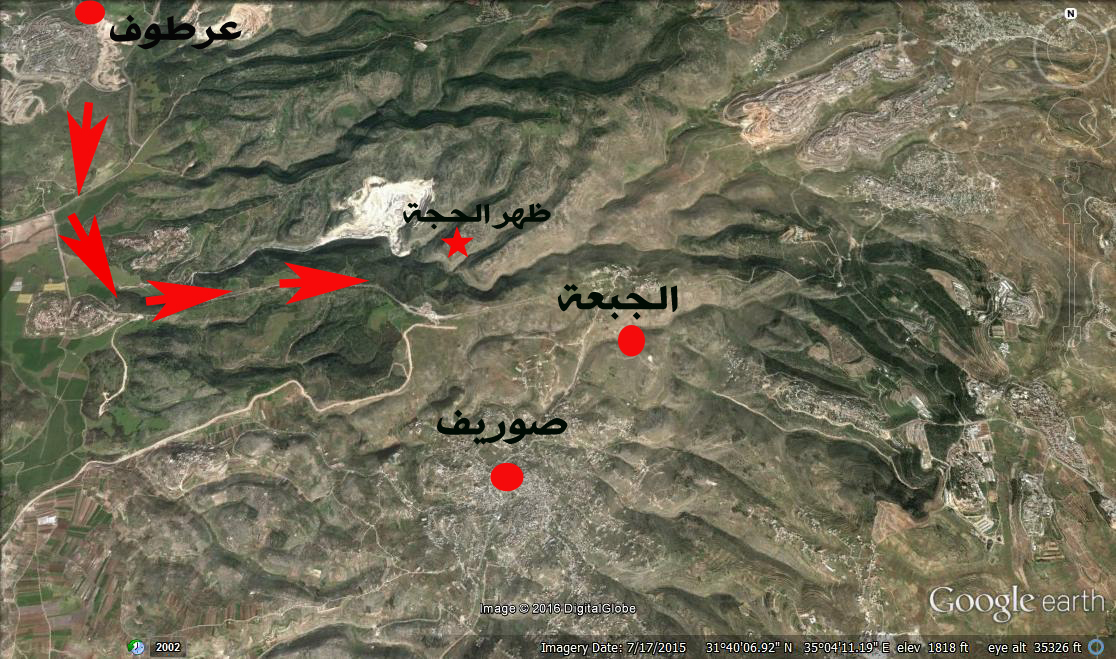«علينا أن ندخل رأس السنوار» هو شعار المرحلة في وسائل الإعلام الصهيونيّة، الّتي ما زالت تبثّ استنكارًا صارخًا في كيانهم، بعدما نفّذ فيهم يحيى السنوار، رئيس «حركة المقاومة الإسلاميّة» في غزّة، أكبر خدعة استخباراتيّة عسكريّة في تاريخهم. باغتهم السنوار في معركة سُمِّيَتْ «طوفان الأقصى»، لكنّ عنوانها الحقيقيّ هو الأسرى، الّذين ظلّ السنوار وفيًّا لهم، وهو نفسه أسير محرَّر في صفقة «وفاء الأحرار».
قضى السنوار ثلاثة وعشرين عامًا من حياته في السجون، منها أربعة أعوام في العزل الانفراديّ، ولم يضيّع أيّ وقت. تعلّم العبريّة وكلّ شيء يمكنه تعلّمه عن عدوّه، بل وضع ونفّذ من هناك خطّة استخباراتيّة طويلة الأمد، وبعيدة المنال آنذاك. درس السنوار وفكّر كثيرًا، وكتب أيضًا. وأعتقد أنّنا أيضًا – في تعبير أقلّ انتهاكًا – علينا أن نتعرّف إلى فكر السنوار؛ فالأسهل من دخول رأسه هو الاطّلاع على كتاباته الّتي أنجزها بعد سنوات من العزلة والتأمّل والدراسة.
عام 2004، بعد عمليّة معقّدة استمرّت زمنًا، وتطلّبت مجهودًا وتجنيدًا للعديد من الأسرى، أخرج الأسير آنذاك يحيى السنوار من السجون روايته «الشوك والقرنفل»، أو «أشواك القرنفل» كما أرادها الكاتب. تتناول الرواية خيطًا من خيوط قصّة النضال الفلسطينيّ، في الحقبة التاريخيّة من 1967 حتّى «انتفاضة الأقصى»، وهو نشأة التيّار الإسلاميّ في المقاومة الفلسطينيّة، و«حركة المقاومة الإسلاميّة – حماس» على وجه التحديد، على خلفيّتها الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة. تحكي الرواية قصّة تبدأ في بيت من بيوت المخيّم في غزّة، الّذي سيشكّل قيم هؤلاء الأطفال واختياراتهم، الّذين سيكبرون ليصبحوا فيما بعد شخصيّات فاعلة ورئيسيّة في «حركة المقاومة الإسلاميّة». ثمّ تتوسّع القصّة من هناك؛ لتشمل الأقارب والجيران وأهل المخيّم والقطاع والضفّة، وباقي أرجاء الأرض المحتلّة، حيث تشكّل كلّ شخصيّة منها حجرًا يبني تجربة «حركة المقاومة الإسلاميّة» في تلك السنوات.
الرواية التاريخيّة – وعاءً للفلسفة
هي رواية شخصيّاتها خياليّة لكن كلّ أحداثها حقيقيّة؛ أي أنّ الجزء الخياليّ فيها يأتي نتيجة تحويل تلك الأحداث إلى عملٍ يستوفي شروط الرواية، كما ينوّه الكاتب في المقدّمة. إنّ اختيار الكاتب، وهو شخصيّة سياسيّة وعسكريّة بالدرجة الأولى، تسجيل هذه المرحلة المفصليّة في تاريخ المقاومة المسلّحة ونقلها في هذا الشكل الإبداعيّ – الروائيّ، يشير إلى أنّها محاولة تتعدّى مجرّد تلاوة التاريخ ووقائعه. الرواية التاريخيّة ليست مجرّد انعكاس لأحداث الماضي؛ بل هي استكشاف عميق للقوى الفلسفيّة والأخلاقيّة الّتي تشكّل الحركات التاريخيّة. الشخصيّات في الروايات التاريخيّة تجسّد وتخوض صراعات فلسفيّة في سياق عصرها[1]. بكلمات أخرى؛ تشكّل الرواية التاريخيّة وسيلة لفهم العلاقة المعقّدة بين المعتقدات الشخصيّة والامتداد الأوسع للتاريخ. أمّا الكاتب فهو من الشخصيّات الرياديّة في «حماس» الّذين عاصروا نشأتها وساهموا في تشكيلها وتطوّرها منذ الشباب حتّى اليوم؛ فخروجه عن محدّدات التأريخ إلى معالجة صراعات دراميّة مبتكرة في التاريخ يتيح له استكشاف أبعاده الفلسفيّة؛ أيّ تأثير المعتقدات على التاريخ، وفي سياق تاريخ نشأة «حماس»، يتيح له صياغة فلسفة لـ «حركة المقاومة الإسلاميّة».
تُرْوى القصّة على لسان أحمد، ابن المخيّم الّذي يفتح عينيه على الدنيا ليشهد منها أوّلًا قسوتها؛ المخيّم والحرب واختفاء والده المقاوم على إثرها دون أثر. يراقب أحمد بيئة المخيّم وظروفه المعيشيّة، ويشهد الفقر والبرد والمطر الّذي يباغتهم من السقف وهم نيام، والّذي يلاحقهم إلى صفّهم في مدرسة الوكالة. يراقب مجتمع المخيّم وثقافته، فيشهد حرص أمّه على أعراض الناس وحزمها معهم في هذا الأمر. في المقابل، يشهد البهجة في رفقة جدّه إلى الصلاة والحلقات الاجتماعيّة في مسجد المخيّم.
يراقب أحمد التحوّلات السياسيّة في المخيّم، وفي قطاع غزّة، وفي الضفّة الغربيّة، وفي سائر الأرض المحتلّة؛ فيشهد منع التجوّل والحصار وملاحقة المقاومين والعقاب الجماعيّ، ويشهد التطبيع والاستقرار المادّيّ وتصاريح العمل، والرحلات الترفيهيّة إلى داخل الأراضي المحتلّة الّتي تَجْلِبُ وتُسْقِطُ المزيد من العملاء. يراقب السجون الّتي تخرّج منها وإخوته وأقرباءه ومعارفه، فيشهد قدرة التصميم والتنظيم على تغيير الواقع. والأهمّ، يراقب السلاح والنضال وتحوّلاتهما بالتفاعل مع كلّ هذه الظروف؛ فيشهد رجالًا صنعتهم المقاومة وصنعوها. ويتتبّع أحمد نشوء حركة «حماس» عبر تتبّع الشخصيّات الّتي كوّنتها وطوّرتها وجسّدتها، ملخَّصة في ابن عمّه إبراهيم، ابن الشهيد الّذي تربّى معه في نفس البيت مع نفس الأمّ، وكبر ليصبح نموذج القائد الحقيقيّ، وصانع المصير السياسيّ.
يؤدّي الراوي دور المراقب المتورّط؛ فهو لا يراقب فحسب بل يلازم إبراهيم في عمله ودراسته ورحلته النضاليّة. ورغم مشاركته له في الاعتصام والرباط العلميّ وعمله الأمنيّ في ملاحقة العملاء، إلّا أنّ الراوي ينفي حتّى النهاية انتماءه أو انضمامه إلى الحركة بشكل رسميّ: «ورغم أنّني لم أعتبر نفسي «كتلة إسلاميّة»، أو نصيرًا لها، لم يكن أمامي خيار غير انتخاب ابن عمّي وقائمته، حيث إنّ ما بيننا من الحياة المشتركة وإعجابي الشخصيّ به ما لم يكن يسمح لي بأن أخالف ذلك».
تنطوي هذه المسافة الفكريّة الّتي يتّخذها الراوي على شيء ما؛ فهو يشير إلى بعده عن الحركة بنفي الانتماء إليها، لكنّه في المقابل يشير إلى قربه من إبراهيم، أحد أعلام الحركة ومشكّليها؛ فينظر الراوي إلى إبراهيم وإلى كلّ ما يمثّله بعين الإعجاب، وكثيرًا ما يصفه بالسموّ والعظمة؛ فتجعل هذه الفجوة ما بين إبراهيم والحركة الّتي يمثّلها، من إبراهيم شخصيّة تتجاوز الحركة في عظمتها. ورغم أنّ إبراهيم لا يشتبك مع قوّات الاحتلال مباشرة ولا يستشهد إلّا في نهاية الكتاب، إلّا أنّه يعرف مصيره منذ البداية، ويسعى إليه، ولا يثنيه عن ذلك حتّى زوجته وأطفاله؛ فربّما يدلّ إبراهيم على حالة يطمح الراوي أن تنتجها هذه الحركة في المجتمع، أو نموذج الفرد الفلسطينيّ الّذي يطمح الكاتب إلى أن تنتجه «حماس»، والّذي سيحقّق أهدافها المتمثّلة في صنع المصير، وتحقيق الكيان السياسيّ للفلسطينيّين.
العصاميّة
يرتبط سموّ إبراهيم عند الراوي بمفهوم ’العصاميّة‘، الّتي ترد في موضعين. في المرّة الأولى يشير الراوي إلى أنّ عصاميّة إبراهيم حقّقت له نوعًا من السيادة على نفسه، ومعنًى لوجوده. «بل إنّه أصبح الآن بنّاء محترفًا؛ إذ تعلّم المهنة من صديقه، وأصبحا شريكين يشغّلان معهما أحد العمّال مساعدًا، وصارا يأخذان مقاولات متوسّطة في البناء وأشغاله، وبات واضحًا أنّ عصاميّة إبراهيم تصنع منه رجلًا».
وتعود العصاميّة بمفهومها اللغويّ على مَنْ «ساد بشرف نفسه لا بشرف سلفه وأجداده»[2]، وقد تداول الناس المصطلح ليعبّروا به عن كلّ «كادح، ساعٍ في سبيل تنمية ذاته بذاته»[3]؛ فيمكن اعتبار العصاميّة فلسفيًّا ممارسة وجوديّة، حيث يجد الفرد معنى وجوده وحياته في التزام مبادئ ثابتة مثل المسؤوليّة الشخصيّة والاستقلال الذاتيّ والحرّيّة الفكريّة، الّتي سترتقي به وتنمّيه في سبيل سيادة نفسه وتشكيل مصيره الّذي يريده.
في المرّة الثانية، يرتبط الإنسان العصاميّ بالقائد الحقيقيّ؛ أي تكون العصاميّة أساسًا للقائد السياسيّ القادر على مجابهة ظرف الاحتلال. «في كلّ يوم، كان إبراهيم يزداد في نظري سموًّا واحترامًا؛ فهو الّذي تربّى يتيمًا من أبيه الّذي استشهد وهو في الرابعة من عمره، ثمّ تركته أمّه وهو لا يزال صغيرًا، وتربّى بيننا، وقد أصبح رجلًا عصاميًّا، وقائدًا حقيقيًّا رغم صغر سنّه وصعوبة الظروف تحت الاحتلال».
عندما تلتحم عصاميّة إبراهيم ببُعدها السياسيّ تجعل منه قائدًا؛ أي قادرًا على تنمية، لا نفسه فقط، بل مجتمعه وشعبه أيضًا، والارتقاء بظرفهم الجماعيّ؛ أي حملهم على تجاوز الظرف السياسيّ الصعب نحو الحرّيّة؛ فيجسّد إبراهيم للراوي نموذج هذا الإنسان المتسامي، الّذي يتسامى ويرتقي بأن يجعل معنى وجوده في التزام دوره السياسيّ للارتقاء بشعبه؛ أي يتسامى بممارسة سياسيّة مبنيّة فلسفيًّا على العصاميّة.
الإنسان الأعلى والإنسان العصاميّ
في الفلسفة الوجوديّة يطرح نيتشه فكرة ’الإنسان الأعلى‘[4]؛ أي الفرد الّذي تسامى وارتقى حتّى حقّق الحرّيّة الحقيقيّة المتمثّلة في تشكيل مصيره بنفسه. إنّ الفرد المتسامي عند نيتشه، هو الّذي يختار أهدافه وينتقي قيمه ومبادئه، دون الخضوع لأيّ ضغوطات مجتمعيّة خارجة عن إرادته. هي فكرة تدعو الإنسان إلى احتضان ما يسمّيه ’إرادة القوّة‘[5]، وهو دافع داخليّ لدى الإنسان للتحرّر وسيادة نفسه؛ فيشكّل الإنسان الأعلى بذلك نموذجًا فكريًّا للإنسان الّذي يتغلّب على القيم والمقاييس المجتمعيّة الّتي تعيقه، ويصنع قيمه الخاصّة. في المقابل، الإنسان المتسامي عند السنوار هو العصاميّ المسيّس؛ أي الإنسان الّذي يختار أهدافه بما يساهم في تحرّره السياسيّ. لذا؛ فهو ينخرط في تشكيل هويّته وتحديد قيمه ضمن النسيج الاجتماعيّ والسياسيّ الّذي يؤويه. وهذه العمليّة ليست مجرّد مسعًى شخصيّ للحرّيّة، بل هي عمل سياسيّ ينطوي على التحدّي والمساهمة في تشكيل الهويّة الجمعيّة بما يخدم حرّيّة المجتمع كاملًا.
الإنسان المتسامي سياسيًّا بالفلسفة العصاميّة هو نموذج للإنسان العمليّ، الّذي يتعامل مع القيم المجتمعيّة الموروثة؛ الاجتماعيّة والأخلاقيّة والدينيّة، بوصفها موردًا لتعزيز دافع التحرّر عند مجتمعه، وتحقيق الارتقاء السياسيّ، فهو يدرك أنّ المعركة مع الاحتلال هي معركة وجوديّة، وحرب على إرادة القوّة الفلسطينيّة؛ أي حرب على دافعهم لسيادة أنفسهم سياسيًّا. في هذا السياق، تصبح العصاميّة فلسفة تتجاوز تقرير المصير الفرديّ، وتصبح أداة للتأثير في الخطاب السياسيّ وتشكيله؛ فالإنسان الكادح المتمسّك بتحقيق هدفه التحرّريّ سيسخّر كلّ جهود غيره لذلك ما استطاع. أمّا «حركة المقاومة الإسلاميّة»، فتسعى من خلال القيم الإسلاميّة إلى إنتاج هذا الإنسان المتسامي، أو هذه الحالة في الفرد الفلسطينيّ؛ فكيف تساهم هذه القيم في ذلك؟
«الدار أصبحت مليئة بالرجال والنساء، والأولاد والبنات من نفس العائلة، وتذكّرت حينذاك صورتنا ونحن أطفال، تضمّنا غرفة واحدة صغيرة وتزيد علينا. وإذا بعائلتنا الصغيرة خلال سنوات أصبحت مثل جيش… ذكرت ذلك مازحًا؛ فصرخت أمّي: صلّ على النبيّ، فنطق الجميع: اللهمّ، صلّ على سيّدنا محمّد».
الإسلام والعصاميّة: الجدّيّة في المسعى
تبدأ الرواية في شتاء 1967 قُبَيل النكسة، عندما كانت غزّة تحت الإدارة المصريّة، فيروي أحمد، ابن الخامسة آنذاك، واحدة من أولى ذكرياته، وهي علاقته بالجنود المصريّين الّذين يتردّد عليهم، فيداعبونه ويعطونه وأصدقاءه الحلوى الفستقيّة، ثمّ تأتي الحرب فيصرخ عليهم الجنود ليعودوا أدراجهم ولا يحصلون على الحلوى.
«كانت قوّات الاحتلال قد واجهت مقاومة عنيفة في إحدى المناطق فانسحبت، وبعد وقت قليل أطلّت مجموعة من الدبّابات وسيّارات الجيب العسكريّ، ترفرف عليها الأعلام المصريّة، فاستبشر المقاومون خيرًا بقدوم العون، فخرجوا من مكانهم وخنادقهم يطلقون النار في الهواء احتفالًا بالمقاومين، وتجمّعوا للاستقبال، وحين اقترب الركب فُتِحت منه نيران كثيفة على المقاومين أردتهم قتلى، ثمّ رُفِع العلم الصهيوني على تلك الدبّابات والآليّات، بدلًا من الأعلام المصريّة».
في هذه المشهديّة إشارة إلى نقطة تحوّل أيديولوجيّة وانطلاقها في النضال الفلسطينيّ، وهي إدراك فشل القوميّة العربيّة، أو قصورها تيّارًا سياسيًّا في خلق الجدّيّة المطلوبة لدى الفرد تجاه المسعى الوطنيّ الفلسطينيّ، خاصّة أمام شراهة الاحتلال الآخذة في التصاعد.
بينما تنطوي فلسفة العصاميّة على شرط للارتقاء، وهو الجدّيّة والالتزام بالمسعى، «العصاميّون ينظرون إلى أهدافهم نظرة احترام وإيمان، ويأخذون أمر تحقيقها بجدّيّة تامّة لا مساومة فيها، إنّهم بكلّ بساطة ملتزمون بما يجب عليهم في سبيل ذلك»[6]. هنا، يحقّق «الربط العجيب بين الدين والوطنيّة» متبلورًا في فريضة الجهاد هذه الجدّيّة وذلك بإضفاء القداسة على المسعى الوطنيّ؛ بحيث يزرع هذا في الفرد الجدّيّة الصارمة اللازمة لتحقيقه؛ كما يأتي على لسان الراوي: «حتّى تأخذ المعركة بُعدها الحقيقيّ، وتكون بالمستوى المطلوب».
فعندما يبحث العصاميّ المسيّس حوله، يجد المنظومة الإسلاميّة من أواخر المنظومات الاجتماعيّة الّتي صمدت في الفلسطينيّين أمام الإبادة المجتمعيّة الّتي يمارسها الاحتلال عليهم. ويجد في ارتباط الممارسة السياسيّة بالإيمان، ونقل مرجعيّة معنى وجود الفلسطينيّ وهدفه إلى الله، مبدأ لا يستطيع العدوّ تفتيته. ويجد العصاميّ في آثار الإسلام صروحًا سياسيّة ثابتة في وجه صهر الوعي وحرف البوصلة. لذلك؛ نجد إبراهيم الّذي يسمّي المعركة «معركة حضارة وتاريخ ووجود»، ينظّم للشباب رحلة لتعرّف البلاد المغيّبة ومقدّساتها والمواقع الإسلاميّة التاريخيّة فيها، وأوّلها المسجد الأقصى، ففي تلك المواقع تجسيد لازدهار ثقافة الفلسطينيّين، وسيادة أنفسهم، وتشكيل بلادهم-مصيرهم.
تقف هنا عمارة المسجد الأقصى وقبّة الصخرة الهائلة في تناقض صارخ مع عمارة المخيّم الّذي يجسّد للفلسطينيّين حالة الانحصار. لذلك؛ تُعْنى «حماس» بالمسجد الأقصى بشكل خاصّ؛ فهو يكثّف هذه المعاني التاريخيّة المقدّسة الّتي تخلّد قضيّة فلسطين مثل الإسراء والمعراج؛ أي أنّه يشكّل نقطة وصل أرض فلسطين بالسماء. وربّما، من هنا تأتي تسمية معركة عنوانها الأسرى بـ «طوفان الأقصى»؛ سعيًا منهم إلى تعظيم قضيّة الأسرى، والتنويه إلى أنّ حرّيّة الفلسطينيّ ما هي إلّا المعنى الّذي خلقه ربّه من أجله. وعلى الرغم من أنّ الإسلام يربط النضال بالله وبمعنى وجود الإنسان، إلّا أنّ هذا الربط يتعدّى مجرّد إعطاء النضال معاني عظيمة مثل الآخرة والثواب من الله، فكيف تنعكس هذه المعاني عمليًّا على الأفراد في ممارسة حياة جوهرها السياسة؟
الزهد
تُعْنى الرواية بالتنويه بشكل خاصّ لمرحلة التربية والإعداد في تاريخ نشأة «حماس»؛ فيمرّ ذات يوم شيخ اسمه أحمد على شباب المخيّم ومراهقيه، الّذين يتسكّعون في الشوارع ويقضون وقتهم في اللعب، فيحذّرهم من اللهو غير المفيد، ويحثّهم على الصلاة والتعبّد والتأمّل عوضًا عن ذلك، «رابطًا كلّ ذلك بمستقبل الإسلام الّذي يجب أن تعلو رايته في أرض فلسطين». ثمّ يقضي الشيخ معهم عقودًا يربّيهم فيها على القيم الإسلاميّة، الّتي تحثّ على الزهد والترفّع عن الدنيا والنفس لصالح الآخرة، ليُنشئ فيهم جيلًا «قادرًا على التضحية والفداء».
لعلّ أطروحة الرواية عن الحبّ، الّذي يمثّل أعنف الروابط بالذات والدنيا بمفاهيم إسلاميّة، تستعرض كيف يعزّز هذا الزهد معنى الوجود في الممارسة السياسيّة. يقول الراوي: «كان يغمرني بشعور من الراحة… هل هذا هو الحبّ؟ (…) اكتفيت فيما بعد بترقّب خروجها إلى الجامعة لأراها من بعيد؛ غير طامح في أكثر من ذلك، ولا حتّى في النظرة فيكفيني أنّني أحببت، ويكفي أنّها فهمت ذلك جيّدًا». فيكتفي أحمد بمعرفة الحبّ في دنياه، ويؤجّل حصوله عليه إلى حينه، إن أصبح قادرًا على خطبتها كما «تربّى منذ طفولته»، بل لا يشعر بضرورة الحبّ لمجرّد أنّه الحبّ الّذي لطالما سمع عنه.
ثمّ يأتي إبراهيم ليوضّح لأحمد أنّه عرف الحبّ أيضًا، ولأنّه يعتبر نفسه جزءًا من الهمّ الوطنيّ فقد قرّر ألّا يسعى إليه؛ لأنّه «يتحوّل إلى سوط يكوي به الاحتلال ظهور المتحابّين. يا أحمد، حين تستخدم هذه العلاقة الشريفة المقدّسة بيد العملاء ورقة ضغط على العشّاق؛ لإجبارهم على ترك معشوقتهم الأولى القدس، هل يظلّ في حياتنا متّسع للحبّ والعشق؟». يوضّح إبراهيم كيف ينعكس الزهد الممنهج في الفلسفة الإسلاميّة، على الحياة السياسيّة؛ فهي تربية تتيح للفرد في أيّ وقت الإعراض عن أهوائه إن تعارضت أو خاطرت بمسعاه الوطنيّ. هي تُنشئ الفرد بحيث يكون المسعى الوطنيّ مركز المعنى في حياته، وأوّل رغباته، وأساسًا يبني عليه مناحي حياته الأخرى.
عقب نقاشهما عن الحبّ، يكتشف إبراهيم أنّ أعزّ أصدقائه، وشريكه في قيادة الحركة طلّابيًّا، فايز، هو عميل للاحتلال؛ فيقول إبراهيم ملخّصًا: «هل يجوز لمثلنا ونحن نعيش هذه الحياة، ونرى ما نرى، أن نحبّ ونعشق يا أحمد؟ قصّتنا قصّة فلسطينيّة مريرة، لا مكان فيها لأكثر من حبّ واحد وعشق واحد». يعتبر إبراهيم حياة الفلسطينيّ مريرة، أيّ منحًى منها تحت رحمة الاحتلال هو قابل للزوال في أيّ لحظة، ويعتبر كلّ المعاني والقيم غير القائمة على الحرّيّة السياسيّة زائفة؛ فلا تعني شيئًا إذا ما قرّر الاحتلال استغلالها، حتّى أوفى علاقات الصداقة لا يمكن للإنسان التعويل عليها. ولربّما حفّزت معركة «طوفان الأقصى» مثل هذه الاستنتاجات عند بعض الأفراد المنخرطين في المجتمع «الإسرائيليّ»، الّذين خانتهم معاني التعايش والمواطنة والقانون عندما عبّروا بأدنى حدّ، ليس عن مبادئهم الإنسانيّة تجاه أطفال غزّة، بل عن هويّتهم الدينيّة، أو عند الّذين خسروا في مصالحهم وأرزاقهم بسبب تعلّقها بكيان العدوّ، وعند الّذين اضطرّوا إلى الخنوع أمام لقمة العيش وبطاقة المواطنة.
تشخّص الرواية وتتطرّق في غير صيغة لنقطة ضعف جوهريّة تعرقل فدائيّة الفرد، وهي إغراء الخلاص الفرديّ والاستقرار. وتوضّح أنّ مثل هذه الرغبات والميول الفرديّة هو محلّ استثمار سياسيّ وعسكريّ للاحتلال؛ فتطرح الرواية مشكلة العملاء بصفتها نتاجًا لمثل هذا الانجراف، وتكثيفًا لذلك الصراع. يتطرّق الراوي لظاهرة تصاريح العبور من غزّة إلى داخل «إسرائيل»، الّتي تبدأ من حاجة إلى الرزق وسدّ رمق الأطفال من خلال تصاريح العمل، فتربط حياة الإنسان وكفافه باستقرار الاحتلال، ثمّ تصبح التصاريح منفذًا للإفلات من تعاسة الحصار وتذوّق الحياة، فتبدأ المكاتب بإعلان تصاريح لرحلات ترفيهيّة.
«ثمّ تجد أحد المكاتب، التابعة لأحد العملاء المشهورين، يعلن التسجيل لرحلة سياحيّة إلى داخل الخطّ الأخضر لبعض المناطق السياحيّة… حيث تجري أثناء الرحلة… محاولات توريط الشبّان في مشاهد وحالات يجري تصويرها، وبذلك يكون تهديدهم بالفضيحة إن لم يتعاونوا».
رغم هذا، يوقن الراوي أنّ هناك فجوة كبيرة بين «الواقع المرير ومستلزماته وضروراته، وبين سقف الطموحات الوطنيّة»، لكنّه يرى أنّها تفرض التضحية الفرديّة جزءًا من انتماء الفرد واستثماره السياسيّ في ارتقائه وارتقاء مجتمعه، ويجب أن يُنشأ الفرد على الاستعداد لتقديمها.
«وتجد أحد هؤلاء العمّال يحاول الإقناع وهو يمتنع عن تسليمهم التصريح، مشيرًا إلى أولاده وبناته الثمانية من خلفه، لا يجدون ما يسدّ رمقهم، وما تصرفه «وكالة الغوث» لا يكفي شيئًا، وهم كثيرًا ما يبقون جياعًا… فيرفض هؤلاء الفدائيّون، ويصرّون على أخذ التصريح وعيونهم تترقرق فيها الدموع… وقد مزّقوا تصريح الرجل وهم يشعرون بالحرج».
التضحية والفداء
يدرك إبراهيم مبكّرًا أنّه بحاجة إلى المال ليكمل دراسته ويمضي في حياته؛ فيتعلّم البناء بمرافقة صديق له يحترفه، ثمّ يصبح إبراهيم نفسه محترفًا ومقاولًا يتسلّم المشاريع. عندما يتخرّج إبراهيم من المدرسة، يرفض السفر خارج البلاد للدراسة، بل يرفض السفر خارج القطاع حتّى إلى «جامعة بير زيت» في الضفّة الغربيّة، ويؤثر الدراسة في «الجامعة الإسلاميّة» في غزّة الّتي لم تمتلك آنذاك حتّى مبنًى خاصًّا بها. تستنكر زوجة عمّه قراره هذا لأنّ «الجامعة الإسلاميّة» بالكاد تصلح لأن تُعْتبَر مؤسّسة تعليميّة، وتحثّه على السفر للدراسة خارجًا على غرار أبنائها أولاد عمّه. لكنّ إبراهيم يختار «الجامعة الإسلاميّة» لأنّها بالكاد تكلّف نصف ما قد تكلّفه الدراسة في «جامعة بير زيت»؛ فكم حريّ الدراسة في مصر. ورغم محاصرة الاحتلال للجامعة ومنعه البناء فيها، «لم يكن بإمكانه الوقوف أمام إرادة شعب للعلم والتعليم»؛ فإبراهيم وخلفه أحمد وغيرهما، يرابطون للدراسة في «الجامعة الإسلاميّة» في خيام وعرائش سعف النخيل. «وإذ بإبراهيم يتحوّل من طالب وناشط إلى مقاول؛ إذ انهال هو وعدد من الطلّاب المحترمين والمئات منّا يساعدونهم في بناء قاعات دراسيّة… هكذا فرض الأمر الواقع على الاحتلال».
يختار إبراهيم استثمار ماله في الجامعة المحلّيّة في بلدته، ويدّخر ماله لشراء سيّارة يستعملها في نشاطه السياسيّ والنضاليّ؛ بل يستثمر جهده وطاقته في بناء الجامعة وتشييدها حتّى تصبح جامعة حقيقيّة بالمستوى المطلوب. يضحّي إبراهيم بخلاصه وارتقائه الفرديّ لصالح عائلته ومجتمعه، فعندما يترفّع الفرد عن نفسه ويسيّس طموحاته، يصبح معنى وجوده بالضرورة مقرونًا بالخلاص الجماعيّ. هذا يجعل الفرد منخرطًا بالنهوض بالظرف الجماعيّ المثقل بالتضييقات؛ ممّا يعني بذله كلّ الجهد اللازم من أجل ذلك، والتعامل بحرفيّة عالية مع الواقع حوله، بما يتضمّنه من مهمّات كبيرة مثل تكوين الأنظمة وإنشاء البنى التحتيّة الّتي تلزمه لهدفه.
في النهاية، يكون إبراهيم قد بنى المؤسّسة التعليميّة، الّتي ستعلّم كلّ الّذين قد يُحْرَمون من العلم لأنّهم لا يملكون مصاريف السفر والجامعات الأخرى، وينقذ أجيالًا من فخّ الجهل والتسيّب وغالبًا العمالة؛ بل يكون قد تحدّى الاحتلال، واستثمر ماله وجهده في إنشاء مؤسّسة ستُنشئ أجيالًا على قيم ومبادئ «حركة المقاومة الإسلاميّة»، وتشكّل بؤرة للنشاط والعمل السياسيّ التحرّريّ. توضّح الرواية كيف تصنع التربية على التضحية الفرديّة، فردًا عصاميًّا في ممارسته السياسيّة، يبذل أيّ جهد يلزمه لتحقيق مسعاه الوطنيّ. العصاميّة كأساس ومبدأ تعزّزه هذه القيم الإسلاميّة في علاقة الفرد الفلسطينيّ بتحرّره، تجعله فردًا يحترف بناء الكيان السياسيّ وإنشاءه.
المقاومة: حرفة الارتقاء السياسيّ
لدى إبراهيم أخ كبير اسمه حسن، وحسن اختار الخلاص الفرديّ مبكّرًا في شبابه؛ فلجأ إلى «تلّ أبيب» ليعيش تحت رحمة فتاة «إسرائيليّة» ومصنع أبيها، حتّى انهارت تجارة والدها وطردته من شقّتها؛ فاضطرّ إلى العودة إلى غزّة والمخيّم. لكنّه، وكونه ميّالًا إلى خلاصه وحده، ينتهي به الأمر عميلًا ومفسدًا في مجتمعه. يجلب هذا إلى العائلة السمعة السيّئة، ويجلب إلى البلد والقضيّة الخراب والإسقاط والتدهور السياسيّ، ويُقلق حياة إبراهيم. يتفاجأ أحمد ذات يوم بتقريرٍ استخباراتيّ محكم بين أوراق إبراهيم عن أخيه حسن، فيقول أحمد «التقرير ليس شغل أولاد أو أصحاب، هذا شغل ناس تعرف ما تفعل»، فيدلّه التقرير على وجود جهاز استخباراتيّ فلسطينيّ متطوّر بناه المقاومون، ومنهم إبراهيم؛ فعلاقة إبراهيم المباشرة بمشكلة أخيه حسن، تحفّزه لإنشاء نظامٍ أمنيّ كامل للتعرّف على العملاء، وطرق عملهم، ومجابهتهم حتّى دون أن ينتبه العدوّ لوجود مثل هذا النظام لديهم. وفي نهاية الأمر، يقتل إبراهيم حسنًا، لكنّه بفضل معرفته هذه، يفعلها دون أن يثبت على نفسه شيئًا.
توضّح الرواية أنّ احتراف الفرد بناء الكيان السياسيّ يتطلّب انغماسه في معرفة عميقة وشاملة بالواقع بكلّ معطياته، بما فيها المعرفة اللازمة لصون الاستمرار والحماية والضمان لممارسته السياسيّة وعمليّة التحرّر؛ أي المقاومة. كما تتطرّق لوجود مفاهيم أساسيّة في هذا السياق مثل (العصافير)، وهم الجواسيس الّذين يزرعهم الاحتلال بين السجناء ليجترّوا الاعترافات من المعتقلين؛ فلولا اطلاع أحمد على هذا المصطلح، لوقع في فخّه، وثبّت على نفسه السجن، وأثبت على إبراهيم تهمة قتل حسن أمام السلطات، ولَكشَف تنظيمهم لاصطياد العملاء؛ أيّ كان سيعرقل مسيرة إبراهيم النضاليّة، الّتي أنجزت للمجتمع سياسيًّا وطوّرت حركة المقاومة؛ فتكون هذه المعرفة قد ساعدتهم على الانتظام في روايتهم أمام التحقيق، دون أن ينسّقوا ذلك.
لذا؛ تركّز الرواية على التربية الأمنيّة، وتنمية الحسّ الأمنيّ في الفرد الفلسطينيّ،الّذي يُعَرَّف على أنّه الشعور والإحساس المتولّد داخل النفس، والمعتمد على أسباب وعوامل موضعيّة تؤدّي إلى توقّع الحدث قبل وقوعه، بقصد منعه وصدّه إن ضرّ الوطن ومكتسباته [7]. الحسّ الأمنيّ بهذا الطرح يصون الفرد ومجتمعه بأسره، بل يضمن للمجتمع القدرة على الاستمرار في المقاومة والنهوض السياسيّ دون أن يكون فريسة سهلة، ودون أن يعرّض مشروعه التحرّريّ للفشل. به يتجنّب الأفراد غير المتورّطين الخطر دون المخاطرة بغيرهم. هو بمنزلة بوصلة انتظام وتنظيم لا تحتاج إلى التواصل بين الأفراد، وبالتالي تجنّبهم خطر انكشاف هذا التواصل. وهو يمكّن المجتمع من مواصلة النضال ودعمه وتنظيمه بأقلّ العواقب، خاصّة في ظلّ استهداف الاحتلال للتنظيم والنظام بين الفلسطينيّين، ومعاقبتهم عليه بالسجن لأحكام مطوّلة. قد لا يندفع أحمد إلى الجهاد كما يندفع إبراهيم، وربّما هذا إقرار من الكاتب بأنّ الأفراد يتفاوتون في سرعة تطوير هذه القدرة على المواجهة، أو يتفاوتون حتّى في أدوارهم. لكنّ الوعي الأمنيّ في نظره ضرورة ومبدأ وجوديّ لتناغم هذه الأدوار، واكتمال هذا الارتقاء السياسيّ.
لعلّ الرواية في حدّ ذاتها، محاولة لبناء هذا الوعي الأمنيّ عند الفرد الفلسطينيّ، الّذي يشمل معرفة بالعمل المقاوم؛ وظروفه وأساليبه، وتجارب وأخطاء المقاومين، وأساليب العملاء، وسلوكيّاتهم والطرق الّتي يجنّدونهم ويُسقطونهم بها. يتجلّى أثر هذا الفكر في نتيجة مبهرة مع أطفال غزّة، الّذين يُعرضون عن إجابة أيّ سؤال، بل الخوض في أيّ موضوع له علاقة بالأنفاق أو المواقع العسكريّة في أحد برامج الكاميرا الخفيّة. ولعلّ وعيهم الأمنيّ هذا تجسيد لرؤية الكاتب للمجتمع الفلسطينيّ، الّتي يسمّيها إبراهيم «التصعيد والاستمراريّة». وهي كما يوضّح؛ البقاء والاستمرار في الحياة اليوميّة «بصورة لا تتعارض مع الانتفاضة المستمرّة»، بل جعل الانتفاضة «العمود الفقريّ لنمط الحياة الفلسطينيّ» الّذي تتكيّف معه باقي الأنشطة الحياتيّة، ومنها – بشكل طبيعيّ – الإنجاب وتكوين العائلة؛ أي بناء مجتمع يحمل تجربة المقاومة، قادر على تكرارها وتصعيدها لإدراك المزيد من الأهداف السياسيّة؛ حتّى يحقّق الفلسطينيّون السيادة على أنفسهم.
في فلسفته الوجوديّة، يطرح نيشته دعوة للأفراد إلى تشكيل حياتهم على نحو يرضونه، بحيث إذا أُجْبِروا على التكرار الأبديّ لنفس دورة حياتهم، فسيكونون راضين وسعداء بتكرار هذه التجربة الّتي صنعوها؛ لأنّها تحقّق لهم الارتقاء والحرّيّة والسيادة على أنفسهم [8]. بالمثل، فإنّ هذه الفلسفة الوجوديّة الّتي يطرحها السنوار في رؤيته للعمل السياسيّ من خلال «حركة المقاومة الإسلاميّة»، هي بمنزلة إنتاج للأفراد، بحيث يصعّدون بشكل تلقائيّ ظروف المقاومة والتحرّر في أيّ مكان وزمان، كلٌّ من موقعه وحسب قدرته ومهارته. في هذا السياق تسرد الرواية تطوّر ظرف التسلّح والسلاح، وهو أشدّ الظروف وأصعبها، الّذي بدأ بالحجارة ثمّ طوّره الشباب من مختلف الخلفيّات والتخصّصات؛ فتذكر مثلًا كيف كان الطالب يحيى ينقّب بمبادرته في كتاب الكيمياء بحثًا عن معادلة ما؛ ليخترع فيما بعد الحزام الناسف، والسيّارات المفخّخة وما تلاها من أساليب العمليّات الاستشهاديّة. ثمّ تمرّ على تجارب المقاومين عبر الأعوام، الّتي تتراكم حتّى يصبح لـ «كتائب القسّام»، الذراع العسكريّ لحركة «حماس»، بنية صاروخيّة ومدفعيّة قادرة على القصف لمسافاتٍ بعيدة.
يؤمن السنوار أنّ وجود مثل هذه المفاهيم، مثل الزهد والتضحية والفداء والوعي الأمنيّ في بنية الأفراد، يخلق فيهم دافعًا داخليًّا للمقاومة غير متأثّر بالضغوطات الخارجيّة عليهم، أو بكلمات أخرى: إرادة المقاومة. المقاومة عنده، تبدأ من مسؤوليّة كلّ فرد تجاه حرّيّته السياسيّة، وانخراطه في تصوّر مسار تحقيقها والزحف المدروس نحوه، كلٌّ حسب ظروفه وقدراته مهما كانت، وإن بدت تلك صعبة وبعيدة. ولعلّ تجربة السنوار، الّذي أخرج نفسه من حكم مدّته 426 سنة في سجون «إسرائيل»؛ ليقود أكبر ثورة في تاريخها، تطبيق مباشر لفلسفة تعتمد الاحتراف في التخطيط؛ خطط طويلة الأمد لأهداف بعيدة المنال. ثورته الّتي سمّتها وسائل الإعلام «الإسرائيليّة» «أكبر خدعة استخباراتيّة في تاريخ إسرائيل»، بدأت باستثمار السنوار سنين أسره لاحتراف لغة عدوّه واحتراف التلاعب به، على أن يخرج ويخضعه يومًا ما. هذه هي فلسفة العصاميّة في المقاومة الّتي يقترحها، هي قدرة على إنتاج المقاومة حتّى في غيابها. ولعلّ في مقولة الشهيد يحيى عيّاش(1966 – 1996)، الّذي يلقّب بمهندس المقاومة، تلخيصًا بليغًا لكلّ ذلك، فيقول «بإمكانهم اقتلاع جسدي من فلسطين، غير أنّني أريد أن أزرع في الشعب شيئًا لا يستطيعون اقتلاعه».
[1] Lukács, Georg. The Historical Novel. Lincoln: University of Nebraska Press, 1983.
[2] معجم المعاني، ر.ف. “عصاميّة“.
[3] مقراني، خولة. “عصاميّون لا عظاميّون”. الجزيرة. 25-10-2018
[4] Nietzsche, Friedrich. Thus Spoke Zarathustra: A Book for Everyone and No One. Penguin Classics, 1961.
[5] Nietzsche, Friedrich. The Will to Power. Penguin Classics, 2017.
[6] مقراني، خولة. “عصاميّون لا عظاميّون”. الجزيرة. 25-10-2018
[7] د. سعيد، محمود، د. الحرفش، خالد. مفاهيم أمنيّة. (الرياض: إدارة العلاقات العامّة والإعلام، الطبعة الأولى، 1431هـ – 2010م).
[8] Nietzsche, Friedrich. The Gay Science. New York: Vintage, 1974.