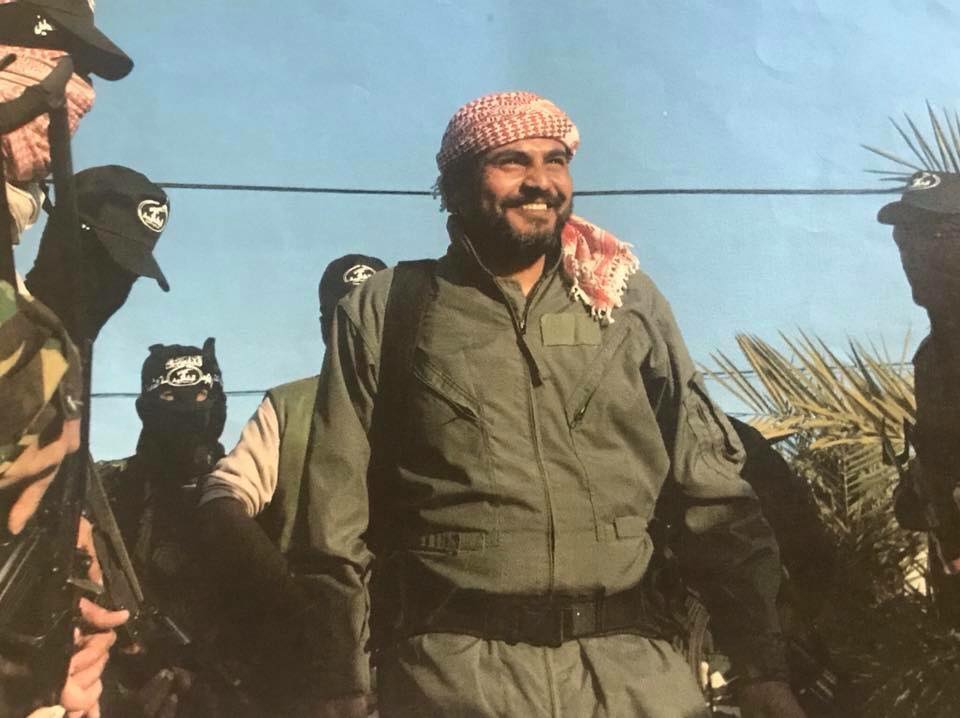في الإضراب عن الطعام، يتكامل “الداخل” و”الخارج” في معركة واحدة، هي المعركة الوحيدة التي يستطيعون فيها الالتحام تحت قيادة أسرى داخل السجون وتتشكّل قيادة واحدة موحّدة يكون التكامل شرط نجاحها، في الوقت الذي يمكن إن تم حصرها في “التضامن” أن تفشل.
كيف يتحوّل خطر موت الفلسطينيّ، أو احتماليّة موته نتيجة الإضراب المستمر عن الطعام إلى خطرٍ على أمن الكيان الاستعماريّ؟ أو بصيغة أخرى، أكثر دقّة، كيف يتحوّل الهدف النهائيّ للمنظومة الاستعماريّة- أي موت الفلسطينيّ، إلى خطرٍ عليها وتهديدٍ لأمنها؟ لماذا يقرّر وزير الأمن الداخليّ في المؤسّسة الصهيونيّة الوصول إلى السجن والتفاوض مع الأسرى لإنهاء الإضراب خوفًا من استشهاد أحدهم، في الوقت الذي يسعى فيه ليلًا ونهارًا لإعدام الفلسطينيّ؟ هذا هو سؤال الإضراب عن الطعام.
ومن هذا السؤال الجوهريّ، يمكن فهم الإضراب ليس كمجرّد امتناع عن تناول الطعام، إنّما كفعلٍ نضاليٍّ. ومن هذا السؤال، تحديدًا، نستطيع الاستدلال على مغزى خوف وزير الحرب الصهيونيّ من استشهاد الأسير، في الوقت الذي يدعو فيه إلى إعدام الأسرى الفلسطينيّين وقوننة الإعدام. فموت الجسد الفلسطينيّ، الرمزيّ والمادّي، لم يكن يومًا هاجس “إسرائيل” وخوفها. بل على العكس، كانت كيفيّة قتله هي هاجس قادتها وصنّاع القرار، والمجتمع الاستيطانيّ ككل. إذًا، ففي الإجابة عن مثل هذا السؤال، هي إجابة عن ماهيّة الإضراب وليس ظاهره، إجابة عن سؤال الموت الفلسطينيّ حين يُصبح مكلفًا للاستعمار. هي إجابة تحمل في طيّاتها فعل الموت الفلسطينيّ حين يغدو صياغة للفكرة ومتناقضًا مع عمليّة صهر الوعيّ، كما يريد له الفلسطينيّ أن يكون.
في البحث عن الإجابة، لا بدّ من استعراض تاريخ الإضرابات عن الطعام، وتحليل أسباب فشل المعركة أو نجاحها. والفشل أو النجاح، في هذه الحالة، ليس إلّا فشلًا في كسر السجّان بمقياس استجابته لمطالب الأسرى، أو نجاحًا في تحقيق هذه المطالب التي مهما كانت بسيطة فهي معركة على الإنحناء، معركة على الإرادة. فمنذ الإضراب الأول عن الطعام في العام 1968 الذي خاضه الأسرى في سجن نابلس- أي بعد عام واحد على احتلال الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، وحتّى العام 2017 لا تزال المعركة تُقاس بأمر واحد فقط لا غير: الاستجابة أو الفشل.
ومن هذا المنطق، لا يمكن النظر إلى الإضراب إلّا بكونه معركة تُحسم إمّا بالانتصار، أو الهزيمة. ومن مبدأ المعركة والحرب- أي النقطة على الطريق، يمكن فهم التراكميّة في الإضراب بوصف الإنجاز ليس مضمونًا، وبوصف النصر ليس نهائيًا ما دام السجن موجودًا.
ومن هذا المنطق أيضًا، أي منطق استمراريّة وتراكميّة وحتميّة الإضراب، المشتقّة من منظومة الأسر والسجن ذاته، كفعل المقاومة المشتق من وجود الاستعمار ذاته، لا يمكن فهم الإضراب إلّا بوصفه معركة فلسطينيّة متكاملة لا تختلف عن غيرها من المعارك إلّا بكون الأسير، هو المبادر، وبكون السجن هو مصدّر ومركز الفعل النضاليّ، في الوقت الذي يكون فيه “الخارج” متلقّيًا لمركزيّة القرار داخل الأسر.
التاريخ بوصفه تاريخ المعارك
لا يمكن النظر إلى تاريخ الثورة الفلسطينيّة عمومًا، وتاريخ الحركة الفلسطينيّة الأسيرة خاصّةً، إلّا بوصفه تاريخ الاشتباك مع المُستعمِر. وفي بحث ونبش تاريخ المعارك والاشتباك، يحتلُّ الاشتباك الجماعيّ القسط الأكبر من عمليّة التأريخ أو القراءة التاريخيّة بشكل عام، وذلك يعود إلى التأثير الأكبر للفعل الجماعيّ، وإسقاطاته على شريحة أوسع وأكبر من الفاعلين والمتلقّين.
وفي وصف تاريخ الحركة الأسيرة، يشكّل الإضراب لحظة ذروة الاشتباك مع السجّان. فالقرطاسيّة، أي الأداة التي تتم فيها عمليّة كتابة الرسالة من الأسر إلى الأم والأب، الابن والابنة، الزوج والزوجة والعائلة والبلدة والأصدقاء، لم تكن موجودة في الأسر. والصورة، أي المرآة الوحيدة التي تخرج من بين القضبان ليرى الأخ، الأخت والصديق والصديقة الأسير يكبر وينضج ويتغيّر شكله مع مرور سنوات الأسر، لم يكن مسموحًا إخراجها من وراء القضبان. والفرشات، التي ينام عليها الأسرى، في سجن نفحة الصحراويّ لم تكن أيضًا كما هي عليه اليوم في الأسر. وباختصار، إن جميع ما ينظر إليه الأسير في محيط غرفته الصغيرة، وجميع ما يتواصل فيه مع المحيط خارج جدران الأسر: هو نتاج معارك تراكميّة من الإضرابات المتتاليّة عن الطعام. فتشكّلت غرفة الأسير، محيطه، أدوات الطعام والرسالة والصورة، النوم والغطاء وقيادته السياسيّة، بأمعاء لم تكن وحيدة.
في العام 1969، خاض الأسرى والأسيرات إضرابين عن الطعام، الأول كان في سجن الرملة واستمر لمدّة 11 يومًا، والثاني خاضته الأسيرات في معتقل “كفار يونا”. تكمن أهميّة هذين الإضرابين عمليًا في أنهما شكّلا المرّة الأولى التي يتم فيها صوغ مطالب واضحة وعينيّة وتحقيق بعض منها. تحقيق بعض المطالب، دفع الأسرى إلى الإعلان عن إضرابين إضافيين في العام 1970 استشهد خلالهما أول أسير فلسطينيّ جراء الإضراب عن الطعام وهو الأسير عبد القادر أبو الفحم. إن استشهاد الأسير، دون تحقيق أي مطالب تُذكر، دفع الأسرى للتصعيد، فأعلنوا إضرابًا آخر في العام 1973، إلّا أن إدارة السجون لم تستجب مرّة أخرى لمطالبهم، فأعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام الأول في العام 1976 واستمر لمدّة 45 يومًا، وتلاه إضراب آخر في العام 1977 استطاعت الحركة الأسيرة فيه تحقيق مطالبها بإدخال القرطاسيّة وتسلّم مكتبة السجن بالإضافة إلى مراسلة الأهل وتغيير الفرشات.
وبهذا شكّل إضراب العام 1976 تحديدًا، نقطة إيجابيّة مفصليّة في تاريخ الإضراب- أي تاريخ الحركة الأسيرة. وإذا أردنا فهم تمايز هذا الإضراب فإنّه يكمن في ما كان قبله وما كان بعده وليس بفعل الإضراب ذاته. فما كان قبله هو تصعيد تدريجيّ مستمر حتّى الوصول إلى الإضراب المفتوح، حيث سبقت ذلك إضرابات متقطّعة تجهيزيّة وتصعيديّة وتعبويّة. أمّا ما كان بعده فإنّه جاء بعد عام واحد على الإضراب. فبعد تراجع مصلحة السجون عن استحقاقات الأسرى التي حقّقوها في العام 1976، أعلن الأسرى في العام 1977 الإضراب المفتوح عن الطعام مرة أخرى.
شكّل هذا الإضراب الذي يعد استمراريّة لإضراب العام 1976 نواةَ تنظيم الحركة الأسيرة، ووجود قيادة موحّدة في السجون للمرة الأولى، قيادة تقود الحركة الأسيرة، وتنتخبها الحركة الأسيرة بدورها ممثلّة لها. وبالتاليّ، نحن أمام إضراب له الأثر ليس فقط على حياة الأسر اليوميّة التي يعيشها الأسير، إنّما على حياة الأسر السياسيّة أيضًا بوصفها تنظيمًا واحدًا وموحّدًا لكافة السجون.
نفحة السجن الذي بُنيّ لكسر الإضراب، وكسره الإضراب
بعد إضراب الأسرى عن الطعام عام 1977 وتحقيق الإنجازات والمطالب وعمليّة التنظيم السياسيّ التي حصلت في الأسر، باتت المؤسّسة الصهيونيّة أمام حركة سياسيّة منظّمة داخل السجون. ولضربها، قامت إدارة السجون بفصل القيادة التي تشكّلت في سجن عسقلان وسجن بئر السبع المركزيّ عن مجموعة من الأسرى تم نقلهم إلى السجن الجديد “نفحة”. إذ قامت إدارة السجون بنقل أسرى جماعيّ إلى سجن “نفحة” وبسلب كافة إنجازات إضراب العام 1977 منهم.
كان الهدف من ذلك بناء فروقات بين السّجون لضرب فكرة القيادة الموحّدة، حيث أبقت سلطات السّجون على القيادات التي تم انتخابها عام 1977 في سجنيّ عسقلان وبئر السبع المركزيّ، ونقلت مجموعةً أخرى من الأسرى إلى سجن “نفحة”، في محاولة لضرب فكرة توحيد الظرف المعيشيّ بين السجون ولتقسيم الأسرى.
وكان سجن “نفحة” قاسيًا جدًا بظروف غير ممكنة للحياة فيه بالمقارنة مع سجونٍ أخرى، وهذا يعود إلى عاملين مهمّين: الأول هو كون السجن موجودًا في الصحراء؛ والثاني، هو الإنجازات التي تحقّقت في السجون الأخرى نتيجة الإضراب والنضال المستمر حيث تحسّنت الظروف مثلًا في عسقلان تدريجيًا نتاج معارك مع إدارة السجون، في الوقت الذي كان فيه “نفحة” سجنًا جديدًا لم يخض الأسرى فيه أي إضراب ولم يحقّقوا أية إنجازات بعد.
هذه الفروق هدفت بصورة غير عبثيّة، إلى ضرب فكرة الوحدة جميعها. فأعلن الأسرى في سجن “نفحة” وبعد مرور 5 أشهر على افتتاح السجن الإضراب المفتوح عن الطعام والذي استمر 33 يومًا، وقوبل بالقمع الصهيونيّ الذي وصل حد الإطعام القسريّ للأسرى والذي استشهد نتيجته ثلاثة أسرى. إلّا أن التصعيد الصهيونيّ قابله تصعيد من طرف الأسرى وتمسّكهم بالإضراب، بالإضافة إلى الالتفاف الشعبيّ مع إضراب “نفحة” في الخارج والداخل (في سجنيّ بئر السبع وعسقلان) والتنسيق الدائم بين السجون، وقد أدّى ذلك في النهاية إلى خضوع مصلحة السجون وتشكيل ما يسمّى بلجنة “كيت” لبحث ظروف الأسر في سجن “نفحة”. وقد كانت المطالب تتمثّل في إعادة كافة الحقوق التي انتزعها الأسرى في سجن عسقلان وبئر السبع بالإضافة إلى تغيير ظروف الأسر في سجن “نفحة” الصحراويّ.
إذا ما نظرنا إلى هذا الإضراب تحديدًا، فإنّه يجسّد المثال الأفضل على إثبات مقولة: “الوحدة، والصمود”. فعلى الرغم من الهجمة الشرسة، والتي لم يسبق لتاريخ الإضرابات عن الطعام في فلسطين أن شهدها، استطاع الإضراب النجاح وذلك يعود إلى عاملين: الوحدة بين السجون، والتي كانت بحد ذاتها تحدّ لهدف سياسات الاحتلال بتقسيم الحركة الأسيرة التي تشكّلت عام 1977، والوحدة بين الداخل والخارج ثانيًا، أي تكامل الإضراب من حيث المعدة الخاويّة والشارع الثائر؛ وثانيًا، صمود الأسرى والإرادة القويّة. والعاملان لا يمكن الفصل ما بينهما فكلاهما مكمّلٌ للآخر. أمّا الناتج النهائي فكان انتصار الحركة الأسيرة ببقائها واحدة، وبتغيير ظروف الأسر في سجن “نفحة” وتحقيق كافة المطالب التي حقّقها إضراب العام 1977. فبدا سجن “نفحة”، الذي افتتح لكسر الإضراب الناجح عام 1977 راكعًا خانعًا وسجانوه أمام الوحدة والتكامل.
إضراب العام 2004: حين يُصبح الإضراب عدوانًا
في كتابه “صهر الوعيّ”، يروي الأسير وليد دقّة تفاصيل الإضراب عام 2004 على أنّه عدوانٌ منظّمٌ على الأسرى جاء اكتمالًا للعدوان الصهيونيّ على الفلسطينيين في فلسطين التاريخيّة والاجتياحات للمدن الفلسطينيّة والدمار وتفكيك البنى المقاومة خلال وبعد الانتفاضة الأولى. وبصورة لافتة للنظر وعميقة جدًا، يربط دقّة بين الداخل والخارج على أساس مرحليّ، ويقول إن سلطات الاحتلال وخلال الانتفاضة الثانيّة ووصول الأسرى بكميّات كبيرة جدًا إلى السجون والمعتقلات والسجون كان أمامها خياران: الأول، هو خلق حالة من عدم الاستقرار وإنهاك الأسرى الجدد بتنقيلهم بين السجون والحيال دون تشكّلهم وانخراطهم في المجموع والإبقاء عليهم كأفراد استمرارًا واستثمارًا للصدمة التي أتوا منها في الخارج حيث الدمار والوحشيّة؛ أمّا الخيار الثاني، فهو ترك الحركة الأسيرة بهيكليّتها وتنظيمها لاستيعاب الأسرى الجدد وتنظيمهم الأمر الذي يعني انضباطهم للقوانين الناظمة داخل الأسر والتي باتت معروفة ومتّفق عليها مع إدارة السجون.
وبحسب دقّة فإن إدارة السجون توجّهت إلى الخيار الثانيّ حتّى نهاية العام 2003 مطلع العام 2004، أي بعد استكمال عمليّة “صهر الوعيّ” وقبول خطّة دايتون التي قامت بها في الخارج. وانتظرت، اكتمال تجهيزاتها واشتداد الانقسامات داخل السجون بين قيادات الحركة الأسيرة ذاتها لتبدأ بعزل قيادات الصف الأول بهدف خلق فراغ قياديّ يتيح ظهور قيادات جديدة “شريكة”، وهو ما لم يختلف بالمطلق عن الخارج وخطاب باراك بعدم وجود “شريك للسلام” في أعقاب مفاوضات كامب ديفيد.
في أعقاب التحوّل للخيار الأول بعد خطّة ممنهجة صهيونيّة لاستكمال عمليّة “صهر الوعيّ” بدأ التضييق على الأسرى، يُضاف إلى ذلك العزل الجماعيّ للقيادات، وتم تعيين مسؤول جديد لإدارة السجون أكثر تطرّفًا، ولم يكن هذا التعيين عبثيًا فكان يسعى إلى التضييق الممنهج ضمن منظومة السجن. وهو، ما دفع الأسرى لإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام في سجن هداريم بتاريخ 15/08/2004 وانضمّت باقي السجون إلى الإضراب عن الطعام استمر لمدّة 18 يومًا.
هذا الإضراب، وعلى عكس إضراب العامين 1976 و1977 تميّز بانقسام داخليّ وخارجي. انقسام بين قيادة السجون داخل الأسر، من حيث عدم الاتّفاق بين السجون وبين القيادات في الفصائل المختلفة، استغلّته المؤسّسة الصهيونيّة لضرب إرادة وصمود الأسرى، وانقسام خارجيّ في الشارع الفلسطينيّ بعد الانتفاضة الثانيّة وبداية مرحلة جديدة من الانقسام السياسيّ والمعرفيّ.
أمّا نتيجة الإضراب فكانت فشلاً في تحقيق المطالب وفشلاً في تحقيق وحدة سياسيّة وتنظيميّة. والأدق، ليس فشلًا في تحقيق وحدة تنظيميّة سياسيّة بالقدر الذي أدّى فيه هذا الإضراب إلى تفكيك الوحدة التنظيميّة السياسيّة التي حقّقها الأسرى في الإضراب ذاته. فكان الإضراب، وكما هو وسيلة وأداة نضاليّة عدوانًا تفكيكيًا هدّامًا أيضًا. وهذا يعود إلى افتقاد ذات الثنائيّة التي أنجحت إضراب العام 1977 “الوحدة والصمود”.
الإضراب بين “التضامن” و”التكامل”
لم يأت اختيار إضرابي العام 1977 و العام 2004 عبثيًا في هذه المقالة. فالإضرابان، وعلى الرغم من وجود إضرابات كثيرة استمرّت لأيّام معدودة ما بينهما، إلّا أنّهما يشكّلان النقيضين. الأول هو حالة وحدة داخليّة وخارجيّة في معركة على الحياة، والثانيّ هو حالة انقسام داخليّ وخارجيّ. الأول عبارة عن نجاح واستمراريّة؛ والثاني عبارة عن عمليّة فشل أدّت إلى تفكيك وإحباط.
وهذا، ما يفسّر عدم خوض الأسرى أي إضراب عن الطعام جماعيّ بين العام 2004 حتّى العام ،2011 حين أعلن أسرى الشعبيّة الإضراب المفتوح، وتكامل ذلك مع صفقة “وفاء الأحرار” التي تضمنّت بعض بنودها تنفيذ مطالب الأسرى، وحقّقت إلغاء العزل الإنفراديّ للأمين العام للشعبيّة أحمد سعدات.
هنا، في إضراب العام 2011 نحن أمام حالة أخرى أبعد من التضامن، هي حالة تكامل بين الخارج بوصفه حركات المقاومة خارج الأسر والداخل بوصفه السجون. ولعل إضراب العام 2012، الذي بدأ التحضير له قبل الإعلان عن بدئه بعام كامل، وتحقيق غالبيّة المطالب بضمنها إلغاء “قانون شاليط” يشكّل هو الآخر مثالًا صارخًا على ماهيّة التكامل بين “الداخل” و”الخارج”. في ذلك الإضراب، تجنّدت كافة مؤسّسات المجتمع المدنيّ، والمؤسّسات الإعلاميّة والشعبيّة بالإضافة إلى كافة الفصائل والأحزاب لدعم الإضراب. وهو ما أرغم رئيس جهاز الشاباك حينها، يورام كوهين، على التفاوض مع الأسرى بوساطة مصريّة لإنهاء الإضراب والموافقة على مطالب الأسرى.
وبالتاليّ، يقودنا هذا التاريخ، إلى حقيقة مفادها أن الحراك الشعبيّ المساند للأسرى في سجون الاحتلال ليس تضامنًا، بل يشكّل جزءًا لا يتجزأ من الإضراب ذاته وشرطًا لنجاحه، ما يُفقده ويسقط عنه عمليًا صفة “التضامن”. فالشريك في المعركة، والمقرّر مدى نجاحها أو فشلها، السياسيّ أو المطلبيّ، هو جزء منها وليس متضامنًا معها.
في الإضراب عن الطعام، يتكامل “الداخل” و”الخارج” في معركة واحدة، هي المعركة الوحيدة التي يستطيعون فيها الالتحام تحت قيادة أسرى داخل السجون وتتشكّل قيادة واحدة موحّدة يكون التكامل شرط نجاحها، في الوقت الذي يمكن إن تم حصرها في “التضامن” أن تفشل. وهنا، لا بد من الإجابة مرّة أخرى على السؤال الذي افتتح هذا المقال “كيف يتحوّل موت الفلسطينيّ إلى تهديد على أمن المنظومة الاستعماريّة؟”. إنّه ليس تهديدًا إلّا للوضع القائم، فالشهادة، في معركة متكاملة شُعلة تنير الطريق. والشهادة، في الإضراب، تهديد وتذكير بقضيّة يحاول الاستعمار بأذرعه المختلفة صهرها وقتلها ووأدها.