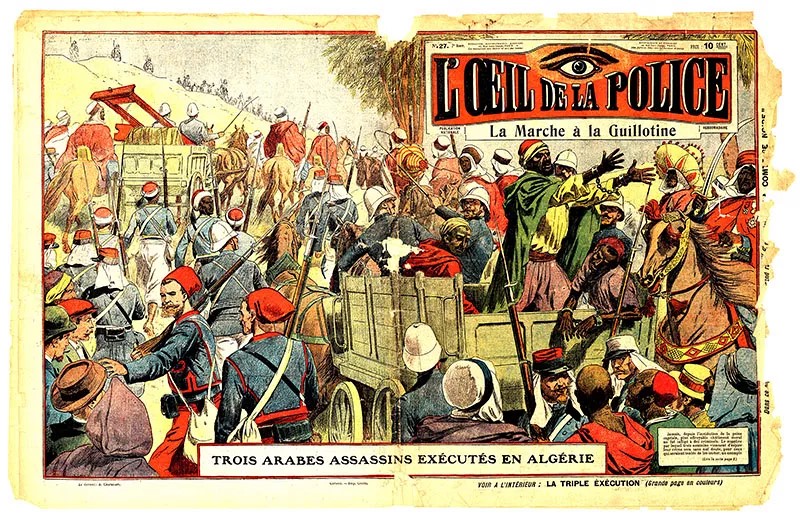(مقدمة كتاب القارعة: دراسات مختارة في ثورة 1919)
توطئة
ننشر على باب الواد مقدّمة كتاب “القارعة”: دراسات مختارة في ثورة 1919 (في مصر) للباحثة المصريّة نجلاء مكاوي، بإذنٍ خاصٍّ منها، والذي صدر في نهاية العام 2019 في الذكرى المئوية لثورة 1919، عن دار المرايا للإنتاج الثقافي في القاهرة. يضمّ الكتاب بين دفّتيه 14 دراسةً لـ 13 كاتباً مصريّاً من مشارب أيديولوجيّة ومنهجيّة متنوّعة، مقدّماً بذلك للقارئ نظرةً على الكيفيّة التي قرأ بها هؤلاء الكتّاب، بأجيالهم المتعاقبة، ثورة 1919، لتشكّل هذه الدراسات في مجموعها مدخلاً لإعادة النظر في “وخلخلة” السرديّة السائدة للثورة، والتي يتلقّاها المصريّون في المناهج المدرسيّة الرسميّة وفي الأعمال التلفزيونية والسينمائية، حيث تبدو “للناظر نزهة وطنية خَلَوية، لا صراع فيها، أو خيانات، أو تناطح بين قوى متناقضة سعت جميعها إلى كبح ثورة الشعب وتبديد طاقاتها الخلاقة”.
تلتقي مقدّمة نجلاء مكاوي في نقدها الرواية الرسميّة للسلطة مع ما قدّمته لاحقاً علياء مسلم من نقدٍ لهذه الرواية في “الوجه الآخر لثورة 1919 المصريّة: ثورة فلّاحي الهماميّة” في مسألة طمسها للوعي السياسيّ الفلّاحيّ لثورة 1919 والمكثّف في معنى “السلطة” لدى الفلاحين؛ سلطة الاستعمار- سلطة الباشوات. ولا تغيب عن مقدّمة مكاوي ثورة يناير 2011 ومآلاتها وما حفّزته من نزعةٍ للعودة إلى التاريخ، بحثاً عن الذات وعن إجاباتٍ لأسئلة الحاضر في الماضي، دون أن تتمخّض هذه النزعة عن ميلاد مدرسةٍ جديدةٍ في التاريخ المصري حسب الكاتبة.
إننا وإذ نقدّم لكم هذه المادة الغنيّة المكثّفة، لا يفوتنا أن نذكّر بالبعد الفلسطينيّ لثورة 1919 المصرية، والتي انطلقت فعليّاً في العام 1918 باحتجاجاتٍ عنيفةٍ للفلّاحين المصريّين على التجنيد “القسري” لأبنائهم ونهب قوتهم ووسائل إنتاجهم من جِمال وحمير على يد “السلطة”؛ الاستعمار الإنجليزي ورجاله من عِلْية القوم، في الحرب العالمية الأولى. هذه الحرب التي كانت فلسطين مسرحها الرئيسيّ على جبهتها الشرقية؛ فإلى فلسطين ساق الإنجليز مئات آلاف الفلّاحين المصريّين ضمن “فيلق العمّال المصري” للعمل القسري في تشييد الطرق وسكك الحديد والجسور ومدّ أنابيب المياه وأعمال نقل العتاد والمؤن، وما زالت مقابرهم الجماعية المنسيّة في فلسطين تنوح:
يا عزيز عيني وأنا بدي أروّح بلدي
بلدي يا بلدي والسلطة خدِت ولدي
ولأنّ للتاريخ دروبه الخفيّة للمكر بمن يتوهّمون سطوتهم المطلقة على تحديد مساره، فقد كانت ميادين الحرب العالمية الأولى، وخاصةً في فلسطين التي سيق إليها العدد الأكبر من الفلّاحين المصريّين (حوالي 330 ألف قروي)، حيّزاً تواصليّاً اجتمع وتلاقى فيه الفلّاحون المصريّون من شتات القطر المصري، فتعارفوا وبثّوا همومهم وتشاركوا حكاياتهم، بما ساهم في تشكيل وعيهم الثوريّ الجماعيّ الذي حملوه معهم إلى قراهم ونجوعهم، وليستخدموا المهارات التي اكتسبوها في مدّ سكك الحديد وبناء الجسور في الحرب، في تخريب سكك حديد الاستعمار وجسوره في مصر أثناء الثورة. بالمقابل، كان لثورة 1919 المصريّة صداها في الهبّات الفلسطينيّة ضدّ الاستعمار الأنجلو-صهيوني في العشرينيّات، هبة النبي موسى 1920، وهبة يافا 1921.
ختاماً، يقدّم كتاب “القارعة” بمقدّمته النقدية ودراساته نموذجاً كتابيّاً يجدر بالبحّاثة الفلسطينيّين استلهامه في كتابة تأريخٍ للتأريخ لثوراتهم؛ كيف كُتِب تاريخ هذه الثورات؟ ومن كتبه؟ وفق أيّ منهجٍ ولأيّ غاية؟ مع نماذج مختارةٍ من هذه الكتابات في عملٍ واحد. هذه الثورات المغدورة التي، وبحسب تعبير نجلاء مكاوي الجميل والمأساوي، “لم تسقط أغلب ثمارها في حجر الجماهير التي صنعتها”.
متواصلون…
(خالد عودة الله)
****
تقديم
“ومهما كان من طبيعة الحوادث التي حصلت في مصر بعد قيامنا، فإنها جاءت قارعة شديدة فوق ما كان يقدّر المقدرون، وعكست القصد على حزب الاستعمار، فألفتت العالم كله إلى أن هناك أمة مظلومة تطلب الإنصاف.” – سعد زغلول، في مذكراته، عن يوم 2 أبريل 1919 [1]
“لا بد لنا من قارعة! تلك هي الكلمة التي كان يرددها سعد في الأسبوعين الأخيرين قبل نفيه، لأنه كان يرى بحق أن السكوت يتبعه سكوت وأن الحركة تتبعها حركة، ولم يكن جازمًا بأن الثورة آتية بعد القارعة التي كان يتصدى لها ويستبطئ وقوعها…” – عباس محمود العقاد، أقرب مؤرخي سعد زغلول إليه [2]
لسنا في حاجة إلى بذل أي جهد في تفسير كلمة “قارعة” أعلاه أو لانتزاع دلالات بعينها منها قسرًا. فإن لبثنا قليلًا في حضرة نصوص “الزعماء”، سنجد وفرةً منها تجنبنا المشقة والحيرة في استنطاق كلام “زغلول” ومؤرخه الأقرب عن “قارعة 1919”.
فالجماهير الشعبية المصرية التي قامت قيامتها في مواجهة مستعمرِيها ومستغلِيها في ربيع العام 1919، مُحدثةً “القارعة” وصانعة ما يعرف بثورة 1919 -الحركة الحائزة موقعًا متفردًا في صفحة تاريخ مصر الحديث- تلك الجماهير، كان الفلاحون منها، وهم آنذاك الغالبية من أهل مصر، في عين زعيم الثورة سعد باشا زغلول وبقلمه: “أبعد الناس عن الاشتغال بالسياسة، ولا تثور لهم ثائرة إلا إذا مُست الجهة الضعيفة فيهم وهي الجهة الاعتقادية، فهم منصرفون عن كل عمل عام إلا إذا وسوس وسواس في صدورهم بالدين وأحكامه”. أما العمال فكانوا لدى “الزعيم”: “الصناع والفعلة لا يهتمون إلا بأعمالهم وقبض أجورها، ولا يتحركون لعمل عام إلا إذا حركتهم عوامل الدين، أو رأوا في الثورة ما يسهّل عليهم النهب والسلب”.
على الجملة، كانت الطبقات الشعبية المصرية عند زغلول “دائمًا تشعر بالحاجة إلى الغير والاستعانة به، ولا تحس من نفسها القدرة على الوصول إلى الغاية بعملها الذاتي، ولأنها مُكِّنَت من الذل والاستعباد أجيالًا عديدة، فإنها تبحث دائمًا عن سندها لدى الحاكم، فإذا لم تجد منه سندًا لها ضعفت، وإن هي وجدته تقوّت وسارت إلى الأمام”. [3] أما عضو الوفد المصري الملقب بأستاذ الجيل، أحمد لطفي السيد، فلم ير في المصريين سوى أنهم بشر “ذوو نفوس وضيعة، وأنهم خانعون يقبلون الإهانات والتحقير، ولا يصدر عنهم احتجاج”. [4]
في قراءة التاريخ لا يكون التعامل مع النصوص بوصفها مقاطع نثرية منقطعة الصلة بسياقاتها، في تجاهل لما تلقيه من ظلال على الواقع التاريخي الذي خرجت منه، بل العكس تمامًا، خاصة وإن كانت منسوبة لشخصيات فاعلة وذات دور مهم. ومع هذا فنحن لا نقصد بالاقتطاف من أقوال هذا وكلام ذاك الوقوف عند الأشخاص على أهميتهم، بل تجاوزهم إلى ما انتموا إليه ومثّلوه. فالمسألة تتعلق بأفكار طبقة اجتماعية وتصوراتها ومصالحها؛ طبقة تكونت من ممثليها مجموعة -الوفد المصري- مثَّلت المصريين جميعًا أمام المحتل، ثم كان لها الإمساك بزمام انتفاضة شعبية واسعة انتهت إلى مآلات معينة نعرفها جميعًا.
لقد تحرك جناح من كبار ملاك الأرض، الذين تثَبَتّ نفوذهم بفضل الاحتلال البريطاني، لكن الذين ما لبثوا أن شعروا بالغبن من تهميشه لهم سياسيًا، ومن عرقلته لمسعاهم لتوجيه جانب من نشاطهم إلى المجالات التجارية والصناعية؛ نقول تحرك هؤلاء مستهدفين دفع الأمور من أجل انتزاع مكاسب سياسية (=المشاركة في السلطة)، واقتصادية (=تعظيم الثروة)، فكان “الوفد المصري” الذي اتخذ من الناس سندًا شعبيًا في شكل مؤطر قابل للسيطرة وقانوني الطابع، تمثّل في حركة “توكيلات” رسمية منزوعة الثورية؛ توكيلات من الشعب لـ”الوفد” ليكون الهيئة المشخِصة لعموم المصريين، ليس في السعي إلى ما ابتغاه هذا العموم بالضبط، بل إلى ما حددته رغبة القيادة وقدراتها وقدمته إلى الشعب بوصفه الممكن.
وكانت اللحظة التي قال فيها زغلول “لا بد لنا من قارعة” لحظة تأزُم خلقها تعنُّت الاحتلال وعدم قبوله التفاهم مع “الوفد” بصفته ممثلاً المصريين، بل عدم قبوله الدخول في مسار تفاوضي أساسًا، أيًا ما كان سقفه أو طرفه الآخر. لذا دار في رأس زغلول والكبار أن ثمة ضرورة لشيء مباغت يحرك ما عزَّ على التحرك حينذاك -لـ”قارعة” بهذا المفهوم.
لكن “القارعة” عندما وقعت كانت “قارعة” حقًا، أي أمرًا من هوله لا يدري المرء من أين يأتيه. ولذا، وتوقّيًا لـ”هول القارعة”، عملت القيادة الوفدية على استيعابها وتأطيرها بدأب وإحكام طوال الفترة التي مثّلت الفصل التمردي الطويل المسمى ثورة 1919، والذي يمكننا أن نحدد نقطة نهايته بعد نحو أربع سنوات من انطلاق الثورة، وذلك مع إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة (اسمية)، وفي سياق تبلور نظام سياسي دستوري جديد، مقرونًا بترسيخ نظام اقتصادي واجتماعي رأسمالي حديث.
أما الطرف الرئيسي الذي تلقى القارعة ومثّل هدفها المباشر، وكان إذ ذاك يعتلي ظهور كل مَن في مصر ويقبض على أزِمَّة كل ما فيها، فهو بريطانيا العظمى: الدولة التي مر على احتلالها لمصر ما يزيد عن ثلث قرن من الزمان، ومر على فرضها الحماية على مصر نحو خمس سنوات، ووقعت مقدّرات البلاد ومواردها تحت سيطرتها. وعلى الرغم من تلك السيطرة، فقد كان ثمة ظرف دولي يطرح احتمالية حدوث خلخلة ما، ليس من جهة القوى الاستعمارية الأخرى -التي طالما بقيت لها أياد ومصالح داخل مصر تقف أمام انفراد بريطانيا التام بها- بل تعلق الأمر بالداخل الذي انعكس الظرف الدولي عليه.
كانت الحرب العالمية الأولى -وهي الذريعة التي فرضت بها بريطانيا حمايتها على مصر- قد انتهت، واستعد الحلفاء المنتصرون للجلوس حول طاولة تقسيم الغنائم وتقرير مصائرها. وكانت مصر إحدى الدول المستعمرة التي تلقف داخلها هذا الظرف، ومعه إعلان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون برنامج لتحقيق السلام في العالم، تضمنت مبادئه حق الشعوب قاطبة في تقرير مصيرها بإرادتها الحرة وعلى أساس من مصالحها هي لا أية قوة أخرى.
وعلى الرغم من أن تلك كانت مبادئ نظرية لم تصمد في أول اختبار، فقد كان لها تأثير في مصر كما نظرائها. هذا فضلًا عن أن ثمة ثورة كبرى كانت قد قامت وأحدثت من الأصداء الكثير، وهي ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا عام 1917، التي اتخذت موقفًا داعمًا بقوة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وأصدر قائدها لينين نداءً إلى شعوب الشرق.
لذلك كله اتجهت بريطانيا، استباقًا، إلى التخطيط لاستمرار الاحتلال وتثبيت وضع الحماية، ما جاء في صور عدة كان أهمها وضع مشروع تَلَّبَس رداء الإصلاح الدستوري والقانوني والإداري، ليحقق أهدافها من جهة، ومن جهة أخرى لتقدمه بوصفه تغييرًا إيجابيًا في وجه من بدأ صوتهم يعلو. وكان هذا التوجه متناسبًا مع سقف توقعات الحكومة البريطانية -أو بعض رجالها- الذي وقف عند احتمالية انعكاس انتهاء الحرب والسعي لإقرار حق تقرير المصير في شكل تحرك محدود قد تقوم به جماعة من الوطنيين سعيًا إلى تسوية المسألة المصرية. أي أن بريطانيا لم تنتظر من المصريين ثورة. فلقد باغتتها انتفاضة 1919 حقًا، وقلبت كل حساباتها؛ هذا على الرغم من أن الدولة المحتلة لم تقض سنوات احتلالها السابقة في سكينة، بل قابلت كثيرًا من أشكال المقاومة والرفض. لكن ما حدث في مارس 1919 كان شأنًا آخر.
أما أصحاب الشأن، عموم الشعب المصري، فقد تشابه النظر إليهم من جانب المحتل الأجنبي، كما من جانب محتلي قمة الهرم الاجتماعي المحلي -طبقة كبار ملاك الأرض؛ البورجوازية (الصناعية والتجارية) الناشئة والمُتخلَّقة في رحمها؛ كبار موظفي الإدارة؛ النخبة الارستقراطية التركية؛ وأخيرًا امتداد الحاكم المؤسِس (محمد علي) القابع في سراي الحكم- كل هؤلاء رأوا جماهير الشعب، المكونة من الفلاحين والعمال ومهمشي المدن وأرباب الحرف وغيرهم، من منظور فوقي تحقيري: مجرد كيان جامد تمرَّس على الانسحاق والرضوخ للاستغلال والقهر. لكن الحقيقة، التي زاغ عنها المتحكِّمون، أن سياسات الاحتلال، والاحتلال في ذاته، وطبيعة النظام الاستغلالي القائم، وما أفرزه من أوضاع، كل ذلك راكم لدى غالبية الشعب مخزونًا ثوريًا، هو ذاك الذي انفجر في مارس، مُرهبًا الجميع، فأضحى الكيان الجامد كتلًا سائلة يتعين استيعابها اتقاءً لشرها.
بالمعيارين الزمني والموضوعي توزَّعت ثورة 1919 على مرحلتين، الأولى هي الانتفاضة الشعبية: المشهد الثوري العنيف المتفرد تاريخيًا من حيث مستوى عنفه ومداه. إذ بعد أن أطلق طلاب المدارس إشارة البدء، انقضت جموع الغاضبين، الذين تمدد غضبهم بامتداد مصر كلها، على كل من وما مثّل السلطة العسكرية البريطانية، وكل من وما مثّل “الحكومة” أو “المتحكمين في الأرزاق”.
واجه أبناء الشعب، بعنف كثيرًا ما كان منظمًا، متوسلين أجسادهم والسلاح الذي استولوا عليه من مخازن السلطة. وبالطبع كان الفلاحون والعمال في القلب من مشهد العنف. فهم أكثرية الأهالي الذين سامتهم السلطات البريطانية سوء العذاب، وعلت بِكَوْمة بؤسهم المقيم، حين ساقتهم جماعات كالدواب خلال الحرب لتستخدمهم في أعمال الجيش البريطاني الحربية، فيما لم تكتف بالتجنيد القسري الذي سحبت إليه أكثر من مليون شخص (أطفالًا وشبابًا وشيوخًا)، مات منهم مَن مات، وعجز مَن عجز، بفعل الجوع والمرض الوبائي ومشقة الأعمال وأساليب الإكراه عليها، بل صادرت محاصيل الفلاحين الزراعية وحيواناتهم أيضًا. باختصار: غرَّمت الحرب الأهالي أجسادهم وأرواحهم وأرزاقهم، ومازج هذا أوجه معاناتهم الأساسية، فجاء عنفهم سلوكًا ثوريًا منطقيًا.
وفي مواجهة العنف الجماهيري توسلت السلطات البريطانية العنف في حده الأقصى، فذهب بها التوحش فيه كل مذهب: من الجلد، إلى التهجير الجماعي من القرى، إلى هدم البيوت وحرقها، إلى اغتصاب النساء، إلى الحصد الجماعي للأرواح بالبنادق والمدافع الرشاشة في ميادين النزال، وعلى أعواد المشانق بأحكام المحاكم العسكرية، وصولًا إلى رمي الأهالي بالقنابل من طائرات حربية.
لكنها ليست السلطات البريطانية وحدها التي عملت على إيقاف تلك الثورة العنيفة، بل كانت معها الطبقات المحلية السائدة، التي انتقلت بالثورة إلى مرحلتها الثانية الأطول، التي بنهايتها وقفت ثورة 1919 عند سقفها المعروف، بفضل جهد المجتهدين في الحيلولة دون خرقه.
فلقد اضطر المحتل، لعجز آلته العسكرية الغشوم عن السيطرة على حركة الثائرين، إلى اللجوء لكبار القوم في مواجهة “غوغائهم”. فاندفع “الكبار” بحمية إلى التدخل لنزع طاقة العنف لدى الجماهير وعرقلة تنظيمها ودفعها في مسار آخر، حتى لا تنقلب المعادلة الاجتماعية برمتها، ومن ورائها السلطة السياسية.
حصل ذلك منذ الشهر الثاني لاندلاع الانتفاضة، واستمر محققًا غاية أصحابه في النهاية. وقد اتخذ إطارًا نظريًا وآخر عمليًا. الجانب النظري كان خطابًا تربويًا ودينيًا مُلجِّمًا بثه أعضاء الوفد والأعيان ورجال الدين (مشتركون ومنفصلون)، حمل تأثيمًا لأعمال المقاومة العنيفة على أرضية دينية وانضباطية. ثم اصطبغ الخطاب بعد ذلك بالطابع الوطني الصرف. فالكل جماعة واحدة ليس بينها تناقض في المصالح والأهداف، تجمعها غاية واحدة هي النضال المشترك من أجل حل المسألة الوطنية، وبالوسائل السلمية فحسب، وعبر قادة هم القادرون على تحديد الممكنات وترتيب الأولويات والبدائل.
أما من الناحية العملية، فقد تُرجم هذا المفهوم في شكل تنظيمات تعبوية استيعابية، تحت عناية الوفد. وبذلك انسحبت كتل جماهيرية حية من المشهد الثوري في الشارع، ومن بقي فيه قاوم قدر طاقته وقدراته وحدود وعيه، حتى استقر داخل الأطر التي رسمتها القيادة.
لكن هذا لا يعني أن “الشعب” عاد وتحول إلى صفر في معادلة السياسة التي انتقلت إليها الثورة، بل ظل حاضرًا ممثَلًا في كثير من فئاته، كطرف يراقب ويعترض ويسهم في توجيه المسار السلمي التفاوضي الذي اندفعت فيه القيادة السياسية. ولولا الاعتبار في وجوده من الطرفين -الزعماء المحليين والاستعمار البريطاني- ما كانت الثورة وصلت إلى ما وصلت إليه من نتائج، حتى وإن كانت أغلب ثمارها لم تسقط في حجر الجماهير التي صنعتها، لكن هذه الأخيرة اقتنصت رغم ذلك لنفسها مربعًا واسعًا في المشهد، وظلت تناضل حفاظًا عليه وتوسيعًا له.
إلى هنا نتوقف عن الخوض في حديث تطورات الثورة وأحوال الفاعلين فيها. فلسنا بصدد التأريخ لها -وإنها لمن جسام المهام- بل قصدنا توضيح المنظور الذي نقرأها به. فإن كنا نقدم للقارئ بين دفتي هذا الكتاب ما سطرته أقلام غيرنا من مؤرخين ومفكرين تصدوا للكتابة عنها، فقد قمنا باختيار تلك الدراسات وهيكلتها بإرشاد من رؤيتنا. إذ ثمة قناعة لدينا بأن مُتلقي المعرفة وصانعها، كلاهما لا يمكنه ترك حمولته الفكرية والأيديولوجية وانحيازاته الاجتماعية وراء ظهره وهو في رحاب المعرفة.
والرؤية التي نقصدها وحملتنا على صناعة هذا العمل وحددت أهدافنا منه، تتعلق بالثورة ذاتها من جهة وبتأريخها من جهة أخرى، وهما معًا يشكلا موضوع هذا الكتاب. وللتوضيح نقول إننا نقف على رصيف القوى الشعبية انتماءً لها وانحيازًا لمصالحها، ونراها من فوقه الفاعل الرئيسي في التاريخ، والمُحرِّك الذي تحدد قدراته، وقدرات خصومه في مواجهته، طبيعة المسار ونتائجه. لذا نقرأ التاريخ وتطوره من هذه الوجهة، ومنها نرى الفصل التاريخي المٌلهِم الذي صنعته ثورة 1919.
أما عن تاريخ هذه الثورة المكتوب، فنحن نعتقد أن أهمية قراءة التاريخ ووظيفته لا تتمثل في الرجوع إلى نصوص تأريخية حول حوادث انفلتت إلى رحم الماضي، من أجل استخلاص العظات والدروس بالمفهوم التربوي المدرسي البورجوزاي، بل في النظر إلى المعرفة التاريخية بوصفها وسيلة في صراعات الحاضر والمستقبل ضد تحالف الاستغلال والديكتاتورية، وخاصة أبنية هيمنته الثقافية والمعرفية، ذلك على أساس أن الوعي التاريخي جزء أصيل من الوعي الشامل المطلوب لتكوين رؤية متكاملة تُمكِّن من صناعة التغيير الجذري.
من هذا المنطلق نعتقد في أهمية تأريخ ثورة 1919 اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لطبيعة اللحظة التاريخية التي نمر بها وما تفرضه من أسئلة ليس من بد عن الرجوع إلى التاريخ إن أردنا لها إجابات.
فما حصل أنه مع اندلاع الثورة المصرية في العام 2011، تزايدت نسبيًا مكانة “التاريخ” و”التأريخ” في الاهتمام المعرفي والجدال العام في مصر، وهو أمر طبيعي، لأن حضور التاريخ يرتبط -وجودًا وعدمًا وحجمًا- بحاضر المجتمع وأزماته وتطلعاته. لذلك تستدعيه أوقات التغيير وتفسح له مكانًا رحبًا.
وهكذا عَلَت في أيام المد الثوري حالة من الاهتمام بـ”البحث عن الذات” عبر سبر تاريخ مصر والمصريين: من حيث الأنظمة السياسية الحاكمة والمفاضلة بينها؛ من حيث مكانة الزعماء وأدوارهم والمقارنة بينهم؛ من حيث الجماعات والتنظيمات السياسية الفاعلة في أطوار التاريخ المختلفة؛ من حيث مآثر ومثالب “الوطنية” كمفهوم جامع للمواطنين؛ وبشكل خاص ومُركَّز من حيث التاريخ الممتد من الثورات والانتفاضات الشعبية. كما امتد الاهتمام إلى سياقات عملية كتابة التاريخ نفسها والقائمين عليها. وكان هذا طبيعيًا في لحظة سقطت فيها، أو ارتجت، كل الهياكل القديمة، ومعها كل ما غلّفها وحماها من أفكار ومقولات نظرية. لذا رافق النظر إلى “مسألة” التاريخ والبحث ورائه، تصور مسبق قوامه التشكك في كل شيء. لكن يمكن القول إنه كان شكًا من النمط الإيجابي، أي الذي يدفع صاحبه إلى المعرفة بعقل نقدي ويجعل حصيلته منها تنعكس تطويرًا في رؤيته.
هنا علينا القول إن ذلك “الهمّ التاريخي العام”، الذي اتسعت قاعدته في أيام ما بعد يناير 2011، قد اتخذ شكلين: الشكل الأول، والأساسي، كان نزوعًا فرديًا غير متبلور عند عموم الناس، المنخرطين في معمعة “قارعة” 2011، والباحثين عن إجابات تروي ظمأهم بشأن الحاضر والمستقبل؛ أي كان معبرًا عن “حالة وعي عامة” أسهمت البيئة الجديدة في تفتيحه. أما الشكل الثاني فتمثل في صورة اندفاعة من جانب نفر من النخبة التأريخية، والثقافية عامةً، نحو التاريخ، بغرض إعادة قراءته والبحث فيه، بيد أن ذلك جاء ضعيفًا وقصير النفس وبعيدًا عن أولويات عموم الناس، كما كل استجابات النخبة للمتطلبات العميقة للحركة الشعبية، فانتهى الأمر بها إلى التوهان في شئون بيروقراطية ومسائل هامشية، بعيدًا عن متطلبات خلق وعي جذري جديد بالتاريخ المصري الحديث وحركته.
إذن فقد انحصر جُلّ الأمر في إطار الاهتمام الفردي ولم يسفر عن ميلاد “اتجاه” جديد لإعادة قراءة التاريخ وكتابته.
ثم أنه مع انحسار المد الثوري، بدأ التعاطي مع التاريخ ينحو إلى السلبية. فمع تسيد حالة من الانهزام، ومع تغوّل الثورة المضادة وشنها حربًا على الذاكرة الثورية، تراجع الاهتمام بالتاريخ، كما كل موضوعات الوعي، وأصبحت قيمته والمكتوب المتراكم منه محل شك كبير؛ لكنه هذه المرة شك من ذلك النوع الذي ينعكس في حالة من الانصراف عن المعرفة والشعور بانعدام الجدوى منها. فعاد التاريخ مرة أخرى إلى موقعه في الوعي العام: نصوص تحوط حقيقة ما بها الشكوك، لكونها صُنعت على عين السلطة، أو وظفتها هذه لصالحها، أو خرجت ملوثة بأتون معارك سياسية وأيديولوجية، أو كانت وقودًا لتلك المعارك، ما انعكس افتئاتًا على الحقيقة التاريخية في شكل كثير من نواقض الموضوعية، وأحيانًا المصداقية.
هذا الموقف السلبي من التاريخ ودوره قد نختلف أو نتفق حول مداه، لكنه يستحق التأمل والنقاش والمعالجة. واعتبارًا في وجوده وفي أهمية قراءة تاريخنا الثوري، ندعو إلى الاقتراب المعرفي بمنظور مختلف من أحد أهم التجارب الثورية الحديثة، أي ثورة 1919.
****
وحتى لا نترك الأسئلة حائرة في ذهن القارئ، ننتقل الآن إلى الحديث عن التأريخ للثورة واتجاهاته ومدارسه وما أثر فيه وتأثر به، وهو حديث يتصل بالدراسات التي نقدمها في هذا الكتاب. فما هي إلا مختارات منتقاة بعناية من إنتاج مختلف الاتجاهات والمدارس.
نبدأ بالقول إنه على الرغم من الأزمات والمشكلات الكبيرة التي تعانيها كتابة التاريخ في مصر، فإن الكتابات التاريخية المصرية تتميز بالوفرة، فيما يحظى التاريخ الوطني بجل الاهتمام. وإن ذهب المرء إلى قوائم الإصدارات عن هذا التاريخ لن يجد موضوعًا/حادثة/ظاهرة تمزقت من فرط التعرض لها أكثر من ثورة 1919. فمِما كُتب عنها تم صوغ سردية كبرى تفرعت منها سرديات صغيرة، هي التي استقرت في وعي أجيال، ليس من القراء فحسب، بل أيضًا ممن تصدوا لكتابة التاريخ.
بشكل عام، تُعرَّف ثورة 1919 في الوعي العام بأنها “هبة” في وجه الاحتلال العسكري الاستعماري، تنظمت سريعًا وأخذت مسارًا طويلًا كان له من النتائج ما غيَّر وجه مصر، فأضحت “ثورة” وطنية عظيمة ومؤسِسة، هذا على الرغم من أنها لم تحرر البلاد من الاستعمار.أما التعريف التفصيلي للثورة، وفق التصنيفات السائدة، فهو أنها ثورة: قومية، سياسية، ليبرالية، علمانية، سلمية.
كونها ثورة قومية، فهذه هي اليافطة الكبرى. إذ لا تطل علينا من كتب التاريخ سوى بوصفها الحركة التي ضمت كل طبقات الشعب وفئاته (أصحاب الثروة ومعدوميها ومَن بينهما؛ الرجال والنساء؛ المسلمين والأقباط؛ الأميين والمتعلمين؛ المدنيين والعسكريين؛ ممثلي الحكومة والمجتمع)، الجميع في مواجهة الاستعمار، دون أي تناقضات أو تباين في مستويات الحضور الثوري؛ حالة تاريخية فريدة من الاندماج الوطني، ومن أجل الوطن ولا شيء غيره.
وهذا يأخذنا إلى تصنيف آخر، وهو أن 1919 صُوِّرت بوصفها ثورة سياسية. إذ يُدَّعى أن التغيير الاجتماعي لم يكن أبدًا على قائمة أهداف القوى الشعبية، وإنما قامت الثورة فحسب من أجل الاستقلال، وظلت في امتدادها الزمني كفاحًا سياسيًا من أجله ومن أجل تحسين شروط الحكم. وعلى هذا استدلالات عدة -وفق المصنفين- أهمها أن المطالب الفئوية كانت هامشية، وأن ثمة فئات لم تعرف للثورة شارعًا إلا مدفوعة باندفاعة الجميع من أجل كرامة الوطن وحريته. أيضًا هناك الاستدلال باستمرار وقوف الجماهير خلف الوفد وارتباطها به بوصفه ممثلها، على الرغم من طرحه المسألة الاجتماعية جانبًا. هذا كله مع ملاحظة أن هؤلاء المصنفين لم يغفلوا الأسباب/الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للانفجار -فهي عصية على التغافل- لكنهم أدرجوها ضمن الهوامش، وسرعان ما أزاحوها عند وصف الثورة وتصنيفها.
وتظهر ثورة 1919 في الوعي السائد أيضًا بوصفها ثورة سلمية الطابع؛ العنف فيها محض لحظة عابرة غير منظمة وغير مدرَكة. وهذا يرتبط بنزع المسألة الاجتماعية منها، وتمييع حضور الكتلة الأكبر -التي مثّلها من أسماهم “الكبار” بـ”الغوغاء”- لصالح من أقاموا مسار السياسة والتنظيم الاستيعابي وأخذوا الثورة فيه. وفي أحسن الأحوال ستجد تمثلات العنف في صورة مشذَّبة، يُرد حدوثها إلى عنف السلطات البريطانية وليس إلى مبادرة الأهالي.
أما عن الأفكار وقوالبها، فثورة 1919 تُطرح بوصفها ثورة علمانية، انعكس نمو الأفكار العلمانية والليبرالية والوطنية الحديثة خلال الفترة التي سبقتها فيها، في مقابل تراجع الفكرة الإسلامية. هذا الانتقال “المؤسِس” من فكرة الجامعة الإسلامية إلى القومية المصرية الحديثة تجلّى في أبرز مشاهد “علمانية الثورة”، وهو المشهد الأم المطبوع في ذاكرة الأجيال: المسلم في كتف القبطي والهلال يعانق الصليب. كما انعكست “علمانية الثورة” وليبراليتها في مشهد رئيسي آخر، وهو خروج المرأة سافرة ومشاركتها في الأحداث -المرأة الحضرية البورجوازية بالطبع، أما بنات الريف وبنات الطبقات الكادحة المدينية، فسقطن في بئر الهوامش.
وبعيدًا عن المشاهد التي صُدِّرت بوصفها علامات الثورة ورمزياتها الرئيسة، فما نعرف عن ثورة 1919 -كما رُسمت صورتها في الوعي العام- هو أنها نقطة فاصلة ومفصلية، ليس ما بعدها كما قبلها، في السياسة، كما في حقول الثقافة والفكر والفن، كما في كثير من المسائل المتعلقة بالحريات والهوية، وغيرها.
هذا هو المعلوم من الثورة بالضرورة، أو بكلام آخر، الخطوط العريضة التي ترسم ملامح ثورة 1919 في تاريخها المكتوب، وكذلك في الخطاب الوطني الرسمي. ليس كل المكتوب بالطبع، بل أغلبه، فثمة استثناءات، تلك التي حاولت نقل الهوامش إلى المتن واقتربت أكثر من “حقيقة” الثورة.
فكيف كُتب هذا التاريخ؟ ومَن كتبه؟ وحسب أي نظريات ومناهج؟ وفي أي اتجاهات وقنوات جرى تأريخ الثورة؟ وتحت أي مؤثرات؟ الإجابات الوافية لا يتسع لها مجالنا بالطبع، لكننا سنحاول الإضاءة حولها، لأن هذا يضيء بالتبعية الدراسات التي يتضمنها هذا الكتاب، والتي انتقيناها من سجل المنتج المعرفي التاريخي المصري.
لعل السؤال الأساسي الذي يقفز إلى ذهن الراغب في معرفة هذه الثورة وكيف أُرخ لها، يدور حول الفترة التي أعقبتها مباشرة، أي المجال الزمني الذي عبأته أصداء الثورة، وحمل بالتالي أكثر تجليات تأثيراتها. نقول إنه يمكن تحديد هذه الفترة بالمرحلة الزمنية التي امتدت حتى خمسينات القرن العشرين، وذلك لاعتبارات تتعلق بتطور مصر السياسي والاجتماعي، وهو الأمر المؤثر بقوة على كتابة التاريخ. فخلال المرحلة المسماة بـ”الليبرالية الدستورية”، التي أقامت ثورة 1919 أعمدتها، والتي استمرت حتى عام 1952، حين كانت 1919 حاضرة دائمًا، تنمو تأثيراتها باطراد على الصعد كافة، تأثرت عملية تأريخ مصر بشكل كبير ومؤسِس.
بإيجاز، يمكن تحديد المرتكزات المفاهيمية للنصوص التأريخية التي خرجت طوال تلك الفترة بركيزتين، الأولى هي انتزاع ثوب البطولة في صناعة التاريخ من الشعب وإلباسه للقادة، والثانية هي الاهتمام بما هو سياسي على حساب الاجتماعي والاقتصادي. وفي الموازاة، يمكن تقسيم صانعي تلك النصوص إلى نوعين، الأول أكاديمي أخرج دراسات تاريخية وفق منهج علمي، والثاني لم يعن بالأكاديميا ولم ينتم إليها، وكتب تأريخًا حدثيًا، جاء في شكل مذكرات وشهادات من المعاصرين والفاعلين، أو في شكل سرد وتوثيق من المهتمين بكتابة التاريخ.
بالنسبة للنوع الأول، وهم الأكاديميون، فقد كان أحد تأثيرات الثورة تأسيس حركة الدراسات التاريخية المصرية على المستويين العلمي والوطني. إذ تأسست مدرسة أكاديمية وطنية مصرية في عشرينات القرن العشرين على يد عدد من الباحثين المصريين الذين اكتمل بناؤهم المعرفي في أوروبا وعلى يد مؤرخيها، فتولوا بعد عودتهم من بعثاتهم العلمية زمام أمر التاريخ في المدارس والجامعات المصرية، وأنتجوا النصوص الأكاديمية الأولى في مصر.
تأثر هؤلاء الرواد بمدارس غربية في قراءة التاريخ وتفسيره، تميل إلى أن البطل الفرد هو صاحب الدور الرئيسي في حركة التاريخ وصناعة أحداثه، وتعتبر أن الأمم ما هي إلا جماعات تُقاد، ولا بد لها من ذلك. هذا نظريًا، أما موضوعيًا، فقد تأثروا باستبداد المسألة الوطنية بالمسرح العام في مصر وإزاحتها ما عداها من قضايا، فرأوها كما أُطِّرت حينذاك: مسألة سياسية تنفصل انفصالًا تامًا عن كل ما هو اجتماعي واقتصادي. وفي ارتباط بذلك اعتبروا التاريخ أداةً في النضال الوطني، الأمر الذي انعكس في شكل وطبيعة كتاباتهم. فكان تاريخ مصر بالنسبة لهم حقلًا للبحث والكتابة السياسيين، أبطاله الرئيسيون هم الزعماء، والشعب يستجيب لهم أو يعينهم بالوسائل، وهو وصُنعه يقبعان في الخلفية عند قراءة التاريخ وتقدُّمه. وقد يظهر الشعب بطلًا، لكن بالمعنى الملحمي البلاغي فحسب، وليس بمعنى الفاعل والصانع الرئيسي.
هذا هو ما تأسس: مدرسة أكاديمية وطنية صنعت ما يسمى بـ”التاريخ الوطني”، المكتوب وفق منهج علمي على يد الجيل الأول من الأكاديميين المصريين، ومن أبرزهم: محمد شفيق غربال (أول أستاذ مصري للتاريخ الحديث بالجامعة المصرية)، ومحمد صبري السوربوني، ومحمد رفعت، ومحمد فؤاد شكري. وجميعهم ركزت كتاباته على تاريخ مصر قبل الثورة، أي التاريخ الحديث وليس المعاصر، غالبًا للاعتبار العلمي القائل بضرورة مضي فترة زمنية طويلة على الوقائع التاريخية. وقد كتبوا تاريخ مصر الحديث من خلال حكامها (محمد علي وأولاده)، وهو التاريخ الذي تلقنه طلاب المدارس في مصر، بدءًا من العشرينات، بوصفه “التاريخ القومي للبلاد”، الموجه إلى جيل جديد من المصريين -الجيل الذي عاش الثورة وكان يتلقى هذا التاريخ وهو يحيا في زخمها بوصفها الحدث الوطني القريب والمؤسِس- إذ تولى أولئك المؤرخون الإشراف على تمصير المناهج ووضعوها، ومنهم من تولى مناصب رسمية في وزارة المعارف، أي قام بدور في السياسة التعليمية.
وتتلمذ على هؤلاء الرواد جيل آخر من المؤرخين، مثّل الامتداد الأكاديمي لهم، ومضى في نفس الاتجاه، وبالمفهوم والتفسير ذاتهما للتاريخ، فلم يختلف منتجهم المعرفي عن أساتذتهم كثيرًا. غير أن الانحراف الوحيد كان عن خط التأريخ السياسي، وقد تمثّل في إنتاج دراسات تاريخية اجتماعية واقتصادية، بيد أنها جاءت وصفية استعراضية، ولم تركز على دراسة المجتمع وتطوره، وما خضع له من تأثيرات، وما أفرزتها من نتائج. لذا اقتصرت تلك الدراسات على معالجة التطور المؤسسي والتنظيمي والإداري في إطار “إصلاحات” الحكام العلويين و”دورهم في صناعة النهضة”. [5] وهي وإن لم تمس ثورة 1919 مباشرة، إلا إنها قدمت صورة ما عن الاجتماع والاقتصاد في مصر خلال القرن التاسع عشر، أي أثناء المجال الزمني الطويل الذي اختمرت فيه الثورة المصرية، ولكن ذلك تم عبر قراءة غيّبت طبقات الشعب وقواه الاجتماعية الفاعلة.
إذن، فقد كان تأريخ ثورة 1919 على يد “الأكاديميين” خلال العقود الثلاثة التي أعقبتها ضعيفًا وهامشيًا، كونها تاريخًا معاصرًا. فلم يخرج ما يمكننا اعتباره منتجًا معرفيًا خاصًا بها ذا اتجاه وتفسير معينين. لكن أهم ما نعرفه، ويحتل موقعًا غير منكور في سجل تأريخ الثورة الكبير، كان لاثنين من الرواد: السوربوني وغربال.
بالنسبة للأول، فقد كان يكتب التاريخ منطلقًا من أن وظيفته هي تشكيل الوعي القومي (الوطني) وتزكيته لدى المصريين من جهة، ومن جهة أخرى لاستخدامه سلاحًا يُشهر في وجه المحتل، أي أنه كان يكتب الأحداث ويحققها ويوثقها على أساس “علمي” خدمةً للقضية الوطنية. وقد ترجم السوربوني ذلك إلى كتابات كانت من أول ما كتب عن الثورة عمومًا، بل إنه كان الوحيد بين الأكاديميين الذي كتب تاريخ الثورة وقت صناعته، فكتب بالفرنسية “الثورة المصرية من خلال وثائق حقيقية وصور التقطت في أثناء الثورة”، وهو كتاب صدر في جزأين، الأول نشر عام 1919، والثاني عام 1921. وقد بذل جهدًا أكاديميًا في عمله معتمدًا على الوثائق، فضم صور ويوميات الثورة، ومعلومات حول أدوار الفاعلين فيها، وجرائم المحتل في مواجهتها.
كتب السوربوني كتابه هذا بالفرنسية، كمعظم إنتاجه، مستهدفًا به الرأي العام الغربي، أي أنه كان عملًا موظفًا لصالح الدفاع الدولي عن القضية الوطنية. كما كتب في جزأين، وبالفرنسية ومن نفس المنطلقات أيضًا، كتاب “المسألة المصرية منذ الحملة الفرنسية حتى ثورة 1919″، الذي صدر الجزء الأول منه عام 1920، متناولًا القضية المصرية منذ الحملة الفرنسية حتى ثورة 1919، وصدر الثاني عام 1921، مركزًا على مقاطعة المصريين للجنة ملنر التي أرسلتها الحكومة البريطانية في أعقاب الانتفاضة للوقوف على الأحداث وتقرير مصير البلاد. ويمكن القول إن كتابات السوربوني، وإن جاءت منحازة للثورة، فإنه كان انحيازًا مفعمًا بالمشاعر الوطنية، إلى الحد الذي يبدو فيه النص وكأنه درس مكثف في الوطنية، فيما لم يتخل المؤرخ عن مركزية موقع القادة في التاريخ. [6]
أما بالنسبة لشفيق غربال وثورة 1919، فقد كتب في وقت متأخر كتابًا عن المفاوضات نشر عام 1952، يعد من المراجع الأولى والرئيسية فيها، وهو “تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية”. وقد كتبه غربال على ذات النهج الذي اتبعه في كل كتاباته، فاعتبر أن المفاوضات تشكل محورًا هامًا في تاريخ مصر، وأنها فصل من هذا التاريخ يحكي قصة رجال من طراز فريد لم تعرفهم مصر من قبل.
هذا عن الأكاديميين. أما عن غيرهم، فبالنسبة لكاتبي المذكرات والذكريات والشهادات، فإن نصوصهم عن الثورة وأحداثها ورؤيتهم لها تحمل الطابع نفسه الذي عادة ما تحمله الكتابات من هذا النمط. ونحن لا نجادل في أهمية مثل تلك النصوص للوقوف على أحداث التاريخ، لكن مع الوضع في الاعتبار أنها تعبر عن رؤية أحادية الجانب، وتخضع لتأثيرات عدة كثيرًا ما تقدح في الموضوعية.
والحق أن النصوص الخاصة بالثورة التي كتبها المعاصرون لها لم تفلت من هذه المثالب، خاصة وأن الصراعات السياسية والحزبية في تلك المرحلة كانت على أشدها. ولذا فكما انعكست تلك الصراعات على “السياسة”، فإنها انعكست كذلك على “التأريخ”.
أما مَن كتبوا تاريخ الثورة في شكل تسجيلي توثيقي مغلف بالتحليل والتفسير، فأبرزهم (ومن أبرز من كتبوا تاريخ مصر القومي عمومًا) هو عبد الرحمن الرافعي. إذ أن ما كتبه الرافعي عن ثورة 1919 (“ثورة 1919: تاريخ مصر القومي من سنة 1914 إلى سنة 1921″، في جزأين، الطبعة الأولى عام 1946) كان -ولا يزال- مرجعًا أساسيًا لكل متصدٍ للكتابة عنها وكل راغب في إطلالة معرفية عليها.
لكن بالنسبة للإطار الذي وُضعت فيه الأحداث والتحليل الذي استند إليه الرافعي، فهو وطني صرف. إذ كان التاريخ عنده هو أداة لتعليم الناس الوطنية وإفهامهم الحاضر وتأهيلهم لبناء المستقبل ونهضته من منظور مدرسي بورجوازي. وعلى الرغم من أنه رأى أن التاريخ القومي هو مجموع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبناء على ذلك قدَّم ما اعتبره أسباب الثورة الاجتماعية والاقتصادية، فإن الرافعي كان من مصنفي الثورة بأنها ثورة سياسية فحسب، وليست اجتماعية أو دينية. هذا فضلًا عن أن القارئ عندما يذهب إلى عمل الرافعي عن الثورة لن يجد صعوبة في اكتشاف تأثير انتمائه الحزبي على ما كتب. فهو كان منتميًا للحزب الوطني (حزب مصطفى كامل ومحمد فريد) الذي كان أحد الحزبين الكبيرين في البلاد قبل الثورة (كان الآخر هو حزب كبار الملاك -“الأمة”- الذي تكوّن في رحمه الوفد)، فأثرت الخصومة الحزبية والصراعات على تحليلات الرافعي وتعليقاته، ونال سعد زغلول منه ما نال من نقد شخصي وسياسي وتقليل من دوره، في مقابل تضخيم دور الحزب الوطني وقادته في التهيئة للثورة.
ذلك بإيجاز -حاولنا أن يكون غير مخل- هو منتج تلك المرحلة، وتلك هي أطره وسياقاته، وأولئك هم صناعه.
لكن حدث ما قطع المسار، ومثّل فصلًا استثنائيًا في تأريخ ثورة 1919، وتأريخ مصر عمومًا. إذ أسهم صعود المسألة الاجتماعية في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية في زيادة حضور التيار اليساري، فكرًا وحركة، الأمر الذي انعكس في بروز فكرة إعادة قراءة التاريخ من منظور ماركسي، فيما ساعدت أجواء ما بعد انقلاب 23 يوليو 1952 وما تلاه من تغييرات على نمو تلك الفكرة، إلى حد ترجمتها خلال النصف الثاني من الخمسينات في صدور عدد من الكتابات لبعض المثقفين الماركسيين حول تاريخ مصر القومي.
وقد استخدم أصحاب تلك الكتابات “المادية التاريخية” مفتاحًا ومنهجًا لقراءة وفهم وتفسير تاريخ مصر. فتناولوه وفق تصور فلسفي له، وللعلل التي تحكم حركته، من خلال فهم قوانين حركة الظواهر الاجتماعية لا مجرد تسجيلها، وتفسير التطور الاجتماعي وعوامله، أي دراسة وتحليل تطور المجتمع بوصفه عملية تتعدد عناصر التفاعل فيها، وعلى أساس أن الطبقات هي المحرك الحقيقي للتاريخ.
ومن أبرز هؤلاء الكتاب -وهم غير أكاديميون- شهدي عطية الشافعي وفوزي جرجس. كتب الأول كتابًا عن تطور الحركة الوطنية المصرية من 1882 إلى 1956، وكتب الثاني كتابًا عن تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي، وكلاهما تناول بالطبع ثورة 1919، مقدمات وطبيعةً ونتائج.
إلى هذا الحد، ورغم ظهور هذه الكتابات الماركسية الأولى، لا يمكننا القول إن تأريخ ثورة 1919 كان قد دخل بالفعل في طور جديد. فقد لاحت بشائر هذا “الطور الجديد” بقوة إثر تغيير فوقي، تمثّل في رفع النظام الناصري راية الاشتراكية وقيامه بحركة تأميمات واسعة في مطلع الستينات. بالتحديد يمكننا اعتبار “الميثاق الوطني” -الذي قدمه الرئيس جمال عبد الناصر للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية في 21 مايو 1962- هو الوثيقة التي كانت وراء الانطلاقة الكبرى لاتجاه جديد في كتابة تاريخ مصر وتاريخ ثورة 1919.
وحتى لا يستنتج القارئ أن تأثير الميثاق -وهو وثيقة سياسية عبأها النظام ببعض المنطلقات النظرية لسياساته- كان ضمنيًا، نقول إنه تحدث صراحة عن ثورة 1919 حديثًا توجيهيًا لمتلقيّ التاريخ وكتّابه. إذ جاء فيه أن تلك الثورة هي إحدى حلقات تاريخ المصريين الثوري ونضالهم الممتد لأكثر من مائة عام. فقد سبقتها هبات كثيرة، كانت آخرها ثورة عرابي، التي أعلى الميثاق من شأنها وأولاها أهمية كبرى في تاريخ البلاد (على عكس وضعها في كتابات ما قبل 1952)، بوصفها ثورة ضد استنزاف موارد مصر وثروتها الوطنية من قِبل القوى الأجنبية والمغامرين الأجانب، بمساعدة الأسرة الحاكمة.
طرح الميثاق أن الفترة التي تلت الثورة العرابية، وتسلط فيها الاحتلال البريطاني وأعوانه على المصريين، قد اختمرت خلالها الثورة في نفوس المصريين، حتى انفجرت عام 1919. ولأنه اعتبر الأخيرة موجة ثورية جديدة، قوامها حركة شعبية مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية، فقد شن هجومًا على قادتها البرجوازيين، واختص سعد زغلول بالذكر، متهمًا إياه بركوب الثورة، وعزا إليه والقيادات فشلها، لإغفالهم مطالب التغيير الاجتماعي ومصالح المحرومين من الشعب، الذين كانوا وقود الثورة وضحاياها، فانتهت إلى ما انتهت إليه من استقلال زائف وحرية تحت حراب المحتل، ولم يكن الشعب طوال المرحلة التي تلت الثورة سوى أداة في يد السلطة المعادية لمصالحه.
وعلى هذا، وباعتبار أن ثورة يوليو قد حققت ما فشلت فيه ثورة 1919، دعا الميثاق إلى إعادة دراسة تلك الأخيرة، ضمن دعوة أشمل لإعادة كتابة تاريخ مصر كله، لأن “أجيالًا متعاقبة من شباب مصر قرأت تاريخها الوطني على غير حقيقته، وصُور لها الأبطال في تاريخها تائهين وراء سحب من الشك والغموض، بينما وضعت هالات التمجيد والإكبار حول الذين خانوا كفاحها”. [7]
عمليًا، انعكس ما جاء في هذا النص في شكل “تنشيط” عملية إعادة كتابة تاريخ مصر للفترة من الاحتلال البريطاني وحتى عام 1952. وطبعًا نالت ثورة 1919 والحقبة التي تلتها أهمية كبيرة في هذا السياق. هنا يمكنك أن تجد كتابات عدة وافق تاريخ صدورها الفترة بين مطلع الستينات ومطلع السبعينات، أكثرها تلبَّس ثوب التاريخ قسرًا، بينما هو قد صوّب مدافعه “السياسية” نحو قيادة الثورة “القديمة” ومجمل المرحلة الليبرالية الدستورية، ولم يكن له من مقصد سوى موالاة النظام الجديد واسترضائه، والضرب بسيفه على رؤوس خصومه الذين لطالما استحضرهم، سواء من أصبح منهم في ذمة التاريخ، أو من كان في هوامش الحاضر، ليس فحسب بتوسل التاريخ وفي حقله، بل أيضًا في مجال القمع السياسي وخطابه الذرائعي، ولهذا حديث آخر. وغني عن التوضيح هنا أن الكتابات من هذا النوع جاءت مصابة بجملة من العلل تجعلها لا ترتقي إلى مستوى “التأريخ”، حتى الوطني الرومانسي منه.
وبعيدًا عن هذا النموذج الرث، وفي سياق الكتابات الجادة، وفيما يمزج بين الاستجابة إلى الدعوة الرسمية، والتعبير عن أصداء المناخ المصري والعالمي العام، الذي رفع طبعات “وطنية” عدة من الماركسية إلى مكانة الأيديولوجيا المحبَذة لدى جناح واسع من المثقفين؛ حدث ما يمكن اعتباره تحولًا نوعيًا في وجهة وفلسفة الكتابة التاريخية. فظهر ما سُمي بـ”مدرسة التاريخ الاجتماعي”، التي يعتبر الدكتور محمد أنيس مؤسسها وراعيها الذي فتح الباب أمامها بكتاباته ونشاطه العلمي الأكاديمي.
استخدم عدد كبير من المنتمين لهذه المدرسة (وليس كل) النظرية المادية التاريخية في التفسير، فأنتجوا دراسات مهمة في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تعرَّض عدد معتبر منها لثورة 1919 جملة أو تفصيلًا، وأعاد قراءتها وتقييمها، وحاول رفع هوامشها -القوى الاجتماعية المغيّبة قسرًا- إلى المتن. وسنؤجل الحديث عن أصحاب تلك الدراسات ومضمون ما جاء فيها وما انتهت إليه، إلى الجزء الخاص بعرض الدراسات الموجودة في هذا الكتاب، لأننا اخترنا منها نماذج ممثلة، أكاديمية وغير أكاديمية.
لكن الذي حصل، كالعادة، هو أن تقلبات السياسة قطعت “الفصل الاستثنائي” الذي تُوّج بميلاد مدرسة التأريخ الاجتماعي في الستينات. فمع تمكُّن أنور السادات من السلطة في 1971، ثم تغييره لتوجهاتها فيما تلا ذلك من أعوام، دُشِّنت تغييرات سياسية واقتصادية كبرى، دفعت بـ”الرئيس المؤمن” إلى الدعوة مباشرة -في 1976- إلى إعادة كتابة تاريخ مصر، ليتناسب، في طبعته الجديدة، مع حاضر السياسة الساداتية.
والحق أن الأمر لم يقتصر على السلطة وحدها، بل إن ثمة تحولات فكرية طالت القائمين على كتابة التاريخ وألقت بظلالها على منتجهم. فالنهاية المفجعة للتجربة الناصرية أصابت جملة من “الماركسيين الوطنيين” بالخرس، أو على الأقل وضعتهم في موضع الدفاع. وهو ما ساهم في وضع كلمة “النهاية” لمشروع التأريخ “الوطني الاجتماعي” الذي دشنه أنيس وكتيبته.
في المقابل، يمكننا تحديد الفترة ما بين أواخر السبعينات وحتى نهاية العقد الأول من حكم مبارك، بأنها آخر الفترات -قبل يناير 2011- التي شهدت حضور التاريخ في الجدال العام، وكان لثورة 1919 نصيبًا كبيرًا في ذلك.
إذ أنه قد انفتح نقاش -تحول إلى معركة حامية الوطيس بين رموز الجماعة التاريخية والثقافية عمومًا- شارك فيه الرأي العام بمشاهدة التاريخ وهو يتمزق إربًا. فما حصل هو أنه في ظل نظام مبارك في عقده الأول، وأثناء عمل هذا الأخير على تصفية الحركة السياسية والاجتماعية، كانت القوى السياسية والحزبية التي سُمح لها بالعمل داخل “هامش ديمقراطي” خانق، قد تدهورت -مع انسحابها القسري (وكذلك المختار) من فضاء “سياسة الحاضر”- إلى معارك هوياتية وأخرى هامشية، فأقامت حربًا حامية الوطيس في ساحة الماضي، ليس استجلاءً لغوامضه حبًا في المعرفة، أو سعيًا إلى إضاءات بشأن مستقبل التغيير، وإنما دعمًا لشرعيتها التاريخية، بل ولاحتكار الشرعية لنفسها ونزعها عن غيرها. وهنا وقعت الفترة السابقة على يوليو، والتي تبدأ من ثورة 1919، موقع القلب من الصراع، الذي عُرِّض فيه بالتاريخ وحقائقه وفاعليه على صفحات الصحف بأقلام أبرز مؤرخي مصر ومثقفيها إذ ذاك.
أثرت هذه المعركة سلبًا على نظرة عامة الناس إلى التاريخ ودوره وعلاقة السلطة والسياسة به. كما أنها تركت أثرها على الكتابات التاريخية، فتحول كثير منها إلى ميادين للنزال الأيديولوجي والسياسي بأضيق المعاني وأتفهها.
ولعل أبرز فصول هذه المسرحية، فيما يرتبط بثورة 1919، هو فصل انعقد فيه دور البطولة للمؤرخ عبد العظيم رمضان. ورمضان اسم مهم في سياقنا. فهو من أبرز من كتبوا تاريخ الحركة الوطنية المصرية الحديثة والمعاصرة. ولعله من الضروري هنا أن نشير إلى أن بعض كتاباته، خاصة التي تناولت ثورة 1919 وما سبقها وما لحقها، تُصنّف بأنها من كتابات الستينات التي استخدمت المادية التاريخية. وهذا صحيح نسبيًا. فهو قد أنجز عمليه الأولين (رسالتي الماجستير والدكتوراه) تحت إشراف الدكتور محمد أنيس، والعملين من أوائل الدراسات التي تناولت تاريخ مصر السياسي. فالماجستير هو كتابه المنشور تحت عنوان “الحركة الوطنية المصرية: 1918-1936”. وقد صدرت طبعته الأولى عام 1968. أما رسالة الدكتوراه، فقد أُنجزت عام 1970، وكانت بعنوان “تطور الحركة الوطنية في مصر: 1936-1945″، ونشر رمضان فصلها الأول في كتاب حمل عنوان “صراع الطبقات في مصر: 1837-1952″، وقد استخدم فيها فعلًا المادية التاريخية.
لكن رمضان اختلف في العملين مع أنيس وتلامذته في قراءة ثورة 1919 وتقييمها في أمور عدة، وأتت كتابته منحازة للوفد، سواء بالنسبة لدوره في الثورة، أو في الحقبة التي تلتها. وإن ضممنا إلى ذلك أعمال رمضان اللاحقة وصولًا إلى فترة الثمانينات التي نتحدث عنها، فيمكننا تصنيفها بأنها النصوص التاريخية الرئيسية التي أخذت الثورة والحركة الوطنية وألقت بهما في فلك الوفد وقادته. هذا عمومًا، أما عن تجليات انغماس رمضان -المتحيز بشكل مغرِق في تسيُّسه- في معركة الثمانينات المذكورة آنفًا، فيكفي الاطلاع على تقديمه لمذكرات سعد زغلول المنشورة عام 1987، وعلى اشتباكاته -بصفته مؤرخًا- على صفحات الصحف مع أي مؤرخ يتعرض للوفد بالنقد، وعلى دراسته التي نشرتها صحيفة “الوفد” على ثمان حلقات تحت عنوان “تاريخ الوفد والنضال الوطني”، (أغسطس/أكتوبر) 1986. هذا بجانب أن كل كتاباته استخدمها حزب الوفد (الجديد) سلاحًا في معاركه السياسية.
النموذج الثاني لتأثير العراك السياسي على الكتابات التاريخية في تلك الفترة، تأتي أهميته من كونه نوعًا مميزًا ونادرًا من الكتابات عن ثورة 1919، ألا وهو القراءة الإسلامية التي قدمها زكريا سليمان بيومي في كتابه “الاتجاه الإسلامي في الثورة المصرية سنة 1919″، الصادر عام 1983. إذ كانت كتابات هذا المؤرخ (الأكاديمي) أبرز انعكاسات صعود الإسلاميين إذ ذاك ودخولهم ميدان التصارع بالتاريخ، لا سيما تاريخ الحركة الوطنية المصرية.
لكن قطعًا، وإن شئنا الدقة العلمية، ليس من الممكن اعتبار ما كتبه بيومي عن ثورة 1919 قراءة إسلامية متماسكة علميًا ونظريًا، بل مجرد محاولة قسرية لصبغ الثورة بالصبغة الإسلامية. وهي محاولة جاءت ضعيفة في مقدماتها واستدلالاتها، ومن ثم أحكامها. فباختصار، اعتبر بيومي أن كل الدراسات التي تناولت الثورة علمانية تجاهلت قصدًا دور الدين، فحاول هو إثبات أن العامل الديني تصدر عوامل قيام الثورة. وداخل هذا الإطار قدم دور الأقباط فيها بوصفه تجسيدًا للوجه الإسلامي لها، إذ اعتبر أن السماحة في معاملتهم كأقليات هي التي جعلتهم يدافعون عن أوضاعهم بصفة خاصة، وعن الكل الإسلامي بوصفهم جزءًا منه، وإن أكد أن دورهم الثوري كان محدودًا، وفي نطاق أضيق مما اشتهر عنه. فيما سعى كذلك إلى إثبات أن قيادة الوفد كانت تريد صبغ الثورة بصبغة علمانية، وأن المفهوم المحدود للوطنية المصرية تصاعد نتيجة ضعف حركة الجامعة الإسلامية، وبمساعي الاحتلال لفرضه عن طريق المثقفين الليبراليين، بيد أن تأثير الدين الإسلامي على غالبية المصريين ظل قويًا دائمًا.
عمومًا، لن يجد القارئ دراسات كثيرة على هذه الشاكلة، إذ ليس ثمة “اتجاه” إسلامي حقًا في قراءة الثورة وتفسيرها. ولعل دراسة بيومي هي التجسيد الوحيد للقلم الإسلامي “المُفترض” في قائمة تأريخ ثورة 1919.
وأخيرًا، فإن العقدين الأخيرين من عهد مبارك لم يشهدا اهتمامًا من المشتغلين بالتأريخ في مصر بالنقاش حول المنتج المعرفي والتفكير فيه ومراجعته، لا بشكل سلبي ولا إيجابي. لقد رُتج باب الجدال رتجًا، ولم يعد أحد يكترث بالتاريخ وكيف كُتب وماذا يقول، لا فيما يتعلق بثورة 1919 ولا بغيرها. أما عما أضيف إلى البناء الكتابي التاريخي عن الثورة خلال تلك الفترة، فقد جاء متنوعًا وبشكل عشوائي وفردي، من هذا الاتجاه أو ذاك، فيما خرج كثير من الدراسات بدون اتجاه أو نظرية في التفسير أساسًا؛ مجرد إضافات سردية وصفية تنزح من المخزون السابق دون إعادة النظر فيه أو الاشتباك معه.
من كل ما سبق، ماذا اخترنا لقارئنا هنا؟ ولماذا؟ لنذهب إلى الإجابة.
****
قام اختيارنا للدراسات المكونة لهذا الكتاب على قائمة من المعايير، هي التي اعتقدنا أنها تفي بالغرض الرئيسي، وهو الإسهام في الاقتراب من جديد من الثورة، عبر نصوص ليست جديدة، لكن تتوافر فيها سمات عدة، في مقدمتها الرصانة، وأن تمثل أهم الاتجاهات والمدارس، وأن تطرح أفكارًا جديرة بإعادة النظر فيها، وأن تعد نصوصًا مؤسِسة وأصلية في بابها، وغيرها من السمات التي قد تجتمع في نص واحد أو لا تجتمع. لكن هدفنا كان ضمان اجتماعها في كتاب واحد يمكّن قارئه من بناء تصور معرفي متماسك ومفيد.
على ذلك، فقد ضربنا صفحًا عن كثير وكثير من الدراسات، أهمها تلك التي طغى عليها الانحياز والهدف الأيديولوجيين. وهنا نؤكد أننا لا نعتقد في القول السائد بضرورة تحرر الكاتب من أيديولوجيته وهو يكتب، أو أن الطابع الأيديولوجي يعد نقيصة في النص، بل على العكس. لكن ما نقصده أن ثمة كتابات صنعت وعين صاحبها مصوّبة على إثبات فكرة معينة، ومن أجل ذلك قام بلي عنق الحقائق وأعاد تركيب الحدث التاريخي وتقديمه في صورة إن لم نقل خادعة، فهي على الأقل تبتعد كثيرًا عن حقيقة ما حدث، وهذا نعتبره تضليلًا معرفيًا جديرًا بالاستبعاد.
وثمة نوع آخر من النصوص تجنبناه، وهو الذكريات والمذكرات والأوراق الشخصية لمعاصري الأحداث، أو الكتابات التي تُصنف بأنها تسجيل توثيقي مطعم بقليل من التحليل، ذلك لأن ما يعنينا هو المقاربة التحليلية للثورة وكل ما يتعلق بها، بحثًا وتفسيرًا.
هذا لا يعني أن أحد معاييرنا كان أكاديمية النص، من حيث هوية صاحبه وطابعه. فلم يحدث أننا استبعدنا عمل لأن صاحبه “غير أكاديمي” أو لأنه لم يلتزم تمام الالتزام بالشروط الصارمة لـ”المنهجية العلمية”. فقيمة النص هي مضمونه، كما أننا نعتقد أن التشبث بذلك المعيار لتقييم العمل يعبر عن ضيق أفق ويتجاهل حقيقة أن ثمة نصوص تعد من أهم الكتابات التأريخية المصرية سطرتها أقلام أشخاص غير أكاديميين. كذلك وجدنا خلال بحثنا كثير من الكتابات الأكاديمية الملتزمة بالقواعد، لكنها إما ضعيفة القيمة المعرفية، أو تتسم بالجمود والتصلب داخل قالب المنهجية، أو لا تعدو أكثر من تقارير معلوماتية استعراضية، فكان موقفنا منها الاستبعاد، خاصة وأنها لا تناسب قارئنا المستهدف بالتحديد.
لكن ذلك لا يعني أن كل ما استبعدناه يحمل بالضرورة تلك العيوب. فنحن لم نقدم أكثر من “نماذج” للأعمال الجيدة، ونماذج قليلة للغاية. وثمة كثير من النصوص المهمة أجبرتنا الاعتبارات الخاصة بحجم الكتاب وعدد صفحاته على التخلي عنها. كما أن ليس كل ما اخترناه تنطبق عليه كافة شروط التميز التي ذكرنها أعلاه. فقد اخترنا عدد من الدراسات، قليل جدًا، ميزته الأهم هي أنه يملأ مربعًا ناقصًا ما في قصة الثورة، بمعنى أنه وُضع لتعريف القارئ بنقطة ما أو لإضاءة جانب معين من الأهمية بمكان الإطلال عليه، حتى وإن كانت الدراسة لا تفعل أكثر من ذلك، مع التأكيد أننا اخترنا هذا النوع بدقة شديدة، وأنه من أفضل ما كتب في موضوعه.
وإذا انتقلنا إلى هيكل الكتاب، نقول إن نيتنا الأصلية، حين شرعنا في إعداده، كانت أن ننتقي للنشر عددًا محدودًا من الدراسات ذات القيمة الكبرى. لكن مع تقدم البحث تمخّض عملنا عن اصطفاء عدد كبير من النصوص، الغالبية فيها أقسام مهمة من كتب يصعب الانصراف عما بها. وهكذا أصبح عدد المختارات وطبيعتها يقتضيان بناء هيكل يتوزع على أقسام عدة تُضمَّن فيها الدراسات. وهو تقسيم مازجنا فيه بين تطور السياق التاريخي، الضروري لفهم الحدث والوقوف على أبعاده، وبين العرض الموضوعي. أما عن المدة الزمنية التي تعالجها الدراسات مجتمعة، فليس ثمة نقطة بداية محددة أو نقطة نهاية. إذ ستجد دراسات تعود إلى الفترة السابقة على الثورة، وهي الدراسات التي تصل الثورة بروافعها ومقدماتها عمومًا، أو التي تركز على أحد الفاعلين الثوريين (والتي تتناول بطبيعة الحال جذور دور هذا الفاعل وأوضاعه قبل الثورة)، كما ستجد دراسات تركز على الفترة التي تعد نطاق الثورة الزمني المتفق عليه، وهو من 1919-1923، فيما تمد دراسات أخرى نطاقها بعد هذا التاريخ.
القسم الأول في الكتاب -تمهيدات- يضم ما تتعين قراءته قبل الدخول في “المعمعة”. فهو يمهد لـ”الحادثة الكبرى” على ثلاثة محاور: أوضاع المصريين قبل الثورة وفي سنوات الاحتلال، ثم طبيعة القيادة السياسية للثورة مُشخَّصةً في سعد زغلول، ثم تفاصيل صراعات السلطة وقيادات البورجوازية وتشكيل الوفد المصري قبيل اندلاع انتفاضة مارس 1919.
أولًا، وفيما يتعلق بأحوال المصريين تحت الاحتلال، يحتوى القسم على فصل اقتطعناه من كتاب مصطفى النحاس جبر المعنون: “سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية من 1914-1936″، والفصل بعنوان: “تهيئة طبقات المجتمع المصري للثورة تحت نظام الحماية”. وستقرأ فيه بكثير من التفصيل عن المتناقضات العالمية والداخلية التي تبلورت في المجتمع المصري بطبقاته الاجتماعية المختلفة وهيأته للمرحلة الثورية.
بعد ذلك ينتقل القسم إلى “القيادة” التي يأتي سعد زغلول على رأس مشخصيها. وعن زغلول -الذي أصبح ذلك الزعيم التاريخي غير القابل للنقد- لم نجد أفضل مما كتبه عبد الخالق لاشين لنقدمه للقارئ، وذلك له عندنا سبب. فأولًا لاشين من جيل المؤرخين الذي أعد أعماله في الستينات وتحت تأثير سياقاتها، لكنه ليس من المجموعة التي استخدمت المادية التاريخية في التفسير. ورغم ذلك، فإن عمله كان أول الأعمال التي عبّرت عن الاتجاه المتمرد على مثالية نظرية البطل الفرد في التأريخ الوطني، بممارسة النقد الصريح بالجملة لـ”زعيم” ثورة 1919.
أنجز لاشين أطروحته للماجستير عن “سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية حتى سنة 1914”. وقد نُشرت عام 1971 تحت العنوان نفسه. وفيها حاول تقويض قالب التقديس للزعماء الذي صُبت فيه أهم أحداث التاريخ المصري، مما جعل البطولة الشخصية منهجًا للتفسير يغفل كافة العوامل الأخرى، وعلى رأسها ما يتعلق بأدوار القوى الاجتماعية وأوضاعها وظروفها.
طبق لاشين مفهومه النقدي على زغلول وثورة 1919 في تناول شكَّل صدمة للجماعة التاريخية ومن بعدها القراء، على الرغم من أن دراساته خرجت في وقت علا فيه شعار إعادة تقييم الثورة وكتابة تاريخها من فوق رصيف الشعب لا الزعماء. لكن، رغم ذلك، لم يتحمل الكثيرون أن تنهار مكانة وصورة الزعيم في عمل علمي موثق ومنهجي. واعتُبرت دراسة لاشين لدى أولئك نموذجًا للتأريخ “غير الموضوعي”، على أساس أن الثورة وزغلول مترادفين لا ينفصمان. لكننا- وغيرنا- لا نعتبرها كذلك، ونضع جزءًا منها بين يدي القارئ، ليس فحسب لكونها دراسة غردت خارج السرب، بل أيضًا لأنها تمتلك الكثير من مقومات العمل الجاد، ليس أقلها إنها اعتمدت على مذكرات زغلول مصدرًا للقراءة والتحليل، بل كانت أول دراسة تاريخية عمودها الأساسي تلك المذكرات قبل أن ينشرها عبد العظيم رمضان في الثمانينات.
اخترنا من عمل لاشين فصل بعنوان “تكوين سعد السياسي”، وفيه اقترب هذا الأخير من شخصية زغلول من حيث تأثرها بمحيطها، ثم من حيث سياقات انطلاق سعد إلى العمل السياسي المحترف، وأثر ذلك عليه، وانعكاساته في مواقفه الفكرية والسياسية، وعلاقاته بالقوى الفاعلة في المجال السياسي المصري. باختصار سلط لاشين في هذا الجزء ضوءًا قويًا على ملامح تكوين زغلول ومعه ملامح المشهد السياسي والفكري المصري قبل الثورة بسنوات.
بعد التعرف على سعد زغلول، يُلقي القسم الأول من الكتاب الضوء، في دراسة ثالثة، على مرحلة “العد التنازلي”، التي تبدأ من تشكيل الوفد المصري في 13 نوفمبر 1918. اخترنا هنا نصًا من كتاب ماجدة محمد حمود، المعنون: “دار المندوب السامي في مصر 1914-1924″، وهو جزء من الفصل المعنون: “دار المندوب السامي وبدايات ثورة 1919″، وفيه نجد وصفًا موجزًا جدًا لعملية تشكيل الوفد المصري، ثم تفاصيل الصدام من أعلى، أي بين الوفد والحكومة البريطانية وممثلها في مصر، وهو الصدام الذي خلقته السلطات الاستعمارية بتعنتها، فصَعَّدت به حركة الناس على الأرض لجمع التوقيعات ومواجهة المحتل. ولأن دراسة حمود تتخذ من الجانب البريطاني مدخلًا لها، فهي كذلك ستوضح تصورات بريطانيا عن إمكانية وحدود انتفاض الشعب، وسياساتها لمقابلة تذمره المتصاعد (في مرحلة ما قبل اندلاع انتفاضة مارس 1919).
أما عن “القارعة” ذاتها -انتفاضة المصريين الكبرى في مارس-أبريل 1919- فقد كان تصورنا الأولي عند إعداد هذا الكتاب أنه ليس ثمة ضرورة لتضمينه دراسة مستقلة عنها، لأن أغلبية الدراسات الأخرى تمر عليها، سواء إجمالًا لتوضيح السياق العام، أو بشكل تفصيلي يتعلق بالفاعل الثوري الذي تركز عليه هذه الدراسة أو تلك. لكننا قررنا أن ثمة ضرورة لوجود نص يكثّف كل ذلك ويسبق الدراسات التفصيلية، حتى يمكن للقارئ تكوين صورة عامة عما حدث. فنحن أمام تجربة أسست لها حادثة تاريخية، هي الانتفاضة، وبالتالي من الصعب تجاوزها ونحن بصدد قراءة كامل التجربة في كل أبعادها ومراحلها.
على ذلك، اخترنا عبد العظيم رمضان لكي يعرِّف القارئ بأحداث مارس وما تلاها مباشرة. وخصصنا لذلك القسم الثاني الذي ضمّناه جزءًا من كتاب رمضان المهم “تطور الحركة الوطنية المصرية: 1918-1936″، وهو ذلك الجزء الذي يغطي انتفاضة مارس وتحليل تنظيمات الوفد والجمعيات السرية.
كنا قد سبق أن أشرنا إلى الاتجاه الذي ينتمي إليه رمضان، وقلنا إنه يتصدر قائمة مُعَظِّمي دور الوفد بشكل كثيرًا ما يجافي الموضوعية. ومع هذا، ونظرًا لأن كتابه من الكتب المتخصصة الأولى، ويعد منذ صدوره مرجعًا رئيسيًا لمن كتبوا عن الثورة، وكذلك لأن وصفه للوحة الثورية في مارس-أبريل 1919 كان ملحميًا ومتكاملًا، رغم اكتظاظه بكثير من المقولات والرمزيات الرائجة التي تلخص ثورة 1919 في الوعي السائد (علمانية الثورة؛ وحدة عنصري الأمة؛ إلخ)؛ نقول إنه نظرًا لهذا وذاك، فإننا قررنا ضم هذا النص لرمضان لكتابنا نظرًا لقيمته الخاصة رغم مثالبه. إذ يُعرّف رمضان القارئ بأحداث الثورة وتمثلاتها، العنيفة في معظمها، وامتدادها من القاهرة إلى الأقاليم، وأساليب السلطات البريطانية في مواجهتها، ومواقف الوفد الأولى منها، ثم التحولات في موقفه، وكذلك في مواقف البريطانيين، وبدايات دخول الثورة مرحلة التنظيم والاحتواء.
أما فيما يتعلق بقوى الثورة، فقد عقدنا القسم الثالث من هذا الكتاب للقوى الاجتماعية المشاركة في 1919. هنا بحثنا عن أفضل الدراسات التي تخصصت في قراءة دور كل فاعل، فاخترنا منها الآتي: دراسة “الفلاحون بين الثورة العرابية وثورة 1919″، لعلي بركات وهي منشورة في مجلة الجمعية التاريخية المصرية عام 1975. وبركات من مجموعة الباحثين الذين تأثروا بكتابات محمد أنيس، وبالمناخ السياسي والاجتماعي والثقافي في الستينات، وكذلك بانتماءاتهم الاجتماعية، فاتجهوا إلى التأريخ من أسفل، وأنجزوا أطروحاتهم العلمية في موضوعات تتعلق بدراسة القوى الاجتماعية، وركز بعضهم -بركات ومعه عاصم الدسوقي ورؤوف عباس- على كتابة تاريخ الملكيات الزراعية، انطلاقًا من أن أشكال الملكية تحدد التكوينات الاجتماعية، وطبيعة العلاقة بين الطبقات، فتسهم دراستها في قراءة طبيعة التطور الاجتماعي، وتاريخ التجربة الاجتماعية وخصوصيتها، ونقاط اختلافها أو اتفاقها مع التجارب الأخرى. داخل هذا الإطار تأتي دراسة بركات للفلاحين التي نعيد نشرها هنا، والتي تقرأ حركتهم بشكل متصل من الثورة العرابية إلى ثورة 1919، موضحة أوضاعهم قبل هذه وتلك، ودورهم في الاثنتين.
وبالنسبة للطلبة، وهم الفئة الأولى التي احتلت ميدان الثورة، وكانت أكثر الفئات الباقية في ممارسة دور فاعل ومؤثر في المرحلة التي أعقبت إخماد الانتفاضة، فقد اخترنا من كتاب محمد أبو الإسعاد “سياسة التعليم في مصر تحت الاحتلال البريطاني 1882-1922″، فصلًا بعنوان: “الطلبة والسياسة”. وتكمن فائدته في أنه لا يبدأ مع القارئ من انطلاق الثورة، بل يقدم إضاءة للحركة الطلابية تحت الاحتلال بوجه عام، متخذًا من السياسة التعليمية مدخلًا لتوضيح كيف سعى الإنجليز لعزل الطلبة عن قوى المجتمع وحركته الوطنية، ثم منتقلًا إلى مناقشة مسألة كيفية نمو حركة الطلبة بفعل الظروف الموضوعية التي مر بها المجتمع ونضوج وعيهم الثوري حتى اندلاع الانتفاضة.
تبنى أبو الإسعاد فرضية رئيسية تقول إن الطلبة هم قلب الحركة الوطنية المصرية ومَن تحملوا عبأها الأكبر وحافظوا على استمرارها، سواء بين الثورتين -العرابية و1919- أو خلال الأخيرة. وعلى ذلك تناول نشاط الطلبة السياسي حتى العام 1918، ثم في اتصال مع ذلك، وعلى أساس أنهم من فجروا الثورة وهيأوا نفوس الفئات الأخرى لها، تناول نشاطهم ودورهم السياسي خلالها وحتى العام 1922.
وعن العمال، اقتطفنا من كتاب أمين عز الدين “تاريخ الطبقة العاملة المصرية 1919-1929″، الفصل المعنون: “الطبقة العاملة وثورة 1919″، وفيه تناول عز الدين تفصيلًا أوضاع العمال ومعاناتهم خلال سني الحرب العالمية الأولى، مقارنًا بينها وبين نقيضها المتمثل في أوضاع طبقة كبار الملاك الزراعيين في الريف والطبقة الوسطى الناشئة في المدن. وهو قد استهدف من ذلك بيان الحالة الحقيقة لطبقة العمال بوصفها جزءًا من القوى الاجتماعية الأساسية قبل اندلاع الثورة. كما تحدث تفصيلًا عن احتجاجات العمال ومعركتهم ضد أصحاب الأعمال في فترة ما قبل الثورة، ليثبت أنهم كانوا أسبق القوى إلى الحركة والانتفاض آنذاك، وليدلل على أن الطبقة العاملة اختزنت طاقة ثورية وامتلكت القدرة على المبادرة إلى الحركة والنضال، وإن اعترى حركتها بعض المثالب التي حجّمتها. ثم انتقل الكاتب مع الطبقة العاملة إلى ثورة 1919، التي بدأت باندماج الحركة العمالية ومطالبها في الحركة الشعبية الواسعة، ثم تطورت إلى الانفصال بين حركة العمال وحركة الوفد بفعل التناقضات الاجتماعية بينهما وتباين الأهداف والأساليب، ما يتضمن بيانًا دقيقًا لموقف الوفد من الطبقة العاملة ومطالبها ومحاولاته احتوائها. كل هذا بجانب كثير من التفاصيل المهمة حول مشاركة العمال في أحداث الثورة، خاصة المشاركة الجماعية المنظمة.
أما عمَّن شكل تمردهم -الاستثنائي عمومًا- خطرًا كبيرًا هدد سيطرة المحتل على جهاز الدولة، وهم الموظفون، فقد اخترنا دراسة لطارق البشري في هذا الشأن. وبشكل عام، تعد كتابات البشري من أفضل، إن لم تكن أفضل، ما كُتب عن الدولة المصرية الحديثة في مراحلها التاريخية المختلفة. لذا اخترنا له دراسة نُشرت في مجلة “الطليعة” عام 1977، بعنوان “ثورة 1919 وجهاز الدولة المصري”، وتناول فيها البشري الحدث الأبرز المجسِّد لحضور موظفي الحكومة في الثورة، وهو إضرابهم في أبريل 1919. قام الكاتب بذلك من خلال رؤية تتجاوز حدود المسألة الوطنية إلى إيضاح حدود وطبيعة سيطرة الاحتلال على جهاز الحكم والإدارة، ومولدات سخط الموظفين الذي كان وراء انضمامهم إلى الثورة. ومن خلال أهمية الجهاز للسلطة المحتلة يفسر البشري أهمية وخطورة إضراب الموظفين، ويوضح تفصيلًا كيف انعكس ذلك في محاولاتها السيطرة على حركة الموظفين عمومًا.
بعد ذلك يأتي القسم الرابع، وقد خصصناه للدراسات التي سبق أن تحدثنا عنها وقلنا إنها استخدمت “المادية التاريخية” في تفسير تطور المجتمع المصري. تختلف هذه الدراسات عن بعضها البعض في الكثير، لكنها تصنف -إجمالًا- كوحدة واحدة، نظرًا لكونها تمثل اتجاهًا يستند إلى نظرية واحدة، هي الماركسية.
ومع مراعاة الاختلافات بينها، فإن هذه الدراسات تطرح -في المجمل- أن بنية الطبقات في مصر هي التي حددت مسار الثورة ومآلاتها. إذ كان في قمة هذه البنية طبقة كبار ملاك الأرض والبورجوازية، وهي التي قادت الثورة وهادنت الاستعمار وتخلت عن مصالح الجماهير، وفي الأخير هي التي حصدت المكاسب التي قرر الاستعمار منحها لـ”المصريين”. وعلى ذلك يأتي تقييم الثورة في تلك الدراسات بأنها لم تحقق أغراض صانعيها (الجماهير)، ولم تتمثل ثمرتها بالنسبة لهم سوى في تقدم وعيهم وقدرتهم على التنظيم المستقل، الذي ساعد عليه التحرر النسبي للمجال العام/السياسي في مرحلة ما بعد الثورة، فيما جاءت ثورة يوليو 1952 لتنقل مصر إلى مرحلة أعلى -حتمية- نظرًا لاحتدام أزمة الحكم وتهالك النظام السياسي والاقتصادي.
هذا بإيجاز، ومع بعض الاختلافات في المقدمات والنتائج، هو مضمون تلك الدراسات التي خرجت في سياق تاريخي معين، وحظيت، وتحظى إلى الآن، بتميز في قائمة الدراسات التاريخية عن ثورة 1919. وقبل أن ننتقل إلى ما قدمناه من نماذجها نشير إلى أنها، خاصة ما كُتب منها بأقلام أشخاص غير أكاديميين، قد تعرضت -ومنهجها وما توصلت إليه من نتائج- لنقد لاذع، تلخص في اتهامها بالقولبة النظرية، وبأنها طوعت المادة التاريخية لصالح رؤية مسبقة، وبالغت في دور عامل وقللت من شأن آخر أو تجاهلته، فأغفلت تفاعل العوامل المختلفة في عملية التطور، ولم تحقق وتبحث في وقائع تاريخية تؤكد خصوصية هذا المجتمع والقوانين التي تحكم حركته.
نحن نرى أن هذا الحكم عام وبه شيء كثير من التعسف، ونرى كذلك أن تلك الدراسات تحتاج إلى “نظرة أخرى”، ربما إلى نقد من على ذات الرصيف الأيديولوجي. وهو ما لم يُقدم منه أي نموذج، كما لم يُقدم أي جهد لتطوير ما احتوته من أفكار وتحليلات. إذ جاء النقد المشار إليه إما من أصحاب اتجاهات يمينية، أو من أكاديميين طغت على نظرتهم، وبالتالي أحكامهم، اعتبارات وقواعد المنهجية العلمية (الشكلية في أحيان كثيرة).
لدينا في هذا القسم الرابع ثلاث دراسات، تتقدمها الدراسة الأم لذلك الاتجاه في مجراه الأكاديمي، وهي دراسة الدكتور محمد أنيس. والحقيقة أن هذه الدراسة تقع ضمن سلسلة دراسات يمكن وصفها بأنها من أنضج الأعمال ثمرة، ولا علاقة لهذا بتقييمها، بل إنه تأثيرها. فهي عمل يعد تاريخ نشره (1965) هو تاريخ نشأة اتجاه -“مدرسة” عند البعض- مثّل تحولًا نوعيًا في وجهة وفلسفة الكتابة التاريخية المصرية لصالح دراسة “المجتمع”.
لتلك الأهمية، وفي سبيل إعادة قراءة أهم ما كُتب عن ثورتنا، نقدم دراسة محمد أنيس المعنونة: “ثورة 1919: تحالف الطبقات بقيادة الرأسمالية المصرية”، المنشورة في مجلة “الكاتب” أغسطس 1965، وكانت واحدة من سلسلة دراسات حملت في مجموعها عنوان: “المجتمع المصري من الإقطاع إلى الاشتراكية”.
ومع أنيس، اقتطعنا من كتاب فوزي جرجس، المعنون: “دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي”، فصلًا بعنوان: “1914-1924- الحرب وإعلان الحماية على مصر”. وجرجس كما سلفت الإشارة هو أحد الكتاب الماركسيين القلائل، غير الأكاديميين، الذي شكلت كتاباتهم في الخمسينات المحاولات الأولى في هذا الاتجاه.
أما صلاح عيسى، فنقدم جزءًا من كتابه “البورجوازية المصرية وأسلوب المفاوضة”، وهو جانب من القسم الذي جاء تحت عنوان “هل عندكم تجريدة”؟ [8] ونرى في دراسة عيسى التميز، إذ إنه قرأ الثورة من منظور طبقي مستخدمًا أسلوب التفاوض لدى البورجوازية المصرية مدخلًا أساسيًا، وذلك لكي يكشف أن المفاوضات، بالنسبة للقيادات الوفدية، لم تكن مجرد أداة من أدوات الصراع مع الاحتلال البريطاني، وإنما هي استراتيجية أساسية تعبر عن هوان البرجوازية المصرية وعدم استعدادها للقيام بأي مواجهة جذرية مع الاستعمار.
أما القسم الخامس فيختص بدخول الثورة مجال الحكم والسياسة، وقد وضعنا فيه دراستين: الأولى لعلي شلبي عنوانها “وضع دستور 1923 والعمل به” وهي جزء من كتابه ومصطفى النحاس جبر المعنون: “الانقلابات الدستورية في مصر 1923-1936”. تناول شلبي في دراسته سياق تشكيل وعمل اللجنة الحكومية التي وضعت مشروع دستور 1923 عقب إصدار تصريح 28 فبراير 1922. كما سلط الضوء على الصراعات الفوقية التي صاحبت إخراج الدستور، وكانت متعددة الأطراف: الوفد والحكومة والملك، والإنجليز فوق الجميع بالطبع. وتلك الصراعات بجانب أنها تعكس مدى تدخل المحتل في شئون الدولة التي اعترف بأنها مستقلة وذات سيادة، فهي أيضًا توضح طبيعة وأثر الانقسامات بين مَن سحبوا الثورة في طريق السياسة. كما عرج شلبي على أول مفاوضات أجرتها حكومة سعد زغلول -التي تشكلت بعد وصول الوفد إلى الحكم عام 1924 عقب فوزه في أول انتخابات برلمانية لمصر “المستقلة”- مع حكومة حزب العمال البريطانية، وما أعقب فشل تلك المفاوضات من حوادث، كان أهمها مقتل السردار سيرلي ستاك في نوفمبر 1924، الذي وضع نهاية وزارة الوفد الأولى.
الدراسة الثانية لطارق البشري، وهي بعنوان: “ثورة 1919 والسلطة السياسية”، ونشرت لأول مرة في مجلة “الكاتب” عام 1967، وفيها يقترب البشري بعمق مما أسماه “دخول الثورة قلعة الحكم” بتولي الوفد الوزارة. فيقول إن الوفد دخلها وهو غير مسيطر على الرغم من أنه كان ممثل الشعب والثورة، وإنه خاض صراعًا ضد أصحاب السلطة السياسية القدامى من أجل أن يتقدم خطوة في سبيل تحقيق السيطرة، فيتمكن بذلك من إزاحة أنصار السلطة القديمة عن مواقعهم، ولكنه عجز عمليًا عن ذلك. وقد حلل البشري ملامح ذلك الصراع وأسباب الإخفاق. وفي ذلك مرَّ مِن بين ما مرَّ على سياسة الوفد الإصلاحية خلال حكمه، وعلى موقف البرلمان الوفدي ضد القوانين الاستثنائية التي صنعت على عين المحتل، وموقف زغلول الرافض لذلك، والذي عكس رغبته في إغلاق أبواب التعبير والتظاهر أمام الجماهير، واستبعادها كطرف مستقل، وإنهاء الحركة الثورية، حتى تبقى الجماهير أداة منظمة طيعة بيد الوفد يحسم بها معاركه.
بعد ذلك يأتي القسم السادس والأخير ليضم دراسة واحدة عن الثورة والفكر والثقافة، وهي جزء من فصل بعنوان “المجتمع والطبقة والثقافة: خلفية المشهد عشية ثورة 1919″، وهو من كتاب ماجدة بركة المعنون: “الطبقة العليا المصرية بين ثورتين (1919-1952)”، وفيه تلقي الكاتبة إضاءات من منظور طبقي (يختلف إطاره النظري والمنهجي عن المعايير الماركسية في تحديد الطبقة) على مسائل عدة، منها الثورة الثقافية البورجوازية وإسباغ قيمها على مختلف تجليات الحركة المصرية القومية قبل عام 1919؛ وظهور ما يسمى الحقل العام في المجتمع المصري؛ وإنتاج التطور الفكري والثقافي ظاهرة المثقف الحديث، التي اقتربت الكاتبة من أهم مَن مثلوها وكتاباتهم وأفكارهم. كما تناولت صور أنشطة الجماعات الأهلية التي اعتبرتها أحد مقدمات الثورة والاحتشاد الممهد لها، مثل الصحف والمجلات الممولة تمويلًا خاصًا، والجمعيات، والصالونات الخاصة التي كان يتردد عليها أشهر مفكرون وأدباء المرحلة. ثم انتقلت الكاتبة إلى ما بعد اندلاع الثورة، وأوضحت كيف استمر النزوع إلى تكوين الجمعيات والروابط والتجمعات المهنية الخاصة، وفيم تجلى ذلك، وكيف عبر عن أن الثورة كانت في جوهرها حركة من أجل التغيير الاجتماعي. كما تناولت أثر مسألة الاستقلال الذي حصلت عليه مصر وكان منجز الثورة الرئيسي على اندفاع السعي إلى الحداثة والتقدم، وانعكاسات ذلك على الحقل الثقافي المصري وتجليه في الأدب، وفي الفن: المسرح والسينما والموسيقى.
تلك هي محتويات الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم. [9] ونود أن نوجه عنايته إلى أن هذا الكتاب يأتي ضمن مشروع نشر حول ثورة 1919 قامت عليه “دار المرايا للإنتاج الثقافي” منذ مطلع العام الحالي احتفاء بالذكرى المئوية للثورة، وكان أول مخرجاته نشر الدار في منتصف عام 2019 كتاب مرايا-10/11 المزدوج/الخاص، الذي ضم أكثر من عشرين دراسة تناولت الثورة في مختلف جوانبها، في محاولة لإضاءة مسائل جديدة حول تاريخها. كما أن ثمة إصدارين سيواكب نشرهما نشر كتابنا هذا: الأول ترجمة لكتاب “تمرد الفلاحين المصريين في 1919” لرينارد شولز، أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في جامعة برن الألمانية. وهذه هي الترجمة الأولى للكتاب المنشور بالألمانية في ثمانينات القرن الماضي، وقامت بها المترجمة وأستاذة الأدب الألماني الدكتورة هبة شريف. وتأتي قيمة هذا الكتاب في أنه ربما يمثل مساهمة كبيرة في تطوير أفكارنا وتصوراتنا عن طبيعة وتناقضات ثورة 1919، إذ يقدم شولز أطروحات جريئة وجذرية عن طبيعة الثورة انطلاقًا من تحليل قواها الاجتماعية على الأرض وفي ميدان المعركة. أما الإصدار الثاني فهو كتاب محرر لعبد المنعم سعيد، الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر بمركز تاريخ مصر المعاصر، يجمع فيه المحرر نصوصًا مهمة تتضمن الكتابات السجالية والموقفية لرموز الإنتليجينتسيا المصرية في مطالع القرن العشرين -مثل طه حسين، ومحمد حسين هيكل، وعباس العقاد، وغيرهم- في غمار سنوات الانتفاض والثورة وما بعدها.
في الأخير، فإن هذا الكتاب هو نتاج جهد بذلناه من أجل أن نقدم للقارئ شحنة معرفية قد تسهم في أن تجعله يقع على كثير من حقائق تجربة تاريخية/ثورية مهمة. وإن كانت لنا كلمة عن المنتج المعرفي الخاص بتلك التجربة وضم كتابنا هذا نخبة من أفضله، نقول إننا نقدّر كل جهد جاد صرفه صاحبه من أجل تقديم إضافة نوعية إلى الإنتاج الكتابي عن تاريخ المصريين الثوري، وفي القلب منه ثورة 1919. لكننا نرى أن هذا الإنتاج، كمًا ونوعًا، لا يعني أن بحر ثورة 1919 قد اجتيزت مياهه ولم يبق في معينه زيادة لمستزيد، بل ثمة جوانب ومسائل كثيرة تبقى في حيز المسكوت عنه، داخل نطاق لم تبدد ظلمته إضاءات معرفية، ونعرف أن ذلك يرتبط بكثير من أزمات ومشكلات الكتابة التاريخية في مصر وبالقائمين عليها، لكننا نأمل في محاولات جادة لاجتيازها تسهم في تطوير معرفتنا ووعينا التاريخيين.
نجلاء مكاوي
الجيزة في 21 نوفمبر 2019
*****
الهوامش:
[1] مذكرات سعد زغلول، تحقيق: د. عبد العظيم رمضان، الجزء التاسع، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998)، ص 73.
[2] عباس محمود العقاد، سعد زغلول سيرة وتحية، (القاهرة: مطبعة حجازي، 1936)، ص 221.
[3] الاقتباسات الثلاثة من مذكرات سعد زغلول غير المنشورة، الكراس 9، ص400، نقلاً عن: عبد الخالق لاشين، سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية حتى سنة 1914، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2010)، ص227، 228 ـ 229.
[4] طاهر عبد الحكيم، الشخصية الوطنية المصرية: قراءة جديدة لتاريخ مصر، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012)، ص 211.
[5] على سبيل المثال، من الدراسات التي أنجزها تلاميذ غربال وتحت إشرافه، رسالتي أحمد الحتة للماجستير والدكتوراه عن “الفلاح المصري في عهد محمد علي” و”تطور الزراعة المصرية في النصف الأول من القرن التاسع عشر”، ورسالتي أمين عفيفي عن “استقرار الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر” و”تجارة مصر في عهد محمد علي”، ورسالتي أحمد عزت عبد الكريم عن “تاريخ التعليم في عصر محمد علي”، و”تاريخ التعليم في مصر من نهاية حكم محمد علي إلى أوائل حكم توفيق”.
[6] في تلك الفترة أيضًا، كتب السوربوني -الذي عُرف بهذا الاسم نسبة إلى جامعة السوربون التي كان أول مصري يحصل على شهادة دكتوراه الدولة منها- أحد الكتب المؤسسة للمدرسة الوطنية في الكتابة التاريخية، وهو “نشأة الروح نشأة الروح القومية المصرية 1863-1882″، الذي استند فيه إلى نظرية البطل الفرد، فأرجع إلى محمد علي وسياساته، وإلى النخبة المصرية، ما أسماه “استيقاظ الشعور القومي والروح القومية المصرية”. وأعقبه بكتاب “تاريخ مصر الحديث من محمد علي إلى اليوم”، الصادر عام 1926.
[7] نص الميثاق في: وثائق ثورة يوليو: فلسفة الثورة، الميثاق، بيان 30 مارس، (بيروت، دار المستقبل العربي، 1991).
[8] هذا النص لصلاح عيسى ينتمي، كما هو واضح، إلى مدرسة الكتابات التي توسلت المادية التاريخية منهجًا لفك مغاليق التاريخ المصري الحديث. وبناءً عليه فهو ينتمي، كما هو الحال فعلًا، إلى القسم الرابع من الكتاب. لكنه كذلك، ومن ناحية أخرى، يتناول “المفاوضات” المصرية-البريطانية، التي بدأت بشكل غير رسمي، ثم انتقلت إلى شكلها الرسمي بعد خمود انتفاضة مارس-أبريل 1919. وبهذا المعنى، فهو من الممكن أن ينتمي إلى القسم الخامس المعنون “من الانتفاض إلى السياسة”، حيث أنه يلقي ضوءًا على المسار التفاوضي اللاحق لانتفاضة مارس-أبريل.
[9] نلفت عناية القارئ إلى أن هناك موضوعات ذات أهمية تتعلق بثورة 1919 لم نُضِّمن كتابنا نصوصًا عنها، وذلك بسبب الالتزام بحجم معين للكتاب. ومن تلك الموضوعات: المرأة، والأقباط، وتأثيرات الثورة المصرية على الحركة السياسية في السودان.