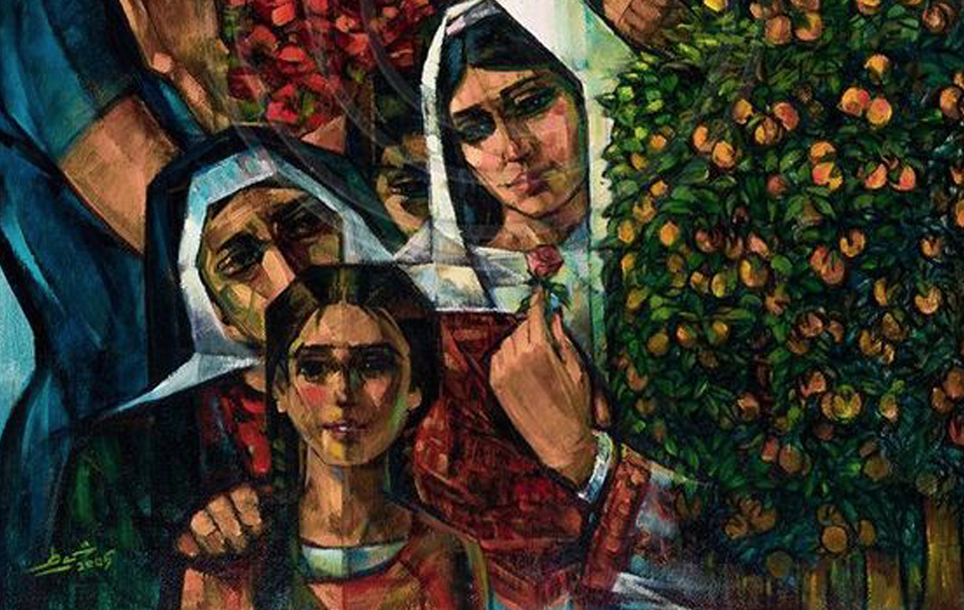يتناول هذا المقال، لأحمد العاروري، إحدى المنافسات الرياضيّة الشعبيّة الأكثر انتشاراً في العقود السابقة، وهي لعبة كرة القدم السُباعيّة، والتي انتشرت في القرى والمخيّمات وبعض المدن، وحملت أبعاداً اجتماعيةً ووطنيةً وسياسيةً تتجاوز البعد الرياضيّ والشبابيّ.
“السُباعيّات” وأيام الانتفاضة
لسنواتٍ عديدةٍ، كان الإعلان عن انطلاق دوري السُباعيات، بطولة كرة القدم التي كانت تنظّم بمشاركة الفرق المحليّة، من الأحداث التي تنعش صباحات قُرانا وتجذب مختلف الفئات الاجتماعيّة والعمريّة، سواءً كلاعبين أو مشجّعين ومتفرّجين، وسُمّيت بذلك نسبةً إلى عدد لاعبي كلّ فريقٍ. [1]
ووفقاً لعددٍ ممّن عاصروا أوجَها، انتشرت السُباعيّات في القرى والمخيّمات أكثر من المدن؛ نظراً لاحتفاظ الأخيرة بأنديتها التي واصلت نشاطها في البطولات الكبيرة، بالإضافة إلى دوريّات كرة القدم التي كانت تنظّمها الفصائل الوطنيّة أو المراكز الشبابيّة وشباب المساجد، وهو ما نلاحظ تقلّصه بعد العام 2007.
وبفعل الإغلاقات خلال انتفاضة الأقصى، اشتدّ الترابط الجغرافيّ والاجتماعيّ في الأرياف، ممّا انعكس على انفتاح القرى المتجاورة على بعضها وزاد من الاعتماد على القرى الكبرى، والتي كانت تشكّل مركزاً تتمّ فيه غالبية النشاطات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بالإضافة للدوريّات الرياضيّة. امتدّت هذه العلاقات الاجتماعيّة إلى قرى ومخيّماتٍ متباعدةٍ من خلال الرياضة، والتي كانت عنصر الربط الرئيسيّ بينها وكان لها دورٌ مهمٌ في تعزيز الهوية الوطنيّة. وفي الوقت عينه، شكلّت بعض الأندية والمراكز الرياضيّة تجمّعاً للعمل النضاليّ لا الرياضيّ فحسب.
ولم يغِب الشهداء والأسرى عن السُباعيّات، سواءً بصورهم التي كانت تعلو المنصّات أو تلك المرسومة على صدور اللاعبين وجدران الملاعب، إضافةً إلى البطولات التي حملت أسماء الشهداء. كما كانت تُفتتح المباريات بالنشيد الوطنيّ، ومن ثمّ أغاني وأناشيد الانتفاضة التي صارت من المحفوظات لجيلنا وغيره مثل “وين الملايين”. بينما صدحت السمّاعات، بين المباراة والأخرى، بأغانٍ وأهازيج لمحمد الدرة وإيمان حجّو وفارس عودة ويحيى عياش وأبو جندل وغيرهم ممن استحالوا “أيقوناتٍ” ورموزاً شعبيةً للانتفاضة.
أذكر كيف كان لاعب كرة القدم فاكر عزيز عرار شعلةً من الحيويّة والنشاط في الملاعب والحركة الطلابيّة، وكذلك في المواجهات مع قوات الاحتلال. اعتادت يده، كقدمه، سرعةَ الحركة، فكان يتحكّم ويدوّر الزجاجات الحارقة كالكرة بمهارةٍ محدثةً كتلاً من اللهب على سقوف الآليات العسكرية.
في صباح الرابع والعشرين من نيسان 2003، وبعد أن أنهى فاكر دوامه المدرسيّ، داهمت قوّةٌ من جيش الاحتلال بلدة قراوة بني زيد بهدف اعتقاله، لتدور مواجهاتٌ عنيفةٌ في البلدة بين الشبّان والجنود. أفلت فاكر من الاعتقال، ولكنّه أصيب بعدّة رصاصاتٍ خلال هذه المواجهات، ليستشهد على إثرها في السابعة عشرة من عمره. أتعب فاكر مُطارديه، وقالوا بعد رحيله إنّه كان ناشطاً في خليّةٍ للمقاومة. ومنذ استشهاده، يتمّ إحياء ذكراه في بطولةٍ رياضيّةٍ سنويّةٍ تحمل اسمه، وبقي حاضراً في زاوية كلّ ملعبٍ جرى فيه وتنفّس عشق كرة القدم.

قوانين اللعبة
تستمرّ المباراة في دوري السُباعيّات لمدّة 15 دقيقةً فقط، تبدأ بالمجموعات ويلعب المتأهل منها في دور الـ 16، ثمّ ربع النهائي ونصف النهائي إلى المباراة النهائية التي يكون الفائز فيها، بطبيعة الحال، صاحب لقب البطولة. وفي مباراة كرة القدم “الشعبيّة” هذه، كان الأكثر جمالاً بنظري هو أنّ قانون اللعبة لم يكن مقدّساً بالشكل الذي يكون عليه في البطولات الرسميّة.
لم يحمل الملعب من مواصفات الملاعب سوى اسمه، فكان سقوط لاعبٍ على أرضه الخشنة التي تكسوها طبقةٌ خفيفةٌ من التراب كفيلاً بتحطيمه وإرغامه على التغيّب عن اللعب لأشهرٍ. [2] بينما وفّرت هذه الدوريّات، قبل انتشار أكاديميّات كرة القدم في بلادنا، فرصةً أمام اللاعبين الذين تعلّموا الكرة في الشوارع لاستعراض مهاراتهم أمام الجماهير.
تحوّل بعض اللاعبين إلى نجومٍ محلّيين، يجري من يسجّل هدفاً منهم صوب جمهوره كنجوم الكرة العالميّين، بينما أشعلت المسلسلات الكارتونيّة اليابانيّة، كـ “أبطال الملاعب” الذي عُرض في السبعينيّات والثمانينيّات، و”الكابتن ماجد” و”الكابتن رابح” في الثمانينيّات والتسعينيّات، خيال أجيالٍ من الفتية ولاعبي كرة القدم لتقليد أبطال المسلسل و”ضرباتهم القاضية” نحو الشِباك.
أما الجماهير، فكانت تندفع في لحظة جنونٍ بشكلٍ جارفٍ إلى أرض الملعب بعد تحقيق هدف النصر، أو تقف مباشرةً خلف الحارس أو اللاعب خلال تسديد ضربة جزاءٍ، دون أن تمنعها نداءات مسؤولي النادي أو لجان النظام من القيام بذلك.

في حين كانت جوائز البطولة على شكل تبرّعاتٍ من رجال الأعمال وأصحاب المحلّات التجاريّة، والذين يتمّ إغداقهم خلال الدوري بالشكر والعرفان من مسؤولي النادي ومعلّقي المباريات المتسمّرين خلف السمّاعات الكبيرة من أول ساعات الصباح حتى انتهاء البطولة.
وفي بعض جوانبه، كان دوري السُباعيّات تكثيفاً لعلاقاتٍ وصداماتٍ اجتماعيّةٍ وإنسانيةٍ، ويُمكن في بعض الأحيان تلمّس المنافسة بين بعض العائلات. ولم يخلُ توزيع الجوائز على الفائزين من الطرائف، فقد يُقدم أحد الأندية المنظِّمة للدوري على تبديل كأس البطولة الأولى بكأسٍ أخرى، إن كان الفائز غريمه التاريخيّ أو من القرى المجاورة التي تتنافس دائماً على كثيرٍ من الأشياء من بينها كرة القدم.
أذكر المنافسة “حامية الوطيس” بين قريتي عارورة وجارتنا مزارع النوباني، والتي أصبح يحلو لكلّ الفرق الأخرى الوافدة على الدوريّات انتظارها لما كان يصاحبها من حرارةٍ في المنافسة وصداماتٍ بين الجماهير. رافق مباراة “الديربي” هذه في بعض الأحيان صداماتٌ عنيفةٌ انتقلت من اللاعبين إلى الجماهير، والتي كانت تتراشق الهتافات من على ما يُمكن أن يُطلق عليها مجازاً بـ “المدرّجات”، تحت شجر السرو العالي المزروع منذ سنواتٍ طويلةٍ حول ملعب مدرستي المهجورة الآن.
ورغم تباعد السنوات، تبقى الذاكرة الجماعية مختزنةً بقصصٍ ونوادر شهدتها هذه الدوريّات. عن اللاعب الذي مزّق “الكرت الأصفر” بعد أن وجّهه له الحكم لأنّه رأى في ذلك ظلماً له، أو لأنه هو من لوَّن الكرت في الليلة التي سبقت البطولة، أو عن الطفل الذي وقف خلف حارس الفريق المنافس مباشرةً راغباً في التدخّل لصالح الفريق الذي يشجّعه، لتنفجر بعدها خلافاتٌ بين الفريقين حول صحة الهدف الذي أدخله الطفل وتوارى عن الأنظار، الأمر الذي تطلّب تدخل وجهاء بلدتين لحلّ الإشكال.

كرة القدم للجميع
ليست الكرة في هذه الرياضة مجرّد “طابة” تتناقلها الأرجل على الملعب، بل هي مزيجٌ من الحبّ والآمال والفخر والحسرات. ويكون التميّز داخل الملعب للموهوبين كرويّاً، أذكر مثلاً تفوّق لاعبٍ يُدعى نعيم، من قرية عموريّة [3]، من بين الجميع. كان صاحب موهبة ساحرةٍ في تمرير الكرة والمرواغة وإرباك الخصم، وكان يلعب حافياً دون حذاء.
كما لم تحتَجْ الفرق التي تنوي المشاركة في السُباعيّات لرصد ميزانياتٍ كبيرةٍ. ففي أحد الدوريّات، جمع أعضاء فريقٍ من الهواة رسوم الاشتراك فيما بينهم، وكتبوا اسم فريقهم “أبطال البوكيمون” بعلبة رشٍّ على قمصانهم البيضاء. لم يملك أيٌّ منهم المهارة أو الاحتراف، ولكن يكفي ما صنعته هذه المجموعة من بهجةٍ بين الجمهور.
عزّز دوري السُباعيّات روح التعاون الجماعيّ لدى أجيالٍ عديدةٍ، حيث كانت تُوزّع المهام المتنوّعة المطلوب إنجازها في البطولة بين من يُكلَّف بتنظيف الملعب وتجهيز المرمى أو توزيع الدعوات للأندية، في حين تكفّلت بيوت البلدة بإعداد الطعام للفرق المستضافة. عدا عن ذلك، شكّل انعقاد الدوري فرصةً اقتصاديةً نوعاً ما لعدّة عائلاتٍ، فيبدأ في الليلة التي تسبق البطولة توزيع البسطات التي تتنوّع مبيعاتها بين المأكولات والساندويشات المختلفة، وبخاصةٍ “الفلافل” والعصائر والدخان وغيرها.

طرأت تغيّراتٌ عديدةٌ على البنية الاجتماعية بين فترة الانتفاضة وما قبلها والمرحلة الحاليّة، وما رافق ذلك من تراجعٍ في العمل التطوعيّ والفعاليات الرياضيّة الشعبيّة. وفي ذات الوقت، ازداد الاهتمام الشعبيّ بدوريات كرة القدم الأوروبية والمنافسات العالميّة، وانصبّ اهتمام الجيل الصاعد عليها أكثر ممّا كان عليه الحال سابقاً. انعكست هذه التحوّلات بصورةٍ ما على الاهتمام بالبطولات الشعبيّة على شاكلة دوريات السُباعيّات.
ووفقاً لكثيرٍ من المهتمّين بالرياضة في فلسطين، كان انطلاق “دوري المحترفين”، بصورته الجديدة بعد العام 2010، أحد مسبّبات تراجع مستويات الفرق الصغيرة في القرى، على الرغم من الرأي الداعم لهذه الدوريّات، والذي يرى فيها فرصةً للجيل الصاعد من اللاعبين لتطوير مهاراتهم والتنافس للوصول إلى الأندية الكبيرة، وما تقدّمه لهم من إمكانياتٍ وملاعب مؤهلةٍ.
أطاح الاهتمام المُبالغ به بأندية المحترفين بكثيرٍ من الأندية الصغيرة في القرى والبلدات، وأضاع كثيراً من البهجة التي كانت تصنعها البطولات الشعبيّة. فعلى الرغم من استناد عددٍ من الأندية الكبيرة في جزءٍ من تمويلها على اشتراكات جمهورها ومحبّيها، لا تملك الفرق الصغيرة ميزانياتٍ تسمح لها بشراء لاعبين جدد أو الاحتفاظ بالمميّزين من لاعبيها، والذين فُتحت أمامهم فرصٌ للعب مع أنديةٍ أكبر في نظام الاحتراف اليوم، وهو ما انعكس على أدائها وشعبيّتها.
وإلى حدٍّ ما، ساهمت الدوريات الكبرى في تبهيت الدور السياسي للرياضة في فلسطين، وهو دورٌ لا أدّعي أنّه انتهى، فهناك عشرات الأسرى والشهداء خلال السنوات الأخيرة من الرياضيين، فضلاً عن بعض النماذج الملهمة التي تمكّنت من الاستقلال عن هذه الحالة، ولكنّ هذا الدور قد تأثّر بشكلٍ بالغٍ لعدّة أسبابٍ مجتمعةٍ، منها “دوري المحترفين”. وما يلزمنا اليوم هو استعادة الرياضة الفلسطينية في صورتها الشعبيّة الوطنيّة، بعيداً عن اشتراطات الرعاة والشركات التجارية.

في الحنين لزمنٍ مضى
دائماً ما أتخيل ملعب بلدتنا، الذي لا يحمل من المواصفات العالمية شيئاً لا في مساحته ولا بأرضيّته الجافة والصلبة، مسكوناً بالحكايا وبأنفاس من لعبوا عليه وتحوّلوا في فترةٍ من العمر لأبطالٍ محليّين، في الرياضة التي كانت تُعرف بـ”لعبة الفقراء”. أسيرُ على أرضه التي كستها الحشائش، بعد أن هجرته أقدام اللاعبين، ولا تتوقف ذاكرتي عن استحضار المشاهد التي اكتنزت فيها لسنواتٍ:
من منتصف الملعب حقّق خالد هدفاً خرافيّاً، هُنا كان أحمد يداعب الكرة كطفلٍ مدلّلٍ بعد هروبه من ورشة البناء، وأمام المرمى كان يفرش إياد الرمل لحماية نفسه عند الارتطام بالأرض بعد قفزاته المشهورة للتصدّي للكرة، يزيد من حماسه فيها تشجيعاتنا نحن الأطفال الذين كنّا نواظب على الوقوف خلفه مباشرةً هاتفين “حارسنا زي السمكة بأساليبه يحمي الشبكة”.
هكذا كانت تدور نهارات الجمعة في صيف عددٍ من القرى الفلسطينيّة، قبل ظهور “دوري المحترفين برعاية جوال”.
****
الهوامش:
[1] سُمّيت بالـ “خُماسيّات” في بعض المناطق، وانتشرت في المدن لا سيّما في الأمسيات الرمضانية، ولكن بشكلٍ محدودٍ.
[2] تنتشر اليوم ملاعب معشّبةٌ تجذب إليها معظم عشّاق وهواة اللعبة، بينما بقيت ملاعب أخرى على حالها بعدما هُجرت وتمّ إهمال أغلبها.
[3] قريةٌ صغيرةٌ تقع على جبلٍ مُشْرفٍ على الطريق بين نابلس ورام الله.