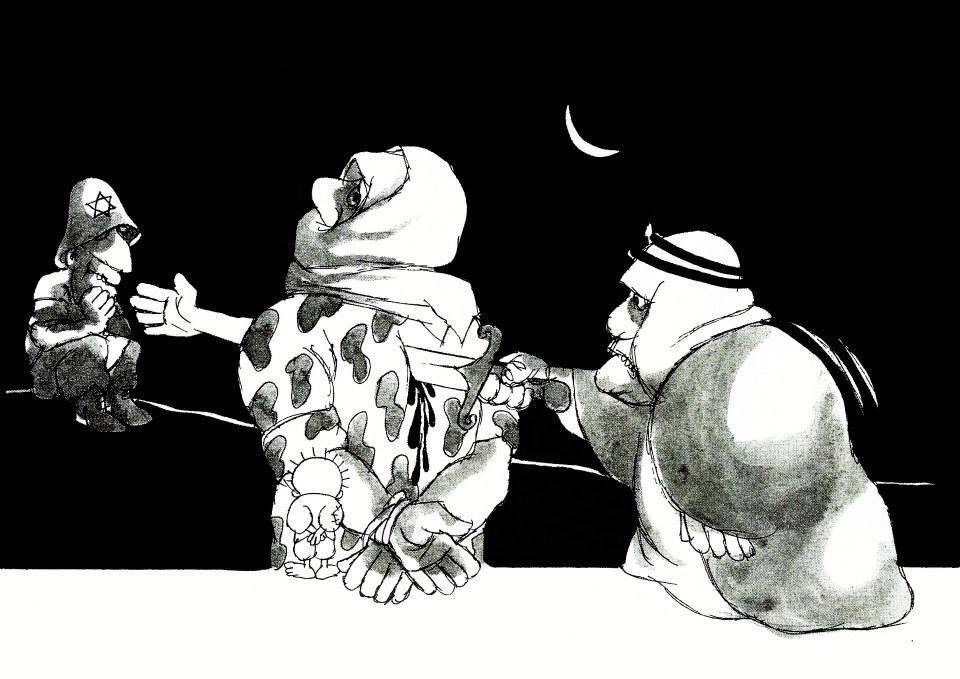يقدّم أحمد الشولي في هذا المقال نقداً للتحفظّات المتعلّقة بـ “ساندرز” والقضية الفلسطينية، مجادلاً أنّ التغيير الذي طرحه المرشح الديمقراطي في المبنى الكليّ للدولة الأمريكية من شأنه تقويض أساسات المبنى الإمبريالي الشامل.
في الثامن من نيسان، أعلن “بيرني ساندرز” عن انسحابه من السباق على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مفسحاً في المجال أمام “جوزيف بايدن”، نائب الرئيس الأمريكي السابق. وخلال حملته الانتخابية، أثار “ساندرز” اهتمام الفلسطينيين والعرب وأصدقائهم في الولايات المتحدة، سلباً وإيجاباً.
هل حقّاً فتح “ساندرز” أبواباً جديدةً أمام القضية الفلسطينية لطالما كانت مغلقةً أمامها، أم أنّه أبطأ من تحوّلات الرأي العام الأمريكي الإيجابية تجاه فلسطين؟ هل كان “ساندرز” وحملته مفيدين للقضية الفلسطينية، أو حتى عموم أحوال المنطقة العربية التوّاقة إلى العدالة الاجتماعية والديمقراطية والأمن والسلام؟
أحاججُ في هذا المقال بأن الإجابة على السؤال الأخير هي نعمٌ مؤكّدةٌ لأسبابٍ مباشرةٍ وغير مباشرة. انتهت حملة “ساندرز” الانتخابية، لكنّ مشروعه السياسيّ قدّم مخرجاً من هوْل اللاممكن الذي يحتجز القضية الفلسطينية.
التقط العديد من الفلسطينيين ما يطرحه الرجل إيجاباً، حيث اصطفّ وراء “ساندرز” عددٌ من منظّمات وأصوات الأمريكيين-الفلسطينيين مثل موقّعي هذا البيان، والناشطة ذائعة الصيت ذات الأصول الفلسطينية، ليندا صرصور، وأوّل نائبةٍ من أصولٍ فلسطينية في “الكونجرس” الأمريكي، رشيدة طليب. وينسحب هذا التأييد على الأوساط العربية الأوسع، كانخراط مجموعة عملٍ عربيةٍ في حملة “ساندرز”، والتي قادت جزءاً من حشد الأصوات العربية وغير العربية لأجله، ممّا عبّر عن اصطفافٍ استثنائيّ داخل الوسط العربي والإسلامي خلفه. فقد حصد “ساندرز” على أصوات المسلمين أكثر من “هيلاري كلينتون” في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في العام 2016، بينما أشارت أوّل دلائل 2020 إلى تأييدٍ واسعٍ ضمن الوسط الإسلامي لـ “ساندرز” أمام منافسه على بطاقة ترشيح الحزب، “جوزيف بايدن”.
وإذا ما نظرنا لسجلّ “ساندرز” فيما يخصّ منطقتنا العربية، فإنّ لهذا التأييد ما يبرّره. فقد عارض قرار الحرب على العراق من موقعه في مجلسيْ النواب والشيوخ الأمريكيين في أعوام 1991 و2003، كما يجاهر بكراهية “هينري كيسنجر” (أحد عرّابي العسكرة في سياسات أميركا الخارجية، ومهندس انتصار “إسرائيل” في حرب العام 1973)، بالإضافة إلى مواقفه ضدّ تغوّل الأجهزة الأمنية بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول مستهدفةً المسلمين بشكلٍ استثنائي. كما حاول استصدار تشريعاتٍ تمنع الإدارة الأمريكية من مساندة السعودية في حربها الكارثية على اليمن التي بدأت في العام 2015، وهذا جزءٌ من رفضه التام لعسكرة أيّ خلافٍ سياسي، حيث ساوى الرجل بين احتلال العراق من جهةٍ، وفرض مناطق حظرٍ جوي لتحييد مخاطر القذافي والأسد من جهةٍ أخرى.
كما ويُمكن القول إنّ “ساندرز” مثّل، وبشكلٍ واضح، أكبر شوكة في حلق الوسط الصهيوني في أميركا اليوم، وكان ذا حظوظٍ جدية للترشّح والفوز. فهو أوّل مرشحٍ للرئاسة الأمريكية من أصولٍ يهوديةٍ ويعادي منظمة “الإيباك”؛ أُمّ المنظمات الحاشدة لدعم “إسرائيل” في الولايات المتحدة. فبينما اعتذر في دورة انتخابات 2016 عن حضور مؤتمر المنظمة السنويّ بحجّة تضارب المواعيد، اعتذر هذا العام بشكلٍ صريح لأنّ المنظمة، وبحسب قوله، توفّر منصّةً لبثّ العنصرية وإنكار الحقوق الأساسية للفلسطينيين. وفي إحدى جولات المناظرة ضدّ “كلينتون” في عام 2016، قال “ساندرز” إنّه يتعيّن على أميركا أن تقول لـ “نتنياهو”، عندما يخطئ، إنّه على خطأ. واليوم، بات يصف “نتنياهو” بأنّه “شخصٌ عنصري”، ويدعو لتوجيه الدعم الأمريكي لـ “إسرائيل” نحو حثّها على التنازلات، قائلاً إنّه سيبحث، كرئيس، إمكانية إعادة السفارة من القدس إلى “تل أبيب”، بالإضافة طبعاً إلى تصدّيه لهجمات اللوبي الداعم لـ “إسرائيل” الساعية إلى تجريم أنشطة حملة المقاطعة الدولية (BDS).
باختصارٍ، لا يُعيد الرجل إنتاج مسرحيات “أوباما”، من خطاب القاهرة الشهير عن الديمقراطية والتسامح على مقاس حسني مبارك، والذي جلس بجوار “أوباما” أثناء إلقاءه خطبته العصماء عن الاحترام المتبادل، أو المفاخرة في الانسحاب الجزئيّ من العراق مقابل تسعير حرب الطائرات المسيّرة بصمتٍ في اليمن ووسط آسيا والقرن الإفريقي، أو استجداء وقف الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية. يخالف “ساندرز” الطبيعة المستقرّة للتحالف الأمريكي مع “إسرائيل” منذ ستينيّات القرن الماضي، بمنطق إجبارها وليس استجدائها لإيجاد حلٍّ ما، ولا يسكت على فظائع الدكتاتوريات العربية، كما يعارض عموم النهج العسكريّ الذي حرق المنطقة طوال عقود من الزمن.
لكن لـ “ساندرز” نقّاد أيضاً
في المقابل، يرى البعض أنّ لا ضرورة لتمييز “ساندرز” كثيراً عن الطبقة السياسية الأمريكية، على اعتبار أنّ الاختلاف في الدرجة، لا في النوع. مثلاً، يقول ستيف سلايطة إنّ الاحتفاء بـ”ساندرز” غير مستحق، فسجلّه التصويتي أو خطابه العام فيما يخصّ فلسطين متقلّب؛ عدا عن كونه غير مؤيدٍ لحملة المقاطعة الدولية (BDS)، فهو لا يعِد بأكثر من الكرامة والاحترام للفلسطينيين، بحسب سلايطة. ووفقاً لجوزيف مسعد، وعبر تبنيه برامج السلام التي تطالب بوقف العنف – وكأنّه متكافئ أو متبادل – يعزّز “ساندرز” مكاسب “إسرائيل”.
وفيما يخصّ السياسية الخارجية لـ “ساندرز”، يرى فادي بردويل شيئاً مشابهاً، فسجلّه متضاربٌ على هذا الصعيد أيضاً: هو ضدّ الحرب على العراق، لكنّه كان معها في أفغانستان، وهو ضدّ الحظر الجوي على سوريا، لكنه أيّد حرب “أوباما” على تنظيم “داعش”. وكما يُشير فراس البيجاوي بأنّ “ساندرز”، في نهاية المطاف، في قلب المركز الإمبريالي، وقد سبق أن صوّت لصالح ميزانيات وزارة الدفاع باستمرارٍ منذ غزو العراق، ودعم عدداً من حملات العقوبات على بلدان مختلفة. أما أسعد أبو خليل، فقد كتب في عام 2016 أنّ “ساندرز” مرشحٌ فرضته الأزمة المالية في عام 2008 وتداعياتها، وستلفظه الاتجاهات المحافظة المهيمنة في أمريكا، على الرغم من اعتدال أطروحاته، مصنّفاً إياه على يمين الرئيس الفرنسي السابق من الحزب الاشتراكي، “فرانسوا أولاند”. وفي عام 2020، حاجج أبو خليل أنّ مأسسة القرارات وعقلانيتها في أميركا لن تعطيَ “ساندرز”، الاشتراكي النزعة، فرصةً لإيقاف نزعة الحرب في الإمبراطورية، معترضاً على دعم العرب له على الرغم من قوله، أيّ “ساندرز”، إنّه متعاطفٌ مع “إسرائيل” بنسبة مئةٍ بالمئة.
كُتّابٌ آخرون رأوا أنّ أيّة انعطافاتٍ إيجابيةٍ بخصوص فلسطين في حملة “ساندرز”، ما بين 2016 و2020، جاءت نتيجةً لضغوطٍ قاعديّةٍ تعرّض لها “ساندرز” في المرّتين، ودفعته لتطوير مواقفه بالاتجاه الصحيح. لكنّه، وبحسب “مايكل براون”، ما يزال يختلق فروقاتٍ وهميةً بين “نتنياهو” و”غانتز”، على سبيل المثال. وحول أهمية حملة “ساندرز”، رأى عمر زهزه أنّها كانت تكمن في الزخم الذي أعطته للحملات الحراكية، على أنواعها، وفي مدى انفتاحها عليها وبناء مواقفها على إثر التواصل معها؛ أيّ أنّها مهمةٌ بشكلٍ غير مباشر، وبمقدار القوة التي أتاحتها للحراكات المختلفة، من ضمنها مجموعات العمل لأجل فلسطين.
إذن، أثارت حملة “ساندرز”، بحسب هذه المراجعة للمواقف من حملته، أربعة تحفظاتٍ لدى متابعين وكُتّاب عن شؤون المنطقة: أوّلاً، “ساندرز” أفضل من غيره، ولكنّه دون المأمول. ثانياً، “ساندرز” متضاربٌ، فهو يفعل الشيء وعكسه في آن. ثالثاً، أميركا لا تقبله، فهو على الهامش، على الرغم من اعتدال طروحاته. ورابعاً: قوته ستزيد بمقدار دفعه أكثر إلى اليسار من قبل النشطاء والحراكات المختلفة.
أقدّم نقداً لهذه التحفظّات المتعلّقة بـ “ساندرز” وفلسطين بدءاً من نقطةٍ أبعد من فلسطين وكلّ المنطقة. إنّ المنفعة المتأتية لفلسطين، أو المنطقة العربية عموماً أو سائر العالم، تنبع، قبل أيّ شيءٍ، من تغييرٍ محتملٍ في أميركا نفسها، وليس عبر اعتماد سياسةٍ خارجيةٍ ما، دون التفكير بالأساس الاجتماعي الذي يحفّز أيّ سياسةٍ ويحمي وجودها. إن ما طرحه – وما يزال يطرحه – “ساندرز” أمامنا جميعاً هو تغييرٌ في المبنى الكليّ للدولة الأمريكية، من آليات ممارسة السياسة التي تعطي الطبقات العاملة سيطرةً وازنةً على الدولة، وبالتالي في التزاماتها الأساسية تجاه مواطنيها، وأخيراً في الوظائف المباشرة المعبّرة عن هذه الالتزامات. هكذا تغييرٌ سيقوّض أساسات المبنى الإمبريالي الشامل، من خلال تجفيف مصادر تمويل آلة الحرب أولاً، وتفكيك الوظيفة التي قامت لأجلها هذه الآلة ثانياً.
إن تشكّل أفق تغييرٍ عميقٍ في الدولة الأمريكية نفسها، وفي ركائزها الاجتماعية الأساسية، يجعل الحديث المنفصل عن خيارات السياسة الخارجية التي يحملها مرشّحي الرئاسة الأمريكية، “تغميساً خارج الصحن”. هذا طبعاً مع القناعة بأنّ ما طرحه “ساندرز” هو منطق التهديد والمقايضة مع “إسرائيل”، على عكس منطق استجدائها لتجود بالفتات الذي تريد كلّ بضعة سنوات. ستيف سلايطة لا يتوقّع من “ساندرز” أن يذوّت الخطاب الوطني الفلسطيني، وهذا توقّعٌ معقول، ولكنّه لا يوضّح طبيعة المنطق الذي يقوده إلى ذلك، بينما ينتقد خيارات “ساندرز” السياسية.
إنّ المنطق الماثل أمامنا اليوم هو أولوية بناء أكبر حلف اجتماعيّ قادرٍ على تغيير أميركا نفسها لارتدادات ذلك الإيجابية على الجميع. لن تربح فلسطين بأن يتمّ الدفع بالمرشّحين الرئاسيين إلى اعتناق مطالب أقصى اليسار في أميركا – ليس اليوم على الأقل – بل في كسب وسط المجتمع الأمريكي، الأكبر عدداً والأوسع على سلّم الدخل. وذلك على برنامجٍ اجتماعيّ ينزع الشرعية عن منظومة الحكم القائمة بأهدافها، حيث تستنبط “إسرائيل” قوتها والأدوار التي تلعبها والمصالح التي تخدمها. لا حاجة لفلسطين بشهداء كلمة حقٍّ داخل العملية السياسية الأمريكية. ولكن، لن تتبدّل أيّ سياسةٍ بقوة الإقناع والحجّة، بل بالتقاء مصالحٍ مثمر. كما علينا ألّا نتوقّع من شعبٍ كاملٍ أن يصبح حراكياً لأجل فلسطين وينتخب قادته لأجلها، فذلك موقفٌ دعويّ وأخلاقويّ يستثير في الناس تعاطفها، دون مراعاة مصالحها بالضرورة.
لقد أنجزت مجموعات العمل من أجل فلسطين الكثير داخل الجسم الطلابي في أميركا، وداخل المجتمع اليهودي الأمريكي، وعموم المجتمع الأمريكي. هذا بالإضافة إلى حملات المقاطعة والبدء بمشاريع قانونية. ولكن، تجدر الإشارة إلى أنّ مواجهة مصالح “إسرائيل” معركةٌ قد تنجح بعض الدوائر الحلقية في إصابتها بأضرارٍ معتبرة، مثل حملات سحب استثمارات صناديق التقاعد الجامعية من شركاتٍ عاملة في “إسرائيل”، حيث لا ارتباط عضوياً وأبديّاً هنا بين صناديق التقاعد و”إسرائيل”. يتزعّم “شيلدون أديلسون”، المتبرع الأكبر لحملات “ترامب” و”نتنياهو” الانتخابية، القطبَ الصهيوني في أعلى مستويات رأسماليّي أميركا اليوم، لكنّ الارتباطات السياسية لهذا القطب غير معمّمةٍ على كامل الطبقة، بل هي متعايشةٌ فحسب، وأحياناً متشاركة. ولا يمكن، منطقياً، أن يُرتهن الاقتصاد الأميركي الذي يفوق اقتصاد “إسرائيل” 55 مرةً بمصالح هذه الأخيرة الضيقة. جهدٌ معقول من النشطاء في أميركا كان كفيلاً بإلحاق عدّة أضرارٍ بمصالح “إسرائيل” الحيوية بسبب عدم الاتساق التامّ بين الجانبين.
إنّ مواجهة المصالح المباشرة للطبقة الحاكمة في أميركا معركةٌ مختلفةٌ تماماً، وذلك بسبب كمّ المصالح المتكدّسة والمتشابكة في استدامة الأمر الواقع. للخوض في هذه المواجهة، لا بدّ من تثوير قطاعاتٍ واسعة من المجتمع الأمريكي نفسه على تناقضات هذا النموذج، ولا بدّ من طرح برنامجٍ مفيدٍ لشرائح عديدةٍ من المجتمع الأمريكي، يفوق مصالحها المتحقّقة في بقاء الوضع القائم. هذا هو لبّ حملة “ساندرز”: التغيير من خلال الوصول إلى السلطة عبر تأييدٍ انتخابي من أكبر عددٍ ممكنٍ من الطبقات الوسطى والعاملة، ويقوم على هدفٍ مشترك؛ برنامج إعادة توزيعٍ يرفع من مستوى معيشتهم الكلية.
لكن، وبحكم كون أمريكا دولةً متطورة اقتصادياً، تنقسم هذه الطبقات إلى شرائح متفاوتةٍ في الامتيازات، وتتعارض بدرجةٍ أو بأخرى حول ترتيب سلّم الأولويات. هذا بالإضافة إلى أن التفاوض العام والحرّ حول موائمة هذه الأولويات يتمّ في مجتمعٍ سبق وأن أطاحت الترتيبات النيوليبرالية بأغلب منظّمات طبقته العاملة، وأطاحت بالظروف الملائمة للتعبئة والتنظيم من خلال اتّساع دوائر العمل الهش. كما يتمّ التفاوض في فضاءٍ مشتركٍ مع أجهزة الرأسمالية الأيدولوجية، بشقّيها الليبرالي والمحافظ، والتي تبتز اختلافات الناس، وتفاوتاتِهم الواسعة، ومخاوفهم الواقعية، وتعمل على قوقعتهم عبر التهديد بمزيدٍ من التدهور في الظروف المعيشية. إنّ تشكيل أفكارٍ وانحيازاتٍ مرتبطةٍ بفلسطين، أو أيّ قضيةٍ عالميةٍ أخرى، يتمّ في هذه البيئة الفاسدة منذ عقودٍ عديدة.
نجح “ساندرز” في أن يكون السياسي الأكثر شعبيةً في أميركا بناءً على برنامجٍ اجتماعيّ ضمن هذه الظروف الطاردة، ويضيف إليه تحسيناً ما في التوجّه الأمريكي نحو القضية الفلسطينية. بكلماتٍ أخرى، قدّم الرجل وعداً مصحوباً بقدرةٍ على التطبيق. لا يجب على الفلسطينيين تقزيم مشاريعهم السياسية نحو سقوفٍ أدنى ليقبلها حلفاءٌ أقوياء، لكنّ العمل في ساحاتٍ خارج فلسطين، يهدف، منطقياً، إلى زعزعة هيمنة “إسرائيل” وقدراتها الكلية، لتحسين شروط النضال الاجتماعي في فلسطين نفسها. هو بالتعريف إذاً، تكتيكٌ مساند، يعمل ضمن أضيق المساحات المتاحة لتعظيم أيّ فرصةٍ قائمة، وليس البرنامج الشامل للتحرير. فلنتفق، إذن، على اعتبار الإمبريالية والصهيونية “ساندرز” تهديداً لمصالحهم، أنّها قاعدةٌ كافية لإيجاد عدّة نقاط التقاءٍ معه، والكفّ عن افتعال الدهشة من لفظ الصهيونية للرجل، لأنّ ذلك ليس أكثر من إغراقٍ في العبث والسفسطة.
يملك رأسماليّو أميركا، وطواقم إدارتها السياسية وحلفائهم من الصهاينة، وغيرهم من الشركاء وأصحاب الأدوار الوظيفية، كلّ الأسباب لعرقلة “ساندرز” ومشروعه السياسي العام؛ على الرغم من انكساره، وُفّقت حملته في الربط بين أزمةٍ اجتماعيةٍ كبرى تنتج ملايين الأشخاص المعبّئين من جهة، وبين برنامجٍ سياسيٍّ عميقٍ يدكّ أساسات الأمر القائم ويطيح بحظوظ المتربّحين منه محاولاً الإمساك بالسلطة، من جهةٍ أخرى.
أزمة اجتماعية عميقة
أن تكون أمريكيّاً اليوم، فهذا يعني أنّ دخلك الأسري، غالباً، يقلّ عن 62 ألف دولارٍ سنويّاً. يُقتطع من ذلك ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى انتسابٍ إلزامي في برامج التأمين الصحي، سواءً يتمّ اقتطاعه بشكلٍ مباشرٍ أو يتكفّل به صاحب العمل. تعادل هذه الاقتطاعات مجتمعةً نسبةً تفوق 43٪ من إجمالي الدخل، وهذه نسبةٌ تزيد عن جميع دول أوروبا، باستثناء هولندا. ولكن، هناك فارقٌ جوهري: لا يوجد تأمينٌ حكوميّ شاملٌ في أميركا كتلك الدول التي تقتطع نسباً متقاربةً من الأجور؛ فأكثر من ثلثي الشعب الأمريكي يحصل على تأمينٍ صحيٍّ من القطاع الخاص. تترك هذه الترتيبات 8.5٪ من السكان، تقريباً، بلا تأمينٍ صحي إطلاقاً، و29٪ بتأمينٍ صحي غير كليّ التغطية.
بالتالي، وعلاوةً على هذه الاقتطاعات، يُضطرّ الكثيرون إلى الدفع من جيوبهم الخاصّة للحصول على خدماتٍ طبيةٍ يحتاجونها، إذ تنفق أميركا على الصحة حوالي خُمس اقتصادها الوطني، أو تقريباً ضعف معدل إنفاق دول أوروبا على الشخص الواحد. هذا مع العلم أنّ الاضطراد في الإنفاق الصحي منذ عام 1960 إلى اليوم يزيد عن ارتفاع متوسط الأجور، ممّا يدفع الناس لتفادي العلاج طويلاً بسبب حدّة هذه النفقات، والذي يجعل بدوره نصف الأمريكان يعانون من أمراضٍ مزمنة، بينما يعاني ثُلثهم من ديونٍ طبية، إذ يبلغ متوسّط تكلفة زيارة غرفة الطوارئ 1400 دولارٍ تقريباً. لا تكمن النتيجة المُرّة لخصخصة الخدمات الصحية في الأموال المبدّدة على جيوش البيروقراطية التي تدير نظام المحاسبة وجني الأرباح شديد التعقيد، إنّما في فضائحية الحقيقة القائمة اليوم، وهي أنّ الدولة ذات الاقتصاد الأكبر في العالم لديها متوسط أعمارٍ آخذٌ في الانحدار.
إنّ الحلول السريعة للخروج من هذه الأزمات مستنفذةٌ تقريباً. فلا سقف يحدّ من عدد ساعات عمل الأجير الأمريكي، والذي يعمل سنويّاً ما مقداره أسبوعان إضافيان مقارنةً بالأجير الياباني، أو شهرٌ إضافي عند المقارنة بالأجير البريطاني، وشهران مقارنةً بالفرنسي. ويُضطّر من يتبقى لديه ساعاتٌ في يومه لعملٍ ثانٍ، وربما ثالث أيضاً؛ إذ يعمل 13 مليون أميركي في أكثر من وظيفةٍ واحدةٍ لتسديد التزاماتهم المعيشية. هذه المجهودات أدّت إلى تضاعف الإنتاجية بمقدار 400٪ منذ العام 1950. لكن، ومنذ العام 1968، تمّ وقف الربط بين الحدّ الأدنى للأجور والتضخّم من جهة، وبين الحدّ الأدنى للأجور والإنتاجية من جهةٍ أخرى، ليقف أجر الساعة في الحدّ الأدنى، المضمون فيدرالياً، عند 7.25 دولار، بدلاً من 24 دولارٍ لو تمّ الإبقاء على هذه الارتباطات.
في الواقع، يعبّر تواضع الزيادات الاسمية في الأجور عن عدم وجود زيادةٍ حقيقيةٍ فيها منذ منتصف السبعينيّات، على الرغم من كل هذه الثروة وكل هذا العمل. فلم يعُد الإغراق في العمل يهدف لزيادة المردود، إنّما غالباً للبقاء في العمل، فهذه هي معايير الوظائف اليوم. كما دفعت ظروف العمل القاسية وعدم موائمة الأجور في أميركا ما يزيد عن نصف مليون شخصٍ للتشرّد. فمثلاً، إنّ 10% من مشرّدي ولاية كاليفورنيا، حيث ترتفع تكاليف المعيشة وكُلفة الإيجارات السكنية، هم موظفون على رأس أعمالهم، ويتقاضون أجراً أكثر من ضعف الحدّ الأدنى للأجور.
ليست الحلول البنيوية للخروج من الأزمة أفضل حالاً؛ خيار التعليم للحصول على الوظائف الأعلى أجراً ليس خياراً متاحاً تماماً، إذ يلجأ أكثر من ثلثي الطلاب الجامعيّين للاقتراض من أجل الالتحاق ببرامج دراسية، بينما يتعثّر ثلثهم مالياً خلال 12 عاماً من الاقتراض، علماً بأنّ هذه المجازفة متاحةٌ فقط لمن تسنّى له الحصول على تأهيلٍ مدرسيّ مناسبٍ للقبول الجامعي. كما يعدّ الإنفاق الفيدرالي على التعليم المدرسي، الملتزم بالمساواة بين الجميع، محدوداً، واضعاً التعليم المدرسيّ في مجال الإنفاق البلدي المموّل من ضرائب الخدمات المحلية، على مستوى الحيّ الواحد. ولذلك، يرتبط مقدار تمويل المدرسة الحكومية، فعلياً، بثراء الحيّ الذي تقع فيه؛ أيّ أن أطفال الميسورين يرتادون مدارس أفضل تمويلاً بالضرورة، بينما يرتاد أطفال الفقراء، غالباً، مدارس مخصخصةً مُشرَّعاً لها معايير جودةٍ أدنى من المدرسة الحكومية التقليدية.
يستمرّ التعليم في طرح نفسه كخيارٍ مؤكّدٍ لتضمن الطبقات العليا امتيازاتها، حيث التحصيل العلمي شديد الالتصاق بالخلفية الاجتماعية. لكن بالنسبة للطبقات الدنيا، أو الوسطى أحياناً، في أميركا، يعدّ التعليم اليوم مجازفةً استثماريةً أكثر من كونه مصعداً مضموناً يرفع الناس بانتظامٍ، كما جرت العادة منذ بداية القرن العشرين. ومع تضاؤل آمال الناس في تحسين أوضاعها المعيشية ضمن الخطوط العامة، من تعليمٍ وعملٍ وبرامج رفاه، يصبح الانحدار إلى الجريمة مسألة وقت.
أصبحت أميركا، وليس من المصادفة في شيء، أكثر دولة فيها سجناء في العالم، ويقبع 8٪ منهم في سجونٍ خاصةٍ ربحية، ويعملون بمستوى أجورٍ أقلّ بكثيرٍ من الحدّ الأدنى السائد خارج الأسوار، حيث يعيش 40 مليون أميركيّ تحت خطّ الفقر. باختصار، إنّ طرقات الصعود الاجتماعي، أو حتى الصمود على نفس المستوى المعيشي، آخذةٌ بالانسداد، على الرغم من زيادة حدّة العمل، والنمو الاقتصادي الهائل على مدى عقود، والذي تشوبه الكثير من عدم المساواة؛ يملك أغنى ثلاثة أشخاصٍ اليوم في أميركا ثرواتٍ تزيد عمّا يملكه نصف المجتمع الأمريكي كاملاً (أيّ أكثر من 160 مليون شخص).
هذه الثروات تكدّست نتيجة الإفراط في استغلال الأُجراء، وتراجع ضرائب الدخل على الأثرياء، فضلاً عن تعطيش برامج الدعم الاجتماعي والرفاه، وتلك حقيقةٌ لا تفوت الأمريكيين، بالطبع. في المقابل، يبقى تعريف الأزمة من خلال خللٍ ما في إدارة الاقتصاد في صدارة الرأي العام الأمريكي في السنوات الأخيرة.
برنامج “ساندرز”
مع إطلاق حملته الأولى للترشح للرئاسة في عام 2015، قدّم “ساندرز” تفعيلاً لأفكارٍ اختمرت في المجتمع الأمريكي خلال عقدين أو ثلاثةٍ من التقشّف وشدّ الأحزمة، على الرغم من نموٍ فلكيٍّ في حجم الثروة الكليّة في المجتمع. مثلاً، برز تحوّلٌ في تفضيل أغلب الشباب الأمريكي للاشتراكية خلال العقد الأخير، كيفما تمّ تعريف الاشتراكية، وهو ما سعى برنامج “ساندرز” الانتخابي للبناء عليه لكسب قطاعاتٍ أوسع من المجتمع. لم يتّجه للتأميم، بما يُرضي جوزيف مسعد على الأقل، بل طرح أنّ بعض الضرائب على المضاربات المالية – شبه المعفاة حالياً – كفيلةٌ بتوفير التعليم الجامعي الحكومي مجاناً وإسقاط كافة الديون التعليمية الحكومية.
ومن خلال زيادة ضريبة الدخل بأقل من 2٪ على من يجني ربع مليون دولارٍ أو أكثر في العام، يتمّ توسيع برنامج الضمان الاجتماعي وضخّ السيولة فيه لخمسين سنةٍ قادمة. كما أنّ إقرار ضريبةٍ على الثراء، باقتطاع ضريبةٍ تبدأ من مبلغ 5 آلاف دولارٍ على الأسرة التي تفوق ثروتها 32 مليون دولارٍ (يصل عددهم إلى 180 ألف أسرة) يستطيع توفير 4.5 ترليون دولارٍ خلال 10 سنوات. تتكفّل هذه الأموال بتغطية برنامج إسكانٍ حكومي يُنقذ ملايين البشر من إفلاسات سداد قروضٍ سكنيةٍ أو عدم دفع الإيجارات. إضافةً إلى توفيره خدمات رياض الأطفال بالمجان لجميع الأسر في أميركا. وبما يعادل متوسّط ما تدفعه العائلة الأمريكية لأقساط التأمين الصحي تقريباً، اقترح “ساندرز” إضافاتٍ تصاعديةً في ضرائب الدخل ليتمّ توفير تأمينٍ حكومي يشمل الجميع، وإنقاذ عشرات الملايين من الانكشاف على المرض، ومن الانكشاف على المتربّحين منه، أيضاً.
بالمجمل، اقترح “ساندرز” ضرائب معقولةً على الثراء، وضرائب تصاعديةً على الدخل، ترفد الخزانة العامة بالموارد اللازمة لمواجهة احتياجات التعليم والصحة والسكن للمجتمع الأمريكي. وعلى بساطة البرنامج وعدالته الاجتماعية، فهو أوّلاً، يقيّد مساحاتٍ شاسعةً من الحياة العامة على الأنشطة التجارية؛ أيّ يقوّض مجالات ربحٍ متعددة. وثانياً، تتضاعف إحباطات الأنشطة الرأسمالية من خلال ارتفاع المساهمة الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى. وثالثاً، يتمّ توجيه الموارد الجديدة باتجاهاتٍ اجتماعية، وليس توفير دعمٍ باتجاه الشركات الكبرى، مثل حزمة الإنقاذ المالي في أعقاب الأزمة المالية في 2008. فالشركات التي لا تتعدّى نسب مساهمتها الضريبية من مجمل الموارد الحكومية 6٪ على المستوى الفيدرالي، و10٪ بشكلٍ أقصى على مستوى الولايات، تُنفق عليها برامج إنقاذٍ مباشرة رغم أنشطتها الطفيّلية، وتتمتّع بعض الشركات الاحتكارية الكبرى بدفع أجور منخفضةٍ للعمّال، ممّا يدفعهم للاعتماد على برامج دعم الغذاء للفقراء. ووفقاً لهذا البرنامج، ومع ارتفاع المساهمة الضريبية لكبار الرأسماليين والالتزام بإنفاقها اجتماعياً، قد تصبح قرارات الاندفاع نحو حروبٍ بكلف ترليونية، مثل احتلال العراق وأفغانستان في العقدين الأخيرين، أكثر صعوبة. إذن، سيعني تمويل هذه الحروب، بالأساس، أن يدفع هؤلاء المزيد من ثرواتهم. وباستثناء المتربّحين مباشرةً من الأنشطة العسكرية، سيصعب حشد النخب خلف هذه الحروب. وهذه أوّل منفعةٍ غير مباشرة من برنامج “ساندرز” فيما يخصّ فلسطين وعموم المنطقة.
حجر الزاوية الآخر في برنامج “ساندرز” هو عملية التحوّل في إنتاج الطاقة؛ العهد الأخضر الجديد، والتي اعتُبرت الردّ الأنسب لدرء الكارثة البيئية المحدقة بالكوكب خلال عقودٍ قليلة. كان من المفترض أن تتكفّل هذه العملية بتشغيل الملايين في عملية تحوّلٍ شاملةٍ نحو طاقةٍ نظيفة، يتمّ تمويلها من خلال تفكيك صناعة النفط المحليّة بالضرائب والغرامات على المخالفات البيئية، وتحويل مخصّصات القوّات المسلّحة الأمريكية التي يتمّ إنفاقها في سبيل حماية خطوط إمدادات النفط العالمية. بإمكان هذه التحولات تقويض المنطق الذي نظم علاقة أميركا بالمنطقة، منذ أن صعد عبد العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية للقاء “فرانكلن روزفلت”، وعقَد تفاهماتٍ حول ضمان إمداد النفط عالمياً، وبالذات باتجاه أوروبا، لإسناد خطط إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية. بكلماتٍ أخرى، فإن المنطقة على وشك خسارة حظوة النفط والتجرّد من خصوصياتها وأهميتها تدريجياً، ليصبح دعم الأنظمة المكلفة مالياً وسياسياً فيها غير ذي جدوى أمام دافعي الضرائب وحملات حقوق الإنسان.
وبهذا، تصبح الأسباب البنيوية التي دفعت إلى تخطيط الانقلاب على مُصدّق في إيران، والتحارب مع عبد الناصر بعد مساهماته في حروب الجزائر واليمن، وترجيح كفّة “إسرائيل” كحليفٍ في المنطقة منذ منتصف الستينيّات للقضاء على أيّ مقاومةٍ شعبيةٍ أو عسكرية، غير قائمة. باختصار، تنقض هذه التحوّلات داخل أميركا الموجبات العميقة لدعم “إسرائيل” والديكتاتوريات العربية، وتنزع عنها حالة الخصوصية بعد أن فقدت سابقاً، كما غيرها من الدول، صفة المحميات مع نهاية الحرب الباردة. فلا اتحاد سوفيتي يسدّ توسّع الأسواق الرأسمالية اليوم، بل يلهث الجميع وراء الاندماج واستقطاب الاستثمار وفق شروط السوق، بما فيها روسيا نفسها. زوال استراتيجية النفط الأمريكية ضمن برنامج “ساندرز”، وتسريع خفوت النفط عالمياً مع دعمٍ هائلٍ للطفرات التكنولوجية بعيداً عنه، هو ثاني منفعةٍ غير مباشرة لهذا البرنامج.
“ساندرز” الذي كان يطمح بإعادة تركيب الاقتصاد الأمريكي نحو تمركزٍ محلي قوامه استعادة الطاقة التصنيعية، وبعيداً عن اتفاقيات التجارة الحرّة والحركة الانسيابية للأسواق الرأسمالية التي تتطلب الاستقرار مهما كان مصدره، قد تمكّن من وضع أساساتٍ للتخفيف من حاجة أميركا لسلطويّي العالم، مصرّحاً بأنّ سياسة إدارته الخارجية كانت لتضع حقوق الإنسان والديمقراطية على رأس أولوياتها. وهذه منفعةٌ مباشرةٌ لفلسطين وعموم المنطقة، بأنّ لا حصانة مطلقة لـ”إسرائيل”، ولا حصانة أمام اندلاع نضالات فلسطينية جديدة.
استراتيجية العمل السياسي في أميركا اليوم
إنّ تشكيل برنامجٍ يلقى قبولاً شعبياً كأفكار “ساندرز” شيء، والوصول إلى السلطة في أميركا شيءٌ آخر. من ناحية، يلقى برنامج التأمين الصحي الحكومي الشامل تأييداً من 70٪ من الأمريكيين، بينما يلقى برنامج مجانيّة التعليم الجامعي الحكومي قبولاً من 58٪ من الناخبين الأمريكيين. ولكن من ناحيةٍ أخرى، لم تكُن فرصة “ساندرز” في الفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات العامة في تشرين الثاني أمام ترامب سلِسةً منذ البداية. على الرغم من تقليص “ساندرز” الفارق في الأصوات من 16٪ في مواجهة “كلينتون” في 2016 إلى فارق 7.5 ٪ من الأصوات أمام “بايدن” في أهمّ مرحلةٍ من السباق الانتخابي داخل الحزب، ظلّ التناقض القائم بين قبول اقتراحات الرجل، لا الرجل نفسه في موقع القرار، عصيّاً على الحل.
تزداد المعضلة غموضاً عند النظر إلى طبيعة المنافس الأوفر حظوظاً من “ساندرز”، فلن تجِد تمثّلاً بشريّاً للنيوليبرالية أكثر من شخص “جوزيف بايدن”، إلا القليل. قضى الرجل خمسين عاماً في العمل السياسي، أغلبها ضمن النخبة الجديدة للحزب الديمقراطي مع صعود “بيل كلينتون”، والذي قاد في أوائل التسعينيّات هجوماً ساحقاً على مكتسبات أميركا الاجتماعية، القليلة أصلاً بالمقارنة بدول أوروبا. من اقتطاعات الضمان الاجتماعي، إلى إقرار قوانين الجرائم التي تعدّ اليوم مسؤولةً عن الظاهرة السجنية المرعبة في أميركا، ووصولاً إلى رفع القيود عن المؤسسات المالية التي أُقرّت في أعقاب أزمة كساد الثلاثينيّات، والتي ساهم تفكيكها في الأزمة المالية في العقد الماضي. لكنّ صعود “بايدن” اليوم، أو “كلينتون” من قبله، أمام شخصٍ كـ”ساندرز”، يقوم على بنية النظام السياسي الأمريكي، الأغلبيّ، الحامي للتوافقات ومانع التغييرات الكبرى، وليس على المنطق الداخلي لحملاتهم الانتخابية نفسها.
صحيحٌ أنّ النظام الأغلبيّ مفتوحٌ قانونياً لأيّ حزب، إلا أنّ مبدأ استحواذ الفائز بنسبة 51٪ أو أعلى على كلّ شيء، وإمساكه بزمام الإدارة التنفيذية أو المجالس التشريعية لتسيير العمل ومنع الإعاقة، هو أسوأ أشكال الديمقراطية لأنّه يقصي الأحزاب الأصغر عن أخذ حجمها المجتمعي الحقيقي من خلال الاستحقاقات الانتخابية. والنتيجة العملية لذلك هي بقاء حزبين كآلاتٍ انتخابيةٍ فقط، تسعى وراء الحصول على 51٪ من الأصوات بأفضل فرصةٍ ممكنة، ويقدّم كلٌّ منهما منصةً تعمل على تجميع مشاريع قوانين، ومقترحات إنفاقٍ حكومي، وتعديلات أنظمة، واستيعاب تعبيراتٍ واحتجاجاتٍ اجتماعيةٍ صاعدة، تأخذ شكل يمين-يسار، تقبل فيها الناس أجزاءً من الطيف السياسي الأقرب، وذلك لدحر الأجزاء الأبعد فحسب. إنّ كنتَ اشتراكياً على سبيل المثال، فمن الممكن أن تقبل بالتحالف مع كينزيين أو ليبراليين، لا لشيءٍ، إلا لوقف يمينيّين ساعين لخوض حروبٍ خارجيةٍ وبنزعةٍ شُرطيّةٍ تجاه الحقوق المدنية، والذين يُمكنهم التحالف مع كتلةٍ فاشيةٍ إلى اليمين الأقصى منهم. والعكس صحيح طبعاً. هذه النمطية تسمّى ”أهوَن الشرور“ في العمل السياسي العُلويّ في أميركا.
سعى “ساندرز” إلى إزاحة الإجماع داخل معسكر اليسار نحو سياسات إنفاقٍ اجتماعيّ بإلزام الأثرياء بمساهماتٍ ضريبيةٍ كبرى. تكتّلت نخبة الحزب وراء “بايدن”، وانسحب جميع المترشحين الآخرين للمنافسة الرئاسية لتعظيم حظوظه أمام “ساندرز”؛ السياسي الأكثر شعبيةً في البلد. كسب الأخير شريحةً أكبر من الحزب ما بين الحملتين، لكنّ مجموعاتٍ واسعةً من الليبراليين رأت لدى “بايدن” فرصاً أفضل أمام “ترامب” لأنّه أقل استفزازاً لليمين، بالإضافة طبعاً إلى عدم تهديده مصالح الشرائح العليا. “ساندرز” بالمقابل، يجد صعوبةً في استقطاب الطبقات العمّالية إلى قاعدة الحزب، أو إلى صالحه كما يُتوقع من برنامجه، لأسبابٍ عديدة، أهمها: يأس هذه الشرائح الواسعة من العملية السياسية، إذ تعدّ نسبة المشاركة في الانتخابات الأمريكية متدنيةً جداً بالمقارنة مع غيرها من الدول الديمقراطية، وتجد هذه الشرائح صعوبةً في المشاركة الفعلية، مع إجراءات النخب لـتقنين المشاركة في الاقتراع على مقدار الحاجة فقط، وبقْرَطة النقابات الكبرى، وبالتالي بعثرة الطبقات العاملة بين أقلياتٍ تحتمي بنخبةٍ ليبرالية وشرائح من العمّال البيض المتطلّعين إلى القيادة اليمينية لإغلاق المنافذ أمام الملوّنين، ما دام اندثار الفرص والتدحرج المستمرّ في المنزلقات النيوليبرالية قدراً لا مفر منه.
ستُبقي الأزمة الاجتماعية القائمة في أمريكا اليوم اليسارَ الأمريكي باحثاً عن استراتيجية عملٍ مناسبةٍ في هذه البيئة. فلو نجح “ساندرز” أمام “بايدن” ثمّ “ترامب”، كانت ستبقى أمامه عثرةٌ إضافيةٌ في “كونجرس” مُخرّب للمشاريع التي سعى لتحقيقها. “ساندرز” نفسه تحدّث عن احتمالية وصوله إلى البيت الأبيض كـإعلان حرب، والذي سيتطلّب استدعاء الناس بالملايين إلى التظاهر لإجبار السياسيّين على إقرار الأجندة الاجتماعية، لأنّ الأثرياء سيبذلون ما بوسعهم لعرقلة ذلك. وهذا ما حدث فعلاً، حتّى قبل أن تُحسم الانتخابات التمهيدية، عندما ترشّح “مايكل بلومبرغ”،عمدة “نيويورك” الملياردير، بشكلٍ مفاجئٍ مبدّداً 500 مليون دولار على حملته الانتخابية في شهورٍ قليلةٍ، قبل انسحابه لصالح “بايدن” الذي أثبت أنّه صاحب الحظوظ الأفضل لمواجهة “ساندرز”.
فشل “ساندرز” في الترشّح، واضعاً اليسار أمام مشهدٍ أكثر قتامة، وعليه الاختيار بين الاستمرار في محاولة السيطرة على الحزب الديمقراطي بهدف تحقيق بيئةٍ صديقةٍ للعمل الجماهيري الأوسع، مثل البرنامج الذي طرحه لتوسيع القاعدة الجماهيرية للنقابات وإقرار عقود العمل الجماعية، وبالتالي، تحسين شروط الممارسة السياسية نفسها في أميركا، أو الانطلاق نحو بناء حزبٍ يساريّ قائمٍ على منظّماتٍ قاعديةٍ تحظى بثقة الطبقات العاملة، وتستطيع حملها إلى إدارة الدولة. كلا الطريقين يستلزم الوصول إلى الطبقات الشعبية في أماكنها على الرغم من كلّ تشوّهاتها، والعمل معها على بناء قدراتها التنظيمية. دفعها، قسراً، نحو الثورية لا يفيد؛ ليست الأفكار هي ما يحتاجه العمّال في المقام الأول، وإنّما إلى ما يربط مصالحهم القريبة في الأمان والبعيدة في التغيير.
تجد القضية الفلسطينية مؤازرين لها بين مؤيدي “بيرني ساندرز” بشكل تلقائيّ، أكثر من عموم الأمريكيين، وليست هذه عقبةً كبرى أمامها، حتّى بعد أن أنهى “ساندرز” ترشّحه الرئاسي. المهم، حقّاً، فيما يخصّ فلسطين أنه باتت هناك كتلةٌ كبرى من المجتمع الأمريكي تسعى وراء إلزام الدولة بمسؤولياتها الاجتماعية وتغيير سلم أولوياتها. هكذا تغيير سيقوّض الطغمة الإمبريالية الحاكمة في أميركا، بلا أدنى شك، مع تلاشي تمويل آلة الحرب وانحسار الأهداف التي قامت لأجلها هذه الآلة.