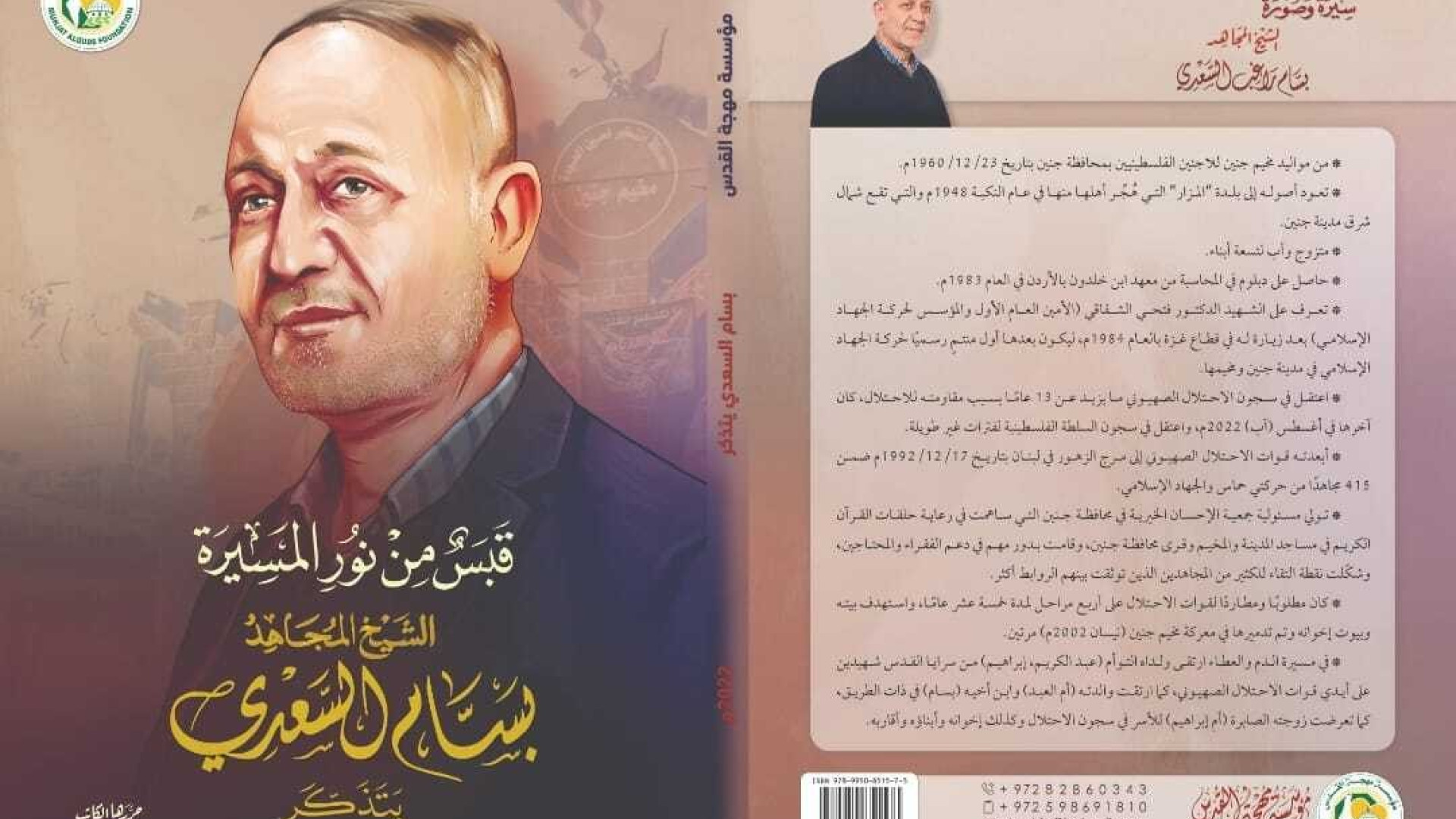في عصر يُوسَم بسقوط وتفكّك القضايا والسرديات الكبرى، تشكِّل فلسطين اليوم المحفِّز (trigger) وبؤرة التكثيف لما يمكن أن يشكِّل ما هو جمعي-إنساني، واستعادة المكانة الإنسانية للبشرية كمشروع جمعي متجاوز للتقسيمات والحدود الجغرافية والهوياتية. فـ"آرون بوشنيل"، الجندي الأبيض، يقطع حاجز "اللون والمهنة" لصالح صرخات تنزّ من جسده المشتعل وتصرخ "فلسطين حرة" على أبواب السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن، موقداً النار لا في جسده فحسب، بل في بزّته العسكرية الامريكية أيضاً، التي شهدت على التواطؤ الأمريكي-"الإسرائيلي" في إنفاذ الإبادة في غزة. وكذلك "إلياس رودريغيز"، ابن محارب "قديم" في العراق، الذي رأى في غزة قضية ينتمي إليها وتعبّر عن إنسانيته المهدورة في أمريكا، موجِّهاً هذا الغضب العارم من العنف الاستعماري إلى وجهته، لقلب "إسرائيل" من داخل الإمبراطورية الراعية، هاتفاً "فلسطين حرة." وقد تنصّل من فعله وعضويته "حزب من أجل الاشتراكية والتحرير" الأمريكي.
وفي بيان منسوب لـ"رودريغز" لتحصين فعله من الاتهامات والتشكيك بصحته العقلية، كما هو حال الكثير من أعمال العنف في الغرب، يقول إن البعض سيعتبر فعله جنوناً، ولكنه في الواقع الفعل الأكثر عقلانية في ظل هذا الجنون، وفي عصر "الفُرجة": "العمل المسلح ليس بالضرورة عملاً عسكرياً، وغالباً لا يكون كذلك. فهو في العادة عرض مسرحي واستعراضي، وهي سمة تشترك فيها العديد من الأعمال غير المسلحة." [1] في هذا السياق، يبرز السؤال التالي: كيف يمكننا فهم هذا الشعور العارم بالانتماء لفلسطين العابر للحدود، سواء كانت جغرافية أو معنوية أو مادية؟ تسعى هذه المقالة للإجابة عن هذا السؤال من خلال تسليط الضوء على رحلة البحث عن الذات التي خاضها وولد منها "إبراهيم"، فرانتز فانون بالتحاقه بركب الثورة الجزائرية، وفي نضاله تحت رايتها.
فالجزائر في ثورتها، كما في فلسطين وقضيتها، شكّلت في حينه بؤرة أطلق عليها "أميلكار كابرال"، قائد حركة التحرر الوطني في غينيا بيساو، "مكّة الثوريين"، نظراً لما قدمته الجزائر وثورتها من نموذج لمناضلي العالم، بوصفها تجسيداً لإمكانية الثورة المسلحة وقدرتها على تحقيق التحرر من الاستعمار، إذ تحولت إلى ملاذ لمن "يتطلّعون لبناء عالم جديد على أنقاض العالم الاستعماري." فقد "بدأ قادة وجنود جبهة التحرير الوطني أيضاً يتبنون الأحلام التحولية (transformative) العالمثالثية، ويدافعون عن رؤى جريئة بشكل متزايد لمجتمع جديد يُعاد بناؤه بعد الاستقلال،" بالتوازي مع تقديم الجزائر "الدعم والضيافة لطيفٍ واسع من حركات التحرر الوطني ولجيوش حرب العصابات الثورية والمنفيين المتمردين من مختلف أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، سرعان ما أصبحت الجزائر نقطة التقاء للثوار، حيث ناضل فيها متمردون وثوّار من فلسطين وأنغولا والأرجنتين وفيتنام، ومن دول غربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، جنباً إلى جنب، 'يتآمرون' معاً ويتعهدون بالموت معاً." [2]
التضامن: فعل تحويلي-تغييري نحو ولادة ثانية للإنسان
على الرغم من كون التضامن مفهوماً فضفاضاً، لا يتوافر إجماع حول تعريفه وحدوده في الخطابين الأكاديمي والشعبي، إذ ينطوي على تعريفات عديدة في الوقت نفسه، فالإطار الذي نُدرك من خلاله ما هو التضامن، ومتى وكيف نمارسه، يظلّ مركباََ. فما يسميه ويصفه "سبستيان جاربي" بفوضى المفهوم، خصوصاً عند تفاعله مع مفاهيم أخرى تتعلق بالفاعلية (agency) والامتيازات (privileges) والتنازل عنها في خضم فعل التضامن، والهشاشة (vulnerability) وتوافرها - أو غيابها - كسمة مشتركة ما بين المتضامنين، والشكل المرئي (visibility) الذي يتجلّى فيه فعل التضامن؛ كل ذلك يطرح سؤالاً حول نوعية العلاقة المتولّدة في خضم الفعل التضامني (solidarity encounter)، وكيفية لعب التضامن دوراً في إحداث تغيير خلّاق في الذوات، وقادر على "إنتاج علاقات مبنية على التبادلية والمعاملة بالمثل،" متجاوزاً بذلك محدّدات التضامن التقليدية التي تناولتها دراسات كثيرة، والتي تركّز على التضامن بين جماعات تتشارك أيديولوجية سياسية معينة أو موقعاً طبقياً مشتركاً، إلى أفق أوسع يتمّ فيه موضعة التضامن وإن كانت الأطراف والجماعات المعنية بالتضامن ذات خلفيات متعددة. [3] وتذهب "سالي تشولتز" إلى تضييق حدود مفهوم التضامن في تناولها لمفهومه، فما هو مشترك في التعريفات المختلفة هي العلاقة التي تنشأ بين المنخرطين في الفعل التضامني، والتي توفّر شكلاً من أشكال الوحدة والتماسك والشعور بالآخر. من هنا، تتناول "تشولتز" مفهوم التضامن السياسي باعتباره ما "يوحّد الأفراد استناداً إلى التزامهم المشترك بقضية سياسية باسم التحرّر أو العدالة، وفي مواجهة القمع أو الظلم". [4]
كان للتضامن الثوري العابر للحدود دور مركزي في تشكيل المخيلة الثورية في الجنوب العالمي خصوصاً، ولعب دوراً توليدياً وتحويلياً (transformative) في الذوات الثورية قيد التشكل (subject in transition). وهو ما يطلق عليه "انثوني اليساندريني"، في قراءته لذات فانون الفكرية والشخصية، سياسات الفرادة (singularity politics)، وحركية الذات وتدفّقها في مواجهة جمود الهوية وسياساتها، التي ترى الهويات كجوهر ثابت لا يتغير، [5] وتمكّن صاحبها من تجسيد ذات تُبنى داخل فضاءين متخيَّلين مترابطين: نضال تحرري وطني محلي، وأممية عالمثالثية على المستوى العالمي. كما تعمل على تخيّل/صياغة وإعادة تخيّل/تشكيل الهويات السياسية في خضم النضال العابر للحدود، حيث تلعب قضايا "الآخر" الذي يشبهني دوراً تغييراً في تعريفنا لذاتنا والـ "نحن"، سعياً لتحقيق التحرر الجماعي، ويتمّ فيها تجاوز الهوية الذاتية المحصورة في أطر ثابتة كالقومية أو الإثنية أو العرق. فلا يقتصر هذا التضامن العابر للحدود فقط على توفير "شبكات ملموسة وموارد تنظيمية وعملية يمكن النشطاء الاستفادة منها والمساهمة فيها في آن واحد،" وكما "لا يقوم فقط على الروابط السببية التي نشأت بين الأمم والشعوب التي كانت تمر بعمليات التحرر من الاستعمار، والسياسات والممارسات الثورية المناهضة للإمبريالية، بل يقوم أيضاً على التصورات السياسية والثقافية التي أُتيح من خلالها تخيُّل أشكال التضامن وشرحها." وأبعد من ذلك، "كأداة لتأطير الخطاب السياسي...أتاح وضع خصوصيات معينة ضمن سياق نضال أوسع مناهض للإمبريالية ومتماهٍ مع حركات تحرر أخرى." [6]
من هنا، يُعاد فهم التضامن السياسي باعتباره ممارسة من ممارسات صناعة العالم (world making practices)، فهذه الممارسات "ليست معطاة أبداً، بل هي دائماً مشروطة، وعلائقية، وغير مكتملة، وكذلك متسعة ومولّدة ومُشكِّلة للفاعلين المعنيين".
ويُنظر إلى التضامن، من هذا المنظور، على أنه علاقة تحوّلية-تغييرية وإبداعية ومنتجة، تتكوّن من خلال النضال السياسي من قِبَل الفاعلين المُهمَّشين وعبرهم، الذين يرتبطون ببعضهم البعض بعلاقات قوة غير متكافئة وجغرافيات مختلفة، من دون افتراض نتيجة محددة سلفاََ، " إلى جانب ما تلعبه الأخروية (otherness) في تأسيس الذات، بمعنى أنه يتم تشكيل الذات من خلال وعبر العلاقة مع الآخر، للوصول إلى ما سماه "لورانس وايلد" التحقّق الذاتي للذات الإنسانية (human self-realization). والذي يتمحور حول "الشعور بالتعاطف المتبادل والمسؤولية بين أعضاء المجموعة بما يعزز الدعم المتبادل. وبذلك، فهو ينطوي على عناصر ذات طابع شخصي ذاتي وعاطفي، وهذا ما يساعد في تفسير إهماله المفاهيمي… ضمن الإطار النظري الليبرالي." كما يتجاوز هذا التأسيس مفهوم التسامح (tolerance)، فكما هو الحال عند "اكسيل هونيث"، فإن "تقدير الناس لبعضهم البعض بشكل "متناظر"، يشير إلى حالة ننظر فيها إلى بعضنا البعض من خلال قيم تُبرز قدرات وصفات الآخر على أنها ذات أهمية للممارسة المشتركة، ما يحفّز اهتماماً حقيقياً بالآخر." ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يحدث أيضاً خلال التضامن "أن نتعلم المزيد عن أشخاص غير مألوفين، نصبح أكثر حساسية تجاه معاناتهم، وفي هذه العملية نتعلم أيضاً المزيد عن أنفسنا." [7]
وضمن هذا الإطار، يمكن استحضار مفهوم الرحلة كما تكشفه الأدبيات الصوفية، والتي لا تقتصر على الترحال المادي فقط، بل تتّسع لتشمل السير في المسالك الروحية والمعرفية، طلباً للسعي نحو الكمال الإنساني في رحلة المعراج الروحي، أو نحو الحقيقة المطلقة بالمعنى العلماني. إذ تتقاطع الكثير من الأدبيات الصوفية في تناولها لمفهوم "الرحلة" في العالم وفي النفس: التخلّي والتحلّي والتجلّي. وفي سياق الحديث عن نظرية المعرفة الصوفية المتبلورة من رحلة البحث عن الذات، لا تركن هذه المقالة إلى التقليد الصوفي الطرقي في مفهومه المختزل للعزلة، والنفور مما هو دنيويّ واللامبالاة بشيء سوى الله، بل تستلهم من هذا التراث الحسّ العالي والعميق بالمسؤولية الاجتماعية، نحو ولادة ثانية للإنسان في خضم رحلة البحث عن الذات.
وهنا، يبرز "إبراهيم فرانتز فانون" كشخصيّة جسّدت عملية البحث عن الذات وإعادة تشكيلها، من خلال إعادة تركيب وتوسعة حدود الـ "نحن" و"الآخر" في خضم النضال العابر للحدود وفي إطار سياسات التضامن. فوفقاً لـ"جيمس بيرن"، جسّد "فانون" الطابع الكوزموبوليتاني لجبهة التحرير الوطني الجزائرية وروحها النضالية، والتكامل ما بين العالمي والمحلي الجزائري من خلال تبنّي قضية جبهة التحرير الوطني كقضيته الخاصة. [8] وكما يعبّر الباحث أحمد ضياء الدردير، "كانت الثورة الجزائرية هي الحاضنة الفكرية والنضالية التي لجأ إليها فرانز فانون هارباً من عقدة المستعمَر (التي كان فانون قد أحسن تشخيصها وتحليلها في كتابه بشرة سوداء أقنعة بيضاء، ولكنه لم يجد منها مهرباً سوى بالتخلّي عن موقعه في الجهاز الطبي للجيش الفرنسي والانضمام إلى جبهة التحرير الجزائرية ليجد في العمل الثوري شفاء سياسياً ونفسياً من الاستعمار.)" [9]
فما اختبره "فانون" على الصعيد الشخصي، في المسافة والرحلة الشخصية ما بين صرخة طفل أبيض عنيفة "انظري أمي إنه زنجي" التي وثّقها في كتابة بشرة سوداء أقنعة بيضاء واعتبرها امتحاناً وجودياً، وبين هويّته الجديدة كجزء من "نحن الجزائريين" التي ردّدها في أكثر من مناسبة؛ هو رحلة مكثّفة في البحث عن الذات وإعادة اكتشافها في خضم الصراع التحرري. وإلا، ما الذي يفسّر تحوّله وتبدّل موقعيته من جندي فرنسي مستعمِر إلى منخرط وناشط في الثورة الجزائرية فكراً وممارسة؟ هذا ما أكد عليه كل من المناضل الأمريكي-الأفريقي "موميا أبو جمال"، ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية ورفيق فانون، محمد بجاوي. فقد أشار أبو جمال إلى أن "فانون، في معذبو الأرض ونحو الثورة الإفريقية، وخصوصاً ككاتب لجبهة التحرير الجزائرية، قد تحدث بصوت المضطَهدين كجزائري أو عربي، وقد عبّر عن ذلك بوضوح، بقوله حرفياً "نحن العرب" و"نحن الجزائريين". فالتزامه بالثورة وحركة التحرر كان شاملاً." [10] أما بجاوي، فيوجز هذه الرحلة بالقول: "اتّخذ فرانتز فانون اسم إبراهيم اسماً حركياً، ولكنه كان أكثر من تسمية بالنسبة لنا ولنفسه. شيء يشبه تفضيلاً للشكل الذي يتبع التزامه الواضح بالمضمون. كما لو كان طقس عبور يستحضر تقاليد أفريقيا. كان وسيلة للشعور بأنه مارتينيكي وإفريقي وعربي في الوقت نفسه، تجسيداً لجوهره الإنساني. اختار اسماً جزائرياً لأن الاستعمار آنذاك كان يوجّه آلته الحربية والتدميرية المميتة ضد الجزائر. وبهذه الطريقة، كان إبراهيم فانون شاهداً على ارتباطه الوثيق بكل الجماعات البشرية التي تعاني من الإقصاء نتيجة الاستعمار." [11] وعلى الرغم من هذا الانغماس الفكري والعملي في الفعل الثوري، أدرك "فانون" حدود تماهيه الوجودي. ففي سيرته التي أعدّها المؤرخ "ديفيد ميسي"، يذكر أنه في آب من العام 1955، اقترح أحد قادة جبهة التحرير الجزائرية عليه المشاركة في تأليف كتاب حول الجزائر، غير أن "فانون" ردّ هذا الطلب، مشدداً على أنه لا يزال يفكر بمنطق وعقل أوروبي. [12]
وعلى الرغم من ذلك، لم تنحصر العلائقية العابرة للحدود عند "فرانتز فانون"، فكراً وممارسة، في جغرافيا دون غيرها، بل كانت عابرة للحدود الهوياتية والجغرافية. وفي هذا السياق، يمكن مقاربة ذلك بما طرحته "ايلا شوحات" تحت مفهوم "الهوية العلائقية بين الأندلس وفلسطين". إذ ترى أن "الدراسة الاحترافية لما هو مبوّب من أطوار تاريخية ومناطق جغرافية (كما في الدراسات الشرق أوسطية أو الدراسات الامريكية اللاتينية) قد أسفرت عن تركيز مفرط في التحديد، أغفل الترابط الداخلي بين التواريخ والجغرافيات، والهويات الثقافية… أدعو إلى مقاربة علائقية لا تشطر الأطوار التاريخية والمناطق الجغرافية إلى مساحات اختصاص عالية التسييج، ولا تتناول الجماعات في حالة عزلة، بل في حالة علاقة." [13]
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة لدراسة "فانون" في إطار عابر للتخصصات، لا تقتصر على الأطر التفسيرية المحصورة في حدود الدولة-الأمة ودراسات المناطق التي تغفل ما هو عابر للحدود، بما يتجاوز حصرية تدفق العلاقة الهرمية ما بين المتروبول الاستعماري والمستعمَرات في كثير من الدراسات، ويسلّط الضوء على الصلات العميقة بين الفضاءات المستعمَرة، [14] على الرغم من الترابط البنيوي بين المتروبول-المستعمَرة داخل العلاقات البينية بين المستعمرات. وهو ما نشهد تجلّيه في كتابات "فانون" في كثير من المواضع، إحداها قوله إنّه "كلما كانت هناك حركة تمردية، كانت السلطات العسكرية لا تضع في المواجهة سوى الجنود الملونين. إنها "شعوب ملوّنة" كانت تقضي على محاولات تحرر "شعوب ملونة" أخرى." [15]
ولعلّ إحدى الجوانب التي يمكن تناولها في هذا السياق هو تجاوز محدودية التقاليد التاريخية الثلاثة التي شكّلت مفهوم التضامن المتمركز اوروبياً. إذ يناقش "هوك برنكخورست" (Hauke Brunkhorst) أن هذا المفهوم يرجع في أصوله الأوروبية إلى إرث ذي مشارب ثلاثة، الأول التقليد الإغريقي القديم لمفهوم الصداقة (friendship)، بين مواطني المدينة-الدولة (polis)، ويتضمن المساواة والوحدة بين المواطنين في إطار سياسي وقانوني. والثاني، التقليد التوراتي للأخوة (fraternity)، والذي يسائل الهرميات الاجتماعية وأتى تعبيراً عن مناهضة العبودية، خارج الإطار السياسي وأقرب ما يكون إلى المفهوم المجازي. أما التقليد الثالث، والذي برز بعيد الثورة الفرنسية، فيجمع ما بين التقاليد السابقة من خلال تسييس الفكرة المسيحية عن الأخوة من جهة، وإعادة موضعة التقليد الإغريقي والروماني من جهة أخرى.[16]
إلا أن "سباستيان غاربي" يشير إلى أنه، وعلى الرغم من احتواء هذه التقاليد وتأكيدها على الروابط الجمعية، فإنّها تنطوي على "طابع إقصائي ضمني، وتنظر إلى التضامن بشكل غير نقدي وعلى أنه العلاقة بين رجال مسيحيين ذوي حظوة (privileged)، وبوصفهم نخباً ومواطني المدينة-الدولة. لذا، يظلّ هذا الفهم التاريخي للتضامن محدوداً بفئة معينة من الناس، ولا يأخذ بالاعتبار أوجه عدم المساواة أو التسلسل الهرمي الاجتماعي بين البشر والفئات الاجتماعية الأخرى أو الجنسيات أو النوع الاجتماعي." كما أن مفهوم التضامن ظلّ "مفهوماً حصرياً دون أن يتطرق إلى البُنى الاستعمارية أو العِرقية أو الجندرية، أو إلى تقسيم العمل القائم عليها." [17]
وتذهب "جيوفانا كوفي" إلى نسابية شبيهة بالنسابية التي قدمّها "هاوك برنكخورست" حول أصول مفهوم التضامن، موضحةً أنه حمل في صيغته اللاتينية بُعدين، قانوني واقتصادي. فالقانوني أشار إلى الواجب الملقى على عاتق المدين لسداد دينه بشكل كامل، بينما ارتبط الاقتصادي بالعصور الوسطى والجنود المرتزقة. ووفقاً لـ"كوفي"، شهد هذا المفهوم تحوّلاً بعيد الثورة الفرنسية، وتجاوز مفهومه الاقتصادي والقانوني إلى الحقل الأيديولوجي والأخلاقي، فأصبح يعني "الشعور القومي المبني على الأخوة والمشترك بين المواطنين داخل الديمقراطية، وارتبط بالحرية السياسية والمساواة… والتضامن الاجتماعي ارتبط مع التضامن الطبقي، فأضحت مفردة التضامن تمتلك مكانة أخلاقية من خلال المساعدة المتبادلة." [18]
ولا يعني هذا أن تطور مفهوم التضامن لاحقاً قد تجاوز هذه المحدودية. فمع استدخال "أوغست كونت" له في العلوم الاجتماعية، ظلّ مقتصراً على الترابطات والاعتمادية السوسيو-اقتصادية داخل الدولة-الأمة الأوروبية. وقد تطور في القرن التاسع عشر، ضمن هذا الإطار، ليشمل تجربة المواطنين البيض من الرجال، واعتبرت المحاولات الليبرالية المبكرة لنظريّة التضامن لمجتمع الدولة القومية (الدولة-الأمة) هو المجتمع المناسب لتحقيقه. وعلى الرغم من الادعاء القائل إن للمفهوم بعداً عالمياً، إلا أن تطبيقاته قامت على إقصاء وتجاهل التراتبيات الاستعمارية والعرقية والجندرية، مما قاد إلى تبلور أطروحات مغايرة حول التضامن نابعة من عدد من السياقات العالمية التي ربطت الجنوب العالمي بشماله، من بينها: الأممية الاشتراكية، وحركات التحرر من الاستعمار، والأممية النسوية، والنضال من أجل محو الاستعمار، ومناهضة الرأسمالية العالمية والعولمة، والنضالات الداعية لإنقاذ البيئة، ونضالات الأصلانيين. ووفقاً لذلك، تطرح "كوفي" سؤالاً حول العلاقة التبادلية بين الذات والآخر: هل يستطيع الجسد المادي الملموس لمجتمع متماسك أن ينفتح على مخاطرة التبادلية المفتوحة والمتبادلة؟" فكانت إجابتها القصيرة عن الحالة المعاصرة: "إن عجز أوروبا عن إظهار التضامن الاجتماعي تجاه أضعف أعضائها، في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق تضامن اقتصادي مع الأقوى، يتطابق -وليس من المستغرب- مع عجزها عن تجسيد التضامن مع حقوق الإنسان، عند مواجهتها للمأساة المتكررة للمهاجرين واللاجئين، وهم الفئات الضعيفة من العمّال وطالبي اللجوء القادمين من الخارج." وتخلص إلى أن فكرة التضامن في السياق الأوروبي تنطوي على الموقف السلبي أو المحايد (passive)، متمحورة حول التضامن 'ضد' (against)، وليس التضامن (for) 'من أجل.' [19]
وتميل هذه المقالة البحثية للنظر إلى التضامن بوصفه مبدأ كونياً، وتجاوز محدوديته في الآن ذاته، وهو ينقسم إلى اتجاهين وفقا لـ"سبستيان غاربي": "الأول يشمل جميع النقاشات في الفلسفة الاجتماعية والأخلاقية التي تفترض التضامن كمبدأ أخلاقي كوني، على الرغم من التجارب التاريخية المناقضة، والخصوصيات المرتبطة بمواقف مختلفة، والانحياز الضمني للمركزية الأوروبية وذكورية المنظور." بالمقابل ينطلق الاتجاه الثاني من كونية التضامن باعتبارها "عملية غير مكتملة وتأملية، تهدف إلى التوصل إلى مفاهيم أخلاقية مشتركة عابرة للاختلافات، من خلال النضال السياسي." [20] ولا تقارب هذه الرؤية التضامن بوصفه معطى اجتماعياً مسلّماً به، كما هو الحال في التوجه المتمركز سوسيولوجياً لدى "ايميل دوركهايم" و"مارسيل موس"، على سبيل المثال، بل تعتبر أن التضامن السياسي يستند إلى أهداف معيارية مشتركة لتحقيق العدالة، خارج حدود الدولة-الأمة أو إطار الدولة القومية، بما يتجاوز مفهوم التضامن المدني (civic solidarity)، الذي يجمع مواطني دولة ما أو أعضاء في مجتمع ما أو أمة، وحيث تلعب مؤسسات الدولة القومية دوراً وسيطاً في صياغة شكل هذا التضامن. ويمتدّ هذا التصوّر للتضامن السياسي إلى ما يتجاوز ضيق الانتماء للجماعة إلى رحاب الولادة الثانية للإنسان، إذ تقتصر "التعبيرات التاريخية للتضامن السياسي من تضامن العمال والنقابات في القرن التاسع عشر إلى التضامن المناهض للاستعمار، والتضامن الثلاثي القارات (آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية)، والتضامن النسوي، وكذلك التضامن الدولي مع ما يُسمى بالعالم الثالث أو الجنوب العالمي في القرنين العشرين والحادي والعشرين." ولكن ما يهمنا في هذا السياق، هو تأطير التضامن باعتباره "علاقة يتم تشكيلها من خلال النضال السياسي الذي يسعى إلى تحدي أشكال الظلم... تمتلك القدرة على تحويل العلاقات الإنسانية القائمة، وتربط بين مواقع جغرافية متنوّعة تتجاوز الحدود السياسية القائمة وتعبر علاقات القوة غير المتكافئة"، مستدخلة للجغرافيات المنسية. [21]
ولذلك، تسعى هذه المقالة لقراءة سيرة "إبراهيم فرانتز فانون" خارج النزعة المتمركزة أوروبياً، بوصفها سيرة قلقة وفاعلة تمتاز بسيولة معرفية في تحديدها للأنا-الآخر، والعلاقة التي تربطهما معاً، وهو ما سيتم استكشافه من خلال عدسة "التضامن" بما هي تأطير وتنظيم لشكل هذه العلاقة وآفاقها ودورها في بناء الهوية الشخصية-الجماعية في سياقات استعمارية، بهدف تحفيز الوعي بضرورة تشكيل جبهة موحّدة ضد الاستعمار والإمبريالية، وكذلك البحث عن الذات والتعبير عنها، سعياً نحو بناء كونية جديدة. فالهدف من بناء التضامن، كما تعبّر عنه "كوفي" بوضوح: "سأذهب إلى حد القول، دون اعتذار، إن علينا تحمّل مسؤولية اقتراح يوتوبيا أخرى، وآمل أن تتم ملاحقة هذه اليوتوبيا الجديدة من خلال تفكير اقتراحي يجرؤ على المخاطرة." [22] وهنا، تضحي ممارسة التضامن يوتيوبيا بحد ذاتها. [23]
وبكلمات أخرى، لا يُنظر هنا للتضامن السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف خارجية فقط، بل يحمل قيمة ذاتية بحدّ ذاته، وهو ما تقدّمه لنا رحلة "فانون" في بحثه عن الذات، بعيداً عن التذرير والفردانية والتشظّي، وتنازلاً عن الامتيازات التي تضمن الركون إلى مناطق الراحة والمألوف (comfort zone) لصالح الاشتباك مع قضايا العالم بالتضامن ووحدة النضال. إذ يخترق نموذج "فانون" قيد الدراسة الجدل الدائر حول الثنائية المتعارضة التي تحكم التضامن والعلاقة ما بين الكوني (العام)-(universality)/المحلي (الخصوصي)-(particularity)، خصوصاً في تقليد النسوية النقدي للمفهوم، ففيه "يتم تفكيك ما يُعرف بالمفاهيم الكونية باعتبارها تموضعات واهتمامات خاصة،" أي الدعوة إلى "فهم الخصوصيات والاختلافات التاريخية والتجريبية في حياة النساء، وكذلك الروابط التاريخية والتجريبية بين نساء من مجتمعات وطنية وعرقية وثقافية مختلفة." كما أن النموذج الوجودي للتضامن عند "فانون"، وتعبيراته مثل "نحن الجزائريين،" قد يُفقد أهمية النقاش النقدي الدائر حول دور "الهوية" في التضامن. فالتساؤلات بهذا الصدد "هل يتشارك الأفراد هوية (شخصية أو جماعية) أم أن التضامن ممكن دون وجود هوية مشتركة سلفاً؟ وهل تُعد الهوية المشتركة شرطاً مسبقاً للتضامن أم أنها نتيجة تُنتَج من خلال علاقات التضامن؟ والسؤال إذا ما كان التضامن طوعياً أم إجبارياً؛" [24] جميعها تساؤلات تجاوزها "فانون" لصالح الانتماء الإنساني الجامع من جهة، والانغماس التام في القضية التي ينتمي إليها من جهة أخرى. إذ يأتي نموذج "فانون" تجسيداً لما عبّر عنه "ايمي سيزار" حول هذه العلاقة بتشكيله توليفة ما بين الكوني والخصوصي، لا كمتناقضات كما تطرحها النسوية النقدية في حديثها عن التضامن، بل باعتبار حدود هذه الثنائية مكملة لبعضها البعض: "أنا لن أدفن نفسي في خصوصية ضيقة، لكنني في الوقت ذاته لا أريد أن أفقد نفسي في كونية مُفرغة وهزيلة. فثمّة طريقتان لأن يفقد الإنسان ذاته: الانغلاق المحصّن داخل الخصوصي، أو الذوبان في "الكوني." أما تصوّري للكوني، فهو كونيّ تغنيه جميع الخصوصيات، كونيّ يتعمق ويتسع بكل ما هو خصوصي: تعايش وتكامل جميع الخصوصيات." [25]
ففي رحلة البحث عن الذات، يضحي التضامن ضرورة وجودية لحل أزمة الذات في تعريفها لنفسها ورؤيتها للعالم، تتلاقح فيه مع الشعور الجمعي كإجابة عن العلاقة ما بين الفرد-المجموع، والطواعية والحتمية في آن. بمعنى أن هذا التوتر الذي تتّسم به الذات قيد التشكيل، تجعلها تنفتح على الإنسانية بالقدر الذي تتحقّق فيه إنسانية الإنسان، أو بلغة غسان كنفاني: إن الإنسان في نهاية الأمر قضية. و"بدلاً من افتراض التضامن كنقطة انطلاق أو كشرط مسبق للعلاقات السياسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو المدنية، ينبغي النظر إلى التضامن باعتباره لحظة لقاء- مغامرة تفتح أفقاً لعلاقات مستقبلية. وبهذا المعنى، يجب اعتبار التضامن علاقة تنطوي على التحوّل (transformative)، منتجة، وخلّاقة، ومنفتحة على احتمالات متعددة، دون ضمانات مسبقة… ففي جوهره، يتوقف التضامن عن كونه شرطاً أخلاقياً أو مدنياً أو اجتماعياً أو سياسياً للعلاقات الإنسانية، ويصبح بدلاً من ذلك نقطة انطلاق لفهم الكيفية التي تتحول بها العلاقات الإنسانية إلى شيء آخر - وهذا "الشيء الآخر" يبقى دوماً مفتوحاً." [26]
الوعي المزدوج: من القابلية للاستعمار إلى القابلية للتضامن الإنساني
يُعد السؤال الأساسي في سياق التضامن عند "فانون": كيف لمن يمتلك جرحاً استعمارياً مغايراً للجرح الاستعماري الجزائري أن يصبح جزائرياً؟ وما هي نوعية العلاقات التي أرساها "فانون" في ولادته الثانية من "فرانتز" إلى "إبراهيم"، والتي حوّلت القابلية للاستعمار إلى قابلية للتضامن الإنساني؟
يؤكد أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن "انثوني اليساندريني" على ضرورة "إعادة النظر في السياق الأنتيلي لـ"فانون"، ليس بوصفه عاملاً حاسماً أو جوهرياً لفهم عمله ونموذجه، بل لأنّ هذا السياق يمكن أن يساعدنا في الوصول إلى فهم أعمق وأكثر ثراء لالتزاماته وتضامناته، سواء في كتاباته أو في حياته." [27] ولعلّ التأطير الأنسب لأشكلة قرائتنا لـ بشرة سوداء وأقنعة بيضاء، هو عبر ما قدّمته كل من "جوديث بتلر" و"ليلا غاندي". تدعو "غاندي" إلى تحقيق التضامن عبر "مجتمع المشاعر (المجتمعات العاطفية)،" والذي ينبني على التشارك في الخيّر العام، من خلال الاعتراف بأخلاقيات عدم الكمال لدى الذات، والإقرار بسياسة التحوّل إلى الهامشي في سبيل الخير العام. ووفقاً لـ "كوفي"، إنّ دعوة "غاندي" إلى أن نصبح "أقل" هي من أجل الاتصال بالآخر؛ (as the willingness to become less in order to relate) وأن "نتمكّن من التواصل مع بعضنا البعض كبشر عاديين، وإلى تقبّل النقص لمواجهة أطر الهيمنة الشمولية والاستعمارية والليبرالية." [28] أما عند "بتلر"، تنطوي الهشاشة الإنسانية على دعوة لسلوك مسلك التضامن، إذ تشكّل وتتبلور، فيها ومنها، الفعالية الإنسانية باعتبارها شكلاً من أشكال المقاومة. ومن هنا، تعدّ العلائقية عند "بتلر" و"غاندي"- بما هي اقتران تشكّل الذات من خلال العلاقة مع الآخرين، وليس بشكل منفصل أو مستقل- بمثابة "تشكُّل للذات، إذ أن السياسات/الشاعرية التي تتبناها كل منهما تفتح أفقاً للأمل في التحول (transformation)، تحديداً لأنها لا تستند وظيفياً إلى هويات مُشكَّلة مسبقاً." [29]
ولذلك، ترى أستاذة الفلسفة "فاني سودرباك" أن "بتلر" كانت، على وجه الخصوص، منشغلة بإرباك جميع تصوّرات الذاتية المستقلة (autonomous subjectivity)، وهو ما يظهر في عدد من أعمالها المختلفة التي تناولت مفاهيم كالهشاشة والأدائية الجسدية ونظريتها الأدائية للتجمع. إذ "تتسق تأملاتها في العمل الجماعي مع نظريتها حول الذات، بوصفها مُشكّلة من خلال الآخرين ومرتبطة بهم، وذات طبيعة هشّة وعلائقية، وعُرضة لأفعال العنف والتجريد من الإنسانية، معتمدةً في بقائها على "شبكة الأيدي الاجتماعية التي تسعى إلى تقليل عدم قابلية الحياة للعيش"..."فجسدي لا يتصرف منفرداً عندما يعمل سياسياً". [30] وفي هذا الإطار، ينطوي مفهوم التضامن لدى "بتلر" على صياغة يوتيوبيا جديدة حول "الشعب": "شعب مترابط، جدير بالحزن (grievable)، هشّ، ومثابر- حيث يمكن تشكيل روابط أخلاقية على مستوى عالمي،" يتم فيها تجاوز الاختلافات، [31]، والاقتراب من الآخر في اختلافيّته (To approach the other in their alterity)، والانفتاح عليه بالخروج من الهوية الذاتية إلى رحاب أوسع. وبلغة "بتلر": "إن مصدر قدرتنا على إحداث التحول الاجتماعي يكمن تحديداً في قدرتنا على التوسّط بين العوالم." [32]
يتخلّل إحداث هذا التحوّل الإقرار بأنه يتمّ إنتاج الهشاشة سياسياً واجتماعياً، ولذلك ثمّة حاجة لتفكيكها سياسياً من خلال عملية التحوّل الاجتماعي هذه. فلا تنفك "بتلر" من التأكيد على أن الاعتمادية المتبادلة للذوات على بعضها البعض هو ما يجعلها متساوية، فـ"الجسد هو ظاهرة اجتماعية؛ فهو مكشوف للآخرين، وهشّ بطبيعته. واستمراريته ذاتها تعتمد على الشروط والمؤسسات الاجتماعية. ما يعني أنه لكي "يكون"، بمعنى "يستمر"، يجب أن يعتمد على ما هو خارج عنه." وبكلمات أخرى لـ"بتلر": "إذا قبلنا أن جزءاً مما يُشكّل الجسد (وهذا، في الوقت الحالي، ادعاء أنطولوجي) هو اعتماده على أجساد أخرى وعلى شبكات دعم، فإننا بذلك نقترح أنه ليس دقيقاً تماماً تصوّر الأجساد الفردية بوصفها منفصلة كلياً عن بعضها البعض." [33] وما تقدّمه "بتلر" في هذا السياق هو أن الهشاشة شرط مسبق للمقاومة، وأن ما يقود إلى المقاومة في المقام الأول هو الهشاشة، وبلغتها: "أود أن أجادل ضد الفكرة التي ترى أن الهشاشة هي نقيض المقاومة. بل أود التأكيد، بشكل إيجابي، على أن الهشاشة -حين تُفهم على أنها تعرّض مقصود للقوة- تُشكّل جزءاً من المعنى الجوهري للمقاومة السياسية بوصفها فعلاً متجسداً. أعلم أن الحديث عن الهشاشة يثير أشكالاً متعددة من المقاومة." [34]
وفي سياق رحلة البحث عن الذات لدى "فانون"، تعود هشاشة الذات وغياب الهوية المشكّلة مسبقاً إلى ظرف موضوعي ألا وهو الاستعمار. إذ يعدّ الانقطاع التاريخي في تشكّل الذاتية والاقتلاع الذي مارسه الاستعمار تجاه الذوات المستعمَرة واقعاً معيشاً مفروضاً عليهم، وهو ما تغفله "بتلر"، في تجاوزها للجرح الاستعماري كمكوّن لفلسفتها. فوفقاً لـ"فاني سويرباك" في نقدها لـ"بتلر"، إنّ السؤال الذي يفرض نفسه: "لماذا يمكن استخدام مصطلحي "الانقطاع" (interruption) و"الاقتلاع" (dislocation) لوصف الواقع المعيشي المتشظي لأولئك الذين جرى استبعادهم بشكل منهجي من الحاضر الاستعماري؟ ذلك أن الانقطاع والاقتلاع بالنسبة لهم هما بالفعل واقعان معيشان مفروضان عليهم، ويجب التعامل معهما." [35]
يتقاطع هذا الطرح في حالتنا مع مفهوم الموت الاجتماعي، فمداخلة "أورلاندو باتيرسون"، في مؤلّفه العبودية والموت الاجتماعي: دراسة مُقارنة، تُعدّ تحليلاً مُقارناً للعبودية في سياقات وفترات تاريخية مُختلفة، وإطاراً نظرياً مُنطلِقاً من جدلية السيّد-العبد لـ"هيجل"، إلى جانب مصادر الشرعية لـ"ماكس فيبر". فبالنسبة لـ"باتيرسون"، تمثّل كلُّ حالة استعباد موتاً اجتماعياً، فيما شكّل مفهوم "الإدماج الحدّي" حجر زاوية في تعريفه للموت الاجتماعي؛ بمعنى أنّ العبد لا يحوز وجوداً اجتماعياً خارج ذاتية السيّد (Subjectivity)، فيظلُّ واقعاً تحت إطار التهميش في مجتمع السادة. وبرأيه، كان ذلك نتيجة الخسارة الفادحة لذاتيّة العبد من خلال عملية الاستعباد، وما يواكبها من محو قسري؛ حيث يظّل العبد ككائن غير مولود. [36]
وفي مقاربة مُشابهة لـ"مداخلة باترسون"، يناقش "أخيل ممبي" في مقاله حول سياساتية الجثث (Necropolitics) موضوع الموت الاجتماعي في سياق عبودية المزارع (Plantations)، واعتبرها موقعاً لحالة الاستثناء. فالموت الاجتماعي، في نظره، يُعادل الإخراج والطرد من الإنسانية. إذ تنشأ حالة العبودية، وفقاً لـ"ممبي"، من خسارة ثلاثية: الأولى خسارة الوطن والبيت، والثانية خسارة السيطرة على الجسد، وأخيراً خسارة المكانة السياسية. غير أن العبد، وفقاً له، يُبقى في حالة إصابة أو جرح (كالجرح الاستعماري). [37]
ويتقاطع استطراد "ممبي" في تعريف حجم الموت الاجتماعي، باعتباره طرداً من الإنسانية، مع ما ناقشه "جورجيو أجامبين" في كتابه الإنسان الحرام (The Homo Sacer) حول أزمة الإنسانية في الوجود والتعريف، على الرغم من عدم تناول الأخير موضوعة الموت الاجتماعي. إذ يربط "أجامبين" نقاشه حول الأزمة الإنسانية بشكل مباشر بأزمة الدولة-الأمة، على اعتبار أنها أزمة منقوشة في داخل هياكل الدولة-الأمة في الأساس. لكنه، في الآن ذاته، يتجاهل أثر الجرح الاستعماري الذي خلّفه مشروع الحداثة في أطواره المختلفة.
وبالنسبة لـ"فانون"، سلب الاستعمار من الأفارقة أصالتهم، وقام بتفكيك ذواتهم الفردية والجماعية، ذلك أن المجتمع الأبيض حطّم "عالمهم القديم، من دون أن يعطيهم عالماً جديداً. فقد قوّض الأسس القبلية التقليدية لحياتهم، وسدّ طريق المستقبل بعدما أغلق سبيل الماضي." [38] ويكمل "فانون": "لقد أخطأ الأبيض، فأنا لم أكن بدائياً، كما لم أكن نصف إنسان، بل كنت أنتمي إلى عرق كان يصنّع الذهب والفضة، قبل ألفي سنة." [39] لكنّ الجرح الاستعماري الذي تحدّث عنه "فانون"، في سياق مدغشقر على سبيل المثال، كان "جرحاً مطلقاً، ولم تكن نتائج هذا التدخل الأوروبي في مدغشقر، سيكولوجية وحسب." [40] فقد أحدث هذا الجرح 'وعياً مزدوجاً' بلغة "دوبويس"، حيث يقول: "بعد المصري والهندي، وبعد الإغريقي والروماني، وبعد التنتوني [Teuton وهي الشعوب والقبائل الجرمانية] والمنغولي، يأتي الزنجي كأنه الابن السابع، الذي وُلِد وحوله حجاب، وحصل على النظرة الثانية في هذا العالم الأمريكي، العالم الذي لا يمنحه وعياً حقيقياً بالذات، بل يسمح له فقط بأن يرى نفسه من خلال رؤية العالم [الأبيض] الآخر له. إنه شعور غريب، هذا الوعي المزدوج، الشعور بأن المرء ينظر دائماً إلى ذاته من خلال عيون الآخرين، وقياس المرء لروحه من خلال تسجيل عالم ينظر إليه باحتقار وإشفاق. إن المرء ليشعر دائماً بأنه اثنان: أمريكي وزنجي، روحان، وفكرتان، وسعيان لا يتفقان، ومثالان [متصارعان] داخل جسد أسود، ليس هناك ما يمنعه من أن يتفكّك ويتمزق غير قوته العنيدة. إن تاريخ الزنجي الأمريكي هو تاريخ هذا النزاع: هذا التوق الى تحقيق الرجولة الواعية، أن يمزج ذاته المزدوجة في ذات أفضل وأصدق، فهو في هذا الاندماج لا يرغب في أن يفقد إحدى ذاتيتيْه، فهو لا يريد أفرقة أمريكا، لأن لدى أمريكا الكثير لتعلمه للعالم ولإفريقيا، وهو لا يرغب في تبييض روحه الزنجية بطوفان من النزعة الأمريكية البيضاء، لأنه يعرف أن للعرق الزنجي رسالة إلى العالم، وكل ما يرغب فيه هو أن يكون في وسع الإنسان أن يكون زنجياً وأمريكياً، دون أن يتلقى اللعنات أو البصقات من جانب أترابه، وبدون إغلاق أبواب الفرص في وجهه بخشونة." [41]
نتلمس هذا الوعي المزدوج عند "فانون" في سياق تحليله لمسألة الوعي بالهوية، فيقول: "من الواضح أن الملغاشي يستطيع تماماً أن يتحمّل عدم كونه أبيض. فالملغاشي هو ملغاشي. أو بالأحرى، لا، الملغاشي ليس ملغاشياً: بل يعيش هويته الملغاشية وجوداً مطلقاً. فإذا كان ملغاشياً، فلأن الأبيض قد وصل؛ وإذا كان في حين معيّن من تاريخه، قد توصّل إلى إثارة مسألة كونه إنساناً أم لا، فذلك لأن هناك من كان يرفض حقيقته الإنسانية هذه. بتعبير آخر، أبدأ أتألم من كوني غير أبيض، على قدر ما يفرض الإنسان الأبيض تمييزاً عليّ، يجعلني مستعمَراً، يجرّدني من كل قيمة، يقول لي إني أشوّش العالم، وأن عليّ الإسراع، قدر المستطاع، لمواكبة العالم الأبيض." [42]
ولا يدخل حديث "فانون" عن الملغاشي الذي يعيش هويته وجوداً مطلقاً في صيغة الليبرالية عن الذات الفردية المكتفية بذاتها، بمعنى ارتكاز "المثُل الليبرالية للفرد المكتفي ذاتياً والمتحكّم تماماً في حياته وجسده على مجموعة من عمليات المحو والتغاضي، حيث يتم تحويل جسد الفرد إلى ملكية منزوعة الجسد قابلة للنقل أو إلى قطعة لحم محددة وثابتة وسلبية." [43] بل يناقش "فانون" هذه المسألة ضمن إطار الوجود السابق للاستعمار، وما قبل انشطار الذات الذي أحدثه [القطع] الاستعماري، والذي عبّر عنه بالقول: "للأسود بعدان. أولهما مع نظيره، وثانيهما مع الأبيض. فالأسود يتصرف تصرفاً مختلفاً، مع أبيض ومع أسود آخر. لا ريب في أن هذا الانشطار العضوي هو النتيجة المباشرة للمغامرة الاستعمارية." [44]
إذ لم يتشكّل هذا الوعي المزدوج لدى الذات السوداء قبل "اللقاء الاستعماري" الذي جمعها بالأبيض فلا يعرف "نقيضه" إلا من خلال هذا التفاعل؛ فكما يوضّح فانون "مادام الأسود في دياره، لا يكون عليه أن يجرّب وجوده مع الآخر، اللهم إلا في مناسبة صراعات داخلية صغيرة. حقاً هناك لحظة "الوجود لأجل الآخر"، التي تحدّث "هيغل" عنها، لكن كل أنطولوجيا، كل آنية، كينونية، تغدو مستحيلة التحقق في مجتمع مستعمَر… فالأنطولوجيا… لا تسمح لنا بفهم كينونة الأسود. لأن الأسود لم يعد عليه أن يكون أسود، بل أن يكونه في مواجهة الأبيض… فبين عشيّة وضحاها، وجد الزنوج أنفسهم بين نظامين مرجعيين، وكان عليهم أن يحدّدوا موقعهم بالنسبة إليهما… إن تقاليدهم والمراجع التي تحيل إليها، كانت قد أُبطلت، لأنها كانت متناقضة مع حضارة كانوا يجهلونها، وكانت تُفرض عليهم." [45]
ولذلك، يستنتج "فانون" أن صنافيات الذوات "البيضاء" و"السوداء" هي نتاج العملية الاستعمارية للبيض، حيث يقول: "نحن أمام مشهد الجهود اليائسة لزنجي ينكبّ بحماسة على اكتشاف معنى الهوية السوداء. فالحضارة البيضاء والثقافة الأوروبية فُرضتا على الأسود انحرافاً وجودياً. سنبيّن في موضع آخر أن ما يُسمى غالباً باسم [الذات] السوداء، هي من إنشاء الأبيض." [46] ولكن، كيف يمكن للأسود أن يخرج من دوامة ردة الفعل وانشطار الذات التي فرضها الواقع الاستعماري؟ وكيف لا ينزلق الى قابلية الاستعمار، وإنما ينفتح على القابلية للتضامن الإنساني؟
بداية، يشير "فانون" إلى أنه "في كل حال، لا ينبغي الشعور بلوني كأنه عاهة. فمنذ أن يتقبّل الزنجي الشرخ الذي يفرضه الأوروبي، لا تعود أمامه فسحة و"منذئذ، لا يكون مفهوماً أن يحاول الارتفاع نحو الأبيض؟ الارتفاع في سلّم الألوان التي يُعيّن لها نوعاً من الهيكيلية؟" سنرى أن حلاً آخر ممكن. فهو يفترض إعادة بناء العالم". [47] وبمعنى آخر، انطلاقاً من الهشاشة، ومن هذا الموت الاجتماعي والوعي المزدوج، إما أن تسير الذات السوداء نحو ما استنتجه "مانوني" من قابلية الاستعمار، ووفقاً لـ"فانون": "يقال لنا بكل بساطة، لأن هناك شيئاً ما، مسجّلاً في "التلافيف القدرية" خصوصاً، في اللاشعور، كان يجعل من الأبيض السيد المنتظر؛" [48] وإما أن يتجاوز قابلية الاستعمار إلى القابلية للتضامن الإنساني، من خلال إعادة بناء العالم، لا بالعودة للماضي وإنما ببناء مستقبل جديد يقوم على التضامن الإنساني. وفي هذا السياق، يضيف "فانون: "لا يمكن للثورة الاجتماعية أن تستمدّ شاعريتها من الماضي، بل فقط من المستقبل،" [49] أيّ نفي فكرة العودة إلى ذات متخيلة والبقاء أسرى الماضي، إذ "إن اكتشاف وجود حضارة زنجية في القرن التاسع عشر لا يمنحني براءة إنسانية. فسواء شئنا أم أبينا، لا يمكن للماضي، في أي حال، أن يوجّهني في الحاضر." [50] مضيفاً أنّه "كلّما رفض إنسان محاولة استعباد غيره، شعرتُ أني متضامن مع فعله. لا ينبغي لي، بأية طريقة، أن أستخرج من ماضي الشعوب الملوّنة توجّهي الأصلي. بأية حالة، لا يحق لي أن أنكبّ على إحياء حضارة زنجية مغفلة، بلا وجه حق. فأنا لا أجعل من نفسي إنسان أي ماض. لا أريد أن أتغنّى بالماضي على حساب حاضري ومستقبلي... وحين أتخطّى المعطى التاريخي… أستدخل دورة حريتي. إن تعاسة الإنسان الملوّن تكمن في أنه كان مستعبداً… فأنا، الإنسان الملوّن، لا أنشد سوى شيء واحد… أن يتوقف استعباد الإنسان للإنسان… وأن يُسمح لي باكتشاف الإنسان، وأن أريده أينما كان." [51]
في هذا السياق، فإن الانتقال من صيرورة قابلية الاستعمار إلى صيرورة التضامن الإنساني، انطلاقاً من هشاشة الذات المفروضة، كما هو الحال عند "فانون"، "تومض إلى الحياة من أعماق العدم واللاوجود (nonbeing)... والمفارقة التي تشكّل الوجودية الفانونية تحتوي على النفي المطلق للوجود [إذا ما نظرنا للموت الاجتماعي وسلب الأصالة عبر تحطيم المستعمِر الأبيض لعالم المستعمَر الأسود القديم كما وضح فانون سابقاً] كمصدر لنشوئها: العدم واللانهائية هما تربتها وماؤها، أما تقرير المصير فهو شمسها... وعليه، فإن منطقة اللّاوجود (nonbeing) تتّسم، على نحو متناقض، بكونها متقلبة ومغذّية في آن معاً، إذ تترك الأنا المتحلّلة عالقة في صراع دائم بين قطبي الوجود: ما بين ذات ناشئة وبين التشييء العنصري." [52] وبلغة "انثوني اليساندريني"، "إن ما تمثّله عملية التحرّر من الاستعمار (decolonization) في جوهرها هو النضال المستمر والدائم ضد المحاولة التي لا تنتهي للاستعمار في فرض حالة من الجمود على المناطق والشعوب التي يسعى إلى إخضاعها." [53]
ويضيف "اليساندريني": "تشترك القوتان اللتان يهاجمهما "فانون" باستمرار – العنصرية والاستعمار – في خاصية أساسية، وهي قطع الطريق أمام أي إمكانية للحركة أو التحوّل، وفرض حالة من الجمود يمكن بسهولة شديدة أن تُخطَّأ وتُؤخذ على أنها واقع ثابت لا يتغير. إن التحديقة (gaze) العنصرية تعمل على تثبيت الآخر… لا تؤثّر هذه الهويات المثبّتة – وفقاً للصيغة التي يعرضها "فانون" – في من يُنظر إليه فقط، بل أيضاً في مَن ينظر، في تلك اللحظة البدئية. وهذا ما يتيح للمستعمِر أن يُصرّ على أنه "يعرف" المستعمَر – وكما يوضّح "فانون" في معذبو الأرض، فإن المستعمِر محق في ادعائه هذا، لأنه هو من "صَنع ويواصل صنع الذات المستعمَرة." [54] ولذلك، يضحي التحرر من الاستعمار عملية في إعادة هيكلة مستمرة ودائمة للذات لمواجهة الجمود الذي يلقيه المستعمِر على المستعمَر وتثبيته ضمن "التحديقة العنصرية والاستعمارية،" فإذا ما كان الاستعمار "تأسيسياً للذات" وفقاً لـ"فانون"، فإن الاستجابة والجواب على التحدّي (لا ردة الفعل) يكون بسيولة تحوّلات الذات نحو التحرر، أي ذات قيد التشكّل في خضم النضال، وخروجاً من خيارات "مانوني" ما بين التبعية للمستعمِر والشعور بالدونية نحوه، نحو فضاء الإنسانية ضمن إطار الفعّالية الذاتية الخلّاقة، فـ "ما يتجلّى حتى الآن هو تكرار لفكرة الذاتية بوصفها تتكوَّن وتُعاد تشكيلها من خلال الأفعال التي تُواجِه العالم الاستعماري." [55] وبكلمات "فانون" إن: "ما نريده هو أن نساعد الأسود على التحرر من الترسانة العقدية (arsenal of complexes) التي نمت في قلب الوضع الكولونيالي." [56]
خاتمة: عالم جديد للتضامن الإنساني من ثنايا العنف
في معرض تصديره لكتاب "فانون" معذبو الأرض، أشار "سارتر" إلى أن قتل الأوروبي هو قتل لعصفورين بحجر واحد، قتلاً للمضطهِد والمضطهَد في آن واحد، أيّ لثنائية الصنافيات هذه وتجسيدها وما يترتب عليها من ناحية وجودية، مضيفاً بأن هذا العنف "الجامح ليس زوبعة سخيفة، ولا هو إيقاظ لغرائز وحشية، ولا هو ثمرة للحقد والاحتقار، بل هو فعل إنسان يعيد تشكيل ذاته… والمستعمَر يشفى من عصاب الاستعمار بطرد المستعمِر بالسلاح، إنه حين ينفجر حنقه يستردّ شفافيته المفقودة… [المستعمَرون] يختبرون معرفة الذات من خلال إعادة تشكيلها." [57]
ولو أخذنا هذه الفكرة على المستوى المعنوي لا الحرفي المادي لعملية القتل، إلى جانب مقولتيْ "فانون" من أن التحرّر ومحو الاستعمار حدث عنيف بالضرورة، [58] وأن "العنف على المستوى الفردي يعدّ فعلاً تطهُريّاً يُخلّص الإنسان من مساوئه وعقدة نقصه أو ربما دونيته، ومن شعوره باليأس وعدم الفاعلية السلبية، ويستعيد شجاعته واحترامه لذاته"؛ [59] فإنّ العنف يؤدي إلى إحلال نوع إنساني محل نوع إنساني آخر، [60] أي أن الإنسان في خضم هذا العنف الخالص يعيد اكتشاف نفسه ويُولَد ولادة ثانية وتبزغ الإنسانية من ثنايا هذا الاكتشاف.
ووفقاً للباحث جورج ماهر، "يمثّل العنف المحتوى لشكل أسطوري (Mythical) للذات الثورية… فإن قوة الأسطورة تشبه إلى حد لافت قوة الحرب: إذ يتم تشكيل ذات ثورية قوية حقاً من خلال تجنّب أي حسابات براغماتية، والتماهي الكامل مع النضال القائم." [61] وعلى الرغم من ارتباط العنف في تشكيل الذات حصرياً في معذبو الأرض، كما تناول العديدون، إلا أن ماهر يشير إلى أنه في سياق بشرة سوداء أقنعة بيضاء "تكتشف الذات السوداء الثورية تَجذّرها العِرقي، وهنا يطوّر فانون نظرية العنف بوصفه تأكيداً وجودياً للذات، وهي نظرية ستشكّل لاحقاً مضموناً لفكرة الذات الثورية التي تُعدّ، من نواحٍ عديدة، "أسطورية" في طبيعتها.. في كتاب بشرة سوداء أقنعة بيضاء، رأينا كيف يتخذ هذا العنف شكل تأكيد وجودي للذات، يعمل على تمزيق التحديدات الزائدة المرتبطة بالعرق... ويتمّ تحويل حالة اللا-وجود الأسود، عبر هذا التأكيد العنيف للذات، إلى كينونة، وإنْ كانت خاضعة، إلا أنها لم تُحرَم مسبقاً من إمكانية الوصول إلى الذاتية." [62] من هنا، ووفقاً لماهر، لا يقتصر العنف على العنف المادّي فقط، "لكن ربما الدليل الأقوى على أن العنف لدى فانون لا يمكن اختزاله في مجرد أفعال عنفية، يكمن في أن العنف بوصفه تأكيداً وجودياً للذات يسبق الفعل العنيف ذاته، إذ "في اللحظة التي يُدرك فيها [المستعمَر] إنسانيته، يبدأ في شحذ الأسلحة التي سيحقق بها انتصاره". فالعنف هنا هو وعي متمرّد، وكرامة في حالة ثورة." [63]
تأتي هذه الولادة الثانية على أنقاض العالم المانوي الذي رسمه "فانون" في معذبو الأرض، أيّ التناقض المطلق بين ثنائية المستعمِر والمستعمَر وتجاوزاً لثنائية الأبيض-الأسود التي حكمت منطق بشرة سوداء أقنعة بيضاء. فوفقاً لـ"الساندريني"، مقتبساً "بول جيلروي": "إن العنف المناهض للاستعمار، والذي يُشكّل الاستجابة الأولى للمانوية، "يفضي في نهاية المطاف إلى وعي أوسع" يفتح "باب الوعي المعارض، وللمرة الأولى الوعي الإنساني الكامل، أمام طيف أوسع من الحساسيات الأخلاقية والسياسية." [64] ووفقاً لذلك، يُعدّ "فانون" تجسيدا لهذا الانفتاح؛ "بالنسبة لـ"فانون"، الذي جاء إلى الجزائر من جزر المارتينيك مروراً بفرنسا، فإن هذا الفعل الإرادي لا يُعبّر عن تأكيد للهوية الذاتية؛ بل يُمثّل قراراً بالانخراط في نضال جماعي محدّد، ليس بصفته متعاطفاً أو داعماً خارجياً فحسب، بل كعضو فاعل في قلب هذا النضال. وما يجب التنويه إليه هنا هو كيف حوّل "فانون" موقعه كـ"غريب" داخل الثورة إلى موقع استراتيجي ونظري. وهذه نقطة مهمة، إذ لا ينبغي فهم موقف "فانون" من التضامن على أنه نشأ بشكل عفوي فقط من التزامه بالثورة الجزائرية أو من هويته المارتينيكية؛ بل أصبح هذا الموقف جزءاً من نضاله المستمر نحو بلورة فكرة جديدة عن الإنسان ذاته." [65]
تطلّب هذا الانخراط الفاعل، وإزاحة حاجز اللون وحواجز السياقات، من جزر الأنتيل إلى فرنسا فالجزائر، وما ينطوي على هذه الجغرافيّات من اختلافات في الجرح الاستعماري للإفريقي؛ إلى "تكريس الذات للآخر،" أيّ الانفتاح كشكل من أشكال الحساسية الإنسانية العالية، وكما عبّر المارتينيكي "ادوارد غلسيانت": "لقد مات في خدمة الجزائر، لقد مات جزائرياً، جزائرياً بالكامل، وسيتشبّث شعب جزر الهند الغربية بذكرى ذلك الجزائري، لأنهم يرون فيه أسمى وأرفع تجسيد لرسالتهم هم أنفسهم". وما قاله "فرانسيس جانسون"، محرّر كتاب "فانون" بشرة سوداء أقنعة البيضاء: "هذا المارتينيكي، الذي حوّله عبوره من خلال الثقافة الفرنسية إلى ثوري جزائري، سيبقى بالنسبة لنا مثالاً حياً للغاية على الكونية في الفعل، وأنبل مقاربة للإنسان وأسمى رؤية للإنسانية تم التعبير عنها حتى الآن في هذا العالم اللاإنساني." [66]
من هنا يأتي تعبير "نحن الجزائريين" تجسيداً للانتماء المبني على إرادة اكتشاف الذات، "بالنسبة لفانون، فإن الأمة هي نتاج الإرادة... وأن تكون جزائرياً لم تكن مسألة ولادة في بلد يُدعى الجزائر، بل مسألة إرادة أن تكون جزائرياً. إن "الأمة" عند "فانون" هي نتاج ديناميكي لفعل الشعب، أما قوميته فهي قومية الإرادة السياسية وربما القومية في أن يكون المرء جزائرياً، وليست قومية تقوم على العرق. وهذه القومية القائمة على الإرادة هي ما يُمكّنه من أن يتحدث بصيغة… "نحن الجزائريين". لقد تطلّب الأمر تحديقة (gaze) طفل أبيض ليُعلِّم "فانون" أنه "زنجي"، لكنه لم يحتج إلى أحد ليخبره بأنه جزائري، لقد كان جزائرياً لأنه أراد أن يكون جزائرياً." [67] ومن هذا المنطلق، تشكّل القومية بالنسبة لـ"فانون" مفتتحاً لوعاء وعي أوسع، ألا وهو الإنسانية، إذ يؤكد "إذا لم يتم شرح القومية وتعزيزها وتعميقها، وإذا لم تتحوّل بسرعة إلى وعي اجتماعي وسياسي، إلى إنسانية (Humanism)، فإنها تؤدي إلى طريق مسدود." [68]
ومن خلال هذه الرحلة في اكتشاف الذات، التي تصنع وتبشّر بالإنسانية الجديدة (New Humanism) من خلال الوعي بها والافتراق عن المعين الغربي، تتشكّل الضمانة نحو تحقيق القيم الإنسانية الجديدة الشاملة والجمع ما بين الخصوصية والكونية. وهنا كما يدلل "فانون"، "ليس وعي الذات انغلاقاً دون التواصل. وقد علّمنا التفكير الفلسفي أن وعي الذات هو ضمانة التواصل. إن الوعي القومي، إن الشعور القومي، الذي ليس تعصّباً قومياً، هو الأمر الوحيد الذي يهب لنا بعداً عالمياً… إذا كان الإنسان هو ما يفعله هذا الإنسان، فإننا نستطيع أن نقول إن الشيء الملح المستعجل اليوم، بالنسبة إلى المثقف الأفريقي، هو بناء أمّته. فإذا جاء هذا البناء صادقاً، أيْ إذا عبّر عن إرادة الشعب الواضحة، إذا كشف عن تحرق الشعوب الأفريقية، كان لا محالة مصحوباً باكتشاف قيم إنسانية شاملة، وكان يرتقي بهذه القيم الإنسانية الشاملة. لا يبتعد التحرر القومي بنا عن الأمم الأخرى، بل إنه هو الذي يجعل الأمة حاضرة على مسرح التاريخ. ففي قلب الوعي القومي، ينهض الوعي العالمي ويحيا." [69]
وكما يقول البروفيسور "اليساندريني"، في مؤلفه عن "فانون": "في إعلانه أن الهدف النهائي من النضال من أجل إنهاء الاستعمار هو "البدء بتاريخ جديد للإنسان." وإذا كان لهذا "التاريخ الجديد" أي معنى، فإن أساسه ذاته يضمن أن شروطه ستكون غير معروفة مسبقاً، لأنه ينطوي على تفجير حدود الفكر والعمل التي تحدد اللحظة الحاضرة… فالهدف هو خلق وجود لتاريخ جديد، لم يُفكَّر فيه ولم يُعش بعد… ومن الضروري الحذر من الوقوع في المثالية، لكن قد يكون من بين إمكانيات لحظتنا المعاصرة انفتاح نحو إحساس متجدد بالتضامن، بمعنى وضع الذات، حرفياً، في خدمة الآخر، باسم تحسين حال البشرية..." [70]
وفي الختام، مطارداً بهاجس الإنسان الجديد والكوني، لا يمكن قراءة تحوّلات "فانون" بما هي تقلبات وتناقضات شخصية فرضها وجود معلول، إذ لم تكن في نهاية المطاف إلا رحلة البحث عن الذات وتخليقاً ذاتياً للإنسان الجديد الكوني الذي طمح إليه، وهو ما يتطلّب منا الوقوف على إساءة قراءة "فانون" واعتباره شخصية ذات بعد واحد تسلبنا نموذجه الإنساني. إذ يتم وصمه باعتباره نبي العنف و"الإرهاب"، أو اختزال مسيرته في عمله كطبيب نفسي، أو بوصفه كارهاً للنساء، أو قراءته في إطار سياسات الهوية الليبرالي، الخ... حتى لو كانت إساءة القراءة تدلّ على، ما وصفه "آدم شاتز" بـ "الهالة التي تحيط [به]، وعلى القوة العاطفية لكتاباته. هذه القوة هي ما مكّن كتابات فانون من الانتشار الواسع، واكتساب معانٍ جديدة مع احتفاظها بقدرتها المستمرة على الإثارة والتحفيز." [71]
فلعل أبرز أشكال إساءة قراءة "فانون" تنبع من تقاسم وتفكيك إرثه الفكري وممارسته السياسية في الحقول المعرفية الأكاديمية. ففي مقابلة مع إحدى العارفات بـ"فانون"، والتي عملت معه، تقول: "لا أحب أن يتم تقطيع فانون إلى أجزاء صغيرة." كانت ترى أن من ينظرون إلى جانب واحد فقط من عمله أو شخصيته يفوتون [إدراك] الكل الذي لا ينفصم: طبيب نفسي وثوري، كاتب ورجل فعل، من جزر الأنتيل وفرنسي، جزائري وأفريقي. وكان يثير استغرابها وغضبها في آن، أن يُفكّك عمل "فانون" بتفانٍ تفسيري في الندوات الجامعية." [72]
****
الهوامش:
[1] Marino, Joe and Emily Crane. “Cops probing anti-Israel manifesto allegedly written by terror suspect Elias Rodriguez ahead of DC Jewish Museum shooting: sources”, New York Post May 22, 2025. https://nypost.com/2025/05/22/us-news/cops-probing-anti-israel-manifesto-allegedly-written-by-terror-suspect-elias-rodriguez-sources/; Shammas, Brittany, Kim Bellware, Katie Shepherd and Aaron C. Davis. “What we know about the man arrested in the D.C. Jewish museum shooting”, The Washington Post May 22, 2025. https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2025/05/22/elias-rodriguez-dc-shooting-israeli-embassy-jewish-museum/; Julie Bosman. “What We Know About the Accused Gunman in Washington”, The New York Times May 22, 2025. https://www.nytimes.com/2025/05/22/us/politics/dc-shooting-suspect-israel-embassy-aides.html
[2] Jeffrey James Byrne. Mecca of Revolution: Algeria, Decolonization, and the Third World Order (New York: Oxford University Press, 2016): pp 2-3, 11.
[3] Sebastian Garbe. Weaving Solidarity: Decolonial Perspectives on Transnational Advocacy of and with the Mapuche (Transcript Verlag, 2022): pp 13-14, 16, 18-19.
[4] Sally J. Scholz, “Political Solidarity and Violent Resistance”. Journal of Social Philosophy, Volume 38, Issue 1 (Spring 2007): p 38.
[5] Anthony C. Alessandrini. Frantz Fanon and the Future of Cultural Politics: Finding Something Different (Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2014): pp 190-191.
[6] Zeina Maasri, Cathy Bergin and Francesca Burke. “Introduction: transnational solidarity in the long sixties” in Transnational Solidarity: Anticolonialism in the Global Sixties, edited by Zeina Maasri, Cathy Bergin and Francesca Burke (Manchester: Manchester University Press, 2022): pp 2, 4, 6, 12, 14, 15-16.
[7] Sebastian Garbe. “Solidarity in Context of Global Inequalities” in Global Handbook of Inequality, edited by Surinder S. Jodhka and Boike Rehbein (Switzerland: Springer Cham, 2023): pp 16, 17-18; Lawrence Wilde, “The Concept of Solidarity: Emerging from the Theoretical Shadows?”. The British Journal of Politics and International Relations, Volume 9, Issue 1 (2007): pp171, 176-177.
[8] Jeffrey James Byrne (2016), ibid: pp 2, 111.
[9] أحمد ضياء دردير، ""قِبلة الثورات": عن حالة ثورية لم تستمر، وكتاب لم يفِ تطلعات قارئيه". موقع حبر، 4 كانون الأول 2022، https://www.7iber.com/culture/%D9%82%D9%90%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/
[10] Mumia Abu-Jamal, “Frantz Fanon and his Influence on the Black Panther Party and the Black Revolution”. In Frantz Fanon and Emancipatory Social Theory: A View from the Wretched, edited by Dustin J. Byrd & Seyed Javad Miri (Leiden & Boston: Brill, 2020): p 13.
[11] Patrick Taylor, “Frantz Fanon and Mythology”. Canadian Journal of African Studies, Volume 16, Issue 2 (1982): p 385.
[12] David Macey. Frantz Fanon: A Biography (New York: Picador USA, 2000): p 397.
[13] ايلا شوحات، "كولومبوس، فلسطين، اليهود والعرب: نحو مقاربة علائقية لهوية المجموعة". الكرمل، العدد 52 (1997)، ص38.
[14] Alina Sajed and Timothy Seidel, “Anticolonial connectivity and the politics of solidarity: between home and the world”. Postcolonial Studies, Volume 26, Issue 1 (2023): p 1-2.
[15] فرانتز فانون. بشرة سوداء أقنعة بيضاء، تعريب خليل أحمد خليل (بيروت: دار الفارابي، 2004): ص ، 109-110.
[16] Sebastian Garbe. “Solidarity in Context of Global Inequalities” in Global Handbook of Inequality, edited by Surinder S. Jodhka and Boike Rehbein (Switzerland: Springer Cham, 2023): p 3.
[17] Ibid: p 3; Sebastian Garbe (2022), ibid: p 31.
[18] Giovanna Covi, “Europe’s Crisis: Reconsidering Solidarity with Leela Gandhi and Judith Butler”. Synthesis: an Anglophone Journal of Comparative Literary Studies, Issue 9 (2016): pp 148-149.
[19] Sebastian Garbe (2023), Ibid: pp 3-4; Giovanna Covi (2016), ibid: pp 150-151; Lawrence Wilde (2007), ibid: p 171.
[20] Sebastian Garbe (2022), ibid: p 34
[21] Ibid: pp 34-38.
[22] Giovanna Covi (2016), ibid: p 152.
[23] Sebastian Garbe (2023), Ibid: p 8.
[24] Sebastian Garbe (2022), ibid: pp 38-39, 41.
[25] Jeremey M. Glick, “Aime Cesaire’s Two Ways to Lose Yourself: The Exception and the Rule”. In Partisan Universalism: Essays in honour of Ato Sekyi-Otu, edited by Gamal Abdel-Shehid and Sofia Noori (Daraja Press, 2021): p 81.
[26] Sebastian Garbe (2022), ibid: pp 43-45.
[27] Anthony C. Alessandrini. Frantz Fanon and the Future of Cultural Politics: Finding Something Different (Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2014): p 189.
[28] Giovanna Covi (2016), ibid: pp 152-153, 155.
[29] Ibid: pp 152, 154, 156.
[30] Fanny Soderback, “Performative Presence: Judith Butler and the Temporal Regimes of Global Assembly”. Diacritics, Volume 46, Issue 2 (2018): pp 33-34, 36.
[31] هنا بتلر تكمل مهمتها في ارث النسوية النقدي، اذ تشير إلى أن التضامن لا ينبغي أن يقوم على طمس الفروقات بين الهويات، ودون السعي إلى الاندماج أو التوحيد الهويّاتي، وهو حال بيل هوكس وحديثها عن غياب الضرورة في "القضاء على الاختلاف من أجل الشعور بالتضامن". انظر/ي:
153-154; Sebestian Garbe (2022), ibid: p 50. Giovanna Covi (2016), ibid: pp
[32] Ibid: pp 36-37, 41.
[33] Adriana Zaharijevic, “Equal bodies: The notion of the precarious in Judith Butler’s work”. European Journal of Women's Studies, Volume 30, Issue 1 (2022): pp 44-45; Judith Butler, “Rethinking Vulnerability and Resistance”. In Vulnerability in Resistance, edited by Judith Butler, Zeynep Gambetti and Leticia Sabsay (Durham and London: Duke University Press, 2016): p 16.
[34] Ibid: pp 14-15, 22.
[35] Fanny Soderback (2018), ibid: p 42.
[36] Orlando Patterson. Slavery and Social Death: A Comparative Study (Cambrdige, Massachusetts and London: Harvard University Press, 1982): pp 5, 38, 45.
[37] Achille Mbembe, “Necropolitics”. Public Culture, Volume 15, Issue 1 (Winter 2003): p 21.
[38] فرانز فانون. بشرة سوداء اقنعة بيضاء، تعريب خليل أحمد خليل (بيروت: دار الفارابي، 2004): ص 196.
[39] مرجع سابق: ص 138-139.
[40] مرجع سابق: ص 103.
[41] وليم إ. بورجهارت ديبويس. روح الشعب الأسود، ترجمة أسعد حليم (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2002): ص 34.
[42] فرانز فانون (2004)، مرجع سابق: ص104.
[43] Adriana Zaharijevic (2022), ibid: p 40.
[44] فرانز فانون (2004)، مرجع سابق: ص19.
[45] مرجع سابق: ص117-118.
[46] مرجع سابق: ص16-17.
[47] مرجع سابق: ص 88.
[48] مرجع سابق: ص105.
[49] مرجع سابق: ص237.
[50] مرجع سابق: ص 239.
[51] مرجع سابق: ص240، ص245.
[52] Nicholas Webber, “Subjective Elasticity, “Zone of Nonbeing” and Fanon’s New Humanism in Black Skin, White Masks”. Postcolonial Text, Volume 7, Issue 4 (2012): pp 1, 7.
[53] Anthony C. Alessandrini (2014), ibid: pp 190-191.
[54] Ibid: pp 191-192.
[55] Sarah Jilani, “Becoming in a colonial world: approaching subjectivity with Fanon”. Textual Practice, Volume 38, Issue 10 (2024): pp 2-5, 11.
[56] فرانز فانون (2004)، مرجع سابق: ص33.
[57] Frantz Fanon, The Wretched of the Earth. translated by Richard Philcox (New York: Grove Press, 2004): p lv.
[58] Ibid, p 1.
[59] Ibid, p 51.
[60] Ibid, p 1.
[61] George Ciccariello-Maher, “To Lose Oneself in the Absolute Revolutionary Subjectivity in Sorel and Fanon”. Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, Volume 5 (Summer 2007): pp 101, 103.
[62] Ibid: pp 104, 110.
[63] Ibid: pp 108.
[64] Anthony C. Alessandrini (2014), ibid: p 212.
[65] Ibid: pp 195-197.
[66] Ibid: pp 212, 214-215.
[67] David Macey (2000), ibid: pp 377-378, 389.
[68] Frantz Fanon (2004), ibid: pp 144
للمزيد حول الانسانية التي دعا إليها فانون وتمييزها عن "Western Humanism" انظر/ي:
Majid Sharifi and Sean Chabot, “Fanon’s New Humanism as Antidote to Today’s Colonial Violence”. In Frantz Fanon and Emancipatory Social Theory: A View from the Wretched, edited by Dustin J. Byrd and Seyed Javad Miri (Leiden and Boston: Brill, 2020): pp 251-271.
[69] فرانز فانون، معذبو الأرض، ترجمة سامي الدروبي وجمال الاتاسي (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، الطبعة الثانية 2015): ص 199.
[70] Anthony C. Alessandrini (2014), ibid: pp 216-217, 223.
[71] Adam Shatz, The Rebel’s Clinic: The Revolutionary Lives of Frantz Fanon (London: Head of Zeus Ltd, 2024): p 346.
[72] Ibid: p 328.
عن الكاتب
عنان حمدالله
كاتب
اقرأ للكاتب
وسوم ذات صلة
شارك المقال على مواقع التواصل الاجتماعي
في عصر يُوسَم بسقوط وتفكّك القضايا والسرديات الكبرى، تشكِّل فلسطين اليوم المحفِّز (trigger) وبؤرة التكثيف لما يمكن أن يشكِّل ما هو جمعي-إنساني، واستعادة المكانة الإنسانية للبشرية كمشروع جمعي متجاوز للتقسيمات والحدود الجغرافية والهوياتية. فـ"آرون بوشنيل"، الجندي الأبيض، يقطع حاجز "اللون والمهنة" لصالح صرخات تنزّ من جسده المشتعل وتصرخ "فلسطين حرة" على أبواب السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن، موقداً النار لا في جسده فحسب، بل في بزّته العسكرية الامريكية أيضاً، التي شهدت على التواطؤ الأمريكي-"الإسرائيلي" في إنفاذ الإبادة في غزة. وكذلك "إلياس رودريغيز"، ابن محارب "قديم" في العراق، الذي رأى في غزة قضية ينتمي إليها وتعبّر عن إنسانيته المهدورة في أمريكا، موجِّهاً هذا الغضب العارم من العنف الاستعماري إلى وجهته، لقلب "إسرائيل" من داخل الإمبراطورية الراعية، هاتفاً "فلسطين حرة." وقد تنصّل من فعله وعضويته "حزب من أجل الاشتراكية والتحرير" الأمريكي.
وفي بيان منسوب لـ"رودريغز" لتحصين فعله من الاتهامات والتشكيك بصحته العقلية، كما هو حال الكثير من أعمال العنف في الغرب، يقول إن البعض سيعتبر فعله جنوناً، ولكنه في الواقع الفعل الأكثر عقلانية في ظل هذا الجنون، وفي عصر "الفُرجة": "العمل المسلح ليس بالضرورة عملاً عسكرياً، وغالباً لا يكون كذلك. فهو في العادة عرض مسرحي واستعراضي، وهي سمة تشترك فيها العديد من الأعمال غير المسلحة." [1] في هذا السياق، يبرز السؤال التالي: كيف يمكننا فهم هذا الشعور العارم بالانتماء لفلسطين العابر للحدود، سواء كانت جغرافية أو معنوية أو مادية؟ تسعى هذه المقالة للإجابة عن هذا السؤال من خلال تسليط الضوء على رحلة البحث عن الذات التي خاضها وولد منها "إبراهيم"، فرانتز فانون بالتحاقه بركب الثورة الجزائرية، وفي نضاله تحت رايتها.
فالجزائر في ثورتها، كما في فلسطين وقضيتها، شكّلت في حينه بؤرة أطلق عليها "أميلكار كابرال"، قائد حركة التحرر الوطني في غينيا بيساو، "مكّة الثوريين"، نظراً لما قدمته الجزائر وثورتها من نموذج لمناضلي العالم، بوصفها تجسيداً لإمكانية الثورة المسلحة وقدرتها على تحقيق التحرر من الاستعمار، إذ تحولت إلى ملاذ لمن "يتطلّعون لبناء عالم جديد على أنقاض العالم الاستعماري." فقد "بدأ قادة وجنود جبهة التحرير الوطني أيضاً يتبنون الأحلام التحولية (transformative) العالمثالثية، ويدافعون عن رؤى جريئة بشكل متزايد لمجتمع جديد يُعاد بناؤه بعد الاستقلال،" بالتوازي مع تقديم الجزائر "الدعم والضيافة لطيفٍ واسع من حركات التحرر الوطني ولجيوش حرب العصابات الثورية والمنفيين المتمردين من مختلف أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، سرعان ما أصبحت الجزائر نقطة التقاء للثوار، حيث ناضل فيها متمردون وثوّار من فلسطين وأنغولا والأرجنتين وفيتنام، ومن دول غربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، جنباً إلى جنب، 'يتآمرون' معاً ويتعهدون بالموت معاً." [2]
التضامن: فعل تحويلي-تغييري نحو ولادة ثانية للإنسان
على الرغم من كون التضامن مفهوماً فضفاضاً، لا يتوافر إجماع حول تعريفه وحدوده في الخطابين الأكاديمي والشعبي، إذ ينطوي على تعريفات عديدة في الوقت نفسه، فالإطار الذي نُدرك من خلاله ما هو التضامن، ومتى وكيف نمارسه، يظلّ مركباََ. فما يسميه ويصفه "سبستيان جاربي" بفوضى المفهوم، خصوصاً عند تفاعله مع مفاهيم أخرى تتعلق بالفاعلية (agency) والامتيازات (privileges) والتنازل عنها في خضم فعل التضامن، والهشاشة (vulnerability) وتوافرها - أو غيابها - كسمة مشتركة ما بين المتضامنين، والشكل المرئي (visibility) الذي يتجلّى فيه فعل التضامن؛ كل ذلك يطرح سؤالاً حول نوعية العلاقة المتولّدة في خضم الفعل التضامني (solidarity encounter)، وكيفية لعب التضامن دوراً في إحداث تغيير خلّاق في الذوات، وقادر على "إنتاج علاقات مبنية على التبادلية والمعاملة بالمثل،" متجاوزاً بذلك محدّدات التضامن التقليدية التي تناولتها دراسات كثيرة، والتي تركّز على التضامن بين جماعات تتشارك أيديولوجية سياسية معينة أو موقعاً طبقياً مشتركاً، إلى أفق أوسع يتمّ فيه موضعة التضامن وإن كانت الأطراف والجماعات المعنية بالتضامن ذات خلفيات متعددة. [3] وتذهب "سالي تشولتز" إلى تضييق حدود مفهوم التضامن في تناولها لمفهومه، فما هو مشترك في التعريفات المختلفة هي العلاقة التي تنشأ بين المنخرطين في الفعل التضامني، والتي توفّر شكلاً من أشكال الوحدة والتماسك والشعور بالآخر. من هنا، تتناول "تشولتز" مفهوم التضامن السياسي باعتباره ما "يوحّد الأفراد استناداً إلى التزامهم المشترك بقضية سياسية باسم التحرّر أو العدالة، وفي مواجهة القمع أو الظلم". [4]
كان للتضامن الثوري العابر للحدود دور مركزي في تشكيل المخيلة الثورية في الجنوب العالمي خصوصاً، ولعب دوراً توليدياً وتحويلياً (transformative) في الذوات الثورية قيد التشكل (subject in transition). وهو ما يطلق عليه "انثوني اليساندريني"، في قراءته لذات فانون الفكرية والشخصية، سياسات الفرادة (singularity politics)، وحركية الذات وتدفّقها في مواجهة جمود الهوية وسياساتها، التي ترى الهويات كجوهر ثابت لا يتغير، [5] وتمكّن صاحبها من تجسيد ذات تُبنى داخل فضاءين متخيَّلين مترابطين: نضال تحرري وطني محلي، وأممية عالمثالثية على المستوى العالمي. كما تعمل على تخيّل/صياغة وإعادة تخيّل/تشكيل الهويات السياسية في خضم النضال العابر للحدود، حيث تلعب قضايا "الآخر" الذي يشبهني دوراً تغييراً في تعريفنا لذاتنا والـ "نحن"، سعياً لتحقيق التحرر الجماعي، ويتمّ فيها تجاوز الهوية الذاتية المحصورة في أطر ثابتة كالقومية أو الإثنية أو العرق. فلا يقتصر هذا التضامن العابر للحدود فقط على توفير "شبكات ملموسة وموارد تنظيمية وعملية يمكن النشطاء الاستفادة منها والمساهمة فيها في آن واحد،" وكما "لا يقوم فقط على الروابط السببية التي نشأت بين الأمم والشعوب التي كانت تمر بعمليات التحرر من الاستعمار، والسياسات والممارسات الثورية المناهضة للإمبريالية، بل يقوم أيضاً على التصورات السياسية والثقافية التي أُتيح من خلالها تخيُّل أشكال التضامن وشرحها." وأبعد من ذلك، "كأداة لتأطير الخطاب السياسي...أتاح وضع خصوصيات معينة ضمن سياق نضال أوسع مناهض للإمبريالية ومتماهٍ مع حركات تحرر أخرى." [6]
من هنا، يُعاد فهم التضامن السياسي باعتباره ممارسة من ممارسات صناعة العالم (world making practices)، فهذه الممارسات "ليست معطاة أبداً، بل هي دائماً مشروطة، وعلائقية، وغير مكتملة، وكذلك متسعة ومولّدة ومُشكِّلة للفاعلين المعنيين".
ويُنظر إلى التضامن، من هذا المنظور، على أنه علاقة تحوّلية-تغييرية وإبداعية ومنتجة، تتكوّن من خلال النضال السياسي من قِبَل الفاعلين المُهمَّشين وعبرهم، الذين يرتبطون ببعضهم البعض بعلاقات قوة غير متكافئة وجغرافيات مختلفة، من دون افتراض نتيجة محددة سلفاََ، " إلى جانب ما تلعبه الأخروية (otherness) في تأسيس الذات، بمعنى أنه يتم تشكيل الذات من خلال وعبر العلاقة مع الآخر، للوصول إلى ما سماه "لورانس وايلد" التحقّق الذاتي للذات الإنسانية (human self-realization). والذي يتمحور حول "الشعور بالتعاطف المتبادل والمسؤولية بين أعضاء المجموعة بما يعزز الدعم المتبادل. وبذلك، فهو ينطوي على عناصر ذات طابع شخصي ذاتي وعاطفي، وهذا ما يساعد في تفسير إهماله المفاهيمي… ضمن الإطار النظري الليبرالي." كما يتجاوز هذا التأسيس مفهوم التسامح (tolerance)، فكما هو الحال عند "اكسيل هونيث"، فإن "تقدير الناس لبعضهم البعض بشكل "متناظر"، يشير إلى حالة ننظر فيها إلى بعضنا البعض من خلال قيم تُبرز قدرات وصفات الآخر على أنها ذات أهمية للممارسة المشتركة، ما يحفّز اهتماماً حقيقياً بالآخر." ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يحدث أيضاً خلال التضامن "أن نتعلم المزيد عن أشخاص غير مألوفين، نصبح أكثر حساسية تجاه معاناتهم، وفي هذه العملية نتعلم أيضاً المزيد عن أنفسنا." [7]
وضمن هذا الإطار، يمكن استحضار مفهوم الرحلة كما تكشفه الأدبيات الصوفية، والتي لا تقتصر على الترحال المادي فقط، بل تتّسع لتشمل السير في المسالك الروحية والمعرفية، طلباً للسعي نحو الكمال الإنساني في رحلة المعراج الروحي، أو نحو الحقيقة المطلقة بالمعنى العلماني. إذ تتقاطع الكثير من الأدبيات الصوفية في تناولها لمفهوم "الرحلة" في العالم وفي النفس: التخلّي والتحلّي والتجلّي. وفي سياق الحديث عن نظرية المعرفة الصوفية المتبلورة من رحلة البحث عن الذات، لا تركن هذه المقالة إلى التقليد الصوفي الطرقي في مفهومه المختزل للعزلة، والنفور مما هو دنيويّ واللامبالاة بشيء سوى الله، بل تستلهم من هذا التراث الحسّ العالي والعميق بالمسؤولية الاجتماعية، نحو ولادة ثانية للإنسان في خضم رحلة البحث عن الذات.
وهنا، يبرز "إبراهيم فرانتز فانون" كشخصيّة جسّدت عملية البحث عن الذات وإعادة تشكيلها، من خلال إعادة تركيب وتوسعة حدود الـ "نحن" و"الآخر" في خضم النضال العابر للحدود وفي إطار سياسات التضامن. فوفقاً لـ"جيمس بيرن"، جسّد "فانون" الطابع الكوزموبوليتاني لجبهة التحرير الوطني الجزائرية وروحها النضالية، والتكامل ما بين العالمي والمحلي الجزائري من خلال تبنّي قضية جبهة التحرير الوطني كقضيته الخاصة. [8] وكما يعبّر الباحث أحمد ضياء الدردير، "كانت الثورة الجزائرية هي الحاضنة الفكرية والنضالية التي لجأ إليها فرانز فانون هارباً من عقدة المستعمَر (التي كان فانون قد أحسن تشخيصها وتحليلها في كتابه بشرة سوداء أقنعة بيضاء، ولكنه لم يجد منها مهرباً سوى بالتخلّي عن موقعه في الجهاز الطبي للجيش الفرنسي والانضمام إلى جبهة التحرير الجزائرية ليجد في العمل الثوري شفاء سياسياً ونفسياً من الاستعمار.)" [9]
فما اختبره "فانون" على الصعيد الشخصي، في المسافة والرحلة الشخصية ما بين صرخة طفل أبيض عنيفة "انظري أمي إنه زنجي" التي وثّقها في كتابة بشرة سوداء أقنعة بيضاء واعتبرها امتحاناً وجودياً، وبين هويّته الجديدة كجزء من "نحن الجزائريين" التي ردّدها في أكثر من مناسبة؛ هو رحلة مكثّفة في البحث عن الذات وإعادة اكتشافها في خضم الصراع التحرري. وإلا، ما الذي يفسّر تحوّله وتبدّل موقعيته من جندي فرنسي مستعمِر إلى منخرط وناشط في الثورة الجزائرية فكراً وممارسة؟ هذا ما أكد عليه كل من المناضل الأمريكي-الأفريقي "موميا أبو جمال"، ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية ورفيق فانون، محمد بجاوي. فقد أشار أبو جمال إلى أن "فانون، في معذبو الأرض ونحو الثورة الإفريقية، وخصوصاً ككاتب لجبهة التحرير الجزائرية، قد تحدث بصوت المضطَهدين كجزائري أو عربي، وقد عبّر عن ذلك بوضوح، بقوله حرفياً "نحن العرب" و"نحن الجزائريين". فالتزامه بالثورة وحركة التحرر كان شاملاً." [10] أما بجاوي، فيوجز هذه الرحلة بالقول: "اتّخذ فرانتز فانون اسم إبراهيم اسماً حركياً، ولكنه كان أكثر من تسمية بالنسبة لنا ولنفسه. شيء يشبه تفضيلاً للشكل الذي يتبع التزامه الواضح بالمضمون. كما لو كان طقس عبور يستحضر تقاليد أفريقيا. كان وسيلة للشعور بأنه مارتينيكي وإفريقي وعربي في الوقت نفسه، تجسيداً لجوهره الإنساني. اختار اسماً جزائرياً لأن الاستعمار آنذاك كان يوجّه آلته الحربية والتدميرية المميتة ضد الجزائر. وبهذه الطريقة، كان إبراهيم فانون شاهداً على ارتباطه الوثيق بكل الجماعات البشرية التي تعاني من الإقصاء نتيجة الاستعمار." [11] وعلى الرغم من هذا الانغماس الفكري والعملي في الفعل الثوري، أدرك "فانون" حدود تماهيه الوجودي. ففي سيرته التي أعدّها المؤرخ "ديفيد ميسي"، يذكر أنه في آب من العام 1955، اقترح أحد قادة جبهة التحرير الجزائرية عليه المشاركة في تأليف كتاب حول الجزائر، غير أن "فانون" ردّ هذا الطلب، مشدداً على أنه لا يزال يفكر بمنطق وعقل أوروبي. [12]
وعلى الرغم من ذلك، لم تنحصر العلائقية العابرة للحدود عند "فرانتز فانون"، فكراً وممارسة، في جغرافيا دون غيرها، بل كانت عابرة للحدود الهوياتية والجغرافية. وفي هذا السياق، يمكن مقاربة ذلك بما طرحته "ايلا شوحات" تحت مفهوم "الهوية العلائقية بين الأندلس وفلسطين". إذ ترى أن "الدراسة الاحترافية لما هو مبوّب من أطوار تاريخية ومناطق جغرافية (كما في الدراسات الشرق أوسطية أو الدراسات الامريكية اللاتينية) قد أسفرت عن تركيز مفرط في التحديد، أغفل الترابط الداخلي بين التواريخ والجغرافيات، والهويات الثقافية… أدعو إلى مقاربة علائقية لا تشطر الأطوار التاريخية والمناطق الجغرافية إلى مساحات اختصاص عالية التسييج، ولا تتناول الجماعات في حالة عزلة، بل في حالة علاقة." [13]
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة لدراسة "فانون" في إطار عابر للتخصصات، لا تقتصر على الأطر التفسيرية المحصورة في حدود الدولة-الأمة ودراسات المناطق التي تغفل ما هو عابر للحدود، بما يتجاوز حصرية تدفق العلاقة الهرمية ما بين المتروبول الاستعماري والمستعمَرات في كثير من الدراسات، ويسلّط الضوء على الصلات العميقة بين الفضاءات المستعمَرة، [14] على الرغم من الترابط البنيوي بين المتروبول-المستعمَرة داخل العلاقات البينية بين المستعمرات. وهو ما نشهد تجلّيه في كتابات "فانون" في كثير من المواضع، إحداها قوله إنّه "كلما كانت هناك حركة تمردية، كانت السلطات العسكرية لا تضع في المواجهة سوى الجنود الملونين. إنها "شعوب ملوّنة" كانت تقضي على محاولات تحرر "شعوب ملونة" أخرى." [15]
ولعلّ إحدى الجوانب التي يمكن تناولها في هذا السياق هو تجاوز محدودية التقاليد التاريخية الثلاثة التي شكّلت مفهوم التضامن المتمركز اوروبياً. إذ يناقش "هوك برنكخورست" (Hauke Brunkhorst) أن هذا المفهوم يرجع في أصوله الأوروبية إلى إرث ذي مشارب ثلاثة، الأول التقليد الإغريقي القديم لمفهوم الصداقة (friendship)، بين مواطني المدينة-الدولة (polis)، ويتضمن المساواة والوحدة بين المواطنين في إطار سياسي وقانوني. والثاني، التقليد التوراتي للأخوة (fraternity)، والذي يسائل الهرميات الاجتماعية وأتى تعبيراً عن مناهضة العبودية، خارج الإطار السياسي وأقرب ما يكون إلى المفهوم المجازي. أما التقليد الثالث، والذي برز بعيد الثورة الفرنسية، فيجمع ما بين التقاليد السابقة من خلال تسييس الفكرة المسيحية عن الأخوة من جهة، وإعادة موضعة التقليد الإغريقي والروماني من جهة أخرى.[16]
إلا أن "سباستيان غاربي" يشير إلى أنه، وعلى الرغم من احتواء هذه التقاليد وتأكيدها على الروابط الجمعية، فإنّها تنطوي على "طابع إقصائي ضمني، وتنظر إلى التضامن بشكل غير نقدي وعلى أنه العلاقة بين رجال مسيحيين ذوي حظوة (privileged)، وبوصفهم نخباً ومواطني المدينة-الدولة. لذا، يظلّ هذا الفهم التاريخي للتضامن محدوداً بفئة معينة من الناس، ولا يأخذ بالاعتبار أوجه عدم المساواة أو التسلسل الهرمي الاجتماعي بين البشر والفئات الاجتماعية الأخرى أو الجنسيات أو النوع الاجتماعي." كما أن مفهوم التضامن ظلّ "مفهوماً حصرياً دون أن يتطرق إلى البُنى الاستعمارية أو العِرقية أو الجندرية، أو إلى تقسيم العمل القائم عليها." [17]
وتذهب "جيوفانا كوفي" إلى نسابية شبيهة بالنسابية التي قدمّها "هاوك برنكخورست" حول أصول مفهوم التضامن، موضحةً أنه حمل في صيغته اللاتينية بُعدين، قانوني واقتصادي. فالقانوني أشار إلى الواجب الملقى على عاتق المدين لسداد دينه بشكل كامل، بينما ارتبط الاقتصادي بالعصور الوسطى والجنود المرتزقة. ووفقاً لـ"كوفي"، شهد هذا المفهوم تحوّلاً بعيد الثورة الفرنسية، وتجاوز مفهومه الاقتصادي والقانوني إلى الحقل الأيديولوجي والأخلاقي، فأصبح يعني "الشعور القومي المبني على الأخوة والمشترك بين المواطنين داخل الديمقراطية، وارتبط بالحرية السياسية والمساواة… والتضامن الاجتماعي ارتبط مع التضامن الطبقي، فأضحت مفردة التضامن تمتلك مكانة أخلاقية من خلال المساعدة المتبادلة." [18]
ولا يعني هذا أن تطور مفهوم التضامن لاحقاً قد تجاوز هذه المحدودية. فمع استدخال "أوغست كونت" له في العلوم الاجتماعية، ظلّ مقتصراً على الترابطات والاعتمادية السوسيو-اقتصادية داخل الدولة-الأمة الأوروبية. وقد تطور في القرن التاسع عشر، ضمن هذا الإطار، ليشمل تجربة المواطنين البيض من الرجال، واعتبرت المحاولات الليبرالية المبكرة لنظريّة التضامن لمجتمع الدولة القومية (الدولة-الأمة) هو المجتمع المناسب لتحقيقه. وعلى الرغم من الادعاء القائل إن للمفهوم بعداً عالمياً، إلا أن تطبيقاته قامت على إقصاء وتجاهل التراتبيات الاستعمارية والعرقية والجندرية، مما قاد إلى تبلور أطروحات مغايرة حول التضامن نابعة من عدد من السياقات العالمية التي ربطت الجنوب العالمي بشماله، من بينها: الأممية الاشتراكية، وحركات التحرر من الاستعمار، والأممية النسوية، والنضال من أجل محو الاستعمار، ومناهضة الرأسمالية العالمية والعولمة، والنضالات الداعية لإنقاذ البيئة، ونضالات الأصلانيين. ووفقاً لذلك، تطرح "كوفي" سؤالاً حول العلاقة التبادلية بين الذات والآخر: هل يستطيع الجسد المادي الملموس لمجتمع متماسك أن ينفتح على مخاطرة التبادلية المفتوحة والمتبادلة؟" فكانت إجابتها القصيرة عن الحالة المعاصرة: "إن عجز أوروبا عن إظهار التضامن الاجتماعي تجاه أضعف أعضائها، في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق تضامن اقتصادي مع الأقوى، يتطابق -وليس من المستغرب- مع عجزها عن تجسيد التضامن مع حقوق الإنسان، عند مواجهتها للمأساة المتكررة للمهاجرين واللاجئين، وهم الفئات الضعيفة من العمّال وطالبي اللجوء القادمين من الخارج." وتخلص إلى أن فكرة التضامن في السياق الأوروبي تنطوي على الموقف السلبي أو المحايد (passive)، متمحورة حول التضامن 'ضد' (against)، وليس التضامن (for) 'من أجل.' [19]
وتميل هذه المقالة البحثية للنظر إلى التضامن بوصفه مبدأ كونياً، وتجاوز محدوديته في الآن ذاته، وهو ينقسم إلى اتجاهين وفقا لـ"سبستيان غاربي": "الأول يشمل جميع النقاشات في الفلسفة الاجتماعية والأخلاقية التي تفترض التضامن كمبدأ أخلاقي كوني، على الرغم من التجارب التاريخية المناقضة، والخصوصيات المرتبطة بمواقف مختلفة، والانحياز الضمني للمركزية الأوروبية وذكورية المنظور." بالمقابل ينطلق الاتجاه الثاني من كونية التضامن باعتبارها "عملية غير مكتملة وتأملية، تهدف إلى التوصل إلى مفاهيم أخلاقية مشتركة عابرة للاختلافات، من خلال النضال السياسي." [20] ولا تقارب هذه الرؤية التضامن بوصفه معطى اجتماعياً مسلّماً به، كما هو الحال في التوجه المتمركز سوسيولوجياً لدى "ايميل دوركهايم" و"مارسيل موس"، على سبيل المثال، بل تعتبر أن التضامن السياسي يستند إلى أهداف معيارية مشتركة لتحقيق العدالة، خارج حدود الدولة-الأمة أو إطار الدولة القومية، بما يتجاوز مفهوم التضامن المدني (civic solidarity)، الذي يجمع مواطني دولة ما أو أعضاء في مجتمع ما أو أمة، وحيث تلعب مؤسسات الدولة القومية دوراً وسيطاً في صياغة شكل هذا التضامن. ويمتدّ هذا التصوّر للتضامن السياسي إلى ما يتجاوز ضيق الانتماء للجماعة إلى رحاب الولادة الثانية للإنسان، إذ تقتصر "التعبيرات التاريخية للتضامن السياسي من تضامن العمال والنقابات في القرن التاسع عشر إلى التضامن المناهض للاستعمار، والتضامن الثلاثي القارات (آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية)، والتضامن النسوي، وكذلك التضامن الدولي مع ما يُسمى بالعالم الثالث أو الجنوب العالمي في القرنين العشرين والحادي والعشرين." ولكن ما يهمنا في هذا السياق، هو تأطير التضامن باعتباره "علاقة يتم تشكيلها من خلال النضال السياسي الذي يسعى إلى تحدي أشكال الظلم... تمتلك القدرة على تحويل العلاقات الإنسانية القائمة، وتربط بين مواقع جغرافية متنوّعة تتجاوز الحدود السياسية القائمة وتعبر علاقات القوة غير المتكافئة"، مستدخلة للجغرافيات المنسية. [21]
ولذلك، تسعى هذه المقالة لقراءة سيرة "إبراهيم فرانتز فانون" خارج النزعة المتمركزة أوروبياً، بوصفها سيرة قلقة وفاعلة تمتاز بسيولة معرفية في تحديدها للأنا-الآخر، والعلاقة التي تربطهما معاً، وهو ما سيتم استكشافه من خلال عدسة "التضامن" بما هي تأطير وتنظيم لشكل هذه العلاقة وآفاقها ودورها في بناء الهوية الشخصية-الجماعية في سياقات استعمارية، بهدف تحفيز الوعي بضرورة تشكيل جبهة موحّدة ضد الاستعمار والإمبريالية، وكذلك البحث عن الذات والتعبير عنها، سعياً نحو بناء كونية جديدة. فالهدف من بناء التضامن، كما تعبّر عنه "كوفي" بوضوح: "سأذهب إلى حد القول، دون اعتذار، إن علينا تحمّل مسؤولية اقتراح يوتوبيا أخرى، وآمل أن تتم ملاحقة هذه اليوتوبيا الجديدة من خلال تفكير اقتراحي يجرؤ على المخاطرة." [22] وهنا، تضحي ممارسة التضامن يوتيوبيا بحد ذاتها. [23]
وبكلمات أخرى، لا يُنظر هنا للتضامن السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف خارجية فقط، بل يحمل قيمة ذاتية بحدّ ذاته، وهو ما تقدّمه لنا رحلة "فانون" في بحثه عن الذات، بعيداً عن التذرير والفردانية والتشظّي، وتنازلاً عن الامتيازات التي تضمن الركون إلى مناطق الراحة والمألوف (comfort zone) لصالح الاشتباك مع قضايا العالم بالتضامن ووحدة النضال. إذ يخترق نموذج "فانون" قيد الدراسة الجدل الدائر حول الثنائية المتعارضة التي تحكم التضامن والعلاقة ما بين الكوني (العام)-(universality)/المحلي (الخصوصي)-(particularity)، خصوصاً في تقليد النسوية النقدي للمفهوم، ففيه "يتم تفكيك ما يُعرف بالمفاهيم الكونية باعتبارها تموضعات واهتمامات خاصة،" أي الدعوة إلى "فهم الخصوصيات والاختلافات التاريخية والتجريبية في حياة النساء، وكذلك الروابط التاريخية والتجريبية بين نساء من مجتمعات وطنية وعرقية وثقافية مختلفة." كما أن النموذج الوجودي للتضامن عند "فانون"، وتعبيراته مثل "نحن الجزائريين،" قد يُفقد أهمية النقاش النقدي الدائر حول دور "الهوية" في التضامن. فالتساؤلات بهذا الصدد "هل يتشارك الأفراد هوية (شخصية أو جماعية) أم أن التضامن ممكن دون وجود هوية مشتركة سلفاً؟ وهل تُعد الهوية المشتركة شرطاً مسبقاً للتضامن أم أنها نتيجة تُنتَج من خلال علاقات التضامن؟ والسؤال إذا ما كان التضامن طوعياً أم إجبارياً؛" [24] جميعها تساؤلات تجاوزها "فانون" لصالح الانتماء الإنساني الجامع من جهة، والانغماس التام في القضية التي ينتمي إليها من جهة أخرى. إذ يأتي نموذج "فانون" تجسيداً لما عبّر عنه "ايمي سيزار" حول هذه العلاقة بتشكيله توليفة ما بين الكوني والخصوصي، لا كمتناقضات كما تطرحها النسوية النقدية في حديثها عن التضامن، بل باعتبار حدود هذه الثنائية مكملة لبعضها البعض: "أنا لن أدفن نفسي في خصوصية ضيقة، لكنني في الوقت ذاته لا أريد أن أفقد نفسي في كونية مُفرغة وهزيلة. فثمّة طريقتان لأن يفقد الإنسان ذاته: الانغلاق المحصّن داخل الخصوصي، أو الذوبان في "الكوني." أما تصوّري للكوني، فهو كونيّ تغنيه جميع الخصوصيات، كونيّ يتعمق ويتسع بكل ما هو خصوصي: تعايش وتكامل جميع الخصوصيات." [25]
ففي رحلة البحث عن الذات، يضحي التضامن ضرورة وجودية لحل أزمة الذات في تعريفها لنفسها ورؤيتها للعالم، تتلاقح فيه مع الشعور الجمعي كإجابة عن العلاقة ما بين الفرد-المجموع، والطواعية والحتمية في آن. بمعنى أن هذا التوتر الذي تتّسم به الذات قيد التشكيل، تجعلها تنفتح على الإنسانية بالقدر الذي تتحقّق فيه إنسانية الإنسان، أو بلغة غسان كنفاني: إن الإنسان في نهاية الأمر قضية. و"بدلاً من افتراض التضامن كنقطة انطلاق أو كشرط مسبق للعلاقات السياسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو المدنية، ينبغي النظر إلى التضامن باعتباره لحظة لقاء- مغامرة تفتح أفقاً لعلاقات مستقبلية. وبهذا المعنى، يجب اعتبار التضامن علاقة تنطوي على التحوّل (transformative)، منتجة، وخلّاقة، ومنفتحة على احتمالات متعددة، دون ضمانات مسبقة… ففي جوهره، يتوقف التضامن عن كونه شرطاً أخلاقياً أو مدنياً أو اجتماعياً أو سياسياً للعلاقات الإنسانية، ويصبح بدلاً من ذلك نقطة انطلاق لفهم الكيفية التي تتحول بها العلاقات الإنسانية إلى شيء آخر - وهذا "الشيء الآخر" يبقى دوماً مفتوحاً." [26]
الوعي المزدوج: من القابلية للاستعمار إلى القابلية للتضامن الإنساني
يُعد السؤال الأساسي في سياق التضامن عند "فانون": كيف لمن يمتلك جرحاً استعمارياً مغايراً للجرح الاستعماري الجزائري أن يصبح جزائرياً؟ وما هي نوعية العلاقات التي أرساها "فانون" في ولادته الثانية من "فرانتز" إلى "إبراهيم"، والتي حوّلت القابلية للاستعمار إلى قابلية للتضامن الإنساني؟
يؤكد أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن "انثوني اليساندريني" على ضرورة "إعادة النظر في السياق الأنتيلي لـ"فانون"، ليس بوصفه عاملاً حاسماً أو جوهرياً لفهم عمله ونموذجه، بل لأنّ هذا السياق يمكن أن يساعدنا في الوصول إلى فهم أعمق وأكثر ثراء لالتزاماته وتضامناته، سواء في كتاباته أو في حياته." [27] ولعلّ التأطير الأنسب لأشكلة قرائتنا لـ بشرة سوداء وأقنعة بيضاء، هو عبر ما قدّمته كل من "جوديث بتلر" و"ليلا غاندي". تدعو "غاندي" إلى تحقيق التضامن عبر "مجتمع المشاعر (المجتمعات العاطفية)،" والذي ينبني على التشارك في الخيّر العام، من خلال الاعتراف بأخلاقيات عدم الكمال لدى الذات، والإقرار بسياسة التحوّل إلى الهامشي في سبيل الخير العام. ووفقاً لـ "كوفي"، إنّ دعوة "غاندي" إلى أن نصبح "أقل" هي من أجل الاتصال بالآخر؛ (as the willingness to become less in order to relate) وأن "نتمكّن من التواصل مع بعضنا البعض كبشر عاديين، وإلى تقبّل النقص لمواجهة أطر الهيمنة الشمولية والاستعمارية والليبرالية." [28] أما عند "بتلر"، تنطوي الهشاشة الإنسانية على دعوة لسلوك مسلك التضامن، إذ تشكّل وتتبلور، فيها ومنها، الفعالية الإنسانية باعتبارها شكلاً من أشكال المقاومة. ومن هنا، تعدّ العلائقية عند "بتلر" و"غاندي"- بما هي اقتران تشكّل الذات من خلال العلاقة مع الآخرين، وليس بشكل منفصل أو مستقل- بمثابة "تشكُّل للذات، إذ أن السياسات/الشاعرية التي تتبناها كل منهما تفتح أفقاً للأمل في التحول (transformation)، تحديداً لأنها لا تستند وظيفياً إلى هويات مُشكَّلة مسبقاً." [29]
ولذلك، ترى أستاذة الفلسفة "فاني سودرباك" أن "بتلر" كانت، على وجه الخصوص، منشغلة بإرباك جميع تصوّرات الذاتية المستقلة (autonomous subjectivity)، وهو ما يظهر في عدد من أعمالها المختلفة التي تناولت مفاهيم كالهشاشة والأدائية الجسدية ونظريتها الأدائية للتجمع. إذ "تتسق تأملاتها في العمل الجماعي مع نظريتها حول الذات، بوصفها مُشكّلة من خلال الآخرين ومرتبطة بهم، وذات طبيعة هشّة وعلائقية، وعُرضة لأفعال العنف والتجريد من الإنسانية، معتمدةً في بقائها على "شبكة الأيدي الاجتماعية التي تسعى إلى تقليل عدم قابلية الحياة للعيش"..."فجسدي لا يتصرف منفرداً عندما يعمل سياسياً". [30] وفي هذا الإطار، ينطوي مفهوم التضامن لدى "بتلر" على صياغة يوتيوبيا جديدة حول "الشعب": "شعب مترابط، جدير بالحزن (grievable)، هشّ، ومثابر- حيث يمكن تشكيل روابط أخلاقية على مستوى عالمي،" يتم فيها تجاوز الاختلافات، [31]، والاقتراب من الآخر في اختلافيّته (To approach the other in their alterity)، والانفتاح عليه بالخروج من الهوية الذاتية إلى رحاب أوسع. وبلغة "بتلر": "إن مصدر قدرتنا على إحداث التحول الاجتماعي يكمن تحديداً في قدرتنا على التوسّط بين العوالم." [32]
يتخلّل إحداث هذا التحوّل الإقرار بأنه يتمّ إنتاج الهشاشة سياسياً واجتماعياً، ولذلك ثمّة حاجة لتفكيكها سياسياً من خلال عملية التحوّل الاجتماعي هذه. فلا تنفك "بتلر" من التأكيد على أن الاعتمادية المتبادلة للذوات على بعضها البعض هو ما يجعلها متساوية، فـ"الجسد هو ظاهرة اجتماعية؛ فهو مكشوف للآخرين، وهشّ بطبيعته. واستمراريته ذاتها تعتمد على الشروط والمؤسسات الاجتماعية. ما يعني أنه لكي "يكون"، بمعنى "يستمر"، يجب أن يعتمد على ما هو خارج عنه." وبكلمات أخرى لـ"بتلر": "إذا قبلنا أن جزءاً مما يُشكّل الجسد (وهذا، في الوقت الحالي، ادعاء أنطولوجي) هو اعتماده على أجساد أخرى وعلى شبكات دعم، فإننا بذلك نقترح أنه ليس دقيقاً تماماً تصوّر الأجساد الفردية بوصفها منفصلة كلياً عن بعضها البعض." [33] وما تقدّمه "بتلر" في هذا السياق هو أن الهشاشة شرط مسبق للمقاومة، وأن ما يقود إلى المقاومة في المقام الأول هو الهشاشة، وبلغتها: "أود أن أجادل ضد الفكرة التي ترى أن الهشاشة هي نقيض المقاومة. بل أود التأكيد، بشكل إيجابي، على أن الهشاشة -حين تُفهم على أنها تعرّض مقصود للقوة- تُشكّل جزءاً من المعنى الجوهري للمقاومة السياسية بوصفها فعلاً متجسداً. أعلم أن الحديث عن الهشاشة يثير أشكالاً متعددة من المقاومة." [34]
وفي سياق رحلة البحث عن الذات لدى "فانون"، تعود هشاشة الذات وغياب الهوية المشكّلة مسبقاً إلى ظرف موضوعي ألا وهو الاستعمار. إذ يعدّ الانقطاع التاريخي في تشكّل الذاتية والاقتلاع الذي مارسه الاستعمار تجاه الذوات المستعمَرة واقعاً معيشاً مفروضاً عليهم، وهو ما تغفله "بتلر"، في تجاوزها للجرح الاستعماري كمكوّن لفلسفتها. فوفقاً لـ"فاني سويرباك" في نقدها لـ"بتلر"، إنّ السؤال الذي يفرض نفسه: "لماذا يمكن استخدام مصطلحي "الانقطاع" (interruption) و"الاقتلاع" (dislocation) لوصف الواقع المعيشي المتشظي لأولئك الذين جرى استبعادهم بشكل منهجي من الحاضر الاستعماري؟ ذلك أن الانقطاع والاقتلاع بالنسبة لهم هما بالفعل واقعان معيشان مفروضان عليهم، ويجب التعامل معهما." [35]
يتقاطع هذا الطرح في حالتنا مع مفهوم الموت الاجتماعي، فمداخلة "أورلاندو باتيرسون"، في مؤلّفه العبودية والموت الاجتماعي: دراسة مُقارنة، تُعدّ تحليلاً مُقارناً للعبودية في سياقات وفترات تاريخية مُختلفة، وإطاراً نظرياً مُنطلِقاً من جدلية السيّد-العبد لـ"هيجل"، إلى جانب مصادر الشرعية لـ"ماكس فيبر". فبالنسبة لـ"باتيرسون"، تمثّل كلُّ حالة استعباد موتاً اجتماعياً، فيما شكّل مفهوم "الإدماج الحدّي" حجر زاوية في تعريفه للموت الاجتماعي؛ بمعنى أنّ العبد لا يحوز وجوداً اجتماعياً خارج ذاتية السيّد (Subjectivity)، فيظلُّ واقعاً تحت إطار التهميش في مجتمع السادة. وبرأيه، كان ذلك نتيجة الخسارة الفادحة لذاتيّة العبد من خلال عملية الاستعباد، وما يواكبها من محو قسري؛ حيث يظّل العبد ككائن غير مولود. [36]
وفي مقاربة مُشابهة لـ"مداخلة باترسون"، يناقش "أخيل ممبي" في مقاله حول سياساتية الجثث (Necropolitics) موضوع الموت الاجتماعي في سياق عبودية المزارع (Plantations)، واعتبرها موقعاً لحالة الاستثناء. فالموت الاجتماعي، في نظره، يُعادل الإخراج والطرد من الإنسانية. إذ تنشأ حالة العبودية، وفقاً لـ"ممبي"، من خسارة ثلاثية: الأولى خسارة الوطن والبيت، والثانية خسارة السيطرة على الجسد، وأخيراً خسارة المكانة السياسية. غير أن العبد، وفقاً له، يُبقى في حالة إصابة أو جرح (كالجرح الاستعماري). [37]
ويتقاطع استطراد "ممبي" في تعريف حجم الموت الاجتماعي، باعتباره طرداً من الإنسانية، مع ما ناقشه "جورجيو أجامبين" في كتابه الإنسان الحرام (The Homo Sacer) حول أزمة الإنسانية في الوجود والتعريف، على الرغم من عدم تناول الأخير موضوعة الموت الاجتماعي. إذ يربط "أجامبين" نقاشه حول الأزمة الإنسانية بشكل مباشر بأزمة الدولة-الأمة، على اعتبار أنها أزمة منقوشة في داخل هياكل الدولة-الأمة في الأساس. لكنه، في الآن ذاته، يتجاهل أثر الجرح الاستعماري الذي خلّفه مشروع الحداثة في أطواره المختلفة.
وبالنسبة لـ"فانون"، سلب الاستعمار من الأفارقة أصالتهم، وقام بتفكيك ذواتهم الفردية والجماعية، ذلك أن المجتمع الأبيض حطّم "عالمهم القديم، من دون أن يعطيهم عالماً جديداً. فقد قوّض الأسس القبلية التقليدية لحياتهم، وسدّ طريق المستقبل بعدما أغلق سبيل الماضي." [38] ويكمل "فانون": "لقد أخطأ الأبيض، فأنا لم أكن بدائياً، كما لم أكن نصف إنسان، بل كنت أنتمي إلى عرق كان يصنّع الذهب والفضة، قبل ألفي سنة." [39] لكنّ الجرح الاستعماري الذي تحدّث عنه "فانون"، في سياق مدغشقر على سبيل المثال، كان "جرحاً مطلقاً، ولم تكن نتائج هذا التدخل الأوروبي في مدغشقر، سيكولوجية وحسب." [40] فقد أحدث هذا الجرح 'وعياً مزدوجاً' بلغة "دوبويس"، حيث يقول: "بعد المصري والهندي، وبعد الإغريقي والروماني، وبعد التنتوني [Teuton وهي الشعوب والقبائل الجرمانية] والمنغولي، يأتي الزنجي كأنه الابن السابع، الذي وُلِد وحوله حجاب، وحصل على النظرة الثانية في هذا العالم الأمريكي، العالم الذي لا يمنحه وعياً حقيقياً بالذات، بل يسمح له فقط بأن يرى نفسه من خلال رؤية العالم [الأبيض] الآخر له. إنه شعور غريب، هذا الوعي المزدوج، الشعور بأن المرء ينظر دائماً إلى ذاته من خلال عيون الآخرين، وقياس المرء لروحه من خلال تسجيل عالم ينظر إليه باحتقار وإشفاق. إن المرء ليشعر دائماً بأنه اثنان: أمريكي وزنجي، روحان، وفكرتان، وسعيان لا يتفقان، ومثالان [متصارعان] داخل جسد أسود، ليس هناك ما يمنعه من أن يتفكّك ويتمزق غير قوته العنيدة. إن تاريخ الزنجي الأمريكي هو تاريخ هذا النزاع: هذا التوق الى تحقيق الرجولة الواعية، أن يمزج ذاته المزدوجة في ذات أفضل وأصدق، فهو في هذا الاندماج لا يرغب في أن يفقد إحدى ذاتيتيْه، فهو لا يريد أفرقة أمريكا، لأن لدى أمريكا الكثير لتعلمه للعالم ولإفريقيا، وهو لا يرغب في تبييض روحه الزنجية بطوفان من النزعة الأمريكية البيضاء، لأنه يعرف أن للعرق الزنجي رسالة إلى العالم، وكل ما يرغب فيه هو أن يكون في وسع الإنسان أن يكون زنجياً وأمريكياً، دون أن يتلقى اللعنات أو البصقات من جانب أترابه، وبدون إغلاق أبواب الفرص في وجهه بخشونة." [41]
نتلمس هذا الوعي المزدوج عند "فانون" في سياق تحليله لمسألة الوعي بالهوية، فيقول: "من الواضح أن الملغاشي يستطيع تماماً أن يتحمّل عدم كونه أبيض. فالملغاشي هو ملغاشي. أو بالأحرى، لا، الملغاشي ليس ملغاشياً: بل يعيش هويته الملغاشية وجوداً مطلقاً. فإذا كان ملغاشياً، فلأن الأبيض قد وصل؛ وإذا كان في حين معيّن من تاريخه، قد توصّل إلى إثارة مسألة كونه إنساناً أم لا، فذلك لأن هناك من كان يرفض حقيقته الإنسانية هذه. بتعبير آخر، أبدأ أتألم من كوني غير أبيض، على قدر ما يفرض الإنسان الأبيض تمييزاً عليّ، يجعلني مستعمَراً، يجرّدني من كل قيمة، يقول لي إني أشوّش العالم، وأن عليّ الإسراع، قدر المستطاع، لمواكبة العالم الأبيض." [42]
ولا يدخل حديث "فانون" عن الملغاشي الذي يعيش هويته وجوداً مطلقاً في صيغة الليبرالية عن الذات الفردية المكتفية بذاتها، بمعنى ارتكاز "المثُل الليبرالية للفرد المكتفي ذاتياً والمتحكّم تماماً في حياته وجسده على مجموعة من عمليات المحو والتغاضي، حيث يتم تحويل جسد الفرد إلى ملكية منزوعة الجسد قابلة للنقل أو إلى قطعة لحم محددة وثابتة وسلبية." [43] بل يناقش "فانون" هذه المسألة ضمن إطار الوجود السابق للاستعمار، وما قبل انشطار الذات الذي أحدثه [القطع] الاستعماري، والذي عبّر عنه بالقول: "للأسود بعدان. أولهما مع نظيره، وثانيهما مع الأبيض. فالأسود يتصرف تصرفاً مختلفاً، مع أبيض ومع أسود آخر. لا ريب في أن هذا الانشطار العضوي هو النتيجة المباشرة للمغامرة الاستعمارية." [44]
إذ لم يتشكّل هذا الوعي المزدوج لدى الذات السوداء قبل "اللقاء الاستعماري" الذي جمعها بالأبيض فلا يعرف "نقيضه" إلا من خلال هذا التفاعل؛ فكما يوضّح فانون "مادام الأسود في دياره، لا يكون عليه أن يجرّب وجوده مع الآخر، اللهم إلا في مناسبة صراعات داخلية صغيرة. حقاً هناك لحظة "الوجود لأجل الآخر"، التي تحدّث "هيغل" عنها، لكن كل أنطولوجيا، كل آنية، كينونية، تغدو مستحيلة التحقق في مجتمع مستعمَر… فالأنطولوجيا… لا تسمح لنا بفهم كينونة الأسود. لأن الأسود لم يعد عليه أن يكون أسود، بل أن يكونه في مواجهة الأبيض… فبين عشيّة وضحاها، وجد الزنوج أنفسهم بين نظامين مرجعيين، وكان عليهم أن يحدّدوا موقعهم بالنسبة إليهما… إن تقاليدهم والمراجع التي تحيل إليها، كانت قد أُبطلت، لأنها كانت متناقضة مع حضارة كانوا يجهلونها، وكانت تُفرض عليهم." [45]
ولذلك، يستنتج "فانون" أن صنافيات الذوات "البيضاء" و"السوداء" هي نتاج العملية الاستعمارية للبيض، حيث يقول: "نحن أمام مشهد الجهود اليائسة لزنجي ينكبّ بحماسة على اكتشاف معنى الهوية السوداء. فالحضارة البيضاء والثقافة الأوروبية فُرضتا على الأسود انحرافاً وجودياً. سنبيّن في موضع آخر أن ما يُسمى غالباً باسم [الذات] السوداء، هي من إنشاء الأبيض." [46] ولكن، كيف يمكن للأسود أن يخرج من دوامة ردة الفعل وانشطار الذات التي فرضها الواقع الاستعماري؟ وكيف لا ينزلق الى قابلية الاستعمار، وإنما ينفتح على القابلية للتضامن الإنساني؟
بداية، يشير "فانون" إلى أنه "في كل حال، لا ينبغي الشعور بلوني كأنه عاهة. فمنذ أن يتقبّل الزنجي الشرخ الذي يفرضه الأوروبي، لا تعود أمامه فسحة و"منذئذ، لا يكون مفهوماً أن يحاول الارتفاع نحو الأبيض؟ الارتفاع في سلّم الألوان التي يُعيّن لها نوعاً من الهيكيلية؟" سنرى أن حلاً آخر ممكن. فهو يفترض إعادة بناء العالم". [47] وبمعنى آخر، انطلاقاً من الهشاشة، ومن هذا الموت الاجتماعي والوعي المزدوج، إما أن تسير الذات السوداء نحو ما استنتجه "مانوني" من قابلية الاستعمار، ووفقاً لـ"فانون": "يقال لنا بكل بساطة، لأن هناك شيئاً ما، مسجّلاً في "التلافيف القدرية" خصوصاً، في اللاشعور، كان يجعل من الأبيض السيد المنتظر؛" [48] وإما أن يتجاوز قابلية الاستعمار إلى القابلية للتضامن الإنساني، من خلال إعادة بناء العالم، لا بالعودة للماضي وإنما ببناء مستقبل جديد يقوم على التضامن الإنساني. وفي هذا السياق، يضيف "فانون: "لا يمكن للثورة الاجتماعية أن تستمدّ شاعريتها من الماضي، بل فقط من المستقبل،" [49] أيّ نفي فكرة العودة إلى ذات متخيلة والبقاء أسرى الماضي، إذ "إن اكتشاف وجود حضارة زنجية في القرن التاسع عشر لا يمنحني براءة إنسانية. فسواء شئنا أم أبينا، لا يمكن للماضي، في أي حال، أن يوجّهني في الحاضر." [50] مضيفاً أنّه "كلّما رفض إنسان محاولة استعباد غيره، شعرتُ أني متضامن مع فعله. لا ينبغي لي، بأية طريقة، أن أستخرج من ماضي الشعوب الملوّنة توجّهي الأصلي. بأية حالة، لا يحق لي أن أنكبّ على إحياء حضارة زنجية مغفلة، بلا وجه حق. فأنا لا أجعل من نفسي إنسان أي ماض. لا أريد أن أتغنّى بالماضي على حساب حاضري ومستقبلي... وحين أتخطّى المعطى التاريخي… أستدخل دورة حريتي. إن تعاسة الإنسان الملوّن تكمن في أنه كان مستعبداً… فأنا، الإنسان الملوّن، لا أنشد سوى شيء واحد… أن يتوقف استعباد الإنسان للإنسان… وأن يُسمح لي باكتشاف الإنسان، وأن أريده أينما كان." [51]
في هذا السياق، فإن الانتقال من صيرورة قابلية الاستعمار إلى صيرورة التضامن الإنساني، انطلاقاً من هشاشة الذات المفروضة، كما هو الحال عند "فانون"، "تومض إلى الحياة من أعماق العدم واللاوجود (nonbeing)... والمفارقة التي تشكّل الوجودية الفانونية تحتوي على النفي المطلق للوجود [إذا ما نظرنا للموت الاجتماعي وسلب الأصالة عبر تحطيم المستعمِر الأبيض لعالم المستعمَر الأسود القديم كما وضح فانون سابقاً] كمصدر لنشوئها: العدم واللانهائية هما تربتها وماؤها، أما تقرير المصير فهو شمسها... وعليه، فإن منطقة اللّاوجود (nonbeing) تتّسم، على نحو متناقض، بكونها متقلبة ومغذّية في آن معاً، إذ تترك الأنا المتحلّلة عالقة في صراع دائم بين قطبي الوجود: ما بين ذات ناشئة وبين التشييء العنصري." [52] وبلغة "انثوني اليساندريني"، "إن ما تمثّله عملية التحرّر من الاستعمار (decolonization) في جوهرها هو النضال المستمر والدائم ضد المحاولة التي لا تنتهي للاستعمار في فرض حالة من الجمود على المناطق والشعوب التي يسعى إلى إخضاعها." [53]
ويضيف "اليساندريني": "تشترك القوتان اللتان يهاجمهما "فانون" باستمرار – العنصرية والاستعمار – في خاصية أساسية، وهي قطع الطريق أمام أي إمكانية للحركة أو التحوّل، وفرض حالة من الجمود يمكن بسهولة شديدة أن تُخطَّأ وتُؤخذ على أنها واقع ثابت لا يتغير. إن التحديقة (gaze) العنصرية تعمل على تثبيت الآخر… لا تؤثّر هذه الهويات المثبّتة – وفقاً للصيغة التي يعرضها "فانون" – في من يُنظر إليه فقط، بل أيضاً في مَن ينظر، في تلك اللحظة البدئية. وهذا ما يتيح للمستعمِر أن يُصرّ على أنه "يعرف" المستعمَر – وكما يوضّح "فانون" في معذبو الأرض، فإن المستعمِر محق في ادعائه هذا، لأنه هو من "صَنع ويواصل صنع الذات المستعمَرة." [54] ولذلك، يضحي التحرر من الاستعمار عملية في إعادة هيكلة مستمرة ودائمة للذات لمواجهة الجمود الذي يلقيه المستعمِر على المستعمَر وتثبيته ضمن "التحديقة العنصرية والاستعمارية،" فإذا ما كان الاستعمار "تأسيسياً للذات" وفقاً لـ"فانون"، فإن الاستجابة والجواب على التحدّي (لا ردة الفعل) يكون بسيولة تحوّلات الذات نحو التحرر، أي ذات قيد التشكّل في خضم النضال، وخروجاً من خيارات "مانوني" ما بين التبعية للمستعمِر والشعور بالدونية نحوه، نحو فضاء الإنسانية ضمن إطار الفعّالية الذاتية الخلّاقة، فـ "ما يتجلّى حتى الآن هو تكرار لفكرة الذاتية بوصفها تتكوَّن وتُعاد تشكيلها من خلال الأفعال التي تُواجِه العالم الاستعماري." [55] وبكلمات "فانون" إن: "ما نريده هو أن نساعد الأسود على التحرر من الترسانة العقدية (arsenal of complexes) التي نمت في قلب الوضع الكولونيالي." [56]
خاتمة: عالم جديد للتضامن الإنساني من ثنايا العنف
في معرض تصديره لكتاب "فانون" معذبو الأرض، أشار "سارتر" إلى أن قتل الأوروبي هو قتل لعصفورين بحجر واحد، قتلاً للمضطهِد والمضطهَد في آن واحد، أيّ لثنائية الصنافيات هذه وتجسيدها وما يترتب عليها من ناحية وجودية، مضيفاً بأن هذا العنف "الجامح ليس زوبعة سخيفة، ولا هو إيقاظ لغرائز وحشية، ولا هو ثمرة للحقد والاحتقار، بل هو فعل إنسان يعيد تشكيل ذاته… والمستعمَر يشفى من عصاب الاستعمار بطرد المستعمِر بالسلاح، إنه حين ينفجر حنقه يستردّ شفافيته المفقودة… [المستعمَرون] يختبرون معرفة الذات من خلال إعادة تشكيلها." [57]
ولو أخذنا هذه الفكرة على المستوى المعنوي لا الحرفي المادي لعملية القتل، إلى جانب مقولتيْ "فانون" من أن التحرّر ومحو الاستعمار حدث عنيف بالضرورة، [58] وأن "العنف على المستوى الفردي يعدّ فعلاً تطهُريّاً يُخلّص الإنسان من مساوئه وعقدة نقصه أو ربما دونيته، ومن شعوره باليأس وعدم الفاعلية السلبية، ويستعيد شجاعته واحترامه لذاته"؛ [59] فإنّ العنف يؤدي إلى إحلال نوع إنساني محل نوع إنساني آخر، [60] أي أن الإنسان في خضم هذا العنف الخالص يعيد اكتشاف نفسه ويُولَد ولادة ثانية وتبزغ الإنسانية من ثنايا هذا الاكتشاف.
ووفقاً للباحث جورج ماهر، "يمثّل العنف المحتوى لشكل أسطوري (Mythical) للذات الثورية… فإن قوة الأسطورة تشبه إلى حد لافت قوة الحرب: إذ يتم تشكيل ذات ثورية قوية حقاً من خلال تجنّب أي حسابات براغماتية، والتماهي الكامل مع النضال القائم." [61] وعلى الرغم من ارتباط العنف في تشكيل الذات حصرياً في معذبو الأرض، كما تناول العديدون، إلا أن ماهر يشير إلى أنه في سياق بشرة سوداء أقنعة بيضاء "تكتشف الذات السوداء الثورية تَجذّرها العِرقي، وهنا يطوّر فانون نظرية العنف بوصفه تأكيداً وجودياً للذات، وهي نظرية ستشكّل لاحقاً مضموناً لفكرة الذات الثورية التي تُعدّ، من نواحٍ عديدة، "أسطورية" في طبيعتها.. في كتاب بشرة سوداء أقنعة بيضاء، رأينا كيف يتخذ هذا العنف شكل تأكيد وجودي للذات، يعمل على تمزيق التحديدات الزائدة المرتبطة بالعرق... ويتمّ تحويل حالة اللا-وجود الأسود، عبر هذا التأكيد العنيف للذات، إلى كينونة، وإنْ كانت خاضعة، إلا أنها لم تُحرَم مسبقاً من إمكانية الوصول إلى الذاتية." [62] من هنا، ووفقاً لماهر، لا يقتصر العنف على العنف المادّي فقط، "لكن ربما الدليل الأقوى على أن العنف لدى فانون لا يمكن اختزاله في مجرد أفعال عنفية، يكمن في أن العنف بوصفه تأكيداً وجودياً للذات يسبق الفعل العنيف ذاته، إذ "في اللحظة التي يُدرك فيها [المستعمَر] إنسانيته، يبدأ في شحذ الأسلحة التي سيحقق بها انتصاره". فالعنف هنا هو وعي متمرّد، وكرامة في حالة ثورة." [63]
تأتي هذه الولادة الثانية على أنقاض العالم المانوي الذي رسمه "فانون" في معذبو الأرض، أيّ التناقض المطلق بين ثنائية المستعمِر والمستعمَر وتجاوزاً لثنائية الأبيض-الأسود التي حكمت منطق بشرة سوداء أقنعة بيضاء. فوفقاً لـ"الساندريني"، مقتبساً "بول جيلروي": "إن العنف المناهض للاستعمار، والذي يُشكّل الاستجابة الأولى للمانوية، "يفضي في نهاية المطاف إلى وعي أوسع" يفتح "باب الوعي المعارض، وللمرة الأولى الوعي الإنساني الكامل، أمام طيف أوسع من الحساسيات الأخلاقية والسياسية." [64] ووفقاً لذلك، يُعدّ "فانون" تجسيدا لهذا الانفتاح؛ "بالنسبة لـ"فانون"، الذي جاء إلى الجزائر من جزر المارتينيك مروراً بفرنسا، فإن هذا الفعل الإرادي لا يُعبّر عن تأكيد للهوية الذاتية؛ بل يُمثّل قراراً بالانخراط في نضال جماعي محدّد، ليس بصفته متعاطفاً أو داعماً خارجياً فحسب، بل كعضو فاعل في قلب هذا النضال. وما يجب التنويه إليه هنا هو كيف حوّل "فانون" موقعه كـ"غريب" داخل الثورة إلى موقع استراتيجي ونظري. وهذه نقطة مهمة، إذ لا ينبغي فهم موقف "فانون" من التضامن على أنه نشأ بشكل عفوي فقط من التزامه بالثورة الجزائرية أو من هويته المارتينيكية؛ بل أصبح هذا الموقف جزءاً من نضاله المستمر نحو بلورة فكرة جديدة عن الإنسان ذاته." [65]
تطلّب هذا الانخراط الفاعل، وإزاحة حاجز اللون وحواجز السياقات، من جزر الأنتيل إلى فرنسا فالجزائر، وما ينطوي على هذه الجغرافيّات من اختلافات في الجرح الاستعماري للإفريقي؛ إلى "تكريس الذات للآخر،" أيّ الانفتاح كشكل من أشكال الحساسية الإنسانية العالية، وكما عبّر المارتينيكي "ادوارد غلسيانت": "لقد مات في خدمة الجزائر، لقد مات جزائرياً، جزائرياً بالكامل، وسيتشبّث شعب جزر الهند الغربية بذكرى ذلك الجزائري، لأنهم يرون فيه أسمى وأرفع تجسيد لرسالتهم هم أنفسهم". وما قاله "فرانسيس جانسون"، محرّر كتاب "فانون" بشرة سوداء أقنعة البيضاء: "هذا المارتينيكي، الذي حوّله عبوره من خلال الثقافة الفرنسية إلى ثوري جزائري، سيبقى بالنسبة لنا مثالاً حياً للغاية على الكونية في الفعل، وأنبل مقاربة للإنسان وأسمى رؤية للإنسانية تم التعبير عنها حتى الآن في هذا العالم اللاإنساني." [66]
من هنا يأتي تعبير "نحن الجزائريين" تجسيداً للانتماء المبني على إرادة اكتشاف الذات، "بالنسبة لفانون، فإن الأمة هي نتاج الإرادة... وأن تكون جزائرياً لم تكن مسألة ولادة في بلد يُدعى الجزائر، بل مسألة إرادة أن تكون جزائرياً. إن "الأمة" عند "فانون" هي نتاج ديناميكي لفعل الشعب، أما قوميته فهي قومية الإرادة السياسية وربما القومية في أن يكون المرء جزائرياً، وليست قومية تقوم على العرق. وهذه القومية القائمة على الإرادة هي ما يُمكّنه من أن يتحدث بصيغة… "نحن الجزائريين". لقد تطلّب الأمر تحديقة (gaze) طفل أبيض ليُعلِّم "فانون" أنه "زنجي"، لكنه لم يحتج إلى أحد ليخبره بأنه جزائري، لقد كان جزائرياً لأنه أراد أن يكون جزائرياً." [67] ومن هذا المنطلق، تشكّل القومية بالنسبة لـ"فانون" مفتتحاً لوعاء وعي أوسع، ألا وهو الإنسانية، إذ يؤكد "إذا لم يتم شرح القومية وتعزيزها وتعميقها، وإذا لم تتحوّل بسرعة إلى وعي اجتماعي وسياسي، إلى إنسانية (Humanism)، فإنها تؤدي إلى طريق مسدود." [68]
ومن خلال هذه الرحلة في اكتشاف الذات، التي تصنع وتبشّر بالإنسانية الجديدة (New Humanism) من خلال الوعي بها والافتراق عن المعين الغربي، تتشكّل الضمانة نحو تحقيق القيم الإنسانية الجديدة الشاملة والجمع ما بين الخصوصية والكونية. وهنا كما يدلل "فانون"، "ليس وعي الذات انغلاقاً دون التواصل. وقد علّمنا التفكير الفلسفي أن وعي الذات هو ضمانة التواصل. إن الوعي القومي، إن الشعور القومي، الذي ليس تعصّباً قومياً، هو الأمر الوحيد الذي يهب لنا بعداً عالمياً… إذا كان الإنسان هو ما يفعله هذا الإنسان، فإننا نستطيع أن نقول إن الشيء الملح المستعجل اليوم، بالنسبة إلى المثقف الأفريقي، هو بناء أمّته. فإذا جاء هذا البناء صادقاً، أيْ إذا عبّر عن إرادة الشعب الواضحة، إذا كشف عن تحرق الشعوب الأفريقية، كان لا محالة مصحوباً باكتشاف قيم إنسانية شاملة، وكان يرتقي بهذه القيم الإنسانية الشاملة. لا يبتعد التحرر القومي بنا عن الأمم الأخرى، بل إنه هو الذي يجعل الأمة حاضرة على مسرح التاريخ. ففي قلب الوعي القومي، ينهض الوعي العالمي ويحيا." [69]
وكما يقول البروفيسور "اليساندريني"، في مؤلفه عن "فانون": "في إعلانه أن الهدف النهائي من النضال من أجل إنهاء الاستعمار هو "البدء بتاريخ جديد للإنسان." وإذا كان لهذا "التاريخ الجديد" أي معنى، فإن أساسه ذاته يضمن أن شروطه ستكون غير معروفة مسبقاً، لأنه ينطوي على تفجير حدود الفكر والعمل التي تحدد اللحظة الحاضرة… فالهدف هو خلق وجود لتاريخ جديد، لم يُفكَّر فيه ولم يُعش بعد… ومن الضروري الحذر من الوقوع في المثالية، لكن قد يكون من بين إمكانيات لحظتنا المعاصرة انفتاح نحو إحساس متجدد بالتضامن، بمعنى وضع الذات، حرفياً، في خدمة الآخر، باسم تحسين حال البشرية..." [70]
وفي الختام، مطارداً بهاجس الإنسان الجديد والكوني، لا يمكن قراءة تحوّلات "فانون" بما هي تقلبات وتناقضات شخصية فرضها وجود معلول، إذ لم تكن في نهاية المطاف إلا رحلة البحث عن الذات وتخليقاً ذاتياً للإنسان الجديد الكوني الذي طمح إليه، وهو ما يتطلّب منا الوقوف على إساءة قراءة "فانون" واعتباره شخصية ذات بعد واحد تسلبنا نموذجه الإنساني. إذ يتم وصمه باعتباره نبي العنف و"الإرهاب"، أو اختزال مسيرته في عمله كطبيب نفسي، أو بوصفه كارهاً للنساء، أو قراءته في إطار سياسات الهوية الليبرالي، الخ... حتى لو كانت إساءة القراءة تدلّ على، ما وصفه "آدم شاتز" بـ "الهالة التي تحيط [به]، وعلى القوة العاطفية لكتاباته. هذه القوة هي ما مكّن كتابات فانون من الانتشار الواسع، واكتساب معانٍ جديدة مع احتفاظها بقدرتها المستمرة على الإثارة والتحفيز." [71]
فلعل أبرز أشكال إساءة قراءة "فانون" تنبع من تقاسم وتفكيك إرثه الفكري وممارسته السياسية في الحقول المعرفية الأكاديمية. ففي مقابلة مع إحدى العارفات بـ"فانون"، والتي عملت معه، تقول: "لا أحب أن يتم تقطيع فانون إلى أجزاء صغيرة." كانت ترى أن من ينظرون إلى جانب واحد فقط من عمله أو شخصيته يفوتون [إدراك] الكل الذي لا ينفصم: طبيب نفسي وثوري، كاتب ورجل فعل، من جزر الأنتيل وفرنسي، جزائري وأفريقي. وكان يثير استغرابها وغضبها في آن، أن يُفكّك عمل "فانون" بتفانٍ تفسيري في الندوات الجامعية." [72]
****
الهوامش:
[1] Marino, Joe and Emily Crane. “Cops probing anti-Israel manifesto allegedly written by terror suspect Elias Rodriguez ahead of DC Jewish Museum shooting: sources”, New York Post May 22, 2025. https://nypost.com/2025/05/22/us-news/cops-probing-anti-israel-manifesto-allegedly-written-by-terror-suspect-elias-rodriguez-sources/; Shammas, Brittany, Kim Bellware, Katie Shepherd and Aaron C. Davis. “What we know about the man arrested in the D.C. Jewish museum shooting”, The Washington Post May 22, 2025. https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2025/05/22/elias-rodriguez-dc-shooting-israeli-embassy-jewish-museum/; Julie Bosman. “What We Know About the Accused Gunman in Washington”, The New York Times May 22, 2025. https://www.nytimes.com/2025/05/22/us/politics/dc-shooting-suspect-israel-embassy-aides.html
[2] Jeffrey James Byrne. Mecca of Revolution: Algeria, Decolonization, and the Third World Order (New York: Oxford University Press, 2016): pp 2-3, 11.
[3] Sebastian Garbe. Weaving Solidarity: Decolonial Perspectives on Transnational Advocacy of and with the Mapuche (Transcript Verlag, 2022): pp 13-14, 16, 18-19.
[4] Sally J. Scholz, “Political Solidarity and Violent Resistance”. Journal of Social Philosophy, Volume 38, Issue 1 (Spring 2007): p 38.
[5] Anthony C. Alessandrini. Frantz Fanon and the Future of Cultural Politics: Finding Something Different (Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2014): pp 190-191.
[6] Zeina Maasri, Cathy Bergin and Francesca Burke. “Introduction: transnational solidarity in the long sixties” in Transnational Solidarity: Anticolonialism in the Global Sixties, edited by Zeina Maasri, Cathy Bergin and Francesca Burke (Manchester: Manchester University Press, 2022): pp 2, 4, 6, 12, 14, 15-16.
[7] Sebastian Garbe. “Solidarity in Context of Global Inequalities” in Global Handbook of Inequality, edited by Surinder S. Jodhka and Boike Rehbein (Switzerland: Springer Cham, 2023): pp 16, 17-18; Lawrence Wilde, “The Concept of Solidarity: Emerging from the Theoretical Shadows?”. The British Journal of Politics and International Relations, Volume 9, Issue 1 (2007): pp171, 176-177.
[8] Jeffrey James Byrne (2016), ibid: pp 2, 111.
[9] أحمد ضياء دردير، ""قِبلة الثورات": عن حالة ثورية لم تستمر، وكتاب لم يفِ تطلعات قارئيه". موقع حبر، 4 كانون الأول 2022، https://www.7iber.com/culture/%D9%82%D9%90%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/
[10] Mumia Abu-Jamal, “Frantz Fanon and his Influence on the Black Panther Party and the Black Revolution”. In Frantz Fanon and Emancipatory Social Theory: A View from the Wretched, edited by Dustin J. Byrd & Seyed Javad Miri (Leiden & Boston: Brill, 2020): p 13.
[11] Patrick Taylor, “Frantz Fanon and Mythology”. Canadian Journal of African Studies, Volume 16, Issue 2 (1982): p 385.
[12] David Macey. Frantz Fanon: A Biography (New York: Picador USA, 2000): p 397.
[13] ايلا شوحات، "كولومبوس، فلسطين، اليهود والعرب: نحو مقاربة علائقية لهوية المجموعة". الكرمل، العدد 52 (1997)، ص38.
[14] Alina Sajed and Timothy Seidel, “Anticolonial connectivity and the politics of solidarity: between home and the world”. Postcolonial Studies, Volume 26, Issue 1 (2023): p 1-2.
[15] فرانتز فانون. بشرة سوداء أقنعة بيضاء، تعريب خليل أحمد خليل (بيروت: دار الفارابي، 2004): ص ، 109-110.
[16] Sebastian Garbe. “Solidarity in Context of Global Inequalities” in Global Handbook of Inequality, edited by Surinder S. Jodhka and Boike Rehbein (Switzerland: Springer Cham, 2023): p 3.
[17] Ibid: p 3; Sebastian Garbe (2022), ibid: p 31.
[18] Giovanna Covi, “Europe’s Crisis: Reconsidering Solidarity with Leela Gandhi and Judith Butler”. Synthesis: an Anglophone Journal of Comparative Literary Studies, Issue 9 (2016): pp 148-149.
[19] Sebastian Garbe (2023), Ibid: pp 3-4; Giovanna Covi (2016), ibid: pp 150-151; Lawrence Wilde (2007), ibid: p 171.
[20] Sebastian Garbe (2022), ibid: p 34
[21] Ibid: pp 34-38.
[22] Giovanna Covi (2016), ibid: p 152.
[23] Sebastian Garbe (2023), Ibid: p 8.
[24] Sebastian Garbe (2022), ibid: pp 38-39, 41.
[25] Jeremey M. Glick, “Aime Cesaire’s Two Ways to Lose Yourself: The Exception and the Rule”. In Partisan Universalism: Essays in honour of Ato Sekyi-Otu, edited by Gamal Abdel-Shehid and Sofia Noori (Daraja Press, 2021): p 81.
[26] Sebastian Garbe (2022), ibid: pp 43-45.
[27] Anthony C. Alessandrini. Frantz Fanon and the Future of Cultural Politics: Finding Something Different (Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2014): p 189.
[28] Giovanna Covi (2016), ibid: pp 152-153, 155.
[29] Ibid: pp 152, 154, 156.
[30] Fanny Soderback, “Performative Presence: Judith Butler and the Temporal Regimes of Global Assembly”. Diacritics, Volume 46, Issue 2 (2018): pp 33-34, 36.
[31] هنا بتلر تكمل مهمتها في ارث النسوية النقدي، اذ تشير إلى أن التضامن لا ينبغي أن يقوم على طمس الفروقات بين الهويات، ودون السعي إلى الاندماج أو التوحيد الهويّاتي، وهو حال بيل هوكس وحديثها عن غياب الضرورة في "القضاء على الاختلاف من أجل الشعور بالتضامن". انظر/ي:
153-154; Sebestian Garbe (2022), ibid: p 50. Giovanna Covi (2016), ibid: pp
[32] Ibid: pp 36-37, 41.
[33] Adriana Zaharijevic, “Equal bodies: The notion of the precarious in Judith Butler’s work”. European Journal of Women's Studies, Volume 30, Issue 1 (2022): pp 44-45; Judith Butler, “Rethinking Vulnerability and Resistance”. In Vulnerability in Resistance, edited by Judith Butler, Zeynep Gambetti and Leticia Sabsay (Durham and London: Duke University Press, 2016): p 16.
[34] Ibid: pp 14-15, 22.
[35] Fanny Soderback (2018), ibid: p 42.
[36] Orlando Patterson. Slavery and Social Death: A Comparative Study (Cambrdige, Massachusetts and London: Harvard University Press, 1982): pp 5, 38, 45.
[37] Achille Mbembe, “Necropolitics”. Public Culture, Volume 15, Issue 1 (Winter 2003): p 21.
[38] فرانز فانون. بشرة سوداء اقنعة بيضاء، تعريب خليل أحمد خليل (بيروت: دار الفارابي، 2004): ص 196.
[39] مرجع سابق: ص 138-139.
[40] مرجع سابق: ص 103.
[41] وليم إ. بورجهارت ديبويس. روح الشعب الأسود، ترجمة أسعد حليم (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2002): ص 34.
[42] فرانز فانون (2004)، مرجع سابق: ص104.
[43] Adriana Zaharijevic (2022), ibid: p 40.
[44] فرانز فانون (2004)، مرجع سابق: ص19.
[45] مرجع سابق: ص117-118.
[46] مرجع سابق: ص16-17.
[47] مرجع سابق: ص 88.
[48] مرجع سابق: ص105.
[49] مرجع سابق: ص237.
[50] مرجع سابق: ص 239.
[51] مرجع سابق: ص240، ص245.
[52] Nicholas Webber, “Subjective Elasticity, “Zone of Nonbeing” and Fanon’s New Humanism in Black Skin, White Masks”. Postcolonial Text, Volume 7, Issue 4 (2012): pp 1, 7.
[53] Anthony C. Alessandrini (2014), ibid: pp 190-191.
[54] Ibid: pp 191-192.
[55] Sarah Jilani, “Becoming in a colonial world: approaching subjectivity with Fanon”. Textual Practice, Volume 38, Issue 10 (2024): pp 2-5, 11.
[56] فرانز فانون (2004)، مرجع سابق: ص33.
[57] Frantz Fanon, The Wretched of the Earth. translated by Richard Philcox (New York: Grove Press, 2004): p lv.
[58] Ibid, p 1.
[59] Ibid, p 51.
[60] Ibid, p 1.
[61] George Ciccariello-Maher, “To Lose Oneself in the Absolute Revolutionary Subjectivity in Sorel and Fanon”. Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, Volume 5 (Summer 2007): pp 101, 103.
[62] Ibid: pp 104, 110.
[63] Ibid: pp 108.
[64] Anthony C. Alessandrini (2014), ibid: p 212.
[65] Ibid: pp 195-197.
[66] Ibid: pp 212, 214-215.
[67] David Macey (2000), ibid: pp 377-378, 389.
[68] Frantz Fanon (2004), ibid: pp 144
للمزيد حول الانسانية التي دعا إليها فانون وتمييزها عن "Western Humanism" انظر/ي:
Majid Sharifi and Sean Chabot, “Fanon’s New Humanism as Antidote to Today’s Colonial Violence”. In Frantz Fanon and Emancipatory Social Theory: A View from the Wretched, edited by Dustin J. Byrd and Seyed Javad Miri (Leiden and Boston: Brill, 2020): pp 251-271.
[69] فرانز فانون، معذبو الأرض، ترجمة سامي الدروبي وجمال الاتاسي (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، الطبعة الثانية 2015): ص 199.
[70] Anthony C. Alessandrini (2014), ibid: pp 216-217, 223.
[71] Adam Shatz, The Rebel’s Clinic: The Revolutionary Lives of Frantz Fanon (London: Head of Zeus Ltd, 2024): p 346.
[72] Ibid: p 328.