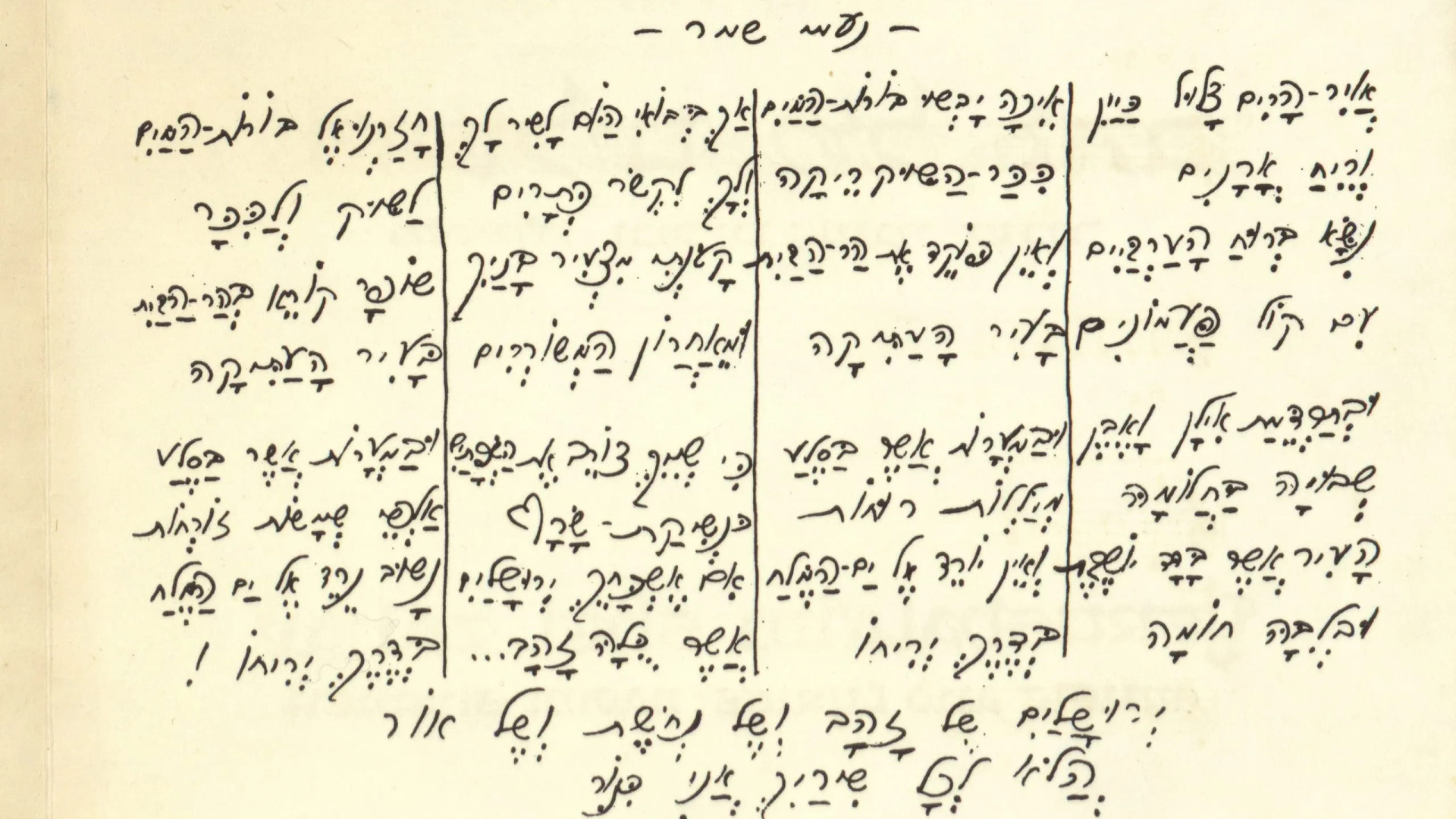نضع بين أيديكم مقالين مترجمين عن العبرية يتناولان الملجأ في "إسرائيل" بوصفه فكرة وحاجة وجودية في مواجهة أخطار "العدو". فما أن انتشرت لبعض الوقت قناعات صهيونية بأن الحاجة إلى الملاجئ تراجعت، عاد النقاش من جديد تحت النار، ولكن هذه المرّة معنوناً بأنّ الملاجئ ذاتها لم تعد مكاناً آمناً وحصيناً يحمي من يلوذ بها، بل تحوّل بعضها إلى مصائد موت وأيضاً مواقع للصراع الاجتماعي، كما كشفت الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة. في ظل هذا التحول، وفيما يشتد النقاش الصهيوني العام، نتعرف أكثر في هذين المقالين على الملجأ الصهيوني وجذوره، في البيت-القلعة والحيّز العام، ونقرأ عن دلالاته في السردية الصهيونية وارتباطه بحروب "إسرائيل" التي لا تنتهي إحداها حتى تبدأ الأخرى، ونتوقف عند ما أظهرته المواجهة الأخيرة من عيوب قاتلة وفروقات مجتمعية عميقة تفرض على المجتمع الصهيوني وقيادته، من جديد، إعادة التقييم والتخطيط.
نُشر المقال الأول بتاريخ 19 حزيران 2025 في صحيفة "هآرتس" العبرية، بعنوان: 'تاريخ موجز للملاجئ "الإسرائيلية" منذ الخمسينيات وحتى تخلّي "الدولة" عن مسؤولياتها'، ونُشر المقال الثاني بتاريخ 20 حزيران 2025، في صحيفة "ذا ماركر" العبرية، بعنوان: 'في حالة الإنذار الحقيقي، فليتدبّر كل شخص نفسه'.
ترجمها لنا كريم قرط
تاريخ موجز للملاجئ "الإسرائيلية" منذ الخمسينيات وحتى تخلي "الدولة" عن مسؤولياتها
"نعما ريفاه"
"استسلمت. غرقت في الملجأ، وحدي. ها هو يؤازرني، لا كما يؤازر صديق حقيقي صديقه، وإنما كما يؤازر وكيل راعٍ، كما يؤازر من يريد أن يجعل الآخرين يدمنون على مؤازرته: "تعال"، سمعته يهمس لي من ثقب بابه الموصد الفضي. "ابق هنا، عندي أفضل لك، فهنا ستشعر بالأمن أكثر. ماذا، أتحتاج الحياة هناك في الأعلى؟ الأفضل أن تختبئ. هنا لن يصلك التلوث مطلقاً. هنا لن تصلك الدولة أبدا. صحيح أنني ملجأ، ولكنني لست معتماً...كلمتي إسمنت".
(من رواية "مكلاتور"، لـ "يوسي سوكري"، إصدار "يديعوت سفاريم"، 2005). [1]
منذ بداية الصهيونية و"إسرائيل" بمثابة أرض الملاجئ. فلكلٍّ منا، كما هو الحال مع "سوكري"، علاقته الحميمة مع ملجأ أو "مماد". [2] غير أن الشهور العشرين الأخيرة [منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة] قد أدت إلى خلخلة مفهوم التحصين في الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، مع تنوع أشكال التهديدات التي تواجهها الدولة، من التهديدات التي تستخدم فيها تكنولوجيا تعود للقرون الوسطى إلى تهديدات وكأنها [خارجة] من كتب الخيال العلمي.
لقد شيّدنا "مماد" [أي غرفة محصّنة داخل الوحدة السكنية] لكل بيت في غلاف غزة، ولكنّها اختُرقت في السابع من أكتوبر، لأنها كانت تحمي من الصواريخ لا من البشر. ولقد طوَّرنا أنظمة دفاع جوي هي من الأفضل بالعالم -قبة حديدية ومقلاع داوود والسهم- والتي منحتنا وهماً بالأمن، إلى درجة أنّنا لم نعد نهرع إلى الملاجئ عند التعرض لهجمات، غير أنّ هذا الدفاع الذي توفّره بدا قابلاً للاختراق عندما يواجه صليةً بعشرات الصواريخ البالستية.
وفي الأيام الأخيرة، اكتشفنا أيضاً أنه حتى "المماد" ليس محصناً ضد الإصابة المباشرة بصاروخ بالستي. فقد أثارت مشاهد الدمار في المباني الحديثة في "بتاح تكفا" هلعاً واسعاً، وذلك دون الحديث عن الفجوات العميقة في مستوى التحصين بين المباني القديمة والجديدة، وبين الأطراف والمركز، وبين الأغنياء والفقراء. وبذلك، يكون السؤال المطروح: أين هو المكان الأكثر أمناً؟ وكيف ينبغي لـ"الدولة" حماية جميع مواطنيها؟
قدّمت المهندسة المعمارية "تولاه عمير" عرضاً بعنوان بلد الملجأ – دفاع مدني مبنيّ، يناقش موضوع [التحصين] من زاوية نظرية وثقافية معتمدةً في معالجتها على مقاربة نقدية. و"عمير" هي أرملة "رون فوندوك"، أحد مهندسي اتفاق أوسلو وهي والدة "ماي فوندوك"، المديرة العامة لمنظمة "بلاد للجميع" التي تهدف لبلورة حل سياسي بديل للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني. وتقول بسخرية: "كان علينا في السابع من أكتوبر أن نضيف غاز الفلفل للملاجئ"، مضيفة: "في الحرب الحالية، يبدو أن من يقرّون السياسيات يملكون أسهماً في شركات النفط والزجاج. فقد أمضينا 70 عاماً ونحن نطوّر نظام التحصين، لنكتشف الآن وجود عيوب كثيرة، سواء أمام السلاح البدائي أو المتطور. ولكن لا أحد يسعى لتقديم حل سياسي الذي هو البديل الحقيقي".
يروي رجل إنقاذ مخضرم، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه تفقّد مؤخراً عدداً من المواقع التي تعرّضت لإصابات شديدة، قائلاً: "لم نواجه قبل هذه الحرب الحالية حالة أصيب فيها "مماد" إصابة مباشرة. ففي موقعين عملت فيهما، تعرض الملجأ لإصابة مباشرة ودُمّر، ولحسن الحظ كان أحدهما فارغاً ساعة الإصابة". ويضيف: "في كل المواقع، ظلت ملاجئ "المماد" المجاورة، سواء كانت فوق "المماد" المتضرر أو تحته، سليمة ولم يُصَب من كانوا بداخلها، على عكس الجدران والأعمدة العادية من حولها التي استُهدفت وانهارت". لكنّه يشير إلى أنه على الرغم من صمود الملاجئ الأرضية أمام الضربات المباشرة بشكل أفضل بكثير، "يمكن أن نواجه مشكلة في عمليات الإنقاذ إذا انهار المبنى فوق مدخل الملجأ. لجأ الكثيرون اليوم إلى مواقف السيارات، وعلينا التأكد من صلاحيتها كبديل للملاجئ، فإذا كانت لا تصلح قد تنهار على من فيها".
التخفف من المسؤولية في عام 1969
ومنذ قيامها، وضعت "إسرائيل" لوائح طوارئ لـ[تنظيم] بناء الملاجئ، ونصّ قانون الدفاع المدني لعام 1951 على وجوب توفّر استجابة أمنية قريبة لكل شقة، سواء عبر الملاجئ العامة أو المشتركة. وعلى الرغم من تعديل القانون أكثر من 20 مرة منذ ذلك الحين، لم يطبَّق بشكل كامل أبداً وظل مئات الآلاف من "مواطني الدولة" بلا ملاجئ، لا سيما في القرى غير المعترف بها في النقب [القرى العربية البدوية في ديار بئر السبع] والبلدات العربية والحريدية.
وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، أقيم عدد كبير نسبياً من الملاجئ العامة، ولا تزال العديد منها قائمة حتى اليوم. لكن مع نهايات الستينيات وبداية السبعينيات، بدأت الدولة تنقل مسؤولية بناء الملاجئ لأصحاب العقارات. وجاء في تعديل قانون الدفاع المدني لعام 1969: "مؤخراً، تنامت ظاهرة بناء المباني الضخمة، وأصبحت سياسة الدفاع المدني (التي عُرفت مع الوقت بالجبهة الداخلية) تُلزم أصحاب العقارات ببناء مساحات تحت أرضية تُخصص كملاجئ عامة، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي الباهظ الذي تتحمّله خزينة الدولة والمرتبط بإنشاء الملاجئ العامة".
وُلد "المماد" بعد حرب الخليج الثانية 1991 استجابةً لسببين رئيسيين: أوّلهما الخطر المتزايد من الهجمات بالغازات السامة، وثانيهما الحاجة لتقصير زمن الوصول للملاجئ نظراً إلى سرعة الصواريخ. وإلى جانب "المماد"، ظهرت أيضاً الغرفة المحصّنة المشتركة داخل المبنى، المعروفة باسم "المماك". [3] التي وعلى الرغم من فوائدها الجمة تكاد لا تُستخدم تقريباً إلا في سكنات الطلاب ومآوي كبار السن أو المباني السكنية ذات الشقق الصغيرة، كما هو الحال في حي "فلورنتين" في "تل أبيب". كما ترجع قلة إنشاء "المماك" واستخدامه إلى أنه مصنّف في لوائح التخطيط كمساحة خدماتية، لا كجزء أساسي من المساحة السكنية في الشقق، ويبيعه المقاولون كغرفة إضافية في الشقة. وقد تمّ إلغاء هذا التصنيف القانوني مؤخراً.
وشهد عام 2005 تحولاً جوهرياً إضافياً في المخطط التفصيلي رقم 38، بعد مراجعات ونسخ لا حصر لها، هدفت بشكل أساسي إلى تعزيز التحصين والجبهة الداخلية في مواجهة الزلازل والصواريخ. تعرض هذا المخطط لانتقادات شديدة بسبب تحويله السكّان إلى مخططين عقاريين يتحمّلون مسؤولية أمنهم بنفسهم، ما عمّق الفجوات الاجتماعية بشكل كبير.
خيار "المَماك"
"أحياناً كنت أخرج فقط حتى لا أفوّت سماع النبأ المرتجى بانتهاء الحرب، ولكنّ طلعاتي تلك كانت عبثاً. ليس فقط لأنّ هذا النبأ لم يأتِ، بل لأن كل خروج بدا وكأنه يدفع الذروة التالية [للحرب] إلى مستوى أعلى، حتى يصير بلوغ [نهايتها] مستحيلاً. ومع ذلك توصّلت لأمر واحد: انتبهت لحقيقة أنني لست وحيداً. تفحّصت باحثاً عن الونس آخرين يسيرون في الطرقات باضطراب شديد، يبذلون كل ما في وسعهم حتى لا تراهم عين الله [ولا تراهم] دولتهم". ("مكلاتور"، سوكري).
لم تنتهِ الحروب، وكبرت "إسرائيل". وفي العقدين الأخيرين، اتجه عدد متزايد من المهندسين المعماريين والمخططين إلى تعزيز خيار "المماك"، الذي تتمثّل إحدى ميّزاته في إتاحته هامشاً أوسع من الحرية من ناحية التخطيط المعماري. إذ يتم اقتطاع مساحته، التي تتراوح بين 20 و25 متراً مربعاً، من عدة وحدات في الطابق، ويمكن استخدامه كحيز عام مشترك لسكان الطابق أو مستخدميه.
وقد أظهرت الحرب الحالية ميزات إضافية للـ"مماك". إذ تقول المهندسة المعمارية "ميخال مئير"، التي شغلت مؤخراً مهندسة بلدية "بَت يام"، أن ما يجري حالياً للـ"مماد" كان متوقعاً. فقد "كان واضحاً أن الأخير مناسب في حالة الإصابات السطحية والشظايا، ولكنه لا يصمد أمام الضربات المباشرة. فهو مناسب أكثر لهجمات قادمة من قطاع غزة، بينما تبيَّن بأن المباني القديمة فيها ملاجئ أكثر أماناً. فالـ"مماد" يوجد غالباً كملحق خارجي للمبنى يتضمّن نافذة، باعتباره مصمّماً لأن يكون غرفة صالحة للسكن والاستخدام تمكّن المطور العقاري من تسويقه، وهذا ما يجعله أكثر عرضة للإصابات [المباشرة].
أما "المماك"، فمن السهل موضعته في قلب المبنى بالقرب من بيت السلالم، ما يجعله نواة [إنشائية] صلبة تصلح أيضاً في حالة حدوث زلازل، وتكاد احتمالية إصابته تكون معدومة. ولذلك، "يجب أن يتم تعديل القانون بحيث لا تحتسب مساحته ضمن مساحة البناء، بما يشجع المطورين العقاريين على اعتماده بدلاً من الـ"مماد". وبالتأكيد، يظلّ "المماد" خياراً أفضل من أي غرفة عادية أخرى في المبنى كونه يوفّر حماية من الأضرار غير المباشرة. ولكنّي متيقنة بأن جهاز التخطيط سيعيد التفكير في هذه المسألة في الفترة المقبلة".
لماذا ربطت "الدولة" بناء المزيد من الملاجئ العامة بهدم المباني القديمة؟
تشير المهندسة "مئير" إلى وجود الكثير من الضغوط، بما فيها الهستيريا، التي تحرّكها اعتبارات اقتصادية وتدفع باتجاه هدم المباني القديمة وبناء أخرى مكانها. وتكمل: "صحيح أن "المماد" [داخل الشقة] يتيح، مثلاً، ترك طفل نائم فيه عند الحاجة للتوجه إلى الملاجئ، ولكن يظل "المماك" والملاجئ العمومية خياراً أفضل من نواحٍ عديدة. ولا يقتصر هذا التفضيل على الاعتبارات الحضرية والمعمارية، بل أصبح واضحاً الآن أنها أفضل أيضاً من الناحية الأمنية. في المقابل، يتحتم على الدولة والسلطات المحلية أن تباشر في بناء ملاجئ عامة في الأماكن التي تفتقر إلى التحصين اللازم، بدلاً من انتظار تنفيذ مشاريع الهدم وإعادة البناء. وقد بادرت العديد من السلطات المحلية، مثل "بت يام"، الاستعداد للمرحلة الراهنة بتحويل المدارس والمراكز الثقافية والرياضية إلى أماكن يمكن للسكان الاحتماء داخلها. وعلى الرغم من الانتقادات، علينا أن نقرّ بأن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة التي تستجيب بطريقة هندسية معمارية لمواجهة الكوارث، سواء هجمات الصواريخ أو الزلازل".
أما المهندس "يوفال براك"، وهو المهندس السابق لبلدية "حاريش" ويعمل في مجال الإنقاذ، فيطرح وجهة نظر مغايرة حول "المماك"، مشدداً على ضرورة التفكير في مسألة صيانته واستخدامه الفعلي: "ماذا سنفعل بهذه الغرفة الفارغة؟". ومع أنه تعرض لإصابات مباشرة في الأيام الأخيرة، فهو يعتبر بأنّ "المماد" يظل الخيار الأمثل وتبقى "احتمالية تعرضه لإصابة مباشرة ضئيلة". ولكنه يقرّ في ذات الوقت بأن الملجأ الأرضي يظلّ أفضل من ناحية التحصين كونه يعزّز "مستوى الحماية بشكل كبير، بفعل عدم احتكاكه تقريباً بمستوى الأرض [أي أنه تحتها]، منبّهاً إلى ضرورة مراعاة سرعة الوصول إليه في التخطيط.
وعلى الرغم من سقوط القتلى ومشاهد الدمار، يرى "باراك" بأن الدولة تواجه تحدياً، إذ "لا يمكنها توفير الحماية المطلقة، والغالبية العظمى ممن احتموا في "المماد" أو الملاجئ لم يصابوا أو يموتوا". بالمقابل، يعتقد بأنّ التعديلات التي أجريت على نظام التحصين على مر السنوات، بهدف تحقيق التوازن بين الواقع ومستوى التهديدات، كانت جيدة بما فيه الكفاية ولا يوجد لها مثيل في العالم. ويشير بصفته رجل إنقاذ ومهندساً إلى أنّ الدمار الذي لحق يعتبر أمراً ثانوياً، مضيفاً "ما يهمني هو أن يكون الناس محميين. صحيح أن المباني أصيبت بشدة، ولكن معظم من كانوا بداخلها خرجوا سالمين، وهذه النجاة تعني أن لدينا نظام تحصين معياري، فلم يتحول أي مبنى إلى ركام".
عموماً، يعدّ الوصول إلى "المماد" أسهل من ناحية الإنقاذ. ولكن من المهم التذكير بأن جزءاً كبيراً من التحصين صُمّم بالأساس لمواجهة الزلازل، بينما لا تصلح "المماد" في حالات الزلازل إطلاقاً، بل تصبح مصائد موت "حين يفترض بك الابتعاد عن المباني لا الاحتماء بها، لا فائدة من النزول إلى الملاجئ في هذه الحالة لأنك ستدفن فيها".
التبادلية والمصير المشترك
تتركز الحيرة والتردد بين "المماد" و"المماك" والملاجئ العامة في المناطق التي تتمتّع بقطاع عقارات جديد وسكان أكثر اقتداراً، بينما تفتقر مساحات شاسعة من البلاد لأي شكل من أشكال التحصين. في طمرة، قُتلت عائلة على الرغم من وجود "مماد" في المبنى الذي تسكنه، وهي حالة نادرة لبلدة تخلو من الملاجئ العامة. وتظل القرى البدوية غير المعترف بها في النقب المثال الأكثر هشاشة من ناحية التحصين، حيث قتل سبعة من سكانها في السابع من أكتوبر جراء سقوط القذائف وليس بسبب تسلل "المخربين". وهكذا، تعود الملاجئ العمومية لتفرض نفسها اليوم كخيار ضروري، [ليس فقط لأسباب أمنية بل أيضاً كـ]خيار مجتمعي وجماهيري يعيد مسؤولية التحصين إلى الدولة.
وعلى الرغم من تقديم جمعيات المجتمع المدني، مثل جمعية حقوق المواطن و"بمكوم"، التماساً إلى المحكمة العليا بعد السابع من أكتوبر بشأن تحصين المناطق القروية، فقد تم رفضه في يناير/كانون الثاني من العام الحالي. استندت الجمعيات في ادّعاءها إلى أن التدابير التي اتخذتها الدولة، كتحصينات مواقف نقل الطلبة، غير كافية لمواجهة التهديدات. ودعت إلى أن يتم نقل التحصينات إلى داخل المؤسسات التعليمية أو إعادة تنظيمها حسب توزيع السكان، مشيرة إلى أن التجمعات البدوية هي الأقل قدرة على تدبّر أمورها. في المقابل، احتجّت الجمعيات أيضاً على قرار الحكومة تقليص ميزانية إنشاء الملاجئ في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، باعتباره قراراً يناقض مبدأ "المساواة بين المواطنين". وقد ردّت المحكمة العليا بأن مقدمي الالتماس لم يثبتوا ما "يبرر التدخل في الإجراءات التي يتخذها المدّعى عليهم (الحكومة) المتعلقة بتقليص فجوات التحصين والإنذار في التجمعات البدوية"، مضيفةً أنه لم يُعرض أمامها "أساس للادعاء بوجود مسٍّ بمبدأ المساواة بين المواطنين فيما يتعلق بالتدابير المتخذة تجاه التجمعات البدوية".
تقول منسقة مشروع النقب في جمعية "بمكوم"، المهندسة المعمارية "دافنا سبورتا"، إن رد المحكمة العليا كان "مخيباً جداً" لاكتفائه بتطبيق حرفي لقانون الدفاع المدني. "التحصين في النقب محدود جداً، والوسائل التي يضطر الناس إلى اللجوء إليها للاحتماء يمكن أن تصبح مصائد موت. فالناس يختبئون في قنوات تصريف المياه على أطراف الطرقات، أو في أماكن مرتجلة".
وتضيف: "لقد ابتدعوا نوعاً من الحلول، يُسمّى 'إسكو'، وهو نوع "البلوكات" المكوّنة من كتل معدنية مملوءة بالرمل، ولكن الفائدة منها غير واضحة، وسرعان ما تحوّلت إلى مكبات للنفايات"، مردفةً بأن خصخصة التحصين، أو إلقاء مسؤوليته على السلطات المحلية، يجعل هذه المناطق هي الأكثر عرضة للإصابات. وتكمل: "على الدولة أن تعود لتحمّل مسؤولية التحصين. فهذه مهمة جماهيرية وتكاليفها عالية، ولا يمكن إضافة "مماد" في كل بيت. يجب أن يكون الحل شاملاً. وقد كشفت هذه الحرب عن إخفاقات متراكمة تمتد لسنوات طويلة في مجال التحصين، والتي تتجلى بوضوح لدى المجتمعات المهمشة".
هناك أيضاً ملاجئ نووية، برزت الحاجة إليها في الخمسينيات إبّان الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وعادت أهميتها إلى الواجهة مع [تصاعد المخاوف من] الطموحات النووية الإيرانية. ومن بين أبرز هذه المواقع التي تُعدّ ملاجئ نووية: ملجأ في باطن الأرض تحت ميدان "هبيما" في "تل أبيب"، وآخر تحت شارع "ديزنغوف"، إلى جانب ملجأ نووي ضخم يقع في المحطة المركزية الجديدة في "تل أبيب" يمكنه استيعاب 16 ألف شخص، وقد تمّ استخدامه في الأيام الأخيرة، فضلاً عن وجود منشأة في جبال القدس تستخدمها الحكومة كـ"حفرة". [ملجأ "يوم القيامة" تحت قرية لفتا المهجَّرة حيث تجتمع الحكومة خلال أوقات التصعيد الخطير.]
وعلاوةً على الجوانب التي أوردناها حول الملاجئ بتنوّعاتها، يضاف إليها أيضاً الفروقات النفسية بين الاحتماء في "المماد" مع العائلة النووية وبين المكوث مع الجيران والمعارف في "المماك" أو الملجأ العمومي التابع للبناية أو الحي. وحول المكوث في حيّز مشترك كالـ"مماك" أو الملجأ العام، يقول المعالج والباحث في مجال الصدمات النفسية الحادة، د. "زوهار روبنشتاين" من جامعة "ريخمان":
"نعلم أن للجماعة قوة خاصة، لا سيّما عندما تسود ديناميكية جيدة وداعمة وشعور بالتشاركية والمصير المشترك، فذلك يعزّز الشعور بالحصانة. وصحيح أنّه عندما تكون العائلات النووية مترابطة وجيدة، يمكنها توفير حصانة، لكنّ الوجود مع العائلة اضطرارياً قد ينتج ديناميكية إشكالية حتى في العائلات المستقرة. ولذلك، يمكن لوجود أناس آخرين أن يخلق توازناً، مع أن بعض الجيران يمكن أن يكونوا بمثابة "جهنم على الأرض". لهذا، من المهم الاعتناء بالمساحات المشتركة وأيضاً إيجاد سبل لاستخدامها في الأيام العادية".
إذا كانت لديّ إمكانية الدخول إلى "المماد" مع العائلة في مدينة أخرى أو البقاء وحدي في شقتي والنزول للملجأ، ما الخيار الأفضل بينهما؟
"عندما نرى المشاهد الصعبة والإصابات المباشرة التي تعرض لها "المماد"، وإن كانت الاحتمالات ضئيلة، فالنزول لملجأ تحت الأرض يمنح شعوراً أكبر بالأمان. الأمر أشبه بلعبة الروليت الروسي، حيث يصعب اتخاذ قرار حاسم فيها. على السلطات أن تعين الناس على تقييم الخيارات المتاحة، وينبغي برأيي أن تتوسّع الخيارات في التخطيط المستقبلي، وأن تكون هناك إمكانية للمكوث في حيز مشترك إلى جانب الحيز العائلي".
كتب "سوكري" روايته قبل 20 عاماً، في زمن سابق للعمليات العسكرية في غزة، وقبل السابع من أكتوبر، وقبل الهجمات الإيرانية، ومنذ حينها ترسّخت علاقتنا بالملجأ، يقول فيها: "أملي فيما يتعلق بمستقبل الدولة، التي استمرت دائماً بالتحرك كذنب سحلية مقطوع تحت كل صخور يأسي، قد خاب. فالانقطاع المتواصل، بينها وبين الجسد الذي ارتبطت به، قد قتلها. سأرحل حتى لا أعود للأبد، عليّ أن أترك البلاد مرة وإلى الأبد، قلت لنفسي. فقد تعلمت أن أتدبّر أمور حياتي من داخل الملجأ. وإذا أردت يمكنني أيضاً أن أتزوج في الملجأ وحتى أن أصبح والداً وأنا ما زلت فيه، ولكن الأطفال.. ما الذي سيحل بالأطفال؟"
في حالة الإنذار الحقيقي، فليتدبّر كل شخص نفسه
"عنات جورج"
في الماضي كانت الملاجئ عامة ومتاحة للجميع، ثمّ حُصرت لسكان البناية فقط، وبعدها لم تعد لأي أحد. وفي ظل الحرب مع إيران، عادت الملاجئ لتتصدّر المشهد، ولكن مع لسعة، فقط من يمتلك القدرة يمكنه الاحتماء في "المماد". وهكذا خصخصت الدولة الحيز المحصّن وحوّلته إلى تعبير عن عدم المساواة.
ليس من الواضح متى ستنتهي الحرب بين "إسرائيل" وإيران، ويبدو الآن بأن الملاجئ عادت لتكون سيدة المشهد بجدارة. فقد تحوَّل المبنى الخرساني تحت الأرض من عقار منسي ومهجور، يُستخدم في حالات كثيرة كمخزن أو كغرفة نفايات تفوح منها رائحة بول نفّاذة، إلى الضرورة الأكثر أساسية ووجودية. وإن كان من الممكن الاكتفاء بانتظار قصير في بيت الدرج أو في غرفة داخلية في البيت أمام صواريخ حماس والحوثيين، ففي حالة التهديد الإيراني لا أحد يجرؤ على المخاطرة. كما أن المدة الزمنية [القصيرة] بين وصول الإنذار الهاتفي وانطلاق صفارات الإنذار هي عامل يساهم بكل تأكيد في عدم المجازفة.
تظهر كل يوم قصص عن السرعة التي اضُطر السكان بها إلى إفراغ الملاجئ وتنظيفها، وعن الركض إليها في الليالي، عن الجيران الذين لم يكن بينهم كلام والآن يتقاسمون الطعام ويغنون ويعزفون معاً أو يتجادلون على الكلب أو الضجة أو السجائر، وأيضاً على إغلاق الأبواب في وجه الغرباء. كتبت "شاي سيغل" في منصة X: "ظننتم أنكم رأيتم كل شيء في هذه الحرب؟ إذن هاكم المزيد: عمتي، التي ليس لديها غرفة محصّنة، حاولت الدخول إلى ملجأ المبنى المجاور فطُردت من هناك. وبعدها علّق سكان المبنى اللطيف لافتة، يجب أن أرفق صورتها، كتبوا عليها أن الملجأ خاص ونتيجة للازدحام وتكدس السكان فيه: "يمنع دخول الزّوار".
وقد حُرم من هذا الخير [تقولها ساخرة] أولئك الذين لديهم "مماد" في بيوتهم ولا يحتاجون للبحث عن ساتر في منتصف الليل، أو التزاحم على كراسٍ بلاستيكية متهالكة أو الاحتكاك بالجيران غائري العيون. تروي أم لطفلين في منطقة المركز [4]: "في هذه الحرب يتجلّى الفرق بين الأطفال الذين يعيشون في بيت مجهّز بـ "مماد" وبإمكانهم متابعة نومهم حتى عند انطلاق صفارات الإنذار، وأولئك الذين يضطرون للاستيقاظ من النوم فجأة والجري مع والديهم إلى الملجأ ليلة بعد أخرى، وببساطة يحرمون من النوم في ليلهم". وأضافت: "نحن نسكن في الطابق الثاني، ولا يوجد مصعد، وننزل في الليل حاملين أطفالنا إلى ملجأ مشترك يخدم مبنييْن. لا توجد هناك أسرّة، فقط كراسٍ قديمة، وهو غير نظيف، ولكن لا خيار لدينا سوى الجلوس والانتظار". وأيضاً لا توجد تغطية خلوية في الملجأ، فتضيف: "يقرر أحد السكان المخاطرة ويخرج ليرى إن كانت الأمور قد هدأت، وإن كان بإمكاننا العودة للبيت".
مع أن الإصابة المباشرة بالـ"مماد" في "بتاح تكفا" أدت إلى مقتل الزوجين "ياعكوف" و"ديسي بلو" اللذين كانا محتمين فيه، تصرّ الجبهة الداخلية على التأكيد (ربما بغرض التهدئة) إن جميع أنواع الملاجئ تتمتع بنفس المستوى من الجودة.
ووفقاً لتقرير مراقب الدولة لعام 2018، يمتلك فقط 38% من السكان "مماد" في بيوتهم، بينما يعتمد 34% على ملاجئ قديمة بُنيت قبل عشرات السنين، كثير منها مهجور وغير مصان أو مغلق بالكامل. وفي السنوات الأخيرة. بُذلت جهود لتمتين المباني من خلال المخطط التفصيلي رقم 38 وتسهيلات منح رخص بناء "المماد"، ولكنّ نطاق تلك المشاريع ما زال محدوداً ومعظمها تنفذ في مناطق الطلب. وإن كان هذا غير كافي، فالمعطى المرعب الذي نشره مراقب الدولة في نفس التقرير هو أن 28% من السكان، أي قرابة 2.5 مليون شخص، ليس لديهم وصول إلى أي تحصين مناسب، وهؤلاء لا يملكون في حالات معينة سوى أن يصلّوا أو ينتظروا معجزة لإنقاذهم. نسبة كبيرة منهم من سكان البلدات العربية، التي وعلى الرغم من التطور في أبنيتها الحديثة التي تحتوي على "مماد"، تفتقر إلى ملاجئ عامة.
وبحسب تحليل أصدره مركز "إدفاه" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فإن أكثر من 55% من الأسر ذات المستوى المعيشي المرتفع تعيش في شقق فيها "مماد"، في مقابل أقل من 30% من الأسر ذات المستوى المعيشي المنخفض. وبحسب التقرير، لا تقتصر هذه الفجوات على الفوارق بين المدن، بل موجودة داخل حدود المدينة نفسها. ففي بئر السبع على سبيل المثال، يعيش فقط ما بين 14-28% من السكان ذوي المستوى المعيشي المنخفض في شقق مجهزة بالتحصين، مقابل 88% من أولئك ذوي المستوى المعيشي المرتفع.
ويمكن أن نجد هذه الفجوات الكبيرة في العديد من المدن الأخرى. لكن وبعيداً عن الإحصائيات، هناك فئة لا تعرف القلق: أصحاب رؤوس المال الذين بنوا في بيوتهم الخاصة ملاجئ مجهّزة ومرفّهة، وجزء منها ملاجئ نووية، حيث يمكنهم الاحتماء بدون بذل مجهود أو مجازفة.
تقول الأنثروبولوجية الاجتماعية من جامعة حيفا، "عملياه ساعر"، أن تفسير ذلك بسيط. فقد خصخصت الدولة التحصين المدني خلال العقود الأربعة الأخيرة، ولذلك الحماية من الصواريخ ليست مسألة متعلقة بالمكان الجغرافي، إنما هي مرتبطة بالمكانة الاقتصادية. "فمن يمكنه تحمل النفقات، يسكن في بيت أو شقة فيها تحصين، ومن لا يستطيع، عليه أن يعتمد على الملاجئ العامة التي تكون في حالات كثيرة مهجورة، أو في أسوأ الحالات، كما هو حال بدو النقب، لا خيار أمامهم سوى الجلوس تحت الجسور أو في قنوات تصريف المياه الخراسانية". وتضيف: "تخيلي امرأة كبيرة، أو أماً معها رضيع، عليها الجري إلى أماكن كهذه بدون تحصين معقول، هذه كارثة".
ومع أن هناك عدداً غير قليل من الأحياء القديمة في مراكز المدن التي تفتقر للـ"مماد"، خاصة في قلب البلاد مثل "تل أبيب" و"كفار سابا" و"هرتسيليا"، وبيوتها قديمة وغير مزوّدة بمساحات محصّنة، فإنّ بيوت الأحياء الحديثة في الأطراف مزوّدة بالملاجئ. ومع ذلك، لا يغيّر هذا من حقيقة أن الدولة مع مرور السنوات قلّصت مسؤوليتها عن بناء وتوفير الملاجئ وحوّلت العبء إلى الأفراد أنفسهم. وفي معظم الحالات، تظل المجتمعات المهمّشة هي التي تدفع الثمن.
بين حبل النجاة وحفلات الرقص
جاء الوعي بضرورة حماية "مواطني الدولة" من التهديدات الخارجية مع قيامها. ففي عام 1951، تمّ إقرار قانون الدفاع المدني، ثمّ أنشئ جهاز الدفاع المدني المكلّف بالتصدّي للغازات السامة والهجمات الجوية، بالإضافة إلى تنظيم المساحات المحصّنة وإدارتها وتعزيزها. ومن بين الأمور التي أُقرّت حينها كان إنشاء ملاجئ عامة في مراكز الأحياء والبلدات القروية. ولكن في الحقيقة استغرق تنفيذ المشروع وقتاً طويلاً وطُلب من المواطنين تدبّر أمور الاحتماء بأنفسهم.
تتذكر "ش"، وهي من مواليد "تل أبيب" عام 1948، عندما كانت طفلة في حرب سيناء 1956، وأيضاً حرب الأيام الستة 1967، وحرب يوم الغفران 1973 حين كانت أماً شابّة؛ وتتحدث عن كيف اعتمد سكان المدينة وسائل "التعتيم": "اعتادوا تثبيت لفائف من الورق المقوّى أو القماش الأسود على النوافذ، وتخفيت الأضواء في البيت، كي لا يرى طيارو العدو النور فيقصفوا البيوت". وتروي: "وزّع الدفاع المدني أكياساً، كنا نملؤها بالرمل ونثبّتها أمام مداخل البيوت لتكون حاجزاً أمام النيران"، مضيفةً بأنّه كان يتم طلاء مصابيح السيارات بالأسود لتخفيف الإضاءة، بما يمكّن من القيادة ليلاً ولكن تقليل الكوارث. أما "ن"، التي نشأت في تلك الفترة في منطقة المركز، فتتذكر كيف حفر أباها خندقاً في فناء بيتهم الجديد بسبب غياب أي تحصين مناسب، وكانت العائلة تهرع إليه في كل مرة تنطلق فيها صفارات الإنذار وتنتظر حتى عودة الهدوء.
بدأت عملية بناء الملاجئ العامة في الستينيات، وسرعان ما أصبحت جزءاً من المشهد "الإسرائيلي" العام، وحتى إلى مصدر جذب للأطفال الذين اعتادوا القفز والتزحلق فوق مبانيها المنحنية. ومع بداية السبعينيات، قبيل اندلاع حرب يوم الغفران، تَقرّر المضي خطوة إضافية إلى الأمام بإنشاء ملاجئ مشتركة خاصة بالمباني السكنية، لتسهيل الوصول إليها بشكل أيسر وأسرع. وانتقلت مسؤولية صيانة وتنظيف تلك الملاجئ من الدفاع المدني إلى السلطات المحلية، ومنها إلى السكان أنفسهم الذين راحوا يستخدمون الملاجئ لمآرب أخرى.
وبفضل الإبداع والإرادة، تحوَّلت تلك الملاجئ في فترات الهدوء النسبي إلى فضاءات اجتماعية فيها نوادٍ للقراءة والألعاب وزوايا للقاءات. وأذكر كيف كنا، ونحن أطفال، نحتفل فيها بأعياد الميلاد ونقيم حفلات الرقص على أنغام موسيقى الثمانينيات، على الرغم من نمو الطحالب وشعور الاختناق فيها. كانت تلك الملاجئ جزءاً لا يتجزأ من الحيّز العام، وكلما قلّ استخدامها لدوافع أمنية، لا سيما في مركز البلاد، تزايدت الاستخدامات الأخرى لها.
في مقابل ذلك، كان الوضع مختلفاً في المناطق الحدودية. في مناطق مثل "شلومي" و"نهاريا" و"كريات شمونه" والمطلّة، ظلت الملاجئ تؤدي دورها في حماية السكان من صواريخ الكاتيوشا التي كانت تُطلق من لبنان على مرّ السنين، خاصة خلال حرب عام 2006. وحينها، كانت الملاجئ مقصداً لمغنيين كثر، أبرزهم "ديفيد بروزا". أما في النقب الغربي، فكانت الملاجئ درعاً في مواجهة "رشقات" القسام والقذائف طيلة العشرين سنة الأخيرة.
ثقب الدولة الأسود
مع نهاية الثمانينيات، كانت معظم الملاجئ العامة، وكذلك الخاصة والمشتركة، قد هُجِرت وتحوَّلت إلى مخازن وغرف قمامة ومساكن مؤقتة للمشردين، وفي البلدات الحريدية إلى كُنُس وصفوف تعليم بديلة. لا أحد يعلم على وجه الحقيقة ما الذي يجري في الملاجئ، ولا أحد يكترث حقاً لذلك، حتى السلطات المحلية. يقول "شلومو لمبارت"، المدير العام لحركة "عوسيم شخوناه" وهي حركة اجتماعية لإيجاد قيادة محلية في الأحياء التي تعاني من ضوائق: "لقد تحوَّلت الملاجئ إلى ثقب أسود بالنسبة للدولة".
ووفقاً لـ"لمبارت"، يوجد اليوم نحو 28 ألف ملجأ عمومي، معظمها مهجورة، بدون عناية وبدون جهة مسؤولة عنها، إلى جانب عشرات آلاف الملاجئ الخاصة المشتركة، التي تعاني هي أيضاً من أوضاع سيئة. وفي المناطق ذات المستويات [المعيشية] المرتفعة، حيث توجد لجان منتظمة للأبنية، كان هناك من يهتم بالعناية بالملاجئ على مر السنين، ولكن في الأحياء الشعبية لم يكن هناك من يفعل ذلك. ويكمل: "في العامين الأخيرين، طفنا على عدد كبير من الملاجئ الخاصة المشتركة، وكان وضعها تعيساً، بعضها تملؤها القمامة حتى السقف، وأخرى تغمرها مياه الصرف الصحي، وبعضها تحوّلت إلى أوكار لتعاطي المخدرات". ويضيف: "السلطات لا تعتني بتلك الملاجئ، لأنها كما يبدو تعدّ ممتلكات خاصة، وكل ما يمكنها فعله هو فرض الغرامات، بينما تُخلي الجبهة الداخلية مسؤوليتها عنها. وكنتيجة لذلك، تُركت مئات الآلاف من السكان، سواء في الأطراف أو المركز، مكشوفين بلا حيّز محصّن قريب منهم يمكنهم الاحتماء فيه".
ويرى "لمبارت" أن المسألة لا تتعلق فقط بالتهديد الأمني، وإنما بالنواحي الاجتماعية والبيئية أيضاً، وهي جزء من الصورة الأعمق لحياة المراهقين المعرّضين للخطر، الذين يعيشون في واقع من الإهمال المادي وجو من العنف وانعدام الأمن في الشارع. ومن وجهة نظره، فإن تأهيل الأحياء السكنية، بما يشمل صيانة الملاجئ، هو شرط ضروري لإحداث التغيير، لافتاً إلى أن "الحرب تعزز الفرق بين طفل لديه "مماد" في بيته، وبين طفل مُضطرّ للجري نحو ملجأ مغلق ومهجور".
المسؤولية ملقاة على عاتق "السكّان" فقط
وُلد "المماد" في عام 1992، بعد حرب الخليج الثانية عام 1991. وقتذاك، وبدلاً من الجري نحو الملاجئ، جلسنا في غرفة عادية مرعوبين من التهديد العراقي آملين بأن الأشرطة اللاصقة والمناديل المبللة وأقنعة الوقاية من التلوث النووي والبيولوجي والكيميائي كفيلة بإنقاذنا من صواريخ تحمل رؤوساً حربية غير تقليدية. في نهاية المطاف، وبدلاً من السلاح الكيميائي الذي كان يُخشى منه، أطلق صدام حسين صواريخ "سكود" تسببت في خسائر مادية وبشرية، وتغيّرت مقاربة الأمن والحماية الشخصية في البلاد. فبدلاً من تعزيز الملاجئ العامة والخاصة المشتركة أو بناء ملاجئ جديدة، اتُخذ قرار بأن كل مبنى جديد يجب أن يحتوي على حيز محصّن داخل كل شقة.
كان المراد من "المماد" أن يقلّص الوقت اللازم للوصول إلى الملاجئ، بالإضافة إلى تحسين ظروف الموجودين فيه. لكن، ومنذ البداية، لم تتحمّل الدولة المسؤولية وإنما ألقتها على عاتق الأفراد، كما هو الحال في تكاليف بناء "المماد"، وبالتحديد على المطورين العقاريين والمقاولين الذين أضافوا بدورهم تكلفة بناء "المماد" على كاهل مشتري الشقق.
في البداية، طلبت الدولة من المقاولين بناء حيز محصّن بمساحة 5 م²، أي ما يعادل تقريباً نصف غرفة، ولاحقاً تمّت زيادة المساحة المطلوبة إلى 9 م² على الأقل، بينما يجب أن يكون سمك الجدار الخارجي 35 سم، وأن يتراوح سمك الجدار الداخلي بين 20 و25 سم.
وبطبيعة الحال، تؤدي كمية الإسمنت اللازمة لإنشاء "المماد" إلى رفع تكلفته بفارق كبير يفوق تكلفة بناء غرفة عادية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار الشقق. وعلى الرغم من أن "المماد" مصنّف كمساحة خدماتية في البناء، وذلك لمغزى ضريبي، إلا أنه يستخدم في كثير من الأحيان كغرفة إضافية. وفي عدد غير قليل من البيوت، ذهب أصحابها إلى أبعد من ذلك وأزالوا الباب الحديدي الثقيل وحوّلوه لغرفة عادية.
زرت في بداية الحرب صديقة في منطقة المركز، وعندما دوّت صفارات الإنذار، اقترحت أن نخرج لبيت الدرج بدلاً من التوجه لـ"المماد". تبيّن لاحقاً أنها أزالت باب "المماد" خلال عملية ترميم البيت ولم تكن قد أعادته بعد. تواصلت معها بعد أسبوع وأخبرتني أنها سارعت لإعادة تركيبه فوراً، فمع الصواريخ الإيرانية، لا مجال للعب.
ولتشجيع إضافة "مماد" في المباني التي شُيّدت قبل عام 1991، تمنح الجبهة الداخلية اليوم رخص البناء خلال 14 يوما فقط، حتى في المباني المكوّنة من طابقين، وهو وقت شبه خيالي في مفاهيم تراخيص التخطيط "الإسرائيلية". وبحسب ما نشرته صحيفة "ذي ماركر"، فقد أنشئ حتى الآن قرابة الـ 7500 "مماد" في مبانٍ مستقلة. وفي عام 2007، تقرّر تحصين كل المباني في النقب الغربي على نفقة الدولة، وهو ما طُبّق بشكل كامل. وفي عام 2018، اتُخذ قرار مماثل لتحصين المؤسسات العامة وآلاف البيوت في الشمال، ولكنه اقتصر على بضع مئات من المباني، بسبب نقص الميزانية. وبعد السابع من أكتوبر، بدأ تسريع عملية تحصين البيوت في الشمال من جديد، ولكنها لم تكتمل بعد.
المال ليس المشكلة
جعلت الحرب مع إيران من الملاجئ ضرورة ملحّة، ولكنّ المكوث فيها في 2025 يختلف جذرياً عمّا كان عليه الأمر في السبعينيات والثمانينيات، ليس فقط بسبب المعايير التي اعتدنا عليها في القرن الواحد والعشرين مثل التكييف والشبكة الخلوية، بل لأن "إسرائيل" اليوم أكثر انقساماً واستقطاباً. فعلى الأقل، حسب القصص التي تنتشر في الإعلام مؤخراً، أصبح المكوث في الملاجئ يشمل أحياناً مشادات كلامية بين الموجودين فيها. تصف لي صديقة تجربتها في الملاجئ: "الكل متعبون، لا نوم في الليل ولا طاقة لأحد، والأعصاب مشدودة وكل شيء كفيل بإشعال مشكلة".
ولكن من وجهة نظر البروفيسور "ساعر"، لا يعني هذا بأن الماضي كان أفضل حالاً، وتقول: "علينا ألا ننكر وجود التضامن في المجتمع "الإسرائيلي"، فهو ما زال موجوداً، ولا أن نشعر بالرومانسية لما كان عليه الوضع في الماضي. صحيح أن هناك حالات لسكان رفضوا مساعدة غيرهم، ولكن بالمقابل يوجد كثيرون آخرون يمدون يد العون بكل طريقة. هناك الكثير من القصص عن متطوعين وعن مساعدة متبادلة، ولقد رأينا ذلك بعد السابع من أكتوبر بوضوح في هبّة الناس المؤثِّرة للمساعدة، ونراها اليوم أيضاً".
أيضاً "لمبارت" يرى أن التضامن موجود، وينوب في كثير من الحالات عن الدولة. ويلفت إلى أنّه ومنذ عملية حارس الأسوار [معركة سيف القدس] عام 2021، رممت جمعية "عوسيم شخوناه" 5895 ملجأ في 12 مجلس محلي، منها "أشكلون" و"بتاح تكفاه"، و"بت يام" وأسدود، بتمويل من تبرعات شخصية وبمساعدة الاتحادات اليهودية في الخارج، من بينها "كِرن رودرمان". ونفّذ غالبية هذه الأعمال على الأرض متطوعون، كثر منهم شباب، عدا عن أعمال الكهرباء وتصريف مياه صرف الصحي بطبيعة الحال.
"المال ليس هو المشكلة، المشكلة هي أن الدولة تخلت عن الجبهة الداخلية لعقود وتعرِّض حياة المواطنين للخطر. في إحدى الحالات، أعدنا تأهيل ملجأ، وبعد نصف ساعة سقط صاروخ أمام المبنى، هذا هو الفارق بين الحياة والموت".
توضّح "ساعر" أن جوهر مسألة لتحصين يكمن في تخلّي الدولة عن مسؤوليتها، وتضيف: "كنت ضمن فريق من جمعية 'التجمع المدني – الشرقي'، أُعدّ تقريراً عن مستوطنة "أوفيكيم" كحالة دراسية لتخلي الدولة عن مسؤوليتها. وجدنا، على سبيل المثال، أن من قُتلوا في هذه المستوطنة في السابع من أكتوبر كانوا بالأساس شبّاناً خرجوا لمواجهة "المخربين"، ولكن التحصين في "أوفيكيم" تحديداً كان يعاني من قصور واضح. وأيضاً، في حي "ميشور هغيفن"، حيث يقع بيت "رحيل أدري" التي أجبرت وزوجها على المكوث لساعات طويلة داخل المنزل مع المقاتلين، توجد مربعات سكنية كاملة تفتقر إلى مساحات محصّنة يمكن الوصول إليها. واضُطر السكّان للركض تحت وابل الصواريخ نحو الملاجئ البعيدة الموجودة في المربعات السكنية المجاورة أو في مركز الحي، ما تسبّب بمقتل بعض كبار السن في الطريق أثناء محاولتهم الوصول.
لذلك، يمكن القول إن المجتمع "الإسرائيلي" قد انقلب إلى تجمّعٍ للأسر النووية، يتولى كل فرد مسؤولية نفسه. وعلى الرغم من أن هذه ظاهرة عالمية لم تستثنِ "إسرائيل"، فإنها لا تعني أن التضامن المجتمعي قد انعطب، وإنما تظهر أن ما تضرر هو واجبات الدولة تجاه مواطنيها".
الهوامش
1
[1] كلمة "مكلاتور" (מקלטור) هي دمج بين كلمتي "ملجأ" (מקלט) و"نور" (אור)، ليصبح معناها "ملجأ النور". وهي عنوان الرواية المقتبسة، التي تروي قصة شخص مجهول الهوية وتدور حول علاقته المعقدة بالدولة (إسرائيل)، بين الشعور بالولاء والانتماء لها وبين اشمئزازه من فسادها ومشكلاتها. ولذلك، يقرر الهروب منها إليها، ويعيش داخل الملجأ ليتدبّر شؤون حياته من داخله.
2
[2] "مماد" (ממ"ד) هي اختصار للكلمات العبرية (מרחב מוגן דירתי)، وتعني الغرفة المحصنة داخل الشقة، وسنستعمله في الترجمة كما هو دون ترجمته.
3
[3] "مماك" (ממ"ק) هو اختصار للكلمات العبرية (מרחב מוגן קומתי) ، ويقصد بها الحيز المحصّن المخصص لطابق سكني كامل، ونشير هنا إلى أنه عادة ما يستخدم لعدّة شقق أو مكاتب في داخل المبنى، بدلاً من وجود ملجأ "مماد" داخل كل وحدة سكنية.
عن الكاتب
مقال مُترجم
كاتب
اقرأ للكاتب
وسوم ذات صلة
شارك المقال على مواقع التواصل الاجتماعي
نضع بين أيديكم مقالين مترجمين عن العبرية يتناولان الملجأ في "إسرائيل" بوصفه فكرة وحاجة وجودية في مواجهة أخطار "العدو". فما أن انتشرت لبعض الوقت قناعات صهيونية بأن الحاجة إلى الملاجئ تراجعت، عاد النقاش من جديد تحت النار، ولكن هذه المرّة معنوناً بأنّ الملاجئ ذاتها لم تعد مكاناً آمناً وحصيناً يحمي من يلوذ بها، بل تحوّل بعضها إلى مصائد موت وأيضاً مواقع للصراع الاجتماعي، كما كشفت الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة. في ظل هذا التحول، وفيما يشتد النقاش الصهيوني العام، نتعرف أكثر في هذين المقالين على الملجأ الصهيوني وجذوره، في البيت-القلعة والحيّز العام، ونقرأ عن دلالاته في السردية الصهيونية وارتباطه بحروب "إسرائيل" التي لا تنتهي إحداها حتى تبدأ الأخرى، ونتوقف عند ما أظهرته المواجهة الأخيرة من عيوب قاتلة وفروقات مجتمعية عميقة تفرض على المجتمع الصهيوني وقيادته، من جديد، إعادة التقييم والتخطيط.
نُشر المقال الأول بتاريخ 19 حزيران 2025 في صحيفة "هآرتس" العبرية، بعنوان: 'تاريخ موجز للملاجئ "الإسرائيلية" منذ الخمسينيات وحتى تخلّي "الدولة" عن مسؤولياتها'، ونُشر المقال الثاني بتاريخ 20 حزيران 2025، في صحيفة "ذا ماركر" العبرية، بعنوان: 'في حالة الإنذار الحقيقي، فليتدبّر كل شخص نفسه'.
ترجمها لنا كريم قرط
تاريخ موجز للملاجئ "الإسرائيلية" منذ الخمسينيات وحتى تخلي "الدولة" عن مسؤولياتها
"نعما ريفاه"
"استسلمت. غرقت في الملجأ، وحدي. ها هو يؤازرني، لا كما يؤازر صديق حقيقي صديقه، وإنما كما يؤازر وكيل راعٍ، كما يؤازر من يريد أن يجعل الآخرين يدمنون على مؤازرته: "تعال"، سمعته يهمس لي من ثقب بابه الموصد الفضي. "ابق هنا، عندي أفضل لك، فهنا ستشعر بالأمن أكثر. ماذا، أتحتاج الحياة هناك في الأعلى؟ الأفضل أن تختبئ. هنا لن يصلك التلوث مطلقاً. هنا لن تصلك الدولة أبدا. صحيح أنني ملجأ، ولكنني لست معتماً...كلمتي إسمنت".
(من رواية "مكلاتور"، لـ "يوسي سوكري"، إصدار "يديعوت سفاريم"، 2005). [1]
منذ بداية الصهيونية و"إسرائيل" بمثابة أرض الملاجئ. فلكلٍّ منا، كما هو الحال مع "سوكري"، علاقته الحميمة مع ملجأ أو "مماد". [2] غير أن الشهور العشرين الأخيرة [منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة] قد أدت إلى خلخلة مفهوم التحصين في الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، مع تنوع أشكال التهديدات التي تواجهها الدولة، من التهديدات التي تستخدم فيها تكنولوجيا تعود للقرون الوسطى إلى تهديدات وكأنها [خارجة] من كتب الخيال العلمي.
لقد شيّدنا "مماد" [أي غرفة محصّنة داخل الوحدة السكنية] لكل بيت في غلاف غزة، ولكنّها اختُرقت في السابع من أكتوبر، لأنها كانت تحمي من الصواريخ لا من البشر. ولقد طوَّرنا أنظمة دفاع جوي هي من الأفضل بالعالم -قبة حديدية ومقلاع داوود والسهم- والتي منحتنا وهماً بالأمن، إلى درجة أنّنا لم نعد نهرع إلى الملاجئ عند التعرض لهجمات، غير أنّ هذا الدفاع الذي توفّره بدا قابلاً للاختراق عندما يواجه صليةً بعشرات الصواريخ البالستية.
وفي الأيام الأخيرة، اكتشفنا أيضاً أنه حتى "المماد" ليس محصناً ضد الإصابة المباشرة بصاروخ بالستي. فقد أثارت مشاهد الدمار في المباني الحديثة في "بتاح تكفا" هلعاً واسعاً، وذلك دون الحديث عن الفجوات العميقة في مستوى التحصين بين المباني القديمة والجديدة، وبين الأطراف والمركز، وبين الأغنياء والفقراء. وبذلك، يكون السؤال المطروح: أين هو المكان الأكثر أمناً؟ وكيف ينبغي لـ"الدولة" حماية جميع مواطنيها؟
قدّمت المهندسة المعمارية "تولاه عمير" عرضاً بعنوان بلد الملجأ – دفاع مدني مبنيّ، يناقش موضوع [التحصين] من زاوية نظرية وثقافية معتمدةً في معالجتها على مقاربة نقدية. و"عمير" هي أرملة "رون فوندوك"، أحد مهندسي اتفاق أوسلو وهي والدة "ماي فوندوك"، المديرة العامة لمنظمة "بلاد للجميع" التي تهدف لبلورة حل سياسي بديل للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني. وتقول بسخرية: "كان علينا في السابع من أكتوبر أن نضيف غاز الفلفل للملاجئ"، مضيفة: "في الحرب الحالية، يبدو أن من يقرّون السياسيات يملكون أسهماً في شركات النفط والزجاج. فقد أمضينا 70 عاماً ونحن نطوّر نظام التحصين، لنكتشف الآن وجود عيوب كثيرة، سواء أمام السلاح البدائي أو المتطور. ولكن لا أحد يسعى لتقديم حل سياسي الذي هو البديل الحقيقي".
يروي رجل إنقاذ مخضرم، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه تفقّد مؤخراً عدداً من المواقع التي تعرّضت لإصابات شديدة، قائلاً: "لم نواجه قبل هذه الحرب الحالية حالة أصيب فيها "مماد" إصابة مباشرة. ففي موقعين عملت فيهما، تعرض الملجأ لإصابة مباشرة ودُمّر، ولحسن الحظ كان أحدهما فارغاً ساعة الإصابة". ويضيف: "في كل المواقع، ظلت ملاجئ "المماد" المجاورة، سواء كانت فوق "المماد" المتضرر أو تحته، سليمة ولم يُصَب من كانوا بداخلها، على عكس الجدران والأعمدة العادية من حولها التي استُهدفت وانهارت". لكنّه يشير إلى أنه على الرغم من صمود الملاجئ الأرضية أمام الضربات المباشرة بشكل أفضل بكثير، "يمكن أن نواجه مشكلة في عمليات الإنقاذ إذا انهار المبنى فوق مدخل الملجأ. لجأ الكثيرون اليوم إلى مواقف السيارات، وعلينا التأكد من صلاحيتها كبديل للملاجئ، فإذا كانت لا تصلح قد تنهار على من فيها".
التخفف من المسؤولية في عام 1969
ومنذ قيامها، وضعت "إسرائيل" لوائح طوارئ لـ[تنظيم] بناء الملاجئ، ونصّ قانون الدفاع المدني لعام 1951 على وجوب توفّر استجابة أمنية قريبة لكل شقة، سواء عبر الملاجئ العامة أو المشتركة. وعلى الرغم من تعديل القانون أكثر من 20 مرة منذ ذلك الحين، لم يطبَّق بشكل كامل أبداً وظل مئات الآلاف من "مواطني الدولة" بلا ملاجئ، لا سيما في القرى غير المعترف بها في النقب [القرى العربية البدوية في ديار بئر السبع] والبلدات العربية والحريدية.
وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، أقيم عدد كبير نسبياً من الملاجئ العامة، ولا تزال العديد منها قائمة حتى اليوم. لكن مع نهايات الستينيات وبداية السبعينيات، بدأت الدولة تنقل مسؤولية بناء الملاجئ لأصحاب العقارات. وجاء في تعديل قانون الدفاع المدني لعام 1969: "مؤخراً، تنامت ظاهرة بناء المباني الضخمة، وأصبحت سياسة الدفاع المدني (التي عُرفت مع الوقت بالجبهة الداخلية) تُلزم أصحاب العقارات ببناء مساحات تحت أرضية تُخصص كملاجئ عامة، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي الباهظ الذي تتحمّله خزينة الدولة والمرتبط بإنشاء الملاجئ العامة".
وُلد "المماد" بعد حرب الخليج الثانية 1991 استجابةً لسببين رئيسيين: أوّلهما الخطر المتزايد من الهجمات بالغازات السامة، وثانيهما الحاجة لتقصير زمن الوصول للملاجئ نظراً إلى سرعة الصواريخ. وإلى جانب "المماد"، ظهرت أيضاً الغرفة المحصّنة المشتركة داخل المبنى، المعروفة باسم "المماك". [3] التي وعلى الرغم من فوائدها الجمة تكاد لا تُستخدم تقريباً إلا في سكنات الطلاب ومآوي كبار السن أو المباني السكنية ذات الشقق الصغيرة، كما هو الحال في حي "فلورنتين" في "تل أبيب". كما ترجع قلة إنشاء "المماك" واستخدامه إلى أنه مصنّف في لوائح التخطيط كمساحة خدماتية، لا كجزء أساسي من المساحة السكنية في الشقق، ويبيعه المقاولون كغرفة إضافية في الشقة. وقد تمّ إلغاء هذا التصنيف القانوني مؤخراً.
وشهد عام 2005 تحولاً جوهرياً إضافياً في المخطط التفصيلي رقم 38، بعد مراجعات ونسخ لا حصر لها، هدفت بشكل أساسي إلى تعزيز التحصين والجبهة الداخلية في مواجهة الزلازل والصواريخ. تعرض هذا المخطط لانتقادات شديدة بسبب تحويله السكّان إلى مخططين عقاريين يتحمّلون مسؤولية أمنهم بنفسهم، ما عمّق الفجوات الاجتماعية بشكل كبير.
خيار "المَماك"
"أحياناً كنت أخرج فقط حتى لا أفوّت سماع النبأ المرتجى بانتهاء الحرب، ولكنّ طلعاتي تلك كانت عبثاً. ليس فقط لأنّ هذا النبأ لم يأتِ، بل لأن كل خروج بدا وكأنه يدفع الذروة التالية [للحرب] إلى مستوى أعلى، حتى يصير بلوغ [نهايتها] مستحيلاً. ومع ذلك توصّلت لأمر واحد: انتبهت لحقيقة أنني لست وحيداً. تفحّصت باحثاً عن الونس آخرين يسيرون في الطرقات باضطراب شديد، يبذلون كل ما في وسعهم حتى لا تراهم عين الله [ولا تراهم] دولتهم". ("مكلاتور"، سوكري).
لم تنتهِ الحروب، وكبرت "إسرائيل". وفي العقدين الأخيرين، اتجه عدد متزايد من المهندسين المعماريين والمخططين إلى تعزيز خيار "المماك"، الذي تتمثّل إحدى ميّزاته في إتاحته هامشاً أوسع من الحرية من ناحية التخطيط المعماري. إذ يتم اقتطاع مساحته، التي تتراوح بين 20 و25 متراً مربعاً، من عدة وحدات في الطابق، ويمكن استخدامه كحيز عام مشترك لسكان الطابق أو مستخدميه.
وقد أظهرت الحرب الحالية ميزات إضافية للـ"مماك". إذ تقول المهندسة المعمارية "ميخال مئير"، التي شغلت مؤخراً مهندسة بلدية "بَت يام"، أن ما يجري حالياً للـ"مماد" كان متوقعاً. فقد "كان واضحاً أن الأخير مناسب في حالة الإصابات السطحية والشظايا، ولكنه لا يصمد أمام الضربات المباشرة. فهو مناسب أكثر لهجمات قادمة من قطاع غزة، بينما تبيَّن بأن المباني القديمة فيها ملاجئ أكثر أماناً. فالـ"مماد" يوجد غالباً كملحق خارجي للمبنى يتضمّن نافذة، باعتباره مصمّماً لأن يكون غرفة صالحة للسكن والاستخدام تمكّن المطور العقاري من تسويقه، وهذا ما يجعله أكثر عرضة للإصابات [المباشرة].
أما "المماك"، فمن السهل موضعته في قلب المبنى بالقرب من بيت السلالم، ما يجعله نواة [إنشائية] صلبة تصلح أيضاً في حالة حدوث زلازل، وتكاد احتمالية إصابته تكون معدومة. ولذلك، "يجب أن يتم تعديل القانون بحيث لا تحتسب مساحته ضمن مساحة البناء، بما يشجع المطورين العقاريين على اعتماده بدلاً من الـ"مماد". وبالتأكيد، يظلّ "المماد" خياراً أفضل من أي غرفة عادية أخرى في المبنى كونه يوفّر حماية من الأضرار غير المباشرة. ولكنّي متيقنة بأن جهاز التخطيط سيعيد التفكير في هذه المسألة في الفترة المقبلة".
لماذا ربطت "الدولة" بناء المزيد من الملاجئ العامة بهدم المباني القديمة؟
تشير المهندسة "مئير" إلى وجود الكثير من الضغوط، بما فيها الهستيريا، التي تحرّكها اعتبارات اقتصادية وتدفع باتجاه هدم المباني القديمة وبناء أخرى مكانها. وتكمل: "صحيح أن "المماد" [داخل الشقة] يتيح، مثلاً، ترك طفل نائم فيه عند الحاجة للتوجه إلى الملاجئ، ولكن يظل "المماك" والملاجئ العمومية خياراً أفضل من نواحٍ عديدة. ولا يقتصر هذا التفضيل على الاعتبارات الحضرية والمعمارية، بل أصبح واضحاً الآن أنها أفضل أيضاً من الناحية الأمنية. في المقابل، يتحتم على الدولة والسلطات المحلية أن تباشر في بناء ملاجئ عامة في الأماكن التي تفتقر إلى التحصين اللازم، بدلاً من انتظار تنفيذ مشاريع الهدم وإعادة البناء. وقد بادرت العديد من السلطات المحلية، مثل "بت يام"، الاستعداد للمرحلة الراهنة بتحويل المدارس والمراكز الثقافية والرياضية إلى أماكن يمكن للسكان الاحتماء داخلها. وعلى الرغم من الانتقادات، علينا أن نقرّ بأن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة التي تستجيب بطريقة هندسية معمارية لمواجهة الكوارث، سواء هجمات الصواريخ أو الزلازل".
أما المهندس "يوفال براك"، وهو المهندس السابق لبلدية "حاريش" ويعمل في مجال الإنقاذ، فيطرح وجهة نظر مغايرة حول "المماك"، مشدداً على ضرورة التفكير في مسألة صيانته واستخدامه الفعلي: "ماذا سنفعل بهذه الغرفة الفارغة؟". ومع أنه تعرض لإصابات مباشرة في الأيام الأخيرة، فهو يعتبر بأنّ "المماد" يظل الخيار الأمثل وتبقى "احتمالية تعرضه لإصابة مباشرة ضئيلة". ولكنه يقرّ في ذات الوقت بأن الملجأ الأرضي يظلّ أفضل من ناحية التحصين كونه يعزّز "مستوى الحماية بشكل كبير، بفعل عدم احتكاكه تقريباً بمستوى الأرض [أي أنه تحتها]، منبّهاً إلى ضرورة مراعاة سرعة الوصول إليه في التخطيط.
وعلى الرغم من سقوط القتلى ومشاهد الدمار، يرى "باراك" بأن الدولة تواجه تحدياً، إذ "لا يمكنها توفير الحماية المطلقة، والغالبية العظمى ممن احتموا في "المماد" أو الملاجئ لم يصابوا أو يموتوا". بالمقابل، يعتقد بأنّ التعديلات التي أجريت على نظام التحصين على مر السنوات، بهدف تحقيق التوازن بين الواقع ومستوى التهديدات، كانت جيدة بما فيه الكفاية ولا يوجد لها مثيل في العالم. ويشير بصفته رجل إنقاذ ومهندساً إلى أنّ الدمار الذي لحق يعتبر أمراً ثانوياً، مضيفاً "ما يهمني هو أن يكون الناس محميين. صحيح أن المباني أصيبت بشدة، ولكن معظم من كانوا بداخلها خرجوا سالمين، وهذه النجاة تعني أن لدينا نظام تحصين معياري، فلم يتحول أي مبنى إلى ركام".
عموماً، يعدّ الوصول إلى "المماد" أسهل من ناحية الإنقاذ. ولكن من المهم التذكير بأن جزءاً كبيراً من التحصين صُمّم بالأساس لمواجهة الزلازل، بينما لا تصلح "المماد" في حالات الزلازل إطلاقاً، بل تصبح مصائد موت "حين يفترض بك الابتعاد عن المباني لا الاحتماء بها، لا فائدة من النزول إلى الملاجئ في هذه الحالة لأنك ستدفن فيها".
التبادلية والمصير المشترك
تتركز الحيرة والتردد بين "المماد" و"المماك" والملاجئ العامة في المناطق التي تتمتّع بقطاع عقارات جديد وسكان أكثر اقتداراً، بينما تفتقر مساحات شاسعة من البلاد لأي شكل من أشكال التحصين. في طمرة، قُتلت عائلة على الرغم من وجود "مماد" في المبنى الذي تسكنه، وهي حالة نادرة لبلدة تخلو من الملاجئ العامة. وتظل القرى البدوية غير المعترف بها في النقب المثال الأكثر هشاشة من ناحية التحصين، حيث قتل سبعة من سكانها في السابع من أكتوبر جراء سقوط القذائف وليس بسبب تسلل "المخربين". وهكذا، تعود الملاجئ العمومية لتفرض نفسها اليوم كخيار ضروري، [ليس فقط لأسباب أمنية بل أيضاً كـ]خيار مجتمعي وجماهيري يعيد مسؤولية التحصين إلى الدولة.
وعلى الرغم من تقديم جمعيات المجتمع المدني، مثل جمعية حقوق المواطن و"بمكوم"، التماساً إلى المحكمة العليا بعد السابع من أكتوبر بشأن تحصين المناطق القروية، فقد تم رفضه في يناير/كانون الثاني من العام الحالي. استندت الجمعيات في ادّعاءها إلى أن التدابير التي اتخذتها الدولة، كتحصينات مواقف نقل الطلبة، غير كافية لمواجهة التهديدات. ودعت إلى أن يتم نقل التحصينات إلى داخل المؤسسات التعليمية أو إعادة تنظيمها حسب توزيع السكان، مشيرة إلى أن التجمعات البدوية هي الأقل قدرة على تدبّر أمورها. في المقابل، احتجّت الجمعيات أيضاً على قرار الحكومة تقليص ميزانية إنشاء الملاجئ في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، باعتباره قراراً يناقض مبدأ "المساواة بين المواطنين". وقد ردّت المحكمة العليا بأن مقدمي الالتماس لم يثبتوا ما "يبرر التدخل في الإجراءات التي يتخذها المدّعى عليهم (الحكومة) المتعلقة بتقليص فجوات التحصين والإنذار في التجمعات البدوية"، مضيفةً أنه لم يُعرض أمامها "أساس للادعاء بوجود مسٍّ بمبدأ المساواة بين المواطنين فيما يتعلق بالتدابير المتخذة تجاه التجمعات البدوية".
تقول منسقة مشروع النقب في جمعية "بمكوم"، المهندسة المعمارية "دافنا سبورتا"، إن رد المحكمة العليا كان "مخيباً جداً" لاكتفائه بتطبيق حرفي لقانون الدفاع المدني. "التحصين في النقب محدود جداً، والوسائل التي يضطر الناس إلى اللجوء إليها للاحتماء يمكن أن تصبح مصائد موت. فالناس يختبئون في قنوات تصريف المياه على أطراف الطرقات، أو في أماكن مرتجلة".
وتضيف: "لقد ابتدعوا نوعاً من الحلول، يُسمّى 'إسكو'، وهو نوع "البلوكات" المكوّنة من كتل معدنية مملوءة بالرمل، ولكن الفائدة منها غير واضحة، وسرعان ما تحوّلت إلى مكبات للنفايات"، مردفةً بأن خصخصة التحصين، أو إلقاء مسؤوليته على السلطات المحلية، يجعل هذه المناطق هي الأكثر عرضة للإصابات. وتكمل: "على الدولة أن تعود لتحمّل مسؤولية التحصين. فهذه مهمة جماهيرية وتكاليفها عالية، ولا يمكن إضافة "مماد" في كل بيت. يجب أن يكون الحل شاملاً. وقد كشفت هذه الحرب عن إخفاقات متراكمة تمتد لسنوات طويلة في مجال التحصين، والتي تتجلى بوضوح لدى المجتمعات المهمشة".
هناك أيضاً ملاجئ نووية، برزت الحاجة إليها في الخمسينيات إبّان الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وعادت أهميتها إلى الواجهة مع [تصاعد المخاوف من] الطموحات النووية الإيرانية. ومن بين أبرز هذه المواقع التي تُعدّ ملاجئ نووية: ملجأ في باطن الأرض تحت ميدان "هبيما" في "تل أبيب"، وآخر تحت شارع "ديزنغوف"، إلى جانب ملجأ نووي ضخم يقع في المحطة المركزية الجديدة في "تل أبيب" يمكنه استيعاب 16 ألف شخص، وقد تمّ استخدامه في الأيام الأخيرة، فضلاً عن وجود منشأة في جبال القدس تستخدمها الحكومة كـ"حفرة". [ملجأ "يوم القيامة" تحت قرية لفتا المهجَّرة حيث تجتمع الحكومة خلال أوقات التصعيد الخطير.]
وعلاوةً على الجوانب التي أوردناها حول الملاجئ بتنوّعاتها، يضاف إليها أيضاً الفروقات النفسية بين الاحتماء في "المماد" مع العائلة النووية وبين المكوث مع الجيران والمعارف في "المماك" أو الملجأ العمومي التابع للبناية أو الحي. وحول المكوث في حيّز مشترك كالـ"مماك" أو الملجأ العام، يقول المعالج والباحث في مجال الصدمات النفسية الحادة، د. "زوهار روبنشتاين" من جامعة "ريخمان":
"نعلم أن للجماعة قوة خاصة، لا سيّما عندما تسود ديناميكية جيدة وداعمة وشعور بالتشاركية والمصير المشترك، فذلك يعزّز الشعور بالحصانة. وصحيح أنّه عندما تكون العائلات النووية مترابطة وجيدة، يمكنها توفير حصانة، لكنّ الوجود مع العائلة اضطرارياً قد ينتج ديناميكية إشكالية حتى في العائلات المستقرة. ولذلك، يمكن لوجود أناس آخرين أن يخلق توازناً، مع أن بعض الجيران يمكن أن يكونوا بمثابة "جهنم على الأرض". لهذا، من المهم الاعتناء بالمساحات المشتركة وأيضاً إيجاد سبل لاستخدامها في الأيام العادية".
إذا كانت لديّ إمكانية الدخول إلى "المماد" مع العائلة في مدينة أخرى أو البقاء وحدي في شقتي والنزول للملجأ، ما الخيار الأفضل بينهما؟
"عندما نرى المشاهد الصعبة والإصابات المباشرة التي تعرض لها "المماد"، وإن كانت الاحتمالات ضئيلة، فالنزول لملجأ تحت الأرض يمنح شعوراً أكبر بالأمان. الأمر أشبه بلعبة الروليت الروسي، حيث يصعب اتخاذ قرار حاسم فيها. على السلطات أن تعين الناس على تقييم الخيارات المتاحة، وينبغي برأيي أن تتوسّع الخيارات في التخطيط المستقبلي، وأن تكون هناك إمكانية للمكوث في حيز مشترك إلى جانب الحيز العائلي".
كتب "سوكري" روايته قبل 20 عاماً، في زمن سابق للعمليات العسكرية في غزة، وقبل السابع من أكتوبر، وقبل الهجمات الإيرانية، ومنذ حينها ترسّخت علاقتنا بالملجأ، يقول فيها: "أملي فيما يتعلق بمستقبل الدولة، التي استمرت دائماً بالتحرك كذنب سحلية مقطوع تحت كل صخور يأسي، قد خاب. فالانقطاع المتواصل، بينها وبين الجسد الذي ارتبطت به، قد قتلها. سأرحل حتى لا أعود للأبد، عليّ أن أترك البلاد مرة وإلى الأبد، قلت لنفسي. فقد تعلمت أن أتدبّر أمور حياتي من داخل الملجأ. وإذا أردت يمكنني أيضاً أن أتزوج في الملجأ وحتى أن أصبح والداً وأنا ما زلت فيه، ولكن الأطفال.. ما الذي سيحل بالأطفال؟"
في حالة الإنذار الحقيقي، فليتدبّر كل شخص نفسه
"عنات جورج"
في الماضي كانت الملاجئ عامة ومتاحة للجميع، ثمّ حُصرت لسكان البناية فقط، وبعدها لم تعد لأي أحد. وفي ظل الحرب مع إيران، عادت الملاجئ لتتصدّر المشهد، ولكن مع لسعة، فقط من يمتلك القدرة يمكنه الاحتماء في "المماد". وهكذا خصخصت الدولة الحيز المحصّن وحوّلته إلى تعبير عن عدم المساواة.
ليس من الواضح متى ستنتهي الحرب بين "إسرائيل" وإيران، ويبدو الآن بأن الملاجئ عادت لتكون سيدة المشهد بجدارة. فقد تحوَّل المبنى الخرساني تحت الأرض من عقار منسي ومهجور، يُستخدم في حالات كثيرة كمخزن أو كغرفة نفايات تفوح منها رائحة بول نفّاذة، إلى الضرورة الأكثر أساسية ووجودية. وإن كان من الممكن الاكتفاء بانتظار قصير في بيت الدرج أو في غرفة داخلية في البيت أمام صواريخ حماس والحوثيين، ففي حالة التهديد الإيراني لا أحد يجرؤ على المخاطرة. كما أن المدة الزمنية [القصيرة] بين وصول الإنذار الهاتفي وانطلاق صفارات الإنذار هي عامل يساهم بكل تأكيد في عدم المجازفة.
تظهر كل يوم قصص عن السرعة التي اضُطر السكان بها إلى إفراغ الملاجئ وتنظيفها، وعن الركض إليها في الليالي، عن الجيران الذين لم يكن بينهم كلام والآن يتقاسمون الطعام ويغنون ويعزفون معاً أو يتجادلون على الكلب أو الضجة أو السجائر، وأيضاً على إغلاق الأبواب في وجه الغرباء. كتبت "شاي سيغل" في منصة X: "ظننتم أنكم رأيتم كل شيء في هذه الحرب؟ إذن هاكم المزيد: عمتي، التي ليس لديها غرفة محصّنة، حاولت الدخول إلى ملجأ المبنى المجاور فطُردت من هناك. وبعدها علّق سكان المبنى اللطيف لافتة، يجب أن أرفق صورتها، كتبوا عليها أن الملجأ خاص ونتيجة للازدحام وتكدس السكان فيه: "يمنع دخول الزّوار".
وقد حُرم من هذا الخير [تقولها ساخرة] أولئك الذين لديهم "مماد" في بيوتهم ولا يحتاجون للبحث عن ساتر في منتصف الليل، أو التزاحم على كراسٍ بلاستيكية متهالكة أو الاحتكاك بالجيران غائري العيون. تروي أم لطفلين في منطقة المركز [4]: "في هذه الحرب يتجلّى الفرق بين الأطفال الذين يعيشون في بيت مجهّز بـ "مماد" وبإمكانهم متابعة نومهم حتى عند انطلاق صفارات الإنذار، وأولئك الذين يضطرون للاستيقاظ من النوم فجأة والجري مع والديهم إلى الملجأ ليلة بعد أخرى، وببساطة يحرمون من النوم في ليلهم". وأضافت: "نحن نسكن في الطابق الثاني، ولا يوجد مصعد، وننزل في الليل حاملين أطفالنا إلى ملجأ مشترك يخدم مبنييْن. لا توجد هناك أسرّة، فقط كراسٍ قديمة، وهو غير نظيف، ولكن لا خيار لدينا سوى الجلوس والانتظار". وأيضاً لا توجد تغطية خلوية في الملجأ، فتضيف: "يقرر أحد السكان المخاطرة ويخرج ليرى إن كانت الأمور قد هدأت، وإن كان بإمكاننا العودة للبيت".
مع أن الإصابة المباشرة بالـ"مماد" في "بتاح تكفا" أدت إلى مقتل الزوجين "ياعكوف" و"ديسي بلو" اللذين كانا محتمين فيه، تصرّ الجبهة الداخلية على التأكيد (ربما بغرض التهدئة) إن جميع أنواع الملاجئ تتمتع بنفس المستوى من الجودة.
ووفقاً لتقرير مراقب الدولة لعام 2018، يمتلك فقط 38% من السكان "مماد" في بيوتهم، بينما يعتمد 34% على ملاجئ قديمة بُنيت قبل عشرات السنين، كثير منها مهجور وغير مصان أو مغلق بالكامل. وفي السنوات الأخيرة. بُذلت جهود لتمتين المباني من خلال المخطط التفصيلي رقم 38 وتسهيلات منح رخص بناء "المماد"، ولكنّ نطاق تلك المشاريع ما زال محدوداً ومعظمها تنفذ في مناطق الطلب. وإن كان هذا غير كافي، فالمعطى المرعب الذي نشره مراقب الدولة في نفس التقرير هو أن 28% من السكان، أي قرابة 2.5 مليون شخص، ليس لديهم وصول إلى أي تحصين مناسب، وهؤلاء لا يملكون في حالات معينة سوى أن يصلّوا أو ينتظروا معجزة لإنقاذهم. نسبة كبيرة منهم من سكان البلدات العربية، التي وعلى الرغم من التطور في أبنيتها الحديثة التي تحتوي على "مماد"، تفتقر إلى ملاجئ عامة.
وبحسب تحليل أصدره مركز "إدفاه" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فإن أكثر من 55% من الأسر ذات المستوى المعيشي المرتفع تعيش في شقق فيها "مماد"، في مقابل أقل من 30% من الأسر ذات المستوى المعيشي المنخفض. وبحسب التقرير، لا تقتصر هذه الفجوات على الفوارق بين المدن، بل موجودة داخل حدود المدينة نفسها. ففي بئر السبع على سبيل المثال، يعيش فقط ما بين 14-28% من السكان ذوي المستوى المعيشي المنخفض في شقق مجهزة بالتحصين، مقابل 88% من أولئك ذوي المستوى المعيشي المرتفع.
ويمكن أن نجد هذه الفجوات الكبيرة في العديد من المدن الأخرى. لكن وبعيداً عن الإحصائيات، هناك فئة لا تعرف القلق: أصحاب رؤوس المال الذين بنوا في بيوتهم الخاصة ملاجئ مجهّزة ومرفّهة، وجزء منها ملاجئ نووية، حيث يمكنهم الاحتماء بدون بذل مجهود أو مجازفة.
تقول الأنثروبولوجية الاجتماعية من جامعة حيفا، "عملياه ساعر"، أن تفسير ذلك بسيط. فقد خصخصت الدولة التحصين المدني خلال العقود الأربعة الأخيرة، ولذلك الحماية من الصواريخ ليست مسألة متعلقة بالمكان الجغرافي، إنما هي مرتبطة بالمكانة الاقتصادية. "فمن يمكنه تحمل النفقات، يسكن في بيت أو شقة فيها تحصين، ومن لا يستطيع، عليه أن يعتمد على الملاجئ العامة التي تكون في حالات كثيرة مهجورة، أو في أسوأ الحالات، كما هو حال بدو النقب، لا خيار أمامهم سوى الجلوس تحت الجسور أو في قنوات تصريف المياه الخراسانية". وتضيف: "تخيلي امرأة كبيرة، أو أماً معها رضيع، عليها الجري إلى أماكن كهذه بدون تحصين معقول، هذه كارثة".
ومع أن هناك عدداً غير قليل من الأحياء القديمة في مراكز المدن التي تفتقر للـ"مماد"، خاصة في قلب البلاد مثل "تل أبيب" و"كفار سابا" و"هرتسيليا"، وبيوتها قديمة وغير مزوّدة بمساحات محصّنة، فإنّ بيوت الأحياء الحديثة في الأطراف مزوّدة بالملاجئ. ومع ذلك، لا يغيّر هذا من حقيقة أن الدولة مع مرور السنوات قلّصت مسؤوليتها عن بناء وتوفير الملاجئ وحوّلت العبء إلى الأفراد أنفسهم. وفي معظم الحالات، تظل المجتمعات المهمّشة هي التي تدفع الثمن.
بين حبل النجاة وحفلات الرقص
جاء الوعي بضرورة حماية "مواطني الدولة" من التهديدات الخارجية مع قيامها. ففي عام 1951، تمّ إقرار قانون الدفاع المدني، ثمّ أنشئ جهاز الدفاع المدني المكلّف بالتصدّي للغازات السامة والهجمات الجوية، بالإضافة إلى تنظيم المساحات المحصّنة وإدارتها وتعزيزها. ومن بين الأمور التي أُقرّت حينها كان إنشاء ملاجئ عامة في مراكز الأحياء والبلدات القروية. ولكن في الحقيقة استغرق تنفيذ المشروع وقتاً طويلاً وطُلب من المواطنين تدبّر أمور الاحتماء بأنفسهم.
تتذكر "ش"، وهي من مواليد "تل أبيب" عام 1948، عندما كانت طفلة في حرب سيناء 1956، وأيضاً حرب الأيام الستة 1967، وحرب يوم الغفران 1973 حين كانت أماً شابّة؛ وتتحدث عن كيف اعتمد سكان المدينة وسائل "التعتيم": "اعتادوا تثبيت لفائف من الورق المقوّى أو القماش الأسود على النوافذ، وتخفيت الأضواء في البيت، كي لا يرى طيارو العدو النور فيقصفوا البيوت". وتروي: "وزّع الدفاع المدني أكياساً، كنا نملؤها بالرمل ونثبّتها أمام مداخل البيوت لتكون حاجزاً أمام النيران"، مضيفةً بأنّه كان يتم طلاء مصابيح السيارات بالأسود لتخفيف الإضاءة، بما يمكّن من القيادة ليلاً ولكن تقليل الكوارث. أما "ن"، التي نشأت في تلك الفترة في منطقة المركز، فتتذكر كيف حفر أباها خندقاً في فناء بيتهم الجديد بسبب غياب أي تحصين مناسب، وكانت العائلة تهرع إليه في كل مرة تنطلق فيها صفارات الإنذار وتنتظر حتى عودة الهدوء.
بدأت عملية بناء الملاجئ العامة في الستينيات، وسرعان ما أصبحت جزءاً من المشهد "الإسرائيلي" العام، وحتى إلى مصدر جذب للأطفال الذين اعتادوا القفز والتزحلق فوق مبانيها المنحنية. ومع بداية السبعينيات، قبيل اندلاع حرب يوم الغفران، تَقرّر المضي خطوة إضافية إلى الأمام بإنشاء ملاجئ مشتركة خاصة بالمباني السكنية، لتسهيل الوصول إليها بشكل أيسر وأسرع. وانتقلت مسؤولية صيانة وتنظيف تلك الملاجئ من الدفاع المدني إلى السلطات المحلية، ومنها إلى السكان أنفسهم الذين راحوا يستخدمون الملاجئ لمآرب أخرى.
وبفضل الإبداع والإرادة، تحوَّلت تلك الملاجئ في فترات الهدوء النسبي إلى فضاءات اجتماعية فيها نوادٍ للقراءة والألعاب وزوايا للقاءات. وأذكر كيف كنا، ونحن أطفال، نحتفل فيها بأعياد الميلاد ونقيم حفلات الرقص على أنغام موسيقى الثمانينيات، على الرغم من نمو الطحالب وشعور الاختناق فيها. كانت تلك الملاجئ جزءاً لا يتجزأ من الحيّز العام، وكلما قلّ استخدامها لدوافع أمنية، لا سيما في مركز البلاد، تزايدت الاستخدامات الأخرى لها.
في مقابل ذلك، كان الوضع مختلفاً في المناطق الحدودية. في مناطق مثل "شلومي" و"نهاريا" و"كريات شمونه" والمطلّة، ظلت الملاجئ تؤدي دورها في حماية السكان من صواريخ الكاتيوشا التي كانت تُطلق من لبنان على مرّ السنين، خاصة خلال حرب عام 2006. وحينها، كانت الملاجئ مقصداً لمغنيين كثر، أبرزهم "ديفيد بروزا". أما في النقب الغربي، فكانت الملاجئ درعاً في مواجهة "رشقات" القسام والقذائف طيلة العشرين سنة الأخيرة.
ثقب الدولة الأسود
مع نهاية الثمانينيات، كانت معظم الملاجئ العامة، وكذلك الخاصة والمشتركة، قد هُجِرت وتحوَّلت إلى مخازن وغرف قمامة ومساكن مؤقتة للمشردين، وفي البلدات الحريدية إلى كُنُس وصفوف تعليم بديلة. لا أحد يعلم على وجه الحقيقة ما الذي يجري في الملاجئ، ولا أحد يكترث حقاً لذلك، حتى السلطات المحلية. يقول "شلومو لمبارت"، المدير العام لحركة "عوسيم شخوناه" وهي حركة اجتماعية لإيجاد قيادة محلية في الأحياء التي تعاني من ضوائق: "لقد تحوَّلت الملاجئ إلى ثقب أسود بالنسبة للدولة".
ووفقاً لـ"لمبارت"، يوجد اليوم نحو 28 ألف ملجأ عمومي، معظمها مهجورة، بدون عناية وبدون جهة مسؤولة عنها، إلى جانب عشرات آلاف الملاجئ الخاصة المشتركة، التي تعاني هي أيضاً من أوضاع سيئة. وفي المناطق ذات المستويات [المعيشية] المرتفعة، حيث توجد لجان منتظمة للأبنية، كان هناك من يهتم بالعناية بالملاجئ على مر السنين، ولكن في الأحياء الشعبية لم يكن هناك من يفعل ذلك. ويكمل: "في العامين الأخيرين، طفنا على عدد كبير من الملاجئ الخاصة المشتركة، وكان وضعها تعيساً، بعضها تملؤها القمامة حتى السقف، وأخرى تغمرها مياه الصرف الصحي، وبعضها تحوّلت إلى أوكار لتعاطي المخدرات". ويضيف: "السلطات لا تعتني بتلك الملاجئ، لأنها كما يبدو تعدّ ممتلكات خاصة، وكل ما يمكنها فعله هو فرض الغرامات، بينما تُخلي الجبهة الداخلية مسؤوليتها عنها. وكنتيجة لذلك، تُركت مئات الآلاف من السكان، سواء في الأطراف أو المركز، مكشوفين بلا حيّز محصّن قريب منهم يمكنهم الاحتماء فيه".
ويرى "لمبارت" أن المسألة لا تتعلق فقط بالتهديد الأمني، وإنما بالنواحي الاجتماعية والبيئية أيضاً، وهي جزء من الصورة الأعمق لحياة المراهقين المعرّضين للخطر، الذين يعيشون في واقع من الإهمال المادي وجو من العنف وانعدام الأمن في الشارع. ومن وجهة نظره، فإن تأهيل الأحياء السكنية، بما يشمل صيانة الملاجئ، هو شرط ضروري لإحداث التغيير، لافتاً إلى أن "الحرب تعزز الفرق بين طفل لديه "مماد" في بيته، وبين طفل مُضطرّ للجري نحو ملجأ مغلق ومهجور".
المسؤولية ملقاة على عاتق "السكّان" فقط
وُلد "المماد" في عام 1992، بعد حرب الخليج الثانية عام 1991. وقتذاك، وبدلاً من الجري نحو الملاجئ، جلسنا في غرفة عادية مرعوبين من التهديد العراقي آملين بأن الأشرطة اللاصقة والمناديل المبللة وأقنعة الوقاية من التلوث النووي والبيولوجي والكيميائي كفيلة بإنقاذنا من صواريخ تحمل رؤوساً حربية غير تقليدية. في نهاية المطاف، وبدلاً من السلاح الكيميائي الذي كان يُخشى منه، أطلق صدام حسين صواريخ "سكود" تسببت في خسائر مادية وبشرية، وتغيّرت مقاربة الأمن والحماية الشخصية في البلاد. فبدلاً من تعزيز الملاجئ العامة والخاصة المشتركة أو بناء ملاجئ جديدة، اتُخذ قرار بأن كل مبنى جديد يجب أن يحتوي على حيز محصّن داخل كل شقة.
كان المراد من "المماد" أن يقلّص الوقت اللازم للوصول إلى الملاجئ، بالإضافة إلى تحسين ظروف الموجودين فيه. لكن، ومنذ البداية، لم تتحمّل الدولة المسؤولية وإنما ألقتها على عاتق الأفراد، كما هو الحال في تكاليف بناء "المماد"، وبالتحديد على المطورين العقاريين والمقاولين الذين أضافوا بدورهم تكلفة بناء "المماد" على كاهل مشتري الشقق.
في البداية، طلبت الدولة من المقاولين بناء حيز محصّن بمساحة 5 م²، أي ما يعادل تقريباً نصف غرفة، ولاحقاً تمّت زيادة المساحة المطلوبة إلى 9 م² على الأقل، بينما يجب أن يكون سمك الجدار الخارجي 35 سم، وأن يتراوح سمك الجدار الداخلي بين 20 و25 سم.
وبطبيعة الحال، تؤدي كمية الإسمنت اللازمة لإنشاء "المماد" إلى رفع تكلفته بفارق كبير يفوق تكلفة بناء غرفة عادية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار الشقق. وعلى الرغم من أن "المماد" مصنّف كمساحة خدماتية في البناء، وذلك لمغزى ضريبي، إلا أنه يستخدم في كثير من الأحيان كغرفة إضافية. وفي عدد غير قليل من البيوت، ذهب أصحابها إلى أبعد من ذلك وأزالوا الباب الحديدي الثقيل وحوّلوه لغرفة عادية.
زرت في بداية الحرب صديقة في منطقة المركز، وعندما دوّت صفارات الإنذار، اقترحت أن نخرج لبيت الدرج بدلاً من التوجه لـ"المماد". تبيّن لاحقاً أنها أزالت باب "المماد" خلال عملية ترميم البيت ولم تكن قد أعادته بعد. تواصلت معها بعد أسبوع وأخبرتني أنها سارعت لإعادة تركيبه فوراً، فمع الصواريخ الإيرانية، لا مجال للعب.
ولتشجيع إضافة "مماد" في المباني التي شُيّدت قبل عام 1991، تمنح الجبهة الداخلية اليوم رخص البناء خلال 14 يوما فقط، حتى في المباني المكوّنة من طابقين، وهو وقت شبه خيالي في مفاهيم تراخيص التخطيط "الإسرائيلية". وبحسب ما نشرته صحيفة "ذي ماركر"، فقد أنشئ حتى الآن قرابة الـ 7500 "مماد" في مبانٍ مستقلة. وفي عام 2007، تقرّر تحصين كل المباني في النقب الغربي على نفقة الدولة، وهو ما طُبّق بشكل كامل. وفي عام 2018، اتُخذ قرار مماثل لتحصين المؤسسات العامة وآلاف البيوت في الشمال، ولكنه اقتصر على بضع مئات من المباني، بسبب نقص الميزانية. وبعد السابع من أكتوبر، بدأ تسريع عملية تحصين البيوت في الشمال من جديد، ولكنها لم تكتمل بعد.
المال ليس المشكلة
جعلت الحرب مع إيران من الملاجئ ضرورة ملحّة، ولكنّ المكوث فيها في 2025 يختلف جذرياً عمّا كان عليه الأمر في السبعينيات والثمانينيات، ليس فقط بسبب المعايير التي اعتدنا عليها في القرن الواحد والعشرين مثل التكييف والشبكة الخلوية، بل لأن "إسرائيل" اليوم أكثر انقساماً واستقطاباً. فعلى الأقل، حسب القصص التي تنتشر في الإعلام مؤخراً، أصبح المكوث في الملاجئ يشمل أحياناً مشادات كلامية بين الموجودين فيها. تصف لي صديقة تجربتها في الملاجئ: "الكل متعبون، لا نوم في الليل ولا طاقة لأحد، والأعصاب مشدودة وكل شيء كفيل بإشعال مشكلة".
ولكن من وجهة نظر البروفيسور "ساعر"، لا يعني هذا بأن الماضي كان أفضل حالاً، وتقول: "علينا ألا ننكر وجود التضامن في المجتمع "الإسرائيلي"، فهو ما زال موجوداً، ولا أن نشعر بالرومانسية لما كان عليه الوضع في الماضي. صحيح أن هناك حالات لسكان رفضوا مساعدة غيرهم، ولكن بالمقابل يوجد كثيرون آخرون يمدون يد العون بكل طريقة. هناك الكثير من القصص عن متطوعين وعن مساعدة متبادلة، ولقد رأينا ذلك بعد السابع من أكتوبر بوضوح في هبّة الناس المؤثِّرة للمساعدة، ونراها اليوم أيضاً".
أيضاً "لمبارت" يرى أن التضامن موجود، وينوب في كثير من الحالات عن الدولة. ويلفت إلى أنّه ومنذ عملية حارس الأسوار [معركة سيف القدس] عام 2021، رممت جمعية "عوسيم شخوناه" 5895 ملجأ في 12 مجلس محلي، منها "أشكلون" و"بتاح تكفاه"، و"بت يام" وأسدود، بتمويل من تبرعات شخصية وبمساعدة الاتحادات اليهودية في الخارج، من بينها "كِرن رودرمان". ونفّذ غالبية هذه الأعمال على الأرض متطوعون، كثر منهم شباب، عدا عن أعمال الكهرباء وتصريف مياه صرف الصحي بطبيعة الحال.
"المال ليس هو المشكلة، المشكلة هي أن الدولة تخلت عن الجبهة الداخلية لعقود وتعرِّض حياة المواطنين للخطر. في إحدى الحالات، أعدنا تأهيل ملجأ، وبعد نصف ساعة سقط صاروخ أمام المبنى، هذا هو الفارق بين الحياة والموت".
توضّح "ساعر" أن جوهر مسألة لتحصين يكمن في تخلّي الدولة عن مسؤوليتها، وتضيف: "كنت ضمن فريق من جمعية 'التجمع المدني – الشرقي'، أُعدّ تقريراً عن مستوطنة "أوفيكيم" كحالة دراسية لتخلي الدولة عن مسؤوليتها. وجدنا، على سبيل المثال، أن من قُتلوا في هذه المستوطنة في السابع من أكتوبر كانوا بالأساس شبّاناً خرجوا لمواجهة "المخربين"، ولكن التحصين في "أوفيكيم" تحديداً كان يعاني من قصور واضح. وأيضاً، في حي "ميشور هغيفن"، حيث يقع بيت "رحيل أدري" التي أجبرت وزوجها على المكوث لساعات طويلة داخل المنزل مع المقاتلين، توجد مربعات سكنية كاملة تفتقر إلى مساحات محصّنة يمكن الوصول إليها. واضُطر السكّان للركض تحت وابل الصواريخ نحو الملاجئ البعيدة الموجودة في المربعات السكنية المجاورة أو في مركز الحي، ما تسبّب بمقتل بعض كبار السن في الطريق أثناء محاولتهم الوصول.
لذلك، يمكن القول إن المجتمع "الإسرائيلي" قد انقلب إلى تجمّعٍ للأسر النووية، يتولى كل فرد مسؤولية نفسه. وعلى الرغم من أن هذه ظاهرة عالمية لم تستثنِ "إسرائيل"، فإنها لا تعني أن التضامن المجتمعي قد انعطب، وإنما تظهر أن ما تضرر هو واجبات الدولة تجاه مواطنيها".