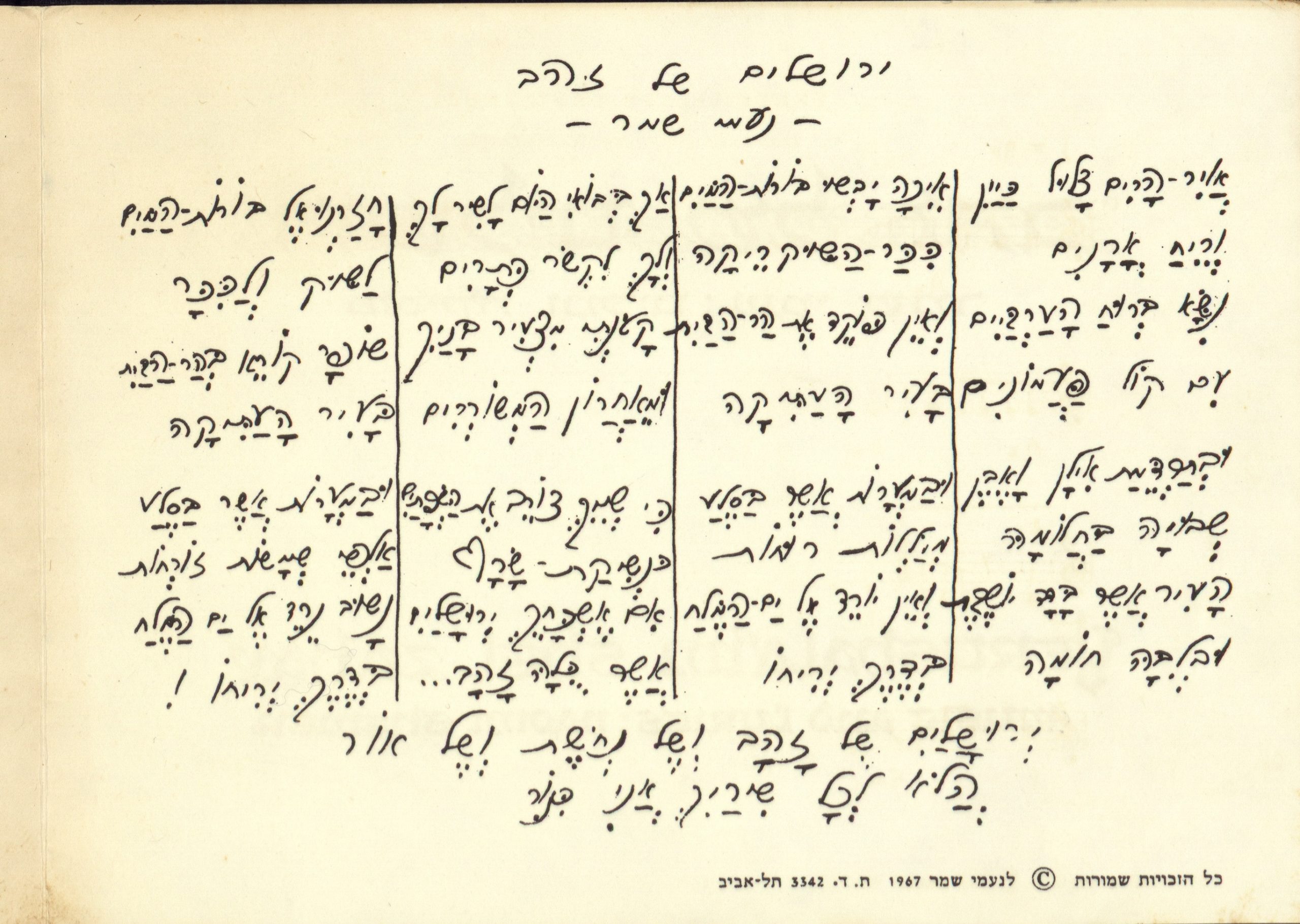تأتي موجة الأعمال الدراميّة الصهيونية ضمن محاولات إعادة إنتاج الرواية الصهيونية مرئيّاً في قالب الإثارة والمعضلات الأخلاقية والأفعال البطولية، تتيح عبرها شركات الإنتاج العالمية، مثل “نيتفليكس” و(HBO)، منصةً لتقديم مقولة العدو الجديدة في حربه الخطابية.
الحنين إلى البطولة
ماذا تفعل في ظل تفسّخ روايتك الأخلاقيّة والسياسيّة حول العالم؟ كيف تُقدّم نفسك في ظلّ التخبّط الخطابيّ والسياسيّ الذي يطال مشروعك أينما تذهب؟ قد تُساهم في نقل المعركة إلى حيّز المسلسلات الدراميّة والوثائقيّة، محاولاً تقديم “عقلانيّة” مخاوفك وسياساتك لجمهورٍ عالميٍّ ومتنوعٍ يُدمن على السرديّات التي تحتوي في ظلالها على المعضلات الأخلاقيّة لممارسة السلطة ضمن آليّات الدولة الليبراليّة، أو على إعادة سرد الرواية الصهيونيّة من خلال الدراما و”التوثيق” المُعقّد، وإعادة إحياء مفهوم “طهارة السلاح” الصهيونيّ، في عالمٍ تعلو فيه الأصوات التي تنبذ سلاح كيان العدو ودمويّته.
في الآونة الأخيرة، أُنتج حول كيان العدو العديد من الأفلام والمسلسلات، والتي تتضمّن كلاً من مسلسل “فوضى” (2015-2017) و”موساد 101″ (2015)، وبرنامج “لواء القدس” (2019)، وفيلم “منتجع البحر الأحمر للغطس”، إضافةً إلى فيلم “العملية النهائية” (2018) والذي يتناول عمليّة خطف الجنرال النازيّ “أيخمان” ومحاكمته، وفيلم “الملاك” (2018) حول العميل المصري أشرف مروان ودوره في حرب أكتوبر. يُضاف إلى ذلك مسلسلٌ جديدٌ من إنتاج (HBO)، بعنوان “أولادنا”، يتمحور حول عملية خطف المستوطنين الثلاثة في عام 2014، وتُستغلّ فيه قصة حرق وقتل الشهيد محمد أبو خضير في القدس المحتلّة ضمن محاولات صيانة هوية “إسرائيل” الأخلاقية حول العالم.
تأتي موجة المسلسلات والأفلام الدراميّة هذه كمحاولةٍ لإعادة إنتاج الرواية الصهيونية مرئيّاً؛ إذ تشمل أهم وأكثر عمليات كيان العدو نجاحاً بما تقدّمه من إثارةٍ ومعضلاتٍ أخلاقيّةٍ وأفعالٍ بطوليّةٍ. تنهمك هذه المسلسلات بتقديم مقولتيْن، الأولى أنَ “إسرائيل” لم تكن دوماً بريئةً، ولسان حالها: نعم، لُطّخت أيادينا بالدماء أحياناً، لكن رغم ذلك حافظنا على طهارة السلاح ما استطعنا، أو على الأقل على الشعور بالذنب بعد اقترافنا الجريمة الضروريّة. وتُبنى السرديّة هنا على لذّة ومتعة الخلل والخطأ والشوائب. أمّا المقولة الثانية فتُبنى على التحدّي الذي يخوضه المقاتل “الإسرائيليّ” بكامل تخبّطاته، فتُصبح أخطاء ذلك المقاتل مدخلَ المشاهد نحو التعاطف معه، وتفهّم تحديات طهارة السّلاح واستحالتها، خاصةً في مواجهة أعداءٍ لا يمتلكون أيّ حسٍ إنسانيٍّ.
وبهذا المعنى، يتمّ تقديم “طهارة السلاح” على أنّها استحالةٌ تبقى في الخلفيّة، وتساهم أحياناً في عملية التأنيب التي تطارد المُقاتل بعد كلّ معركةٍ، لكنّها بالمقابل غير ممكنةٍ كممارسةٍ على أرض الواقع. بتعابير أخرى، تصبح طهارة السّلاح أداةً خطابيةً تُوظّف في بناء التفوق الأخلاقيّ لدى الصهيونيّ على أعدائه؛ أي أنّها تساهم في بناء نظريّته في التفوق. بينما في الواقع، يحاكي الصهيونيّ عدوّه ويتفوّق عليه بقسوته. وتكمن المفارقة في أنّ امتلاكه للفلسفة وحديثه في الأخلاقيات وإحساسه بالذنب ما يجعله إنساناً أكثر من غيره، ويؤهّله لنزع صفة الإنسان عمّن يواجهه.
من ناحيةٍ أخرى، تشكّل هذه الأفلام والمسلسلات والإنتاجات الوثائقيّة حنيناً للنظرة الرومانسيّة للحرب والعسكرة، بكلّ ما تعنيه الحرب من مصدر إلهامٍ نحو قضايا وأيديولوجيّاتٍ كبرى تستحق القتال والموت لأجلها. فنجدُ المقاتل الصهيونيّ مدمناً على المعركة بكلّ تعقيداتها وهمومها وإشكاليّاتها وضغوطاتها، فمهما حاول خوض غمار حياةٍ يوميّةٍ مملةٍ، فهو لا يقوى على مقاومة العودة إلى عمليات المطاردة والإثارة والأدرينالين. ويأتي هذا الحنين للبطولة في زمن اندثارها في الرحم الاجتماعيّ الصهيونيّ، بل تفحّمها وتفسّخها لتصبح الحرب بعقيدتيها -الضاحية وجزّ العشب- أدواتٍ لعقلنة تجنّب المعركة وثمنها. بطبيعة الحال، لا يمكن أن تسرُدَ إنتاجات العدو بطولاتِ الآلة والتقنيّة فقط؛ إذ إنّ التعويل على ذلك يعني إمكانيّة الموت، وبالتالي خسارة سرديّة البطولة نفسها.
اقرأ/ي أيضاً: تمثيلات الشخصية اليهودية في السينما الصهيونية: تحولات أساطير البطولة
إنّ فهم”عقيدة الضاحيّة” على سبيل المثال، يدفعنا إلى إدراك أن كثافة العنف الذي يلوّح به العدو، تعبّر بدورها عن فشل خياراتٍ تكتيكيةٍ أخرى في مواجهة المقاومة في لبنان. بحيث يصبح الألم الذي يشمل الكلّ الاجتماعي اللبناني المسار الوحيد للنصر، أو بالحدّ الأدنى منع الهزيمة والإبقاء على معادلةٍ ملتبسةٍ حول النصر والهزيمة. بمعنىً أخر، إن تهديد الردع الرئيسي لـ “إسرائيل” اليوم هو التلويح بقدرتها على ارتكاب المجازر، واستحالة الجميع هدفاً أساسياً للأداة العسكرية “الإسرائيلية”.
الفريسة الفلسطينية
يفتتح الفيلسوف الفرنسيّ “شاميو” كتابه حول التاريخ الفلسفيّ للمطاردة (Manhunts: A Philosophical History, 2012) بمقولةٍ قد تبدو بديهيّةً: “كتابة تاريخ المطاردة والتعقّب هي كتابة أحد مكوّنات وجزيئات العنف لدى القوى المهيمنة، وهي أيضاً كتابة تاريخ تقنيّات التعقّب التي لا غنىً عنها في عملية إقامة وإعادة إنتاج الهيمنة في المجتمعات”. بتعابير أخرى، يُشكّل تاريخ المطاردة والتعقّب، بالإضافة إلى تاريخ التخلّص والاستثناء والقبض والقتل، مكوّناً أساسيّاً في تاريخ صعود الغرب وتبوئه موقع المُهيمن منذ القرن الخامس عشر إلى يومنا هذا. وتضمّنت عمليّات التعقّب والقتل والخطف إبادةَ السكان الأصلانيين في الأمريكتيْن وأستراليا، وتاريخ استعمار مناطق واسعةٍ من العالم، وخطف أكثر من خمسة عشر مليون إفريقيٍّ واستجلابهم كرقيقٍ للأمريكتيْن، وصولاً إلى استخدام الدرونز في عمليّة تصفية وقتل الفلسطينيين والعراقيين واليمنيين وغيرهم من أبناء شعوب منطقتنا.
ولكن ما يهمّنا هنا ليس عمليّة التعقّب كعمليّةٍ أنتجت تقنيّاتها فحسب، بل أنتجت علوماً كاملةً من علم اجتماع المراقبة إلى علوم البيانات وتحليلها وغيرها، تبرّر التعقب بضرورة تجميع بيانات البشريّة بأكملها على شاكلة ما تقوم به أجهزة الاستخبارات الصهيونية والأمريكية. كما تستدعي عملية المطاردة والصيد والتعقّب نظريةً حول الفريسة؛ أيّ حول من تُطارِد، ولماذا تطارده، وكيف تطارده، وإلى أيِّ مسعىً يتمّ مطاردته. وتتطلّب عمليّة التعقّب والمطاردة نظرياتٍ متعددةً ومترابطةً حول الفريسة وضرورة إقصائها أو خطفها أو إخضاعها أو قتلها. فمثلاً، استدعتْ عملية استجلاب الرقيق من القارة الإفريقيّة بناءَ نظريّةٍ في التفرقة على أساس اللون، مثّل الأسود فيها مَن “هو أقلّ من إنسانٍ وأكثر قليلاً من دابّةٍ”.
بالتالي، إنّ عمليّة اختطاف الأسوَد الإفريقيِّ وإخضاعه واستجلابه للعمل هي أيضاً عمليّة تعقبٍ ومطاردةٍ، لكنّها في بنيتها تسعى إلى القبض على عمّالٍ يمتلكون بنيةً جسديّةً تؤهلهم للعمل في ظروفٍ سيئةٍ بهدف نقلهم إلى قارةٍ أخرى. بينما تُشكّل عمليّة تعقّب وتتبّع اليهود في أوروبا إبّان الحرب العالميّة الثانية مسعىً آخر تمظهر في الإبادة وليس الخطف، وهي عمليةٌ تحتاج بطبيعة الحال إلى تحديد اليهوديّ وتعقّبه وخطفه كفريسةٍ ووضعه في معسكراتٍ وقتله، كما تحتاج إلي مجموعةٍ من الأفكار كتفوّق العرق الأبيض ومعاداة الساميّة. باختصار، تحتاج عمليّة التعقّب والمطاردة إلى نظريةٍ في الإقصاء، والتي قد تُبنى على أساس التقسيم البيولوجي للإنسان على شاكلة تفوّق عرقٍ على آخر، أو بناءً على ادّعاءاتٍ أخلاقيّةٍ تجعل من الإنسانيّة مدخلاً إلى صناعة تقسيمٍ عنصريٍّ جديدٍ، يكون فيه الامتثال إلى مجموعةٍ من القيم “الإنسانيّة” وسيلةً لنزع الإنسانيّة عن الآخر/العدو.
وعودٌ على بدء، فإنّ ما يقدّمه كيان العدوّ نظريّاً حول فريسته، عبر الأعمال الفنيّة والتوثيقيّة، يتمثّل بمبنى الشخصيّة الفلسطينيّة خاصّةً المقاوِمة منها، على أنّها بالغالب منهمكةٌ بالانتقام والمال، وتغلُب عليها المصالح الشخصيّة التي تتضمّن فقدان أيّ بوصلةٍ أخلاقيّةٍ، ولا تختزل ذلك بما يتعلّق بعمليّة انتقاء الأهداف لعمليّاتهم فحسب، بل أيضاً بخيانة أصدقائهم وزوجاتهم وأفراد أسرهم، كشخصيّة المقدسيّ في “فوضى”، أو كحرص عناصر شرطة العدوّ في برنامج “لواء القدس” على تصوير بيع المخدّرات في القرى والأحياء العربيّة في القدس؛ وكأنّه تعبيرٌ بطريقةٍ ما عن طبيعة المجتمع الفلسطينيّ وعدم اكتراثه بالتربية أو بالحبّ والعطاء للأبناء.
تصوّر هذه الأعمال الفنيّة “العدوّ” الفلسطينيّ المقاوم شخصاً يتمتّع بالقدرة على الكذب والخداع واستغلال المقرّبين له لتحقيق مكاسب شخصيّةٍ. كما تُقدَّم قدرات المقاومة الفلسطينية بعينٍ من التساوي وعدم التفاوت على الإطلاق. فمن ناحيةٍ، حينما يُصوَّر الفلسطيني على أنّه يمتلك هذه القوّة، تنكشّف حاجة الصهيونيّ إلى فريسةٍ يستطيع من خلالها إثبات حجم بطولته؛ أي أنّه يحاول إظهار التساوي في القوة بين الفلسطينيّ و”الإسرائيلي” والتباهي ببطولة الأخير وتفوّقه.
ومن ناحيةٍ أخرى، يكشف ما سبق جدليّة العلاقة ما بين الصيّاد والطريدة، حيث إنّ الهاجس الذي يُقلق الصهيونيّ دائماً يكمن في تخوّفه من أن يصبح هو الفريسة. ويعلّل “شاميو” ذلك بالقول: “تتعلّق الإشكاليّة الرئيسة بحقيقة أنّ الصيّاد والمطارد لا ينتميان إلى فصيلةٍ مختلفةٍ، نظراً لأن التمييز بين المفترس والفريسة ليس مدرجاً في قوانين الطبيعة، فعلاقة الصيد دائماً عرضةً لعكس الموقف والموقع”. وبالرغم من تطوّر نظريّاتٍ أنتجت الاستثناء والآخر، فواقع الأمر أنّ الصيّاد يهاب التحوّل إلى فريسةٍ دوماً. لذلك نجد أنّه في لحظات المصارحة، يصبح مقتل الشرطي في “اليسّام” على يد الشهيد مصباح أبو صبيح، الهاجس الأوحد الذي يحرّك قائد وحدة “اليسّام” في برنامج “لواء القدس”، ويظهر خوفه من تحولّه هو ورفاقه إلى هدفٍ يمكن ملاحقته.
في هذا السياق، لابدّ من الانتباه إلى أنّ المطاردة والتعقّب والبحث والمراقبة وجميع تقنيّات السّيطرة، بما فيها تطوّر السجن كمكانٍ للعقاب والاستثناء، هي تقنياتٌ ابتكرتها السلطة وتستند أساساً إلى فعل “الصيد”. وتكون الشرطة الجهاز المخوّل في بنية الدولة الحديثة بالقيام بعمليات الصيد والتعقّب والقتل والحبس، بينما يشكّل القانون ضابطاً، أو أحياناً كابحاً، لعمل الشرطة. لذلك، نجد أنّ معظم أفلام الأكشن أو دراما الشرطة والجريمة تتناول التوتر ما بين نصّ القانون ورؤية الشرطيّ لكيفيّة العثور على المجرم وعقابه. حيث يرى الشرطيّ في القانون والأدلّة والمحاكمة كابحاً يتوجب عليه أن يتخطّاه في مهمته لإيجاد “المجرم” واعتقاله. وبينما تعمل الشرطة كجهاز ردعٍ، تميّزها استطاعتُها القبض على من تحيلهم إلى موقع “الإجرام” و”الإرهاب”، أو غيرها من التقسيمات القانونيّة المبطّنة بالعنصريّة.
الفريسة والصياد
عندما خرج “يوسف حييم بن دفيد” وأصدقاؤه للبحث عن فريسةٍ، كان الطفل محمد أبو خضير بجسمه الهزيل هدفاً سهلاً وسائغاً. لم تكن في حوزة العصابة الصهيونيّة تقنيّات الدولة ومواردها (سواء منظومات الحبس الجماعيّ، أو تقنيات المراقبة الحديثة) في انتقاء الطفل الفلسطينيّ وخطفه وإخضاعه، لكنّ المجموعة امتلكت العقليّة والنظريّة ذاتها حول فريستها بالتأكيد. ويتّضح هنا الفرق الداخلي بين مَن تعتبره “الدولة” صيّاداً سيئاً ومن تعتبره صياداً فاضلاً. في كلتا الحالتين، يكون العربي والفلسطيني هما الفريسة، لكن في حالة الدولة وأجهزتها يكون تحديد الهدف، وخطفه أو قتله، شرعيّاً ومرغوباً وضروريّاً.
تكمن قسوة مشهد قتل الطفل أبو خضير في الالتفاف على الضحيّة وعزلها عن بيئتها، فضلاً عن العجز المطلق الذي تعرّضت له. بالمقابل، يمكن القول إنّ العزل هو المحرّك الرئيس لمعظم الاعترافات التي يستخرجها محقّقو الشاباك من المعتقلين. ويحاكي هذا العزل المرتبط ببيروقراطية الدولة عزلَ أبو خضير بأحراش القدس المحتلّة. بالحالتين، هو تعبيرٌ عن القدرة الكليّة لـ”السيد”، وعمّا يستطيع فعله.
كما تتّضح في هذه الحالة خيارات الطريدة، فإمّا تجد الحريّة بصمودها في وجه العزلة كما تجسّد حالة السجن، أو في خيار المواجهة حتى النهاية بعد الانكشاف الأخير؛ أي خيار الحريّة بالشهادة، كما اختار العديد من المطاردين الفلسطينيين.
تخبرنا مطاردة المقاومين في الضفة المحتلة أنّ هاجس المنظومة الأمنيّة بعد لحظة الصفر، أيّ لحظة القيام بأول فعلٍ، هو ألّا يتحوّل المقاوم الفلسطيني المطارَد من فريسةٍ إلى صيّادٍ مرةً أخرى، ولذا يسخّر العدوّ جميع الأدوات الممكنة من قواتٍ وتكنولوجيّاٍت لخلق حالة ضغطٍ على المطارَد ودفعه لمغادرة مخبئه، خاصةً في الساعات الأولى من حدوث العمليّة، والحيلولة دون وصوله لمكانٍ آمن. ويكمن الهدف من وراء توظيف جميع الموارد المتاحة هنا في إبقاء المُطارد مُطارداً. كما تخبرنا عمليّات المطاردة، التي تتّضح في البرامج الأخيرة، خاصةً في “فوضى” و”لواء القدس”، أنّ تتبّع الطرائد بفعاليّةٍ يحتاج إلى نوعٍ من أنواع “التعاطف” معها بهدف فهمها واستيعاب ذهنيتها.
لذلك، لا تختصّ وحدة المستعربين بالتنكّر والتمويه لأجل الوصول السريع والمفاجئ إلى فريستها فحسب، إنّما هي أيضاً وحدةٌ تحاول تقمّص الشخصيّة العربيّة ثقافيّاً ولغويّاً وجسديّاً، أو على الأقل تحاول استنساخ نموذجٍ عربيٍّ، بهدف فهم هدفها وتفاصيل حياته ومعاينتهما بدقة. لكن بالمقابل، تنكر هذه العملية الذهنيّة، والتي تتضمّن شيئاً من التعاطف، المسافةَ النفسية والاجتماعيّة وبنية العلاقة بين الطرفين. فإنْ كنتَ الصيّاد، ستُنكر في نهاية الأمر واقع المسافة الاجتماعيّة واستحالة إزالة الضباب عن الفريسة، التي تمثّل العدوّ الذي تخشاه أيضاً. وبالرغم ممّا تظهره برامج كـ”فوضى” و”لواء القدس” من إلمامٍ بالواقع الفلسطينيّ المحليّ، تطفو هذه المعرفة على السطح؛ إذ إنّها ليست استشراقيّةً فقط، كحاجة المرأة المضطهدة لنجدة الرجل الأبيض، إنّما أيضاً تُعدّ معرفةً مبنيّةً من خلال علاقة قوّة محدّدةٍ، وعلى مسافةٍ نفسيّة لا يمكن أن تكون حميميةً.
الصهيونية كعلامةٍ تجاريةٍ
أصبحت الصهيونية علامةً تجاريةً إشكاليّةً لكثيرٍ من روّادها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجه اليوم صعوبةً في إيجاد حواضن دعمٍ لها. لذلك، يسعى الكيان وداعموه إلى إيجاد هذه الحواضن من خلال الاشتباك والتعاون وتأجيج الأيديولوجيّات اليمينيّة، والتي لا تزال تحافظ على إرثٍ طويلٍ من معاداة الساميّة. وفي الوقت ذاته، يوجّهون اتهاماتٍ بمعاداة السامية لحركاتٍ تقدميةٍ تتجه نحو دعمٍ مُتزايدٍ للفلسطينيين، كاستراتيجيةٍ خطابيةٍ هجوميةٍ يحاول الكيان فيها إسكات الأصوات المتصاعدة في العديد من الحركات الاجتماعية والسياسية. [1]
ألقت هذه التحوّلات بظلالها على قوة الخطاب الصهيونيّ التقليديّ وتماسكه ورصانته. فمن جهةٍ، لم يُعد كافياً أو مقنعاً، ومن جهةٍ أخرى، بات مشبّعاً بالدفاعيّة والتحجّر. وفي ضوء هذا، تتكاثر المسلسلات والإنتاجات المرئيّة المثيرة التي تسرد انتصارات أجهزة الموساد والشاباك والجيش، وتستهدف جمهوراً واسعاً، تقدّم له الدراما والإثارة في “محاربة الإرهاب” العربيّ والفلسطينيّ.
وفي الولايات المتحدّة الأمريكية، بدأت حُمّى المسلسلات التي تتناول معضلات الأمن الصهيوني وتاريخ حروبه بمسلسل “الرهائن” الذي تحوّل فيما بعد إلى مسلسلٍ ناجحٍ يدعى “هوملاند” (Homeland). وقد كان لنجاح هذا المسلسل أثرٌ واضحٌ على توجهات شركاتٍ، مثل “نيتفلكس” و(HBO) و”أمازون” وغيرها، في التوجه لشراء أو إعادة إنتاج الدراما “الإسرائيليّة”، خاصةً وأنّ الكيان سبّاقٌ بما يخصّ السرديّات التي تتناول “مكافحة الإرهاب”، التي تحوّلت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر إلى الشغل الشاغل لأجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنيّة حول العالم.
إضافةً إلى ذلك، لا يمكن إغفال الدور الذي يلعبه المُنتج الثقافي في خلق تصوراتٍ حول “الصراع”، بل بالفعل يصبح تناول الشخصيّة الفلسطينيّة بتعقيداتها ضرورياً في عمليّة تدوير المنتج الصهيونيّ وتسويقه، والذي يُطرح كبرنامجٍ يحاول أنسنة الآخر، مثل مسلسل “فوضى”.
بلغةٍ أخرى، في عالمٍ بات يرى الصهيونية علامةً تجاريةً إشكاليةً، فإنّ توظيف الدراما والسرديّة الذكيّة بما فيها استدخال وجهة النظر الفلسطينيّة، أصبح ضرورةً في إنتاج التفوّق الأخلاقيّ الصهيونيّ. لذلك، تحافظ معظم هذه المسلسلات على بعضٍ من المانوية التي تتمحور حول ثنائية الخير والشر، ولكنّها تقول أيضاً إنّ الخير قد يتضمّن بعض الشر، والشر قد يتضمّن بعض الخير.
وتُساهم شبكات الإنتاج العالميّة الجديدة بشكلٍ فاعلٍ في تدوير وعرض “الهاسبرا” الجديدة لأسبابٍ مختلفةٍ، منها ما قد يكون أيديولوجياً عند البعض، ومنها ما يكون مدفوعاً من قبل الكيان وأجهزته المختلفة.
وهنا تحديداً، لا يمكن إغفال العلاقة الوطيدة والتاريخيّة بين شركات الإنتاج الأمريكيّة من جهةٍ، والبيروقراطيّة الأمريكيّة و”الإسرائيلية”، بما فيها أجهزة الاستخبارات والبنتاغون، من جهةٍ أخرى. إلّا أنّ هذه الإنتاجات تأتي أيضاً في سياق البحث الدائم عن قصصٍ تمزج ما بين الواقع والخيال، وتكون قادرةً على استقطاب الجمهور، خاصةً تلك التي تقدّم نفسها على أنها مستوحاةٌ من أحداثٍ حقيقيةٍ. وبهذا، ترى “إسرائيل” أنّ بمكنتها أن تكون علامةً تجاريةً قويةً، أو العلامة التجاريّة الأهم في العالم.
خاتمة
عندما قدّم العقيد في الجيش الصهيوني “عوري درومي” محاضرته حول آليّات عمل القوة الجويّة الصهيونيّة، اختار تصوير القوّة الجويّة كإنسانٍ نائمٍ يتعرّض إلى قرصات بعوضةٍ، فيستيقظ محاولاً التخلّص منها، ويحمل وسادةً ويضربها في كلِّ اتجاهٍ، حتى تخرج البعوضة الصغيرة من مخبئها وتستقرّ على حائطٍ ذي خلفيّةٍ بيضاء. وعن تلك اللحظة، يقول الكولونيل “عوري”: “أصبح لدينا هدفٌ”.
تأتلف الاستخبارات والمراقبة والجيش والشرطة والقوّة الجويّة جميعها للوصول إلى معلوماتٍ تؤدي إلى تحديد الأهداف وتطويرها، فضلاً عن تطوير آليّاتٍ تمكّن عمليّة الاستهداف، سواءً من خلال وحدة مستعربين أو من خلال طائرة F-36. لكن ما يثير الاهتمام هنا، أنّه وفي أحيانٍ كثيرةٍ تعمل المنظومة كما صوّرها الكولونيل ” درومي”، فتصحو في منتصف الليل وتعمل في ظلّ رؤيةٍ محدودةٍ، وتضرب في كلّ اتجاهٍ، وأحياناً يسعفها الحظّ في إيجاد هدفها. كما قد تخطئ المنظومة فلا تصيب هدفها، وقد تنتج أهدافاً لا يمكن ضربها، كحالها اليوم في بحثها عن إخضاع الفلسطينيّ وهزيمة إرادته.
ومؤخّراً، توقّف عرض برنامج “لواء القدس” على التلفزيون “الإسرائيلي” بعدما تبيّن تلاعب القائمين عليه وزرع “أبطال المسلسل” سلاحاً في بيت أحد الفلسطينيين، ضمن محاولات تقديمهم نجاحات وبطولات الشرطة في القدس للجمهور الصهيوني. وفي هذا ما يؤكّد أنّ أسوأ أنواع الصيادين هو ذلك النوع الذي يتخيّل البعوضة ويصطنعها من اللاشيء، فعلى الرغم من قدرات العدو، إلّا أنّ ظهوره بطلاً يستدعي كثيراً من التمثيل، حتى في مسلسلٍ توثيقيٍّ.
كما يكشف لنا زخم البرامج وعددها ونجاحها النسبيّ أمرين؛ أوّلهما أنّ “إسرائيل” تلعب دوراً فاعلاً في الترويج لهذه البرامج من خلال أجهزتها المختلفة، والآخر أنّها تُعاني من أزمة الرواية، والتي تساعدها في حلّها شركاتُ الإنتاج ومواقع العرض، كـ”نيتفلكس” و(HBO) وغيرها، وتوفّر لها منصةً لعرض سرديّتها عن نفسها وتقديم مقولتها الجديدة في حربها الخطابيّة حول العالم بكونها صيّاد القرن الواحد والعشرين الفاضل.
****
[1] لا يمكن تجاهل الجهود التي تبذلها “إسرائيل” على صعيد العالم العربي، بتعاونٍ كاملٍ مع أنظمةٍ عربيّةٍ مختلفةٍ، في الترويج لنفسها وروايتها للمجتمعات العربية.